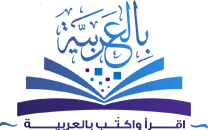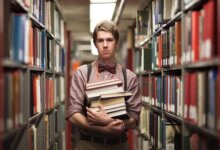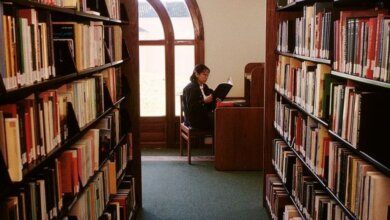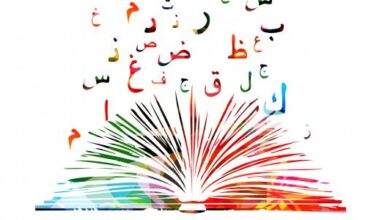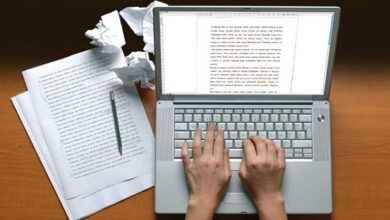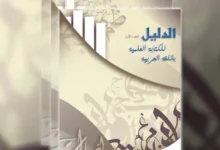التأنيث والتذكير في اللغة العربية – أخطاء الشائعة
- الدليل المنهجي للكتابة باللغة العربية -

قضية التذكير والتأنيث في اللغة العربية؛ من القضايا التي تُربك الكُتَّاب، خصوصا أولئك الذين يكتبون بالعربية من غير الناطقين بها. ومؤخراً؛ شاع هذا الخطأ واستفحَل فيمن يُنسَبون للعربية لسانا وانتماءً، واختلَّ ميزانُهم اللغوي.
ومِمَّا زاد الطينَ بلةً وفاقم المشكل أكثر؛ تسرُّبُ عباراتٍ غريبة وتراكيبَ شاذة من الصحافة المكتوبة إلى المُعجم التعبيري العربي الخاص بالحقول العلمية والمعرفية الأخرى.
وأنت تُطالع مقالا صحفيا أو ندوة علمية مطبوعة، ستتفاجأ بِوُرُودِ عبارات دالة على التذكير منسوبة للمؤنث، وقد شاع هذا أكثرَ ما شاعَ؛ في التعريف بالصفة العلمية للأنثى، فتجد على سبيل المثال؛ الدكتور: فاطمة – العميد: عائشة – الرئيس: نعيمة – النائب: مريم …، وغيرها كثيرٌ من هذه الألفاظ التي تُذكَّر وحقُّها التأنيث.
وعند البحث والتحري؛ لا تجد أيَّ مصوّغ أو إكراه أو صعوبة تُفضي إلى هذا الخطأ وإلى هذا الخلط المتعمَّد في تعريف المؤنث باللفظ المذكر، سوى أنها صارت موضةً تسرَّبت إلى التحرير العلمي عن طريق ما يسمى بـ(لغة الصحافة). أما عندما يَرِد هذا الخلط في تركيبٍ جمليّ؛ فالأمر يصبح أكثر سوءً وفجاجة. كأن تجد مثلا العبارة التالية:
(أعلنَ مدير مركز الأبحاث؛ الأستاذ الدكتور: مُنى فُلان؛ أنها ستُعلنُ عن الخطوات المستقبلية لسياسة المركز العلمية، وأضاف الدكتور قائلا ” إنني مهتمةٌ كثيرا بتطوير أنشطة المركز العلمية وواثقةٌ من قدرات وإمكانيات أعضائه، ومتفائلةٌ بمستقبلِه العلمي والمعرفي).
في هذا المثال؛ نجد أن مبتدأ الجملة يشير إلى المذكر (أعلن مدير مركز الأبحاث) في حين أن مُستأنَف الجملة يشير إلى المؤنث (أنها ستُعلن). ثم نُسِبَ الكلام مرة أخرى للمذكر (وأضاف الدكتور قائلا) ثم استُؤنفت الجملة بصيغة المؤنث (إنني مُهتمَّة – وواثقة – ومتفائلة).
وهذا الخلط والتلاعب بالصيغ؛ ظُلمٌ وتعدٍّ إجحافٌ في حق اللغة العربية. فهذا الخطأ مقصودٌ. ومردُّهُ أن كثيراً من الكتاب يعتقدون أن المناصب والمراكز السياسية: (رئيس – محافظ – والي- وزير – حاجب …). والإدارية: (مدير – مستشار – نائب – مندوب …). والعلمية: (عميد – ناظر – دكتور – أستاذ – مفتش …). تُذكَّرُ كلُّها قطعا.
وسببُه بالدرجة الأولى؛ هيمنة الذكور على المناصب والمراكز السيادية والقيادية. وبالتالي؛ وجب الحفاظ عليها مذكرةً كتابةً، بِغض النظر عن جنس من يتولاها رجلاً كان أو امرأة.
ويعتقد البعض الآخر ممن تشبَّع بالفكر الذكوري؛ أن توَلِّي المرأة للمراكز العليا والمناصب السيادية، مجرَّدُ استثناءٍ، والاستثناء لا يُقاس عليه. والأصل؛ هو تذكيرُها قطعا، لأنها مجالٌ موقوفٌ مُخصص حصرا للذكور دون الإناث. (والصواب غير ذلك طبعا).
ففي اللغة العربية الفصيحة قديما وحديثا نجد لفظيْ: ملك وملكة – أمير وأميرة – رئيس ورئيسة – وزير ووزيرة – مدير ومديرة – عالم وعالمة – كاتب وكاتبة – دكتور ودكتورة- أستاذ وأستاذة – طالب وطالبة …،
تُتيح اللغة العربية إمكانيات كبيرة وجبَّارة في تأنيث المذكر وتذكير المؤنث، عكس اللغات الأخرى التي تعاني من فقر شديد في وصف المذكر والمؤنث، ولو جاز استعمال الألفاظ المذكرة للإحالة على المؤنث كما يزعم البعض، إذا لجاز أن نقول:
(هذا رجلٌ – وهذا امرأة)
ولكن الأمر لا يستقيم. وبالتالي وجب التمييز بين الجنسيْن بما تُتيحه اللغة العربية من إمكانيات تعبيرية؛ سواءً بأدوات التذكير والتأنيث أو باستعمال أسماء الإشارة الخاصة بكل جنس.
ولكن للأسف؛ يُصر البعض على إغلاق الباب وإحكامِه في مثل هذه الأمور البسيطة، لا لشيء؛ سوى لتظل الأنثى حبيسةً، بعيدةً ومغيَّبةً عن أمورٍ هيمنَ عليها الرجل وجعلَها حكرا عليه وحدَه. في حين تتيح اللغات الأجنبية الأخرى إمكانية تأنيث المذكر وإن بكفاءة أقلَّ بكثيرٍ من اللغة العربية.
ففي اللغة الإنجليزية مثلا، سنجد كثيرا من الألفاظ التي تصلح للجنسين معا، لعجزها عن حمل علامة التذكير والتأنيث فنجد (Writer ) تستعمل للكاتب والكاتب، كما أن لفظة (Child) تطلق على الطفل والطفلة.
ولأن اللغة الإنجليزية قاصرة وعاجزة عن التعبير عن الطفلة وعن الكاتبة؛ فقد مُنح اللفظ لهما مناصفة بين الذكور والإناث، نفس الشيء يتكرر مع اللغة الفرنسية.
فكثير من الألفاظ الفرنسية مبهمةٌ فيما يخص قضية التذكير والتأنيث، مما دفع اللغة الفرنسية إلى إنتاج أدوات للتعريف من قبيل (le – un) للمذكر و (la – une) للمؤنث، ففي حين أن اللغة العربية التي تفيض بعلامات التأنيث، نجد من يَضِنُّ بها ويبخل بها عن الأنثى أهمالاً أو تجاوُزاً.
تتيحُ اللغة العربية إمكانيات اشتقاقية هائلة لتوليد اللفظ المذكر من اللفظ المؤنث والعكس، وتمتلك أدواتٍ كثيرة ومتنوعة لتصنيف وتحديد وتمييز المذكر من المؤنث.
وإنَّ من عجائب اللغة العربية؛ أنها اشتَقَّت المذكر ليس من المؤنث فقط؛ بل من أصل التأنيث الذي هو المرأة. فاسم (امرؤٌ) اشتق من لفظة (امرأة). فنجد: امرؤ القيس– ونقول:
(امرأةٌ فاضلةٌ – وامرؤٌ فاضلٌ).
بل إن من عجائب اللغة العربية كذلك؛ أنها جعلت للأنثى ألفاظا خاصة بها لا يمكن تذكيرها، والأعجب من ذلك، أن هذه الألفاظ لا تحمل أي علامة تأنيث. ورغم ذلك، لا يمكن للذكر استعمالُها أو استعارتُها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
(عجوز) (في المذكر نقول؛ شيخ) – (أرملة) – (حامل) – (عانس) – (أيِّم) – (طالِق) – (عاقِر) – (ثيِّب) – (بِكر) …
تُتيح اللغة العربية كذلك؛ إمكانية اشتراك استعمال بعض الألفاظ في التذكير والتأنيث. إذ يصح فيها الوجهيْن، فإن ذكَّرتها (باستعمال اسم الإشارة هذا) صحَّتْ، وإن أنَّثتها (باستعمال اسم الإشارة هذه) صحَّتْ كذلك، ومنها:
(حال)، (حانوت)، (دلو)، (ذراع)، (سكين)، (طريق)، (ملح)، (فرس)، (رأس)، (الطريق)، (السوق) …،
ونجدُ كذلك في لغتِنا العربية الجميلة، ألفاظاً موحدةً يشترك في استعمالِها الذكر والأنثى ومنها: (عروس) – (زوج) – (بِكر) (نقول ولدٌ بِكْر وبنتٌ بِكْرٌ).
إن موضوع التذكير والتأنيث في اللغة العربية؛ موضوع سهل جداً وبسيط للغاية، ومقدور على استيعابه وفهمِه وتمثُّلِه جملةً.
- علامات التأنيث في اللغة العربية
التاء المربوطة: وهي الأشهر والأكثر استعمالا ومِثالُها : طبيبة – عالمة – رُبانة – مهندسة – ملكة – مديرة – أستاذة …،
يجب مراعاة المعنى المقصودة في حال نقل اللَّفظ من المذكر إلى المؤنث باستعمال التاء المربوطة (ة). فهناك أسماءٌ يتغير معناها كليا؛ في حالِ تطبيق قاعدة التاء المربوطة عليها، ومثالُها: (طريق) و (طريقة) – (مكان) و (مكانة) – (جَمل) و (جُملة) …،
كما أن هناك الكثير من الأسماء والصفات المؤنثة لفظا، والتي تحمل علامة التأنيث (التاء المربوطة) والمذكرة معنىً، وهي مخصوصة للمذكر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
الأسمـــاء: (عُتبة) – (حمزة) – (عُقبة) – (عنترة) – (معاوية) ..
الصفـــات: (علاَّمة) – (داهية) – (طاغيَّــة) – (داعية) ..
كما يمكن الحصول على صيغة جمع المذكر من الألفاظ المؤنثة التي تنتهي بالتاء المربوطة، فقط بحذف التاء المربوطة منها ومثالها:
(وردة – وردٌ)، (زهرة – زهرٌ)، (قطْرة – قطرٌ)، (قُبلة – قُبَلٌ)، (سحابة – سحابٌ)، (شجرة – شجرٌ)…،
- ألف التأنيث المقصورة: ومثالها؛ الأسماء المنتهية بألف مقصورة (ى) كـــ: (لبنى) – (هدى) – (منى) – (ليلى) – (نجوى) – (سلوى)…،
- ألف التأنيث الممدودة: ومثالها؛ الأسماء المنتهية بألف ممدودة (أ) كــ: (حسناء) – (أسماء) – (هيفاء) – (صحراء) – (سماء) …،
هناك بعض الأسماء المؤنثة التي لا تحمل أيًّا من علامات التأنيث كــ: (سعاد) – (هند) – (قوس) – (درع) – (نار) – (نعل) – (فأس) – (ساق) – (فخد) – (بئر) – (قدم) – (عين) – (شمس) …
في (أعضاء الجسم)؛ هناك قاعدة سهلة جدا لتمييز المذكر منها عن المؤنث؛ حيث إن الأزواج من الأعضاء كــ (العين، القَدَم، اليد، الأذن، الرئة، الكِلية …) يُناسبها التأنيث. والأعضاء الأخرى يُناسبها التذكير ومنها: (القلب، الأنف، الفم …).
- اخترنا لكم في هذا العدد، قاعدة سهلة وهامة للغاية؛ تتعلق بمعرفة مواطن استعمال حرفيْ ((أو)) و ((أَمْ)).
يُستعمل حرف ((أو)) إذا لم يكن المقصود طرحَ سؤالٍ. كأن تقول مثلا:
“المالُ ذهبٌ أو فضةٌ أو نُحاسٌ أو ورق“.
أما إذا كان الـمُراد الاستفهام (طرح السؤال)؛ عندها نوَظِّفُ حرف ((أَمْ)) كأن تقولَ مثلا:
“هل تُريد عِوضاً عن بضاعتِكَ ذهباً أم فضة؟”.
نُحيل المتخصصين في موضوع ((التذكير والتأنيث)) على المراجع التالية: