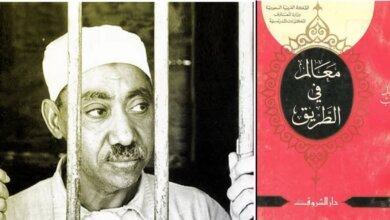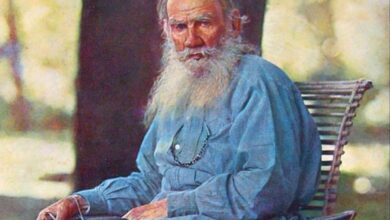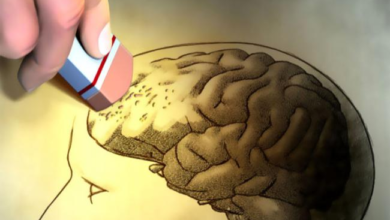في تذكّر إحسان عبّاس ومحمد القيسيّ.. الرّاعي والتروبادور

تمرّ هذه الأيّام ذكرى رحيل مُبدعَين عربيّين (فلسطينيّين) كبيرَين، فقَدَتهما الثقافة العربية. الأستاذ الدكتور إحسان عبّاس، والشّاعر محمّد القيسيّ. الأول (مواليد 1920) رحل في الثامن والعشرين من تمّوز/ يوليو 2003. وبعد ثلاثة أيّام اختطف الموتُ الشاعرَ القيسي (مواليد 1944) في الأوّل من أغسطس/ آب. وكان رحيل الاثنين قاسيًا، وترك فراغًا.
كيف نتذكّر كلًّا من هذين المبدعين المتميّزين؟
- عبّاس متعدّد بإبداع
إحسان عبّاس، الناقد والباحث والمحقّق الأدبي- التراثيّ والمترجم، عرفته قبل أن ألتقيه شخصيًّا، وحين اقتربتُ منه كان أوّل ما تعلّمت منه مقولة “تشاؤم العقل، وتفاؤل الإرادة”. عبارة تشبه شعارًا يردّده بين كلامه. وثمّة حكمة ثانية أوردها في مطلع سيرته “غربة الرّاعي” وهي عبارة هيراقليطس “إنك لا تستطيع أن تخطو في النهر نفسه مرّتَين”. فما الذي يوفّي هذا العالِم قدْره؟ لستُ هنا إلّا لاستحضار شذرات من سيرة هذا الذي لقّبوه بـ”شيخ المحقّقين والنقّاد العرب”، أمّا تاريخه الحافل بالإنجازات، فهو ما يجدر بالدارسين والباحثين الوقوف عليه.
كان كتابه “تاريخ النقد الأدبي عند العرب” واحدًا من المراجع الأساسية في دراستنا الجامعيّة، لمادة النقد، في كليّة الآداب (الجامعة الأردنية)، وهو بين مراجع عربية قليلة في هذا الاختصاص، حيث التأريخ هنا صورة للنقد الأدبيّ عند العرب بين القرنين الثاني والثامن الهجريّين، وهو يتدرّج زمنيًّا ليُظهر حركة التطوّر في هذا النقد، ويقف على القضايا الكبرى لإبراز الدور “الفكريّ” للنقّاد العرب، وما يسمّيه “إقامة كيان للنقد الأدبي عند العرب”، والاحتكام إلى “أساس شموليّ في النظرة الكلية إلى هذا الكيان”.
ولهذا نراه لم يقصُر الرؤية على من عُرفوا بالنقد التطبيقي، بل درس من كان لهم نشاط نظريّ في النقد أمثال الفارابي وابن سينا وابن خلدون.. ما جعل من هذا الكتاب مرجعًا لا غنى عنه لكل طالب علم في هذا المجال.
ثمّ حدث أن حضر إحسان عبّاس إلى الأردن، مدعوًّا من جهة ما، لكتابة تاريخ بلاد الشام، وحين سمع بذلك تلاميذه ممّن صاروا كتّابًا، وكنتُ منهم، أخذوا يلتفّون من حوله، وكان هو على درجة من التحفّظ والانشغال، فكان الاقتراب منه محدودًا بقلّة من الأشخاص، وكنت محظوظًا بالتقرّب منه، وبدعوته لي لزيارته في بيته، حيث كان يجتمع ثلّة من أساتذتنا الذين هم في مقام تلاميذ له، عبر كتبه على الأقلّ. وكان له حضور متميّز لا يُضاهيه حضور سواه.
قرأنا سيرته الذاتية “غربة الرّاعي” وناقشنا معه جوانب فيها، فهي تقدّم الكثير من ملامح شخصيّته “الغامضة” إلى حدّ ما، ولكن المحافظة و”المتحفّظة”، أيضًا. ثم حين قرّر إصدار ديوان شعر تعود قصائده إلى أربعينيات القرن العشرين، أي قبل نكبة 1948، كان يبدو متردِّدًا، لكنّ آراء بعض “الأساتذة” جعلته يحسم أمره ويدفع به إلى النشر، وهو ديوان يستحقّ وقفة ولو قصيرة، خصوصًا تقديمه هو نفسه للديوان، فقد كان موضع نقاش وجدل أيضًا. وربّما كان ديوان “أزهار بريّة” هو آخر إصداراته (1999).
أتوقّف قليلًا عند “شذرات” وملامح قد تبدو عابرة، في شخصية هذا “العالِم” بالأدب والنقد، شذرات تُفصح عن شخصيّة إنسان ريفي بسيط ومتواضع، رغم كلّ ما قدّمه للأدب من خدمة فريدة وثمينة. ولكنّه في شعره (الديوان) بدا فيه عنصر القلق مهيمنًا، القلق الذي يجعل كل ما حول الشاعر مثار أسئلة وتوترات. ثمة قلق وجودي أولًا، وقلق خاص بشخص ينتمي الى بيئة معينة، قلق تثيره قراءات وتجارب حياتية، فيدفع بالشخص الى مواقع الشك والتوتر واللايقين. القلق الذي يوجع روح الشاب ونفسه هو قلق العلاقة بالمرأة أولًا، وقلق العلاقة بالعالم أخيرًا.
نتركه هنا يقول “كنت قد انتحيت بالشعر وجهة التغني بالريف والحياة الريفية وأهل الريف الذين أطلقت عليهم اسم “الرعاة”، ولم يكن بين الرعاة الذين أعرفهم من يستهويهم سماع الشعر المكتوب بلغة فصحى، فلم يكن لشعري بين القرويين الأميّين جمهور، وكان في طبيعته العامة بعيدًا عن السياسة وعن حماسة شعر السِّيَر الشعبية، وعن الموضوعات والقضايا التي تشغل بال الناس وتستأثر باهتمامهم، فكان التحدث إليهم عن الشؤون العاطفية أمرًا نابيًا قد يعني – في نظرهم – الاستهتار بما يعدّونه أهمّ وأجدى”.
وفي تقديمه “أزهار بريّة”، الذي يسمّيه “المجموع الشعريّ”، يعترف عباس بعجزه عن الخوض شعريًا في الشؤون القومية والقضايا الاجتماعية والإنسانية، لكنه لا يستبعد الشعر “إذا تحدث في هذه الموضوعات”، كما أن محبته للريف والريفيين كانت “جزءًا من محبتي للأرض والمنزل والقرية والوطن بعامة، والحديث عنها حديث إنساني أقرب إلى مشاعري الصادقة وأقرب إلى الطبيعة، وهو في ذاته يكفل الاستقلال بموضوع قل من يحاوله”.
ومع ذلك لا تخلو قصائد عبّاس هذه من ذكر للوطن والقضايا الوطنية في صورة مباشرة، فنجد في الجزء الأخير من الكتاب قصائد في هجاء القيادات السياسية العربية، نقرأ في “الجبناء” عن القادة “الخائنين شعوبهم…”، وصرخة “خلوا المقادة للشعوب…” التي ترددت في قصائد الكثير من الشعراء العرب منذ العشرينيات تقريبًا. وفي قصيدة “مصرع خائن” نقرأ هجاءً لاذعًا لـ “الباغي الذي باع الوطن”، ونرى في الختام “أن من يَهْزَاْ بتاريخ العربْ/ ليس يُسقى بسوى الموت المرير”.
لقد أنجز الكثير الذي يستطيع أيّ من متابعيه العودة إليه في سيرته ومنجزاته من التحقيق، وحتى في الترجمة يكفي أن نتذكّر نقله رواية هرمان ميلفل الشهيرة “موبي دِك” في ترجمة هي من روائع الترجمات إلى العربية.
وأخيرًا، لقد ودّعناه في جنازة مهيبة من حيث مشاعر الألم والحزن التي ظهرت على من شاركوا في تشييعها (الجنازة). لكنّ عدد المشاركين فيها كان، كما علّق أحد الأصدقاء، “أقلّ من عدد الكتب التي أنجزها هذا المبدع الكبير”، فهو لم يكن من أصحاب المناصب والشهرة.
- القيسي جوّال الشّعر والحياة
منذ مجموعته الشعريّة الأولى “راية في الرّيح” (1969)، مرورًا بمجموعاته التالية، وخصوصًا “الحداد يليق بحيفا” (1975)، ثمّ “اشتعالات عبد الله وأيّامه” (1981)، وصولًا إلى آخر ما صدر له في حياته من شعر “منمنمات أليسا” (2002)، شكّلت تجربة الشاعر الفلسطينيّ الراحل، محطّة بارزة في الحياة الثقافيّة الفلسطينية والعربية، فهي تجربة جديرة بالدراسة والتقدير، لما مثّلته من خصوصيّة وتميّز، إن على مستوى الموضوعات والأسئلة التي طرحتها، أو على صعيد اللغة التي تمّ طرح هذه الموضوعات بها في نصوصه.
لكنّ الشعر، بالنسبة إلى القيسي، كان يتجاوز النصوصَ إلى الحياة “المعيوشة”، وسلوكه فيها هو الشاعر ابنُ الحياة. وفي هذا السياق، يمكن الحديث عمّا كان يسمّى بجماعة مقرّبة منه، بل ربّما تلتفّ من حوله، في مجلس يخصّه، خصوصًا من شعراء يطلق عليهم “جيل الثمانينيات”، الجيل الذي بدأ بنشر مجموعاته الشعرية مطلع عقد الثمانينيات. وكان هو المكرّسَ بينهم، الشاعر بكاريزما بارزة، ولكن من دون ممارسة دور “الأستاذ” معهم.
نحن حيال حالة شعريّة عمادُها الشعر، والإبداعُ عمومًا، إذ كتب القيسي أشكالًا من الإبداع، منها السيرة والرواية والنصوص المفتوحة. وحتّى داخل الكتابة الشعريّة ذاتها، كان “يتجوّل” بين أشكال شتّى، من القصيدة ذات الشطرتين، إلى قصيدة النثر، لكنّ قصيدة التفعيلة ظلّت هي عمادُ تجربته الشعريّة وعمودها الأساس.
ومن بين أشهر قصائد القيسي، تبرز قصيدته ذات الشطرتين “الوقوف في جرش”، بما تناولته من ثيمة الألم واستعادة جرح فلسطينيّ نازف، كتبها بمطلع وأبيات على بحر “الرّمَل”، شديد المُرونة والمطاوَعة للكلمة واللحن المطلوب لذلك الوجع:
وقِفا نَحْكِ على أسوارِها
بعضَ ما يُوجِع من أسرارِها
لكن الوزن تغيّر، في أبيات تالية، إلى “الوافر”، المرن أيضًا، ولكن النزف يشتدّ في المقاطع التالية التي يخاطب بها جرش:
دفَنّا أجملَ الفِتيانِ فيكِ
وقُلنا يا صبيّةُ هل نفِيكِ
فمَن أسْقاكِ هذا الكأسَ مرًّا
سقاني من لَظاهُ بِختمِ فيك
(وأتوقّف قليلًا، فالقيسي جعل الكأسَ مذكَّرًا، ونعلم أن حقّ الكأس هو التأنيث، وكان الأصحّ “هذي الكأس مُرّةً/ لظاها”، لكن القيسي الذي نادرًا ما كان يخطئ في اللغة أو الأوزان قد سحبه الوزن فخان اللغة ربّما!). وهو يختمها بأبيات على “السريع”:
ما نام أهلي في الخليل ولا
هدَأتْ هناك شرارة اللهبِ
واصلْ طريقك غير مُنكسرٍ
واحبسْ – فديتُك – دمعةَ العربِ
وفي الختام، أستحضر شيئًا من آخر ما قاله القيسي، في آخر حوار أجراه معه الشاعر يوسف عبد العزيز، إذ يسأله ابتداءً: محمد القيسي، من أنت؟ فيقول: (…) كنت أظنّني أواصل البحث عنّي، ولكنّني كلّما قاربتُ معنى أوغلت في الغموض. مع ذلك يمكن القول إنّي ابنُ ذلك المخيّم الذي ترعرعت فيه وترعرع فيَّ، إذ صرت شابًّا وجوّالًا في الأمكنة.
لكنّ هذه الأمكنة تظلّ تعيدني إلى مسقط الرأس البعيد، تلك القرية (كفر عانة) التي تقع بين خاصرتي اللد ويافا… ولم يكن الشعر إزاء هذا المسار كلّه إلا محاولة للإمساك بمعنى ما يعيد التّوازن الداخلي إلى هذه الذات القلقة، لترى إلى أفق جديد لها، وترى إلى ضوء باعث على الأمل وديمومة الحياة، التي تتضمن شرط وجودها، وهو المعنى الإنساني لها وحسّ الكرامة.
ضفة ثالثة