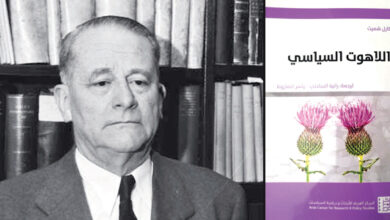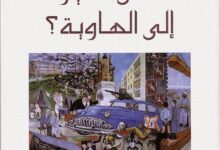الشرعيات السياسية والتسلطية العربية – الأسباب والتجذر

تقوم الشرعية السياسية على قبول الأغلبية (عن قناعة وحرية واختيار) لحُكم الأقلية، سواء أكانت هذه الأقلية فردا أو جماعة أو مؤسَّسة، بناء على شروطٍ مُحددة أو تعاقدٍ (وهو كغيره من العقود التي تَسقط إذا أخلَّ أحدُ الطرفين / المتعاقدين/ بشرطٍ من شروطِه) مُبرمٍ، يؤدي الإخلال به إلى إسقاط الشرعية السياسية عن الحاكم فردا كان أو جماعة أو مؤسسة، (لعدم أهليتِه لاحتلال موقع القرار ومركز السلطة) وانتقال الحُكم الى جهة أخرى (فردا أو جماعة أو مؤسسة..)، إذْ الشرعية هي المُقوِّم والمُسوغ والميزان الوحيد الكفيلُ ببقاء النظام السياسي الحاكم أو رحيلِه.
تتنوع الشرعيات السياسية وتتعدد بتنوع البيئات واختلافِها، وقد أورد ماكس فيبر أربعة أنواع من هذه الشرعيات (السياسية) وهي:
– الشرعية التقليدية: وهي الشرعية المتوارَثة والممثلة في الغالب في الـمُلك أو السَّلطنة أو الإمارة، التي اعتاد الناس عليها، وعلى طريقة تداولِها وانتقالِها بين أفراد هذه النُّظم السياسية.
– الزعامة الملهَمة: وهذا المصطلح (ذو النبرة الشاعرية) مُضطرِب ويوظفه المحللون في سياقات مختلفة؛ خصوصا في تبرير الزعامة أو تمجيد الزعيم وتصويرِه على أنه الخارق والمنقذ والبطل، وهو نفس المنحى الذي نَحَاهُ ماكس فيبر في وضعِه لهذا المفهوم.
ولككنا نُجْمل القول في كون الزعامة الملهَمة؛ هي حالة طارئة (ثورة، انقلاب، أزمة اقتصادية ، كارثة طبيعية، حرب …) التي تسقط فيها القوانين والأعراف الاجتماعية، وتدخل فيها البلاد في فوضى يستغلها الطامحون للسلطة ليُلغوا القوانين والمؤسسات، ويُحكموا قبضتهم على السلطة بشكل مطلق وشمولي، وبالتالي يُصبح الحاكم هو الدولة، وهو المحرك لكل شيء، ونُمثل لهذه الزعامة بالديكتاتوريات الشيوعية والعربية.
– الشرعية الإيديــولوجيـة: وهي السائد في الدول العربية التي ترفع شعار القومية، وتتبنى ظاهريا قضايا الأمة كغطاء للحفاظ على شرعيتها السياسية. (مصر – سوريا – العراق – ليبيا- الجزائر..).
– الشرعية العقلانية أو القانونية: وتعرف كذلك بالشرعية الدستورية أو شرعية المؤسسات، وهي أعلى وأرقى أنواع الشرعيات، وهي السائدة في الدول الديمقراطية.
بخلاف الشرعية الدستورية تتسم مجتمعات الشرعيات الأخرى التي ذكرناها (أعلاه) بعدم الاستقرار أو بما يمكن أن نسميه بالاستقرار الموهوم، إذ تعيش مجتمعات هذه الأنظمة في حالة من الكَبْتِ والغليان والاحتقان والسُّخط، يحول بينه وبين تنفيسه آلات قمعية عنيفة، تُكرسُ لها هذه الأنظمة جزءًا كبيرا من الموازنة لتطبيق سياسة ضبط الشارع وإسكات المعارضين،
وبعض هذه الأنظمة؛ تنتهج سياسةَ نظام الطوارئ الدائم (مصر – سوريا)، لضمان عدم انفجار الوضع أو ما يمكن أن نسميه بـ (الانفجار نحو الداخل)، كما يتم توظيف الآلة الإعلامية النظامية للترويج لهذا الاستقرار الموهوم لتجميل صورتِها في الخارج.
في حين أن المجتمعات المستقرة حقيقة هي التي تحكم من طرف الشرعية السياسية، بل إن الشرعية السياسية (الدستورية / القانونية / العقلانية) هي من أهم مقومات الاستقرار والأمن والسِّلم الاجتماعي، حيث تعمل هذه المؤسسات بشكل دؤوب على تبرير مسوغات وجودِها في السلطة، وبالتالي ينعكس هذا المجهود على تسيير القطاعات الحيوية كالاقتصاد والصحة والتعليم والحقوق والحريات؛ وعلى مظاهر النمو والتطور بشكل عام، مما يخلق نوعا من الاطمئنان والرضا في المجتمع.
فتكون الاستفادة مشترَكة بين المؤسسة الحاكمة بمنحها فرصة أخرى للحُكم، وبين المجتمع الذي تتغير ظروفه ومُتطلباتُه الحياتية نحو الأفضل. ومتى ما نقصتْ أو انعدمتْ هذه الفاعِلية، (فاعلية السلطة الديمقراطية) فإنها تقود مباشرة إلى سحب الشرعية منها، ومنحها لمؤسسة سياسية بديلة (بواسطة الانتخابات) تستجيب لسقف المطالب التي يرفعها الشعب الذي يختار من يَحكمُه، وهكذا دوليك.
فبينما تكون الفاعلية هي المعيار وهي الوسيط بين الشرعية المؤسساتية والشعب في الدول المتقدمة ديمقراطيا، نجد أن الوسيط بين الشعب والأنظمة الشمولية هي أجهزة الداخلية (في الحالة المستقرة ظاهريا) أو الجيش (في حالة الانفلات)، وهذه الحالة كلما طالتْ، إلا وازدادتْ احتمالات انفجار الوضع.
وبالتالي؛ فالأنظمة الشمولية لا يمكن بأية حال وصف مجتمعاتِها بالمستقرة، إذ لا يمكن توقع متى ينفجر الوضع فيها وكيف سيكون هذا الانفجار وما النتائج المترتبة عنه (حالة الربيع العربي / صراع الثورة مع الثورة المضادة).
ولأن الوضع على هذه الحال، تلتجئ بعض الأنظمة غير الشرعية خصوصا في الدول العربية؛ إلى عمليات تجميلية لتحسين صورتها أمام العالم أو ما سمى بـ “ديمقراطية الواجهة” أي إلى إجراء انتخابات شكلية ومزوّرة لتأكيد أحقيتها في الحكم وشرعنة استمرارها إلى الأبد؛ تحت شعار (غياب البديل / غياب الزعيم / الأمن مع الاستبداد أو الفوضى مع التحرر).
كل هذه العوامل وغيرها (كثير)، جعل هذه الانظمة الشمولية العربية تعتقد أن شرعيتها أصل، وأنها مطلقة وأبدية وأنَّ من يعارضُها هو الشاذ وهو المنحرف (التخوين / العمَالة/ التخابر …)، وبالتالي تم تحويل وتحوير مبدأ “شكل الحكم هو الأهم” إلى “مبدأ من يحكم هو الأهم”. وهذا ما يفسر منطق الحكم مدى الحياة في كل النُّـظُـم السياسية العربية (الديكتاتورية / الشمولية).
- التسلطية في البيئة السياسية العربية، وأسباب تجَذّرِها:
السلطة الدينية أو العلمانية أو القومية في وطننا العربي، ما هي إلا نموذج أو غطاء لممارسة السياسة التسلطية، ومادام الخيار الديمقراطي ليس مطروحا على الطاولة السياسية العربية، فإن أي نظام سياسيٍّ تحت أي مسمىًّ آخر (غير الديمقراطية) لن يكون غير وجه آخر للتسلطية السياسية العربية، فالراديكالية العربية ماهرة في إنتاج وإعادة إنتاج نفسِها بنفسِها حتى وإن اختلفتْ المسمَّيات و الشعاراتُ والأشخاص.
إن التسلطية السياسية ليست حالة شاذة عند العرب، وترجع جذورها إلى القرن الأول الهجري بعد تغليب خيار “من يَحكُم” على “شكل الحُكم”، في حادثة سقيفة بني ساعدة؛ التي يمكن أن نصفها بأول صراع على السُّلطة في الإسلام، والتي فرضتْ امتثال الأنصار لإرادة قريش (المهاجرين) والتي سعتْ إلى أن تبقى السُّلطة (الحُكم) في قريش.
هذا الصراع (القبَلي / العشائري) بدأ باغتيال أبي بكر الصديق، وانتهى باغتيال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليٍّ بن أبي طالب، على أن القبَليَّة الضيقة في قريش، برزتْ بشكل جليٍّ في صراع عثمان بن عفان (من بني أمية) مع علي بن أبي طالب (من بني هاشم)، ثم صراعُ معاوية بن أبي سفيان (من بني أمية) مع علي بن أبي طالب (من بني هاشم)، الذي انتهى بانقلاب الأمويين على الهاشميين، وفرضِ مبايعة يزيد بقوة السيف.
فتم التكريس للسيف في الحكم بدل الفاعلية (التداول الديمقراطي للسلطة)، وتم تقديم القبيلة والعصبية على الكفاءة والاستحقاق، وكان استلال السيوف لأجل الإمارة في الإسلام لا يُضاهيه استلالٌ فيما عداها، فكان السيف مُسَلطا أيضا على رقاب العلماء الذين فكروا في التأليف في السياسة وطريقة الحُكم وِفْقَ شريعة الإسلام التي تدعوا للشورى وتداول السلطة،
وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحقوق الرعية وغيرها من القضايا التي صُرِفَ عنها العلماء لأمور أخرى (إلهائية) كإرضاع الكبير والقَبْضِ والسَّدل في الصلاة، وتحريكِ السبابة في التشهد و…، مما أفقر المكتبة الإسلامية في مجال العلوم السياسية.
وبالتالي انعكاس ذلك على الواقع السياسي نفسِه، في حين تم توظيف رواة آخرين لوضع أحاديثَ تُبرر حُكم الأمويين وخطـأ الهاشميين وظُلمِهُم، وغيرها من الأحاديث المكذوبة في تكريس الطاعة للحاكم، والتحذير من فتنة مخالفته، وتصويرِه في مقام أعلى من الأنبياء، فيمَ تم توجيه فئة أخرة من (العلماء) إلى تأجيج الفتنة المذهبية والطائفية وتخوين المعارضين بتأويل النصوص.
أو اختراع أحاديث لتبرير حربِهِم تحت مبرر الخروجِ من المِلة أو الزندقة، ووصفهم بالخوارج أو النواصب أو …، فأنشأ هذا السلوك مؤسسة دينية تابعة للسلطة، لا تزال قائمة إلى اليوم، ولا تزال تُوظف نفس الوسائل إما في التحريض أو في التخويف.
وهي إذ تفعل (السلطة السياسية) كلَّ هذا، تستمد شرعيتَها من الدين، وتتبنى شعار “هذه إرادة الله” في حين أن الزعامة الدينية مَوْكولة للأنبياء فقط وليس لأحد آخر غيرِهِم.
هذه الحالة البئيسة والمَوْرُوثة والـمُتَوارَثة منذ القرن الأول، تسببت في سفك الكثير من الدماء، وتعميق الفُرقة بين المسلمين، وتأجيج الطائفية والقبَلية والمذهبية، ولا زالتْ هذه الوسيلة (الذميمة) إلى اليوم، هي المطية التي تركب عليها هذه الأنظمة الشمولية لتبرير استمرارها في الحُكم واستئثارِها بالسُّلطة، وإلهاء الناس بعضَهُم بِبَعض.
- الأنظمة السياسية التسلطية العربية، وانفصامُها عن الواقع:
كما سبق وأشرنا تعمل هذه الأنظمة الشمولية التسلطية على استنساخ نفسِها بنفسِ الأساليب وبنفس الوسائل، وبنفس المنطق، وبنفس الحُجج والتبريرات أيضا، دونما مراعاة للتغيرات والتقلبات المطّردة التي يعيشها العالَم اليوم، الذي صارتْ العولمة السِّمة البارزة في كل تفاصيله، والسبب؛ أن هذه الأنظمة مازالت تعيش في الماضي وترفع شعارات الماضي مِن قبيل الثورية والدينية والتاريخية، والتغني بالاستقلال وملاحم وبطولات التحرير وقيم الوطنية والقومية.
وتتوقع من المجتمع العربي (الشاب) الذي تغير 180 درجة، والذي لم يعاصر هذه الأحداث ولا يعرفها ولا يريد أن يعرفِها أصلا، أن يتماهى مع هذه الشعارات، ويصفق لها كما صفق لها أسلافه، إن “… لهذا الشبابِ تَطلُّعاتٌ وآمالٌ تختلف عن تلك التي كان يحلم بها جيل الاستقلال،
فشباب اليوم أقلُّ حساسية للخطاب الوطني وتمجيد الماضي، بينما بقيتْ هياكل السلطة على حالِها، وهذا مِمَّا فاقم من منحنة شرعية الأنظمة الحاكمة وجَعَلها تنفصِل نهائيا عن المجتمع، فكان أن عَمَّقَ هذا الانفصال بين الدولة والمجتمع من أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم”.
ولما لم يتم تبني مشروع ديمقراطي حقيقي يستجيب للتطور الطبيعي الذي تعرفه المجتمعات الإنسانية، فإن مألات الصدامِ وانفجار الأوضاع في هذه المجتمعات المكبوتة والمقهورة والـمُعنَّفة، مسألة وقت فقط وستكون نتائِجُه كارثيةً، وأضرارُه بالِغة على البلاد والعباد (كما حصل مؤخرا في البلدان العربية التي تحفظون أسماءَها).
- للاستزادة في الموضوع؛ يُرجى الاطلاع على:
عبد النور بن عنتر، التسلطية السياسية العربية، مجلة فكر ونقد، العدد 45، يناير 2002م، ص 29.