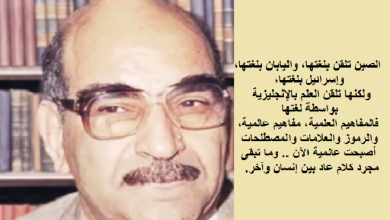التأليف في الفلسفة بالمغرب: أفق التأليف الفلسفي

- I – من سؤال الاعتراف إلى الاعتراف بالسؤال
يمكن أن ننطلق في مقاربة موضوع: “أسئلة الكتاب الفلسفي المغربي” من سؤال أصلي: هل يمكن الحديث عن كتاب فلسفي مغربي؟ هل ثمة وجود لتأليف فلسفي مغربي؟ إن ما يبرر طرح هكذا سؤال، وما يجعل مشروعا تلمس مكامن التشكيك، هو قول المشتغلين بالفلسفة عن الفلسفة.
إذ يبدو أن هناك صعوبة في الاعتراف بوجود تأليف فلسفي. وما يعقد المسألة أكثر أن من يطرح سؤال الاعتراف، لا يطرحه من زاوية التشكيك في قيمة الفلسفة، وفي لا جدوى التأليف فيها، إذ لو كان الأمر كذلك لاعتبرناه سؤالا قيميا.
يتموقع صاحبه خارج الفلسفة ويتموقف منها في إطار نبذ وتبخيس الفكر والإنتاج الفلسفيين، سنقول آنذاك أنه موقع وموقف أعداء وخصوم الفلسفة، الذين شكلوا دائما جزء من حياة الفلسفة وصراعاتها.
لكن السؤال هنا ليس قيميا، بقدر ما هو معرفي، بقدر ما هو فلسفي، يطرح من موقع الاشتغال داخل الفلسفة، ويطرح أيضا من موقف الدفاع عنها والانخراط في نداء ملح من أجل حضورها. لنستمع لشهادات المشتغلين بالفلسفة:
يقول عبد السلام بنعبد العالي: “ربما لم يحن الوقت لدراسة الإنتاج الفلسفي عندنا ومتابعة حركته وتقويمه…” (الفكر الفلسفي المغربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1983، ص7).
يقول بنسالم حميش: “إن حاضر الفكر الفلسفي عندنا ملتبس، مضطرب، معاق وبالتالي فهو بأمس الحاجة إلى أن نفكر في واقعه وآفاقه عبر المراجعات التقييمية الهادفة والوقفات النقدية الجذرية”… (“في نقد بداوة الفكر”، مجلة مدارات فلسفية، ع1، 1998، ص130).
يقول سالم يفوت: “إن التراكم الفلسفي الذي كان المعول عليه في خلق مناخ فلسفي عربي حقيقي، لم يحقق أهدافه، لا لقصور ذاتي فيه، بل لعوائق خارجية منعته من أن يستمر لينجز مهامه المتمثلة في تأسيس أرضية صالحة للنظر والتأمل الفلسفي وتهييئ تربة ينبت عليها النقد..” (“النظام الفلسفي الجديد”، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، عدد 104-105، السنة 1998، ص36).
يقول محمد وقيدي عن التأليف إنه تأليف مدرسي في مجال الفلسفة، و”لا يرقى التأليف الفلسفي إلى تأليف شمولي يساهم في بناء إشكاليات جديدة” (“الإبداع في الفلسفة العربية المعاصرة: شروط طرح الإشكال”، مجلة الوحدة، س5، ع60، 1989، ص53).
يقول كمال عبد اللطيف: “لا تندرج الكتابة الفلسفية المغاربية في سياق تاريخ الفلسفة بمعناه الكوني والشمولي، إنها تنمو على هامش تاريخ الفلسفة..
لا يحضر إذن تاريخ الفلسفة في الفكر الفلسفي المغاربي كمدارس وتيارات، قدرما يحضر كمفاهيم وأطروحات موجهة باهتمامات تاريخية، سياسية وثقافية محلية..” (“الفلسفة والهاجس السياسي، عوائق الكتابة الفلسفية المغاربية” من كتاب جماعي حول الثقافة والمجتمع في المغرب العربي، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، 1992، ص61-62).
يقول طه عبد الرحمان في تمهيد عنونه بـ: كيف تحرير القول الفلسفي؟: “من ذا الذي بوسعه أن ينكر أن القول الفلسفي العربي، لفظا أو جملة أو نصا، هو قول مستغرق في التقليد؟
لقد قطعنا عمرا ليس بالقصير ننظر في هذا التقليد الذي ليس بالقليل، متطلعين إلى ما يمكن أن يدفع عن جيل الغد ما لحق أجيال الماضي من شروره، وفي قلبنا من الهم والألم ما أسهر ليلنا وأشغل وقتنا لما آلت إليه هذه الأمة من سوء التفلسف..” (فقه الفلسفة، القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل، المركز الثقافي العربي، 1999، ص12).
يقول محمد سبيلا، في مقالة بعنوان (متى يعود زمن الإبداع الفلسفي؟): “فالشرط الأول لإمكان قيام إبداع فلسفي عربي هو أن ننقل إلى لغتنا الأفكار والقضايا والمفاهيم الفلسفية من الفلسفات المتقدمة علينا. فنحن لا نستطيع أن نبدع إن لم نحقق أولا الاستيعاب الجيد عن طريق النقل” (مجلة مدارات فلسفية، ع1، 1998، ص178).
يبدو أن هناك اعترافا مشتركا بصعوبة نعت ما يوجد حاليا أنه إنتاج فلسفي، صحيح تختلف التبريرات (وهذا موضوع آخر يمكن أن يحظى وحده باشتغال مفصل): فهناك من يرد ذلك إلى تبعية الإنتاج الفلسفي إلى نمط القول الغربي.
وهناك من يرجع ذلك إلى عدم انخراط قولنا الفلسفي في البعد الكوني للفلسفة وعدم استيعابنا لتاريخ الفلسفة، ومن قائل بخنق الإنتاج الفلسفي بسبب استئساد النزعة القومية والقراءات الإيديولوجية المتسرعة إلى قائل بندرة التفكير وغياب الخطاب النقدي داخل المحصول الفلسفي وهيمنة قيم البداوة، إلى قائل بهيمنة اللاهوت وضغط الهاجس السياسي، إلى قائل بعدم المساهمة في بناء إشكاليات جديدة واختزال التأليف الفلسفي في التأليف المدرسي.
إن خلاصة القول، هي أن المشتغل بالفلسفة في المغرب، يجد نفسه أمام هذه المفارقة: الحديث عن تأليف في الفلسفة، وليس عن تأليف فلسفي بل يمكن نعته بأنه تأليف ما قبل فلسفي.
إذا كان المشتغلون بالفلسفة يجدون صعوبة في تبني خطاب موجب عن سؤال الاعتراف، فيمكننا أن نحول هذا السؤال من سؤال ذاتي إلى سؤال نسميه تجاوزا “بالموضوعي”، أي نحول الاعتراف، من اعتراف الأشخاص إلى اعتراف الواقع.
فهل يصطدم التأليف الفلسفي المغربي بعوائق تتجاوز قدراته وآفاق اشتغاله؟ هل فضاء المجتمع المغربي، لا يسمح باستقبال بذور الفلسفة، وتجذير إنتاجاتها وإخصاب محصولها؟ هل يصح الحديث عن ظروف ملائمة للإنتاج الفلسفي وعن ظروف معيقة له؟ هل الفيلسوف هو الذي يخلق شروط التفلسف أم هو نتيجتها فقط؟ هل الفيلسوف ابن المدينة أم مؤسسها وفاعل فيها؟
أعتقد في نظري، أنه يجب التحرر من خدعة الظروف أو الشروط الملائمة، وقد حدد عبد الله العروي مبادئ ثلاث لتحقيق هذا التحرر، ونحن نراها مناسبة للحديث عن وضعية التأليف الفلسفي بالمغرب[1].
فمن جهة أولى يجب تجاوز عطب التفكير، على اعتبار أن الفكر الفلسفي لا يشهد حضورا على مستوى الخطابات السائدة، ويظل بعيدا عن حياة الناس وهموم المدينة.
ومن جهة ثانية يجب إعادة النظر في توجه المشتغلين بالفلسفة وذلك عن طريق الاهتمام بقضايا ومواضع تهم المستقبل وعن طريق تسلحهم بالواقع عوض التوتن للماضي واستمراء الوهم.
خاصة وأن التأليف في الفلسفة تمركز كثيرا حول الماضي ومساءلة التراث. ومن جهة ثالثة ضرورة الاعتماد على منهج النقد كاستراتيجية في عملية التأليف، تتغيى التحرر من النزعة التبجيلية والتقريرية، وتتجاوز السقوط في السجالية.
لتعميق النظر في الأسئلة المذكورة أعلاه، واستئناسا بمصوغة المبادئ الثلاث، نقول: نحن في حاجة ملحة لطرح سؤال ما هي الفلسفة؟ لما لا يهتم المشتغلون بالتأليف في مجال الفلسفة، بسؤال ما هي الفلسفة؟
على اعتبار أن العودة إليه من حين لآخر تعتبر ضرورة فلسفية، لتصحيح المسار، وتجديد عدة الأسئلة وتوسيع دائرة الممكن. فلكي يواجه التأليف في الفلسفة بالمغرب شيخوخته عليه أن يطرح سؤال ما هي الفلسفة، حتى تتحول هذه الشيخوخة من شيخوخة عمرية إلى شباب خالد، يمنح حرية أسمى ويسمح بضرورة الانتشاء بلحظة فاصلة بين الحياة والموت.
إنها لحظة السؤال عن ما هي الفلسفة، إنها اللحظة التي قال عنها دولوز وكواطاري، يجب أن نتحدث فيها بشكل واقعي وملموس، إنها تعبير عن قلق حذر يجتاحنا حينما نشعر وكأنه لم يعد لدينا شيء يمكن قوله.
هكذا فتحليل سؤال الاعتراف بتأليف فلسفي مغربي، يتحول إلى الاعتراف بضرورة طرح سؤال ما هي الفلسفة؟ ليس من أجل الحصول على جواب يحررنا من السؤال ذاته، ولكن من أجل الوقوف على مجاهيل السؤال: “يجب أن نطرحه بيننا “كأصدقاء”، وكأنه بوح أو ائتمان، أو نطرحه في مواجهة العدو كتحدي.
إنها اللحظة التي نقول فيها: “هذا ما قلته (أو كتبته) ولكن لا أعرف هل قلته بشكل جيد، ولا أعرف هل كنت مقنعا في ذلك”. ولكننا ننتبه أنه ليس مهما أن نكون قد قلناه بشكل جيد ولا أن نحس بأننا كنا مقنعين، لأنه على أية حال، هذا ما هو موجود الآن”[2].
- II – مفارقات التأليف في الفلسفة بالمغرب
المفارقة الأولى هي تلك التي لاحظها المشتغلون بالفلسفة أنفسهم، وهي أن التأليف في الفلسفة بالمغرب لم ينجح بعد في أن يكون تأليفا فلسفيا، لكن إخراج هذا التأليف يكمن في وجود مساهمات فلسفية تخرج من رحم من لا يشتغلون بالفلسفة تخصصا.
هذا ما لاحظه بنعبد العالي: “قد لا نعثر على المفاهيم الفلسفية في الكتب التي تقدم نفسها على أنها إنتاج فلسفي، وقد نلفيها على العكس عند مفكرين يضعون أنفسهم خارج الفلسفة وعلى هامشها، نجدها أساسا عند دارسي التاريخ الفكري والاجتماعي. ولكن أيضا عند بعض السيميولوجيين وعلماء الاجتماع وأصحاب النقد الأدبي”[3].
هل الأمر يتعلق بحقل قاحل، أم بعقم المشتغلين في هذا الحقل؟ هل يتعلق الأمر بانفتاح المعرفة لدى المشتغلين بغير الفلسفة، وعدم حضور هذا الانفتاح المعرفي لدى المشتغلين بالفلسفة؟ هل يتعلق الأمر بخروج الفيلسوف من المدينة وخلاله عن المنافذ المؤدية إليها، واهتداء مفكرين من خارج الفلسفة واكتشافهم لمدينة الفيلسوف؟ يمكن أن نعثر على عناصر للجواب في المفارقات اللاحقة.
المفارقة الثانية هي غياب الحوار، أو على الأصح غياب المحاورة والتي هي أساس الفلسفة، إذ نلاحظ فقر (إن لم نقل) غياب المطارحات النقدية داخل التأليف في الفلسفة بالمغرب، فالمشتغلون بالفلسفة نادرا ما ينخرطون في قضايا الشأن العام، كأن يخترق خطابهم عالم الناس اليومي.
ويتجذر كنمط خطابي متميز ضمن الأنماط الخطابية السائدة (السياسية أو الدينية) فلا نتصور وجود فلسفة خارج فضاء الجدال العمومي، ولا نتصور فلسفة يمكن أن تحيا على هامش المدينة. علاوة على ذلك فالتأليف في الفلسفة بالمغرب قل ما يدخل في حوار مع الفلاسفة ومع التآليف الفلسفية.
إننا نشير هنا إلى ذلك الحوار اللازم مع تاريخ الفلسفة ومع حاضر الفلسفة، فخارج دائرة الاهتمام البيداغوجي والأكاديمي، وخارج منطق هل يصلح لنا أم لا يصلح، لماذا لم ينخرط التأليف في الفلسفة بالمغرب في حوار مع الفلاسفة، صحيح اهتم التأليف بمسألة نقل بعض القضايا والمفاهيم الفلسفية من خلال ترجمة بعض النصوص، إنها خطوة هامة.
ولكنها غير كافية بمعنيين، أولا غير كافية على مستوى الإنتاج، فهي لا تعدو أن تكون محدودة العدد والإنتاج. وقاصرة على نصوص صغيرة وشذرات ومقتطفات مأخوذة من نصوصها الأصلية، فما هي الأعمال الفلسفية الكاملة التي نقلها التأليف المغربي إلى العربية؟ هل لدينا ترجمات لأعمال (أو على الأقل لنصوص كاملة) الفلاسفة؟ هل لدينا مختصون في أفلاطون أو ديكارت أو كانط أو هوسرل أو هيدغر… إلخ؟
قد يكون ذلك راجع إلى نقص في التأهيل، فالتكوين الفلسفي بالمغرب لا يؤهل دارسي الفلسفة من أجل المساهمة في هذه الحركة، الشيء الذي يجعل من الصعب الانخراط فيها، يقول الخطيبي: “الحوار مع الغرب هو الرجوع إلى الأصل.
إن عملية الرجوع إلى الأصل عملية صعبة جدا، لأن هناك مسألة الترجمة، كيف نترجم هيدغر إلى اللغة العربية؟ (الترجمة مطروحة وضرورية لتطوير الفكر العربي) إنها عملية صعبة لأنها تحتاج إلى تكوين مزدوج. تكوين في الثقافة والحضارة الغربية وتكوين في الثقافة العربية لغويا وحضاريا”[4].
وثانيا، فالترجمة المتوفرة حاليا –وعلاوة على قلتها- فهي غير كافية على مستوى الأفق، لأنها لا تطرح سؤال أفقها، ولا تذهب إلى ما بعد النقل، أي محاورة المنقول، وقد يكون ذلك ناتج عن غياب تراكم على صعيد المنقول.
هناك وجه آخر لغياب الحوار داخل التأليف في الفلسفة بالمغرب، فالمشتغلون بالفلسفة لا يحاورون بعضهم البعض، نتحدث هنا عن الحوار بما تقتضيه الوظيفة النقدية، وليس بالمعنى التعريفي أو الاعترافي، بل نتحدث عن ذلك الحوار الذي يجعل “أنا مفكرة” في وجه “أنا مفكرة” أخرى. صحيح هناك انشغالات واجتهادات، وتأليفات.
لكنها جزرية ومنفصلة عن بعضها البعض، تتجنب المواجهة والمناقشة الفكرية، كأن يواجه تيار فكري تيارا آخر، أو يدخل هذا المنهج في مناقشة منهج آخر، أو يكون هذا الفكر مناظرا لفكر آخر، دون أي يختزل أو يسقط في السجال.
المفارقة الثالثة، وهي الطلاق الحاصل بين المشتغل بالفلسفة وبين العلوم. يكشف تاريخ الفلسفة على أن معلمي الفلسفة وروادها كانوا منشغلين بالمعرفة العلمية. وكانوا دائما في حوار منتج ومؤسس للنظريات العلمية.
فلا يمكن الحديث مثلا عن وجود الفلسفة الأفلاطونية بمعزل عن علم الهندسة، ولا يمكن الحديث عن اللحظة الديكارتية بمعزل عن الجبر، كما لا يمكن الحديث عن فلسفة كانط بدون ربطها بعلم الفيزياء، كما لا يمكن الحديث عن فلسفة برغسون بمعزل عن علم الأحياء.
وكذا فالفيلسوف المعاصر هو فيلسوف منفتح على ما تشهده العلوم الإنسانية من تطور في مفاهيمها ومناهجها، وكذا على ما تشهده العلوم الدقيقة وما تطرحه التقنية من سؤال مستفز للتفكير في وضع الإنسان ووضع الوجود ووضع المعيش كذلك:
بدء من هيدغر، هوسرل إلى يومنا هذا، أو لم يكن حلم الفلسفة. كما قال هوسرل، هو أن تكون “علما”، معرفة شمولية؟ لقد عوضت الفلسفة حلمها كي تصبح علما بخلق حوار مفتوح ودائم مع العلم.
لكن المشتغل بالفلسفة، في المغرب، لا يدخل في حوار مع العلم، صحيح قد يهتم بتاريخ العلم، أو قد يهتم بالاطلاع على الإشكالات الفلسفية والإبستمولوجية بصدد المعرفة العلمية، ولكن لا ينشغل بنحت نظرية بصدد العلم[5]، لا ينشغل بالتدخل فلسفيا في ما يعج به حقل العلوم، ولا يحول التطورات العلمية التي يشهدها زمانه إلى مولد لأسئلة فلسفية خاصة به.
إذا كانت الفلسفة المعاصرة تشتكي من تصاعد النزعة الوضعية وطغيان التقنوقراطية وخطورة ذلك على مستقبل الإنسان فكرا، وجودا ومعيشا، فلا مبرر لدينا لطرح –بالنسبة للمجتمع المغربي مثلا- خطورة النزعة الوضعية وخنقها للتفكير الفلسفي. وهنا المفارقة الكبرى،
فهل سنقول إن انتعاش الفلسفة عندنا يحتاج إلى حضور الفكر والنزعة الوضعية، يحتاج إلى تغلغل العلم ليس كتجليات، بل كفكر، كخطاب متجذر في بنية المجتمع؟ لقد لاحظ العروي أن التركيز على الفيزياء (لما هو تأصيل للفكر الوضعي) هو التركيز على مستقبل العلم في مجتمعنا.
فهو في حاجة ملحة لتغلغل الفيزياء باعتباره أساس تقدم كل المعارف الأخرى[6]. ألا يحتاج التأليف في الفلسفة بالمغرب إلى تعميق التفكير والإنتاج في قيمة ومساهمة الثورة العلمية في خلق الثورة الذهنية التي من شأنها أن تخلق فضاء أنسب للفلسفة، بحيث تنقلنا من كون إلى كون؟
هل يمكن أن نبرر هذا الطلاق بين الفلسفة والعلم في التأليف المغربي، بغياب إنتاج علمي وغياب تغلغل للعلوم في بنية المجتمع؟ هل تصبح قاعدة الخصوصية عقبة أمام الانخراط في الكونية؟
المفارقة الرابعة: لقد انتبه باحث مغربي إلى صعوبة الحديث عن التأليف الفلسفي المغربي، لما تساءل عن معيار تصنيف الإنتاج الفلسفي المغربي، هل سنترصده عموديا عبر الحديث عن الأشخاص والمصنفات؟ أم أفقيا فنتحدث عن موضوعات وقضايا ومفاهيم؟
يرى هذا الباحث، أنه يصعب الحديث لدى المشتغلين بالفلسفة عن وجود اهتمام فلسفي بالقضايا الفلسفية المعروفة والتي شكلت قاعدة تفكير مشتركة بين الفلاسفة، لذا لا يتبقى لنا سوى الحديث عن المفاهيم المتداولة، وهي تدور في فلك التاريخ، الهوية والإيديولوجية، أو بصيغة أخرى حول دائرة التاريخ والسياسة[7].
إن الاحتماء بالتاريخ يتضمن مزلقا، يقتضي المزيد من التأمل. صحيح لا يمكن فصل الفلسفة عن تاريخ الفلسفة، ذلك أن كل فلسفة تنتج بالأساس بالعلاقة مع الفلسفات السابقة، كما يقول هيغل، وصحيح أيضا أن الهدف من تاريخ الفلسفة هو معرفة الفلسفة كما ظهرت (سؤال الأصل)،
وكما تتالت في الزمن (سؤال التطور)، ولكن علينا أن نستوعب الدرس الهيغلي في كليته، فتاريخ الفلسفة ليس مجرد تجميع للآراء، ذلك أن دور تاريخ الفلسفة هو أن يجعلنا نكشف عن فكر مرحلة ما وعلاقته بواقعه الخاص، إنه تاريخ يحكي عن ما وقع ولكن عن ما ضاع أيضا، إنه تاريخ يؤرخ للذاكرة كما يؤرخ للنسيان.
وإذا كانت الفلسفة ترصد حقيقة منشودة، فتاريخ الفلسفة يعرض حقيقة متجلية، وما دامت الحقيقة خالدة، فلا تاريخ لها، كما يقول هيغل: “وحتى إذا كان لها تاريخ فلا يمكن أن نعبر فيه عن الحقيقة، لأن الحقيقة لا توجد في الماضي”[8].
مفارقة التأليف في الفلسفة بالمغرب، هي أنه يرتبط بالتاريخ، ليس بتاريخ الفلسفة ككل، بل بتاريخ الفلسفة في التراث العربي الإسلامي، إذ يرجع إلى هذا التاريخ بهدف تبجيلي أو إحيائي، وفي أحسن الأحوال يرجع إليه كتاريخ للأفكار هدفه رصد المذاهب والمدارس والتيارات، وتصنيفها والحكم عليها.
إننا لا نفهم معنى ابن رشد معاصرا مثلا؟ لا نفهم معنى أن يكون الرجوع إلى فلاسفة كحلول لمشاكل عصرنا، عوض اللجوء إليها كفسيفساء وكمفاتيح لهندسة جديدة تروم فك أبعاد حياتنا ومغالق مجتمعنا (بنفس المنطق يمكن الحديث عن الفكر الديني وعودته إلى فقهاء ومدارس فقهية سابقة من أجل فهم مستجداتنا).
أعتقد أن التأليف في الفلسفة بالمغرب استنفذ كثيرا الحديث عن التراث وقراءته دون أن ينتهي إلى صياغة فلسفته الخاصة، إذ لا يفيد هذا النقد الجزئي، بل يتعلق الأمر بطي وإحداث قطيعة منهجية، “فلا أحد يستطيع أن يدعي أنه يدرس التراث دراسة علمية، موضوعية، إذا بقي هو في مستوى ذلك التراث(…) فالرأي اليوم هو أن ينطلق الدارس من فكرة دون أن يدرك مكوناتها ليطبقها على مادة دون أن يتحرى مسبقا هل تتحملها أم لا”[9].
بهذا المعنى يصبح الانغماس في مساءلة التراث معولا يحفر انفصالنا عن زماننا. إن خدعة التاريخ هنا، خدعة مزدوجة، فهي من جهة تختزل تاريخ الفلسفة في التراث العربي الإسلامي، وتحول هذا التاريخ من مركز لإنتاج فلسفة في الحاضر، إلى إنتاج في الحاضر يتمركز حول التاريخ. ومن جهة ثانية، غالبا ما يتم ربط الحديث عن الفلسفة بالمغرب بالحديث عن الفلسفة العربية.
فكلما أراد باحث الحديث عن وضع الفلسفة بالمغرب، إلا وتحدث عن الفكر العربي أو العقل العربي. يمكن أن نبرر ذلك بهيمنة سؤال الهوية، ولكن لماذا اختزال الهوية في الدلالة السوسيوثقافية، عوض تعميق الحفر في الهوية الفلسفية حول ما يمكن أن نسميه بالإبداع الفلسفي عموما؟
قد يعترض على هكذا قول، بأن الأمر يتعلق بخصوصية فكر وعقل، ولكن يمكن إحراجه بما قاله عبد الكبير الخطيبي: “لنأخذ الإنسان العربي، وعلى وجه التحديد الإنسان المغربي، فإننا لا نلاحظ أنه يحمل في أعماقه كل ماضيه، الإسلامي وما قبل الإسلامي والبربري والعربي والغربي.
أهم شيء إذن هو أن نفصل هذه الهوية المتعددة التي تكون هذا الكائن، ومن ناحية أخرى يجب أن نفكر في الوحدة الممكنة بين هذه العناصر جميعا، لكنها وحدة غير لاهوتية، تترك لكل عنصر نصيبه من التمييز وتتيح بالنسبة للمجموع حرية الحركة”[10].
وبهذا المعنى، يمكن القول إن ما يطغى على التأليف في الفلسفة بالمغرب، هو كونه يندرج في الغالب، ضمن اهتمامات فلسفات الوعي، ولا يهتم كثيرا في قراءاته وانشغالاته بمسألة اللاوعي، يهتم بالذاكرة ولا يعير الاهتمام للنسيان، يهتم بالأجوبة التقريرية وليس بالمسألة النقدية، يهتم بالماضي وليس بالمستقبل، يهتم بالتاريخ وليس باليوطوبيا.
- III – ضرورة سقراط (المربي)
ثمة مسألة مهمة يمكن الإشارة إليها، والانطلاق منها قصد تحليل تبعاتها. يتعلق الأمر بكون تدريس الفلسفة بالمغرب، وتدريس العلوم كذلك، لم ينجحا في ترسيخ وخلق فكر فلسفي وتفكير علمي، وبالتالي لم ينجحا في خلق خطابهما، ولم يتغلغلا داخل النسيج المجتمعي، ولم يحتلا موقعهما داخل المدينة.
أي لم يتحولا إلى ندين يمكنهما أن يفرضا ذاتهما ويواجها أنماطا خطابية أخرى سائدة، وهذا يعني أن حياة الفلسفة وحياة العلم كذلك غير منفصلتين عن تدريسهما، سواء تعلق الأمر بالطرق والمناهج أو بالمضامين والاختيارات والرهانات.
وبهذا الصدد يمكن القول إن تدريس الفلسفة لم يتوفق في تحرير الجمهور العام من ما يحمله من صور وتمثلات خاطئة عن الفلسفة بل “لم يساهم في إعطاء معنى إيجابي ودقيق ومحدد لكلمة فلسفة أو فيلسوف. فالكلمة مشحونة بالسلب، ليس فقط في الأوساط التيولوجية واللاهوتية، وإنما أيضا في الأوساط التي أتيح لها التعليم المدني والجامعي الحديث”[11].
صحيح تشهد الفلسفة حصارا غير مبرر، كإقصائها داخل العديد من الكليات والمعاهيد العليا ولكن هذا ليس معيارا كافيا للحديث عن تعثر تشكل فكر وخطاب فلسفي بالمغرب. لهذا سننطلق من فرضية مفادها أن التأليف الفلسفي بالمغرب لن يصلح حاله إلا بصلاح تدريس الفلسفة وبطرح سؤال الجامعة.
وبالتالي التفكير في الفلسفة والجامعة، وربطهما بالماقبل (الفلسفة بالثانوي) والما بعد (اختراق الفكر الفلسفي لفضاء المدينة). إن مبرر هذه الفرضية وسندها القوي هو أن المشتغل بالفلسفة هو مدرس الفلسفة، لذا وكما قال دريدا: “قبل الحديث عن البنيات المرئية أو الكثيفة (المدرسة، الجامعة، السلطة، السندات الشرعية).
هناك بالأحرى تجربة الخطاب واللسان (…) تحاول المؤسسات أن تملي علينا البلاغة وإجراءات البرهنة، وكذا طريقتنا في الكلام والكتابة التي سنوجهها للآخر… أن نسائل بشكل نقدي أو تفكيكي علاقتنا بالفلسفة، يعني أن نضع أنفسنا في محك المؤسسة ومفارقاتها أيضا..”[12].
فما هي الصورة التي يحملها المشتغل بالفلسفة عن نفسه، هل هي صورة المدرس، أم صورة الفاعل الاجتماعي، أو صورة المصلح؟
نقصد بصورة المدرس ذاك الذي يراهن على الفرد، فينشغل بترسيخ آليات التفكير الفلسفي، ينشغل بهاجس التفلسف، وليس بتعليم الفلسفة وتاريخ الأفكار، ينشغل بتاريخ الفلسفة من أجل تجذير فكر حواري تساؤلي ونقدي، إنه يركز على مفهومي الفكر والوعي (واللاوعي).
ونقصد بصورة الفاعل الاجتماعي الذي يضع نصب أعينه المجتمع والمدينة، فينكب على دراسة بنيات المعرفة والسلطة، منخرطا في قضايا واقعه، معبرا عن مواقفه ومحتلا مواقعه، حاضرا بخطابه، محللا لما هو كائن، مدافعا عن ما ينبغي أن يكون، إنه يركز على مفاهيم التغيير والحداثة (وفي زمن غير بعيد الثورة).
ونقصد بصورة المصلح ذاك الذي يراهن على الأمة، فينشغل بربط الماضي بالحاضر، يغوص في تلابيب التراث، قراءة وتأويلا، معتبرا الفرد والمجتمع المنشودين نتاجين لثقافة أشمل لا يمكن الصعود نحوهما والنهوض بهما إلا بالنزول في أدراج تراث الأمة، نحقق به إحياء أو معه مصالحة أو نوجه له نقدا.
لهذا يصبح الاهتمام بالمجتمع المغربي جزء من دائرة اهتمام أوسع ألا وهو المجتمع العربي (إنه سؤال النهضة الشهير: لماذا تقدم الغرب وتأخرنا نحن؟) ويصبح الهاجس هو النظر في مفهومي التاريخ والعقل.
أعتقد أن المشتغلين بالفلسفة لم يهتموا كثيرا بصورة المدرس، واهتموا أكثر بصورة المصلح، إننا لا ننكر قيمة وأهمية مثل هذه الدراسات، ولكن لا نتصور أن يكون التأليف في الفلسفة مختزلا فيها، كما لا نتصور أن تعطي حياة ما للفلسفة في المغرب.
قد نقبلها كاهتمامات أكاديمية توجد بموازاة حياة فلسفية حقيقية وبجانب حضور فلسفي داخل النسيج المجتمعي وداخل مؤسسة الجامعة، إذ لا حياة للفلسفة بدون جدال عمومي، إن مزلق المشتغلين بالفلسفة وهم جامعيون ومدرسون للفلسفة يكمن في أن “كل واحد يقوم بعمله ولكن يبقى أسير ذاته ونادرا ما يخرج إلى المدينة، خوفا من أن يواجه الواقع،
وأن يكشف نظرة الغير إليه، يحتقر أمكنة السلطة الاجتماعية، ليس بسبب أنه يتميز بسمو الروح، ولكن لأنه غير مقبول فيها”[13]. لقد انتقد تويلر علاقة الفلسفة بالجامعة (في فرنسا) ملاحظا عليها هيمنة النزعة الأفلاطونية، ولكن بشكل مشوه، لأنها تركز على مبدأ الجدل الصاعد وتتغافل عن المبدأ المكمل أي الجدل النازل، إنها تغرق في المعرفة النظرية، وتتناسى الفعل.
وهذا يؤدي إلى نزع الحياة عنها[14]. إن هذه الملاحظة رغم ما تصوبه من انتقاد للفلسفة والجامعة، فهي تقر على الأقل بوجود توجه وتقليد فلسفيين سائدين في فرنسا، قياسا على ذلك يمكن أن نتساءل ما هي التقاليد التي رسخها تدريس الفلسفة بالمغرب؟ ما هي التوجهات التي حكمته؟ ما هي فلسفة تدريس الفلسفة بالمغرب؟
أعتقد أن التأليف في الفلسفة بالمغرب في حاجة إلى ترسيخ صورة المدرس، إننا في حاجة إلى النموذج السقراطي، الذي يكون الفرد، المشبع بروح الفلسفة، تفكيرا وتساؤلا ونقدا، إنه الفرد/المتعلم المغربي، الذي سيغادر أسوار المؤسسة، حيث من المفروض أن تحرره من قيود الكهف وتضعه في قلب المدينة، وأن تسلحه ببوصلة السير وتنمي فيه القدرة على الإقامة والترحال.
إن تذكر صورة المدرس (المنسية) هو رهان على التأهيل. فلا جدوى من الاهتمام بالمجتمع أو بالأمة، إذا كنا لا نؤهل الفرد لاستقبال امتدادات الأسئلة ولجعله فاعلا فيها.
نعتقد أن وظيفة التأليف الفلسفي هي وظيفة نقدية من شأنها أن تحرر الفرد (والفيلسوف) من كل دوغمائية، إنه مطمح فلسفي من أجل تغيير وعي وتصورات الناس، وذلك يفترض فتح آفاق للنظر، توسع من دائرة الممكنات، التي تحمينا من السقوط في انغلاق الفكر وقطعيته.
- IV – تركيب
نعتبر أن التأليف في الفلسفة بالمغرب هو حاليا عبارة عن تأليف ما قبل فلسفي، إذ نجد صعوبة في اعتباره تأليفا فلسفيا على شاكلة ما يؤلفه الفلاسفة الغربيون المعاصرون، أو على شاكلة ما ألفه الفلاسفة السابقون الغربيون منهم والمسلمون.
صحيح ثمة انشغال، ثمة تأليف، ثمة تراكم –لا زال ضئيلا- لكنه انشغال يحتاج إلى معانقة اللحظة السقراطية، ليس استنساخا لها، أو إحياء لها، بل استئناسا بها من أجل توطين فن المحاورة، ليس أسلوبا بل جوهرا.
إن ضرورة سقراط هي ضرورة العودة إلى الأصل، إلى سؤال الأسئلة: ما هي الفلسفة؟ والذي من شأنه أن يجدد الأسئلة ويوسع دائرة ممكن التفكير، إنه محك لمواجهة ما قيل وما كتب على ضوء حاضر الفلسفة، وفي أفق صياغة فلسفة لحاضرنا.
إن ضرورة سقراط هي كذلك الحاجة إلى ربط الفلسفة بتاريخها وليس اختزالها في تاريخنا الخاص، لكنه أيضا الحاجة إلى ربط الفلسفة بالمشتغل بالفلسفة وبالمدينة وبالجامعة، وبالتالي عودة الخصوبة والحياة إلى رحم الفلسفة.
إن ضرورة سقراط تعني ضرورة عودة الفيلسوف إلى المدينة، بما هو محاور فذ يغوص في الجدال العمومي، يحاور الناس ويحررهم من أسر اليومي، يحاور العلوم ويحاور باقي المشتغلين بالفلسفة، وباقي التأليفات، كما يحاور الفلاسفة والفلسفات.
إن ضرورة سقراط هي ضرورة الحلم بالمدينة، ضرورة اليوطوبيا، والتي من شأنها أن تحررنا من كهف الماضي وتجعلنا ننخرط في إبداع المستقبل[15].
إن ضرورة سقراط هي ضرورة استحضار صورة المدرس، أي الاهتمام بتكوين الأفراد، إنها إذن ضرورة الاهتمام بتدريس الفلسفة، كمختبر لضمان حضور قوي للفلسفة، وكفضاء لتجذير الوظيفة النقدية، بما هي تجليات عاكسة لكل ما سبق الحديث عنه من ضرورات.
أي بما هي أداة لفك مغالق الذاتي، والخصوصي، والكوني وفك مجاهيل الوجودي، الزمني والمستقبلي، ولما هي كذلك استراتيجية للانفتاح على العلوم وعلى تاريخ الفلسفة، وبما هي أساس لتفكيك عمران المدينة وبناء يوطوبياها، لذا وكلما غابت هذه الوظيفة وكلما خفت حضور هذه الضرورات إلا وتساءلنا، كما يقول تويلر:
“هل هو ضعف الفكر أم رغبة في الاطمئنان؟ مهما يكن الأمر، فإن مثل هذه المرافعات لا تعمل سوى على إثبات الفرق بين الوعود والوقائع. من المحتمل أن يكون الفلاسفة الموظفون هم أساسا أفراد طيبون، لكن الظروف قد تجاوزتهم، فليكن على الأقل ما يكفي من الوضوح لكي يخضعوا أنفسهم لهذا المبدأ الشهير: “التفكير النقدي” والذي هو مبدأ باعترافهم مرتبط دائما بالفلسفة”[16] g
[1] – عبد الله العروي: الإيديولوجية العربية المعاصرة، دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1979، ص16.
[2] – G.Deleuze – F.Quattari : Qu’est ce que la philosophie ? Les éditions de minuit, 1991, p7-8.
[3] – عبد السلام بنعبد العالي: الفكر الفلسفي المغربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1983، ص9.
وهذا ما أكده كمال عبد اللطيف في موضوع: (الفلسفة والهاجس السياسي عوائق الكتابة الفلسفية المغاربية)، المنشورة في كتاب جماعي حول الثقافة والمجتمع في المغرب العربي، منشورات المجلس القومي للثقافة العربي، 1992، ص61.
نفس الملاحظة ستشير إليها ورقة مشروع استراتيجية المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة (1997-1999) والتي نشرت في مجلة فلسفة، ع6، السنة 1998.
[4] – عبد الكبير الخطيبي: (النقد المزدوج وتفكيك الميتافيزيقا)، مجلة فلسفة، العدد 1، 1990، ص32.
هذا ما يؤكد عليه أيضا عبد الله العروي، وهذا ما يبرر طرح سؤال الترجمة كإشكالية اهتم بها بعض المشتغلين بالفلسفة (عبد السلام بنعبد العالي + طه عبد الرحمان).
[5] – عبد السلام بنعبد العالي، مرجع سابق، ص9.
[6] – عبد الله العروي: ثقافتنا في ضوء التاريخ، دار التنوير للطباعة والنشر، 1983، المركز الثقافي العربي. يرجع عبد الله العروي غياب الثورة العلمية في مجتمعنا إلى غياب ذهنية علمية وغياب ذهنية مدنية، وانفصال المؤسسات العلمية عن محيطها الاجتماعي واهتمامات الناس اليومية.
[7] – عبد السلام بنعبد العالي، مرجع سابق، ص10. انظر كذلك كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص63.
[8] – Hegel : Leçons sur l’histoire de la philosophie, Tr. Gibelin, T1, Gallimard, 1954, p27.
[9] – عبد الله العروي: مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، 1996، ص11.
[10] – عبد الكبير الخطيبي: النقد المزدوج، دار العودة، بيروت، ص19.
[11] – هاشم صالح: (دور الفلسفة في بلورة المشروع الحضاري العربي)، مجلة الوحدة، س5، ع60/1989، ص7.
[12] – J.Derrida : (Derechef du droit à la philosophie), in Points de suspensions, édition Galillé, 1992.
[13] – A.Renault : (L’université et la philosophie), in Magazine littéraire, 1996.
[14] – Pierre Thuillier : Socrate fonctionnaire, édition Complexe, 1985, p55.
[15] – عبد الكبير الخطيبي: (العلم والتقنية والفلسفة)، مجلة مدارات فلسفية، ع1، السنة 1998، ص8.
[16] – Pierre Thuillier, Ibid, p78.