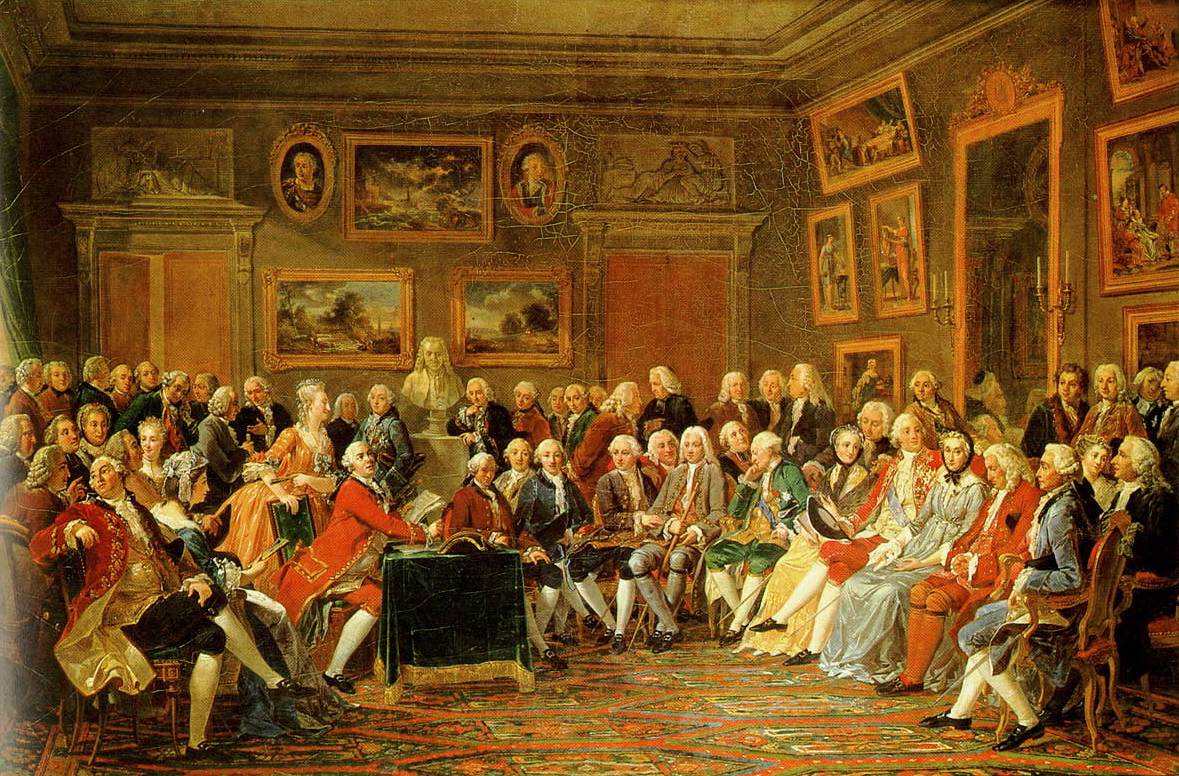لعل أبسط تعريف للمعجم أنه “كل قائمة تجمع كلمات في لغة ما، على نسق منطقي ما، وتهدف إلى ربط كل كلمة منها بمعناها، وإيضاح علاقتها بمدلولها” وهذا يقودنا إلى المحاولات الأولى في النشاط المعجمي العربي وأسبابها ودوافعها، فنحن نعلم علم اليقين أن علوم اللغة العربية كلها، والنشاط اللغوي، كانت جميعها مسخرة لخدمة الدين الإسلامي وفهمه وتوصيله للناس كافة. فليس غريباً أن نجد المحاولات الأولى تمثلت هذا الهدف واضحاً. فقد ابتدأ علماؤنا بشرح غريب القرآن الكريم وألفوا في ذلك مؤلفات وصل بعضها إلى عصر المطابع.
وثنوا بعد ذلك بشرح الغريب من ألفاظ الحديث الشريف، ثم أقبلوا يجمعون التراث الشعري الهائل الذي تناقلته الرواة منذ عصر الجاهلية، وتولوا أمر شرح هذا التراث الشعري وحفلت لنا كتب الفهارس برصيد ضخم منه.
وعندما شرع العلماء في التأليف المعجمي استمدوا جمهرة التعريفات من هذه الشروح الأولية لغريب القرآن والحديث والشعر. وبدئ بتأليف الرسائل الصغيرة التي تجمع النادر والغريب، وأخيراً تلت ذلك كله مرحلة بناء المعاجم اللغوية التي لدينا الآن منها رصيد ضخم.
وإنما سقت هذه المقدمة السريعة لأوضح أموراً، منها أن النشاط المعجمي أصيل نابع من حاجة وهدف، ومنها أن مراحل بناء المعجم القديم وخطواته التي مر بها ربما كانت عوناً لنا في بناء المعجم العربي الذي نطمح إلى بنائه، ومنها أن هذه المعاجم العربية القديمة، وإن بدت للوهلة الأولى أنها من عمل فرد، لكن مادتها، ومصادرها، جاءت نتيجة جهد جماعي قام به مجموعة من العلماء والرواة والأفراد.
ومنها لننفي التهمة التي علقت بأذهان نفر منا ومن غيرنا وهي أن العرب بنوا تلك المعاجم متأثرين بالهنود، أو الرومان، أو اليونان، أو غيرهم من أمم الأرض. يقول Haywood في مؤلفه الشهير عن المعاجم العربية: “الحقيقة أن العرب في مجال المعاجم يحتلون مكان المركز سواء في الزمان أو المكان بالنسبة للعالم القديم، وبالنسبة للشرق والغرب” ويؤكد في موضع آخر أسبقية العرب لغيرهم كالهنود “ومن العدل أن تقول أن فترة النشاط المعجمي في الهند كانت في القرن الثاني عشر، وهو وقت كان العرب فيه قد أنتجوا بعضاً من معاجمهم العظيمة”.
ولا يعني هذا الذي نذهب إليه أننا ننكر التأثر بين أمة وأخرى، وأن علماءنا لم يطلعوا أو يعرفوا شيئاً عن نشاط غيرهم اللغوي، ربما حدث هذا، ولكن طبيعة اللغة ونحوها وصرفها وتراكيبها، والهدف الذي من أجله بنيت المعاجم العربية، كلها أمور تختلف عن اللغات الأخرى، ولا سيما أنها تنتمي إلى عائلة لغوية مختلفة. وقد ناقش هذه القضية بإسهاب شديد الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه “البحث اللغوي عند الهنود”.
فالمعجمية العربية فن من فنون اللغة الكبرى التي اعتنى بها العرب عناية خاصة، ووضعوا فيها نظريات كبيرة، واستنبطوا لها تطبيقات عدة، ولكن أصحاب المعاجم لم يعتنوا بالنظريات بقدر ما عنوا بالتطبيقات مما يستوجب من الذين يهمون بصنع معاجم حديثة أن يولوا الدراسات الحديثة التي خصصت لهم عناية خاصة.
وقد يبدو تناقض بين القولين في ظاهر الأمر، ولكن الذي أراده الباحث أن صناع المعاجم العربية القديمة وضعوا في مقدمة معاجمهم نظريات وعدوا بالتزامها في معاجمهم، ولكنه لم يعتنوا بها كثيراً فخرجوا عنها، وشغلوا بالتطبيقات.
والعربية غنية غناء ملحوظاً بمعاجمها، بل لا تكاد تجاريها أمة من الأمم في القديم والحديث. وقد ألفت المعاجم في وقت مبكر من تاريخها (القرن الثاني الهجري)، وتنوعت تلك المعاجم بحيث لم تترك مجالاً إلا أغنته، ومن ألوان المعاجم:
- – المعاجم اللغوية.
– المعاجم المتخصصة: كتب التفسير، وكتب الحديث، وكتب الطبقات والتراجم في مختلف العلوم والمعارف الإنسانية، ومعجمات البلدان والأماكن، ومعجمات المصطلحات.
– معاجم المعاني.
ويجد القارئ ملاحق بهذا البحث توضح سعة هذا النشاط المعجمي، ولعل في هذا ما ينفي الزعم بأن المعاجم المتخصصة من صنع التاريخ الحديث والمعاصر. وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنها “وليدة جمع وتحصيل لجهود سابقة، واستخلاص من مكاسب وثروات محققة، وتتويج لحركات فكرية متلاحقة”.
ويرى فيها الدكتور إبراهيم مدكور أنواعاً ثلاثة من المعجم العربي المتخصص:
1. فمنها ما اقتصر على المصطلح، ولم يخلط به شيئاً سواه، وهذا أساس المعجم المتخصص.
2. ومنها ما التزم بالترتيب الأبجدي، وهذا دعامة التأليف المعجمي اليوم.
3. ومنها ما نحا نحواً موسوعياً ممهداً لظهور دوائر المعارف الحديثة. وهذه الأنواع الثلاثة متعاقبة زمنياً.
وبعد، فهذا تاريخ أو لمحة عن تاريخ المعجمية العربية، فماذا حدث في عصر النهضة العربية (القرن التاسع عشر والقرن الحالي)؟
الإجابة عن هذا التساؤل شائكة عسيرة، فقد صحا القوم من سباتهم على نهضة أوروبية شاملة، وغزو ثقافي وفكري ومطامع استعمارية للعالم العربي، ومطابع جلبها مبشرون غربيون إلى سوريا ولبنان، وأخرى حملها معه نابليون في حملته على مصر، فكانت ردود الفعل كثيرة متباينة.
كانت ثمة رغبة جامحة في اللحاق بركب الحضارة المتقدم، فكانت بعثات محمد علي إلى فرنسا، وكانت حركة أخرى تحاول الإفادة من هذه المطابع في استعادة الهوية الحضارية العربية، فأقبلت على التراث تنهل منه. وكان للمستشرقين دور لا ينكره منصف في بعث هذا التراث ونشره وتحقيقه ودراسة بعض جوانبه.
أما بالنسبة للمعاجم فقد كانت مجالات اهتمام الباحثين متمثلة فيما يلي:
1- الاهتمام بتاريخ المعجمية العربية.
2- الاهتمام بخصائصها الفنية وعيوبها.
3- المساهمة في وضع معالم المعجم العربي الجديد.
4- إبراز عوامل التأثر والتأثير التي طرأت على المعجمية العربية مبينة طرافتها القديمة، وخضوعها المعاصر لبنيات المعاجم الأوروبية.
وقد سعت هذه الدراسات النقدية المعاصرة إلى ضبط بعض النواحي من المعجمية العربية، والتعمق فيها دون أن تقدم نظرة صحيحة في الموضوع.
وبعبارة أخرى فإن الدراسات النقدية المعجمية المعاصرة سارت في اتجاهين رئيسيين:
- الأول: دراسة المعاجم القديمة ونقدها.
الثاني: السعي إلى وضع معالم المعجم المعاصر مفيدة من تجارب الأمم الأخرى. أما المسرب الأول فقد تعددت وسائله وطرائقه، فبعض الباحثين ركز على معجم قديم بعينه وتناوله بالنقد والتحليل، وقل أن نجد معجماً قديماً لم يدرس في كتاب أو أطروحة جامعية أو بحث، وبعضهم الآخر كتب في المعجم العربي منذ نشأته وشغلت دراسته مجلداً أو اثنين وبعضهم نشر بحثاً أو أكثر في خصائص المعاجم العربية القديمة أو عيوبها بينما طرق آخرون الموضوع في مقدمة معجم حديث قاموا بتأليفه، ويجد القارئ ثبتاً بالدراسات في آخر هذا البحث.
ويعد عمل الدكتور حسين نصار، كما ذهب الدكتور رشاد الحمزاوي، أشمل عمل عالج القضية معالجة مطولة متوخياً في ذلك نهجاً واحداً مركزاً على حياة المؤلف، وثقافته، وفنياته المعجمية، وصلاتها بمختلف المدارس المعجمية العربية، دون أن يعتني بتأثر المعجمية العربية بغيرها أو بتأثيرها فيها.
والقضية الخطيرة التي أخذها الدكتور الحمزاوي على الدراسات الحديثة حول المعجمية العربية القديمة أنهم جميعاً سعوا إلى ضبط أصول المعجمية العربية، وتدقيق مناهجها والتعريف بمدارسها بطريقة وضعية دون أن يعالجوها معالجة لغوية اجتماعية.
ولقد كثر ورود هذه العبارة “عيوب معاجمنا القديمة” في الدراسات الحديثة، وبالرغم من أنني لا أنكرها، ولكنني أرى أنها تبدو الآن عيوباً بعد مضي اثني عشر قرناً على تأليفها، ولكنها سنة التطور، ولا يمكن أن تحاسب وتنقد بمقاييس اليوم، لأن في ذلك ظلماً لهما ولمؤلفيها. وكذلك فإن هذه المعاجم في تنوعها وغزارة مادتها قد حفظت لنا لغتنا وأدبنا وحضارتنا ومعارفنا في تلك الحقب المتتالية.
وسنحاول الوقوف على عيوب هذه المعاجم، ومن خلاصة ما أورده الباحثون نستطيع أن نميز العيوب والنواقض التالية:
1. هي ناقصة المادة بالرغم من اتساعها، وإن أي باحث في التراث الأدبي القديم يحس بهذا النقص، وقد لمسته بنفسي قبل خمس عشرة سنة حينما كنت أعد أطروحة الدكتوراه حول شعر أيام العرب في العصر الجاهلي، وظلت فكرة معجم لألفاظ الشعر الجاهلي حية في ذهني حتى أخرجتها إلى حيز التنفيذ قبل أربعة أعوام.
2. عنيت المعاجم القديمة بإثبات الألفاظ القديمة بما فيها الغريب والموات، وفي الوقت نفسه أهملت كثيراً من الألفاظ والاستعمالات الجديدة التي تتردد في الشعر المحدث (العصر العباسي)، وفي مؤلفات مختلف العصور العباسية التي تعد العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية.
3. لا تعيننا على مسايرة التطور التاريخي للغتنا بشكل واضح لوقوفها عند زمن معين لا تتجاوز (حوالي 150هـ) إلى ذكر الألفاظ المولدة أو المعاني المستحدثة إلا قليلاً، وهي بذلك تقطع سلسلة التطور من معاني الألفاظ قطعاً اعتباطياً، وكأن أصحاب المعاجم اعتبروا اللغة العربية لغة أزلية ثابتة لا تتغير. وترتب على هذا أن المعاجم جميعها ينقل بعضها عن بعض بتقيد شديد لا سيما المتأخر منها.
4. هذه المعاجم بعيدة عن مقتضيات العصر الحديث فتنقصها السهولة والوضوح وقرب المأخذ.
5. لا تضبط هذه المعاجم المعاني للفظة الواحدة بالضوابط الزمنية.
6. التصحيف؛ ويؤخذ هذا العيب عليها جميعاً. فالكتابة العربية لا تبين نطق الحروف التي ترسمها، وتحتاج إلى إشارات مضافة لإبانة ذلك. وقد تقع الإشارات المضافة في موقعها غير الصحيح بسبب إهمال الكاتب أو تعبه فتسبب خطأ.
وقد يكون التصحيف بالحركات كما بينا، ولكن الضبط بالكلمات استوعب جزءاً كبيراً فضخم المعجم، ولم نستقر إلى اليوم على حل للمشكلة.
وقد يعتري التصحيف الحروف لتشابه بعضها فلا يختلف إلا بنقطة أو اثنتين أو ثلاث فوقها أو تحتها، ولم يسلم من هذا عالم قديم ولا حديث. وقد نوه الأب الكرملي على أغاليط مدرسة اليسوعيين من المعجميين. وهناك المصنوع الموضوع من العلماء أنفسهم، فقد كثرت الألفاظ التي ادعى فيها الإبدال ونسبت إلى القبائل، وابتكرت ألفاظ لم تعرفها العربية أبداً. ويكمن الحل بفرز دقيق للألفاظ، وما لم نستطع الحكم عليه ومحاكمته في ضوء الاشتقاق نبذناه.
7- القصور: نكاد نتفق جميعاً على أنه ليس فيها إلى اليوم ما هو جامع بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. ولعلنا نعذرهم لقلة المصادر وحداثة العهد بهذا النوع من التأليف ولأنهم لم يستقصوا الألفاظ الواردة في الرسائل اللغوية الصغيرة ودواوين الشعر. وقد اعترف بعض أصحاب المعاجم القديمة، فذكروا مصادرهم، ولم تكن شاملة.
ومن الأسباب التي يمكن تحديدها خلافاً لما ذكرنا:
أ- نظرتهم إلى اللغة ناقذة لا جامعة، فقد اقتصروا على الفصيح الصحيح وقسموا القبائل إلى فصيحة يعتد بلغتها وغير ذلك.
ب- أنهم أقاموا أحكامهم على هدى القرآن واللغة الشعرية الفنية.
ج- إهمال المولد وعدم اعتباره من اللغة حتى ضاع كثير من الألفاظ والمعاني المبتكرة للمظاهر الحضارية الجديدة وهي كثيرة جداً.
8- قصور العرض وإبهامه وسوء التفسير:
فهم لا يلتزمون توضيح أبواب الفعل ومصادره والمتعدي واللازم وبم يتعدى اللازم، كما لم يوضحوا المفرد من الأسماء والصفات ومجموعها، والمعرب وأصله، وكيف دخل العربية ومتى كان ذلك وما عراه من تغيرات، وهل يأتي اللفظ في أسلوب معين أم هو طليق ولا يفرق لنا بين الأفعال والصفات والأسماء.
وأما سوء التفسير فيتمثل في التقليد بالنقل ممن سبقهم، لذا فهم يفسرون تفسيراً مبهماً غير مفهوم، بل إن المعاجم تفسر الكلمات تفسيراً دورياً (سئم، ضجر، ملّ، برم) .. وقد تخلو المعاجم من تفسير للأشياء كقولهم: نبات أو عشب أو طائر أو ضرب من السمك، ولا يحددون اسمه أو صفاته. وقد تفسر الأشياء بتفسير أشد غموضاً (الحزم هو الأخذ بالثقة). وثمة أمر أشد خطورة وهو اختلاف المعاجم في تفسير بعض الكلمات، وفي أحيان كثيرة لا تأتي المعاجم بأمثلة لتوضيح بعض المعاني.
9- عدم تمثل العلماء للغرض الدقيق من المعاجم: فهم قد جمعوا فيها كل شيء، لأنهم أرادوا جمع اللغة ونوادر الأعراب ومعارفهم والنواحي المختلفة للثقافة العربية والاعلام والقصص والخرافات والإسرائيليات والروميات والهنديات.
10- خلوها من الدقة في الترتيب والتقسيم: فلا يكاد يوجد معجم كبير واحد يسير على حروف ألف باء من أول الكلمة إلى آخرها. وقد ترتب على ذلك وضع كثير من المفردات بسبب مراعاتهم لبعض الأحكام الصرفية، وكرروا كثيراً من الألفاظ التي اختلف الصرفيون في أصلها المشتقة منه (مثلاً: الرباعي المضاعف، الكوفيون: مشتق من الثلاثي، البصريون: مادة أصيلة، وكذلك المعرب استبرق).
وقد دخل الاضطراب المواد نفسها، فاختلطت المعاني المجازية بالحقيقية والمتقدمة بالمتأخرة، والمشتقات بعضها ببعض. وقد تذكر الصيغة في أكثر من موضع، وتفسر بأكثر من قول. وقد تبدأ المادة بالفعل أو الاسم أو الصفة بدون سبب. وقد شعر بهذا ابن سيده الأندلسي في “المخصص” فوضع قواعد، ولكنه لم يسر عليها في كتابه.
11- وأخيراً فإن من عيوب المعاجم العربية القديمة التضخم، وقد حاول الدكتور أحمد أمين حصر أسباب التضخم فكانت:
– اختلاف العرب في اللهجات.
– بعض الأفراد كان يحرف في بعض الكلمات أو يقلبها، مثل: حمد، ومدح.
– القلب مثل: الأوشاب والأوباش.
– قد تستعمل قبيلة من قبائل العرب كلمة، وتستعمل قبيلة أخرى كلمة، ويأتي جامعو اللغة، ويجمعون كل ذلك.
– كان الجامعون الأولون يجمعون اللغة حيثما اتفق غير معنيين في الغالب بالقبيلة التي تنطق بالكلمة.
– توسع بعض الأعراب دون بعض في المجاز.
– لم يكن بعض جامعي اللغة يتحرى في جمعه.
– التصحيف.
– كانوا يزعمون أن العرب لا تخطئ في نطقها لا لفظاً ولا معنى.
– احتمال الخطأ في السمع.
– تعرض المتأخرون من رجال اللغة لما ليس لهم به علم، وأطالوا في ذلك.
– أن اللغويين بعد الفتح وكثرة الأقطار جدّت أشياء كثيرة من نبات وحيوان وأسماء قرى وغير ذلك فأدخلوها في المعجم.
– بعض اللغويين مزجوا اللغة بالأدب كابن منظور والزبيدي.
وهكذا، فإنه مع بداية عصر النهضة، وتوافر الطباعة، والرغبة في صنع معاجم تخدم الأهداف وتتجنب عيوب المعاجم القديمة، كما زعموا، بدأت نهضة معجمية. ولقد تأخر ظهور المعجم الحديث في مصر عن لبنان، لأن التنافس الإنجيلي الكاثوليكي استهدف طبقات الشعب، تبشيرياً أولاً، ثم تقليدياً وتعليمياً. وجاءت المعاجم العربية الحديثة تلبية للمتطلبات الدراسية والنشاطات الأدبية واللغوية والثقافية.
د. عفيف عبد الرحمن – الأردن.