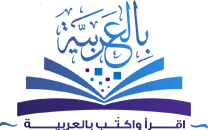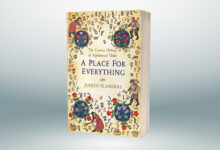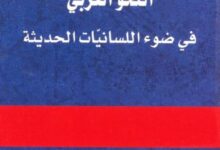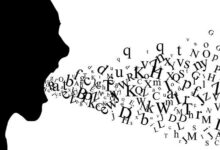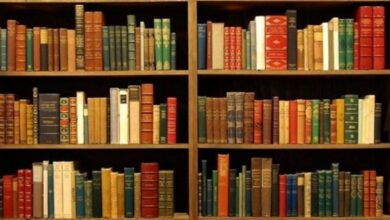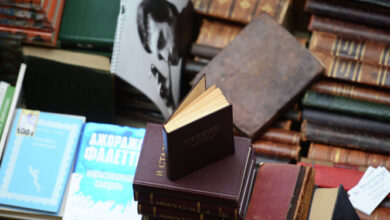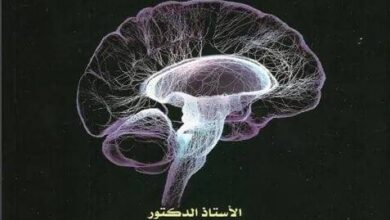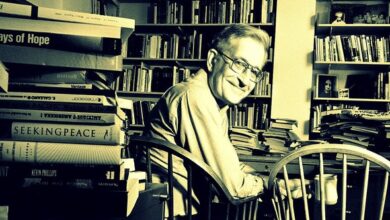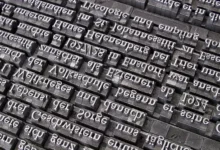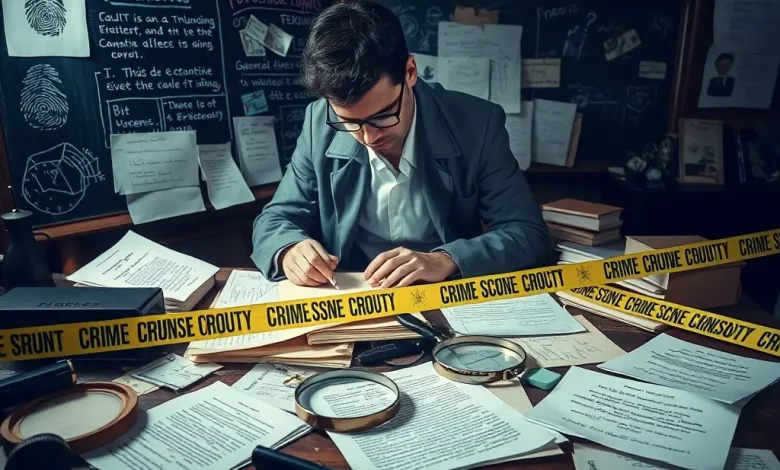
- تقديم:
تسعى هذه الدراسة الأكاديمية إلى تفكيك واحدة من أعقد الإشكالات التي لازمت حقل الترجمة منذ نشأته، والمتمثلة في إشكالية «ما لا يمكن ترجمته». تنطلق الورقة من الوعي بأن الترجمة ليست مجرد نقل لغوي بين نظامين دلاليين، بل هي (فعل معرفي وثقافي) يتقاطع فيه الفهم اللغوي بالتصور الفلسفي، حيث يصبح «اللامترجَم» فضاء يكشف حدود اللغة وطاقتها في تمثيل المعنى.
تستند الدراسة إلى الخلفيات النظرية التي رسّخها “فالتر بنجامين“ في نصه المرجعي «مهمة المترجم»، والذي أعاد صياغة مفهوم الترجمة بوصفها (تواصلا ميتالغويا) يتجاوز الإحالة المباشرة نحو بحثٍ في جوهر المعنى وإمكانات التعبير عنه في لغات متعددة.
وتُبرز الورقة كيف تحوّل هذا التصور إلى منطلق فلسفي وثقافي أثّر في اللسانيات الحديثة ودراسات الترجمة المعاصرة، خاصة في مقاربات ما بعد البنيوية والتفكيكية.
كما تتناول الدراسة بإمعان قضية “ترجمة الاستعارة“، بوصفها أحد أكثر مظاهر اللغة مقاومة للنقل بين اللغات، وذلك في ضوء (نظرية الاستعارة التصورية) التي ترى في الاستعارة بنية فكرية قبل أن تكون ظاهرة لغوية. ومن هذا المنظور، تبيّن الورقة أن ما يبدو “غير قابل للترجمة” لا يعود إلى قصور لغوي، بل إلى (اختلاف في النماذج الإدراكية والثقافية) التي تشكّل المعنى في كل لغة.
وبذلك، تقدم الدراسة مقاربة فلسفية ولسانية متكاملة لمفهوم «ما لا يمكن ترجمته»، محاولة استكشاف حدوده النظرية وآثاره العملية على فعل الترجمة ذاته، وعلى وعي المترجم بوظيفته المعرفية في نقل المعنى بين الثقافات دون أن يُفقده عمقه المفهومي أو رمزيته الثقافية.
تخلص الورقة في نهايتها إلى أن إدراك المترجم لهذه الفجوات المفهومية هو ما يتيح له تجاوز حدود اللغة نحو أفق ترجمي خلاق، يعيد إنتاج المعنى دون إخلال بروحه أو تفريغ رمزيته الثقافية.