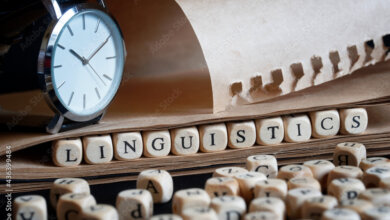راجت في الأيام الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قولة للمفكر الأميركي نعوم تشومسكي (1928) جاء فيها: “فاتني خيرٌ كثير حين لم أتعلّم العربية”. وهي قولة يردّدها مع تعدّد دعواته للمشاركة في ندوات عربية، خصوصاً في المغرب، وأكثر من مرة أشار إلى أنه أهدر في شبابه فرصة ثمينة لتعلّم العربية، وكان يمكن للضاد أن تساهم في تطوير نظرياته اللغوية.
يُحسب هذا الاعتراف بأهمية العربية مع مواقفه الداعمة لتحرّر الشعوب العربية، ونقده للصهيونية رغم أصوله اليهودية، وهجومه على ما تقترفه الرأسمالية من جرائم في حق البشرية، وهو يعيش في معقلها. كلّ ذلك يصبّ في خانة “النزاهة المعرفية” التي عُرف بها وصنعت أمجاده كمثقّف بعد أن صنعت نظرياته في اللسانيات أمجاده كباحث. ومن هذا الموقع، يُصبح لاحتفاء تشومسكي بالعربية وقعٌ خاص.
لكن، في مقابل عدم تعلّمه العربية، لم يتقن تشومسكي سوى الإنكليزية، متأثراً بموطنه الأميركي، والعبرية المستحدثة من خلال أصوله اليهودية، مع معرفة جزئية بالفرنسية اقتضاها العمل على النظريات الأولى للسانيات ومرجعية ديكارت في مشروعه المعرفي.
هذه اللغات الثلاث، الإنكليزية والفرنسية والعبرية، هي للأسف أكثر المحامل عدوانية ضدّ العربية وأهلها. فإذا علمنا أنّ النظريات اللغوية تنطلق من مادة ملموسة (هي كلمات اللغات التي يعرفها وتراكيبها ومخيالها)، نعرف ما فات تشومسكي حين لم يتعلّم العربية. فاتته الكثير من الدقة المعرفية، فاللغات تتأثر بمضامينها وبمواقعها الجيوسياسية وبرهاناتها، كذلك فإن مشروعه العلمي الأبرز، وهو البحث في الكوني داخل اللغة، منقوص بالضرورة دون العربية.
دائماً ما يربط تشومسكي بين البنى القائمة في سطح النص وتلك الثاوية في عمقه. وفي سطح مقولة تشومسكي، هناك احتفاء بالعربية، ولكن في عمقها توجد إدانة. ما الذي منع مشاريعه النظرية أن تمتد إلى العربية، فيضيف الباحثون العرب “الخير الكثير الذي فات تشومسكي” لصالح المعرفة العالمية.
في عمق قولة تشومسكي، تبدو العربية في انتظار مفكّر غربيّ يضعها على الطرق السريعة للبحث العلمي في العالم. ما تقف عنده قولة تشومسكي ولا تلامسه هو ما الذي كان سيتغيّر في فكر تشومسكي لو أنه تعلّم العربية؟
وفي الحقيقة، إن الإجابة عن هذا السؤال لا تقع على عاتق تشومسكي، بل على الباحث العربي في اللسانيات، وما تشومسكي إلا مادة أولية وفضاء مفاهيمي وإشارات لبرنامج بحثي يمكن الاستفادة منه في وضع العربية على خريطة العالم في البحث اللساني.
العربية التي يتحدّث عنها تشومسكي كأمر فاته متاحة لنا، مُلقاة كنوزُها على قارعة الطريق بيننا
أما على مستوى التلّقي العربي لهذه المقولة، فمن جانب لا نزال نطرب لمثل هذه الاعترافات بالعربية، لغة وثقافة وتراثاً. تتشكّل حالة من الزهو لمن يقول إنّ علم الاجتماع أسّسه ابن خلدون، وأنّ لابن سينا أيادي بيضاء على كلّ إنجاز طبي حديث، وأنه لولا ابن رشد، لاندثر الكثير من تراث الحكمة اليونانية.
ومن جانب آخر، توجد علاقتنا بتشومسكي كمثقف معاصر لنا، له خصوصية الانتصار للكثير من قضايانا. وكثيراً لا يلبث أن يصبح هذا البُعد إلى انبهار، فنحوّل كلّ ما يصدر من تشومسكي، وغيره من المفكرين المقربين من قضايانا (إدغار موران…) إلى فكر جاهز.
ومن الوجيه أن نلاحظ تزايد حضور تشومسكي من عقد إلى آخر في الثقافة العربية. بدءاً بترجمة عدد من مؤلفاته، ليأخذ منذ تسعينيات القرن الماضي موقع نجومية فكرية في ثقافتنا إلى جانب أسماء مفكرين أحياء، مثل هابرماس وإيكو وتودوروف (الثاني والثالث توفّيا منذ سنوات قليلة).
لكن تشومسكي حضر أساساً عبر كتاباته السياسية، وبقي عمله البحثي في اللسانيات -وهو أبرز منجزاته المعرفية- منحصراً حضورُه في الأطر الأكاديمية، ولم يتغيّر الأمر إلا في السنوات القليلة الماضية مع حضوره المتواتر في منتديات بحثية يشارك فيها عبر الإنترنت، معظمها في المغرب.
ولا ندري، هل الأمر متعلّق بحماسة بحثية ومحاولة فهم فكر تشومسكي في مصادره، أم هو متعلّق بنجوميّته الفكرية؟ وهل للأمر علاقة باستراتيجيات تواصلية طوّرها تشومسكي بشكل واعٍ ليصل إلى مختلف الثقافات، أم هو مجرّد طلب عربيّ عليه كعالم لسانيات وكمثقف له آراؤه في السياسة وحال البشرية اليوم؟
في السيرة التي وضعها لتشومسكي عام 1997، هيكل الباحث روبرت بارسكي عمله حول محورين متناظرين: “الوسط الذي كوّن تشومسكي” و”الوسط الذي كوّنه تشومسكي”. أما الأول، فإن مقولة تشومسكي آنفة الذكر تبيّن أنّ العربية لم تكن جزءاً من الوسط الذي كوّن تشومسكي. أما الثاني، فإن العقد الأخير يبدو كمرحلة اندماج للفضاء العربي في “الوسط الذي كوّنه تشومسكي”.
وبالتالي في الإطار العالمي للبحث في العلوم الإنسانية، وهو أمر له إيجابياته بالتأكيد على مستوى أن يكون العرب مرئيين في حقول المعرفة، ومن واجبهم هم أن يحرصوا كي يكونوا أكثر من متلقين أو تكون ثقافتهم مجرّد فضاء تطبيق لنظريات غربية.
لا يستطيع تشومسكي أن يفكّر بدلاً عنا. وإن كان من تحية عربية إلى تشومسكي فهي أن نستعمل فكرَه لنفكّر بأنفسنا
الفائدة الأبرز من مقولة تشومكسي أن ينهمك شق من الباحثين العرب في فهم ما لم يُنجزه تشومسكي حين لم يتعلم العربية. كيف كانت ستكون النظريات اللغوية الحديثة لو أخذت في حسبانها لغتنا، ولغات أخرى كثيرة بعضها بصحة جيّدة وبعضها مهدّد بالاندثار؟
العربية التي يتحدّث عنها تشومسكي كأمر فاته متاحة لنا، مُلقاة كنوزُها على قارعة الطريق بيننا. بعبارة أخرى، نحن لم يفتنا الخير الكثير الذي فات تشومسكي. لكن ماذا نفعل بهذا الخير ما لم نطوّر حوله نظريات ومعارف؟
ها نحن نستعمل يومياً كلمات لها ذاكرةُ قرون. وحدنا نحن لنا فرصة أن نتعهّدها يومياً حين نضعها في احتكاك مع إشكاليات الواقع المتجدّد، أن نجعلها تفكّر معنا، وإن كان لتشومسكي درس يلقيه علينا، فهو أنّ اللغات تناصر كلّ مقاومة، كذلك يمكن أن تكون أداة تسلّط. في كلتا الحالتين، تشومسكي مفيد كي نعرف كيف تكون اللغة معنا، ومتى تكون ضدّنا.
دروس كثيرة أخرى يمكن أن نتلقاها من تشومسكي. معه نعرف أنّ التخصّص ليس إلا خطوة لقول شيء مبتكر وفاعل حول الواقع، ولنا أن نصطحبه في نظرته النقدية التي رأت مبكراً تحويل الديمقراطية في الغرب إلى قشرة دون نواة، وأن تصديرها يأتي كوسيلة هيمنة جديدة. وما لم تكن الديمقراطية منتجاً تفرزه المجتمعات كحاجة، فإنها بضاعة مسمومة.
وبذلك ربما نقف على بعض مواطن تعثّر الانتقال الديمقراطي في منطقتنا. وعلى مثال الديمقراطية، لنا أن نقيس كلّ النظريات الفكرية واللغوية، فإذا لم تنبع من أصالة تعيد إنتاجها، فهي عامل تعطيل، وليست نظريات تشومسكي استثناءً.
لا يستطيع تشومسكي أن يفكّر بدلاً منا. وإن كان من تحية عربية إلى تشومسكي، فهي أن نستعمل فكرَه لنفكّر بأنفسنا.
نقلا عن العربي الجديد