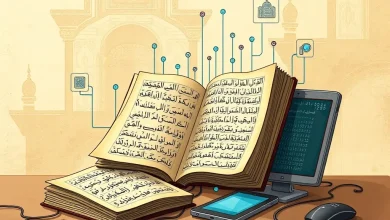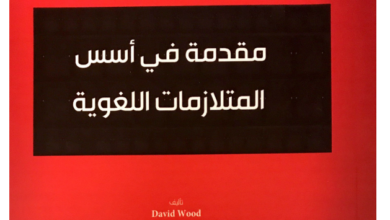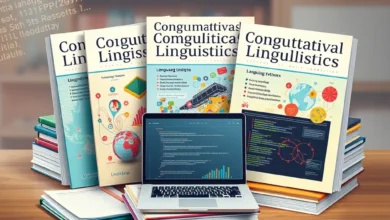“Not only is our conceptualized world our own reality”
.”we constantly check wether it converges with everyone else’s”
.R. Jackendoff (2002), p. 332
- تقديم
تسعى النظرية الدلالية إلى الإجابة عن أسئلة من أبرزها، إلى جانب السؤال الأنطولوجي حول ماهية المعنى (أو التصورات)، والسؤال الدلالي حول علاقة العبارة اللغوية بمعناها، وسؤال التعلم حول اكتساب التصورات، سؤال التواصل المتعلق بكيفية استخدام التصورات في التواصل بين البشر. ويتناول البحث هذا السؤال وبعض عناصر الإجابة عنه من خلال محورين رئيسين:
- تحديد طبيعة التصورات باعتبارها كيانات تمثيلية نفسية؛ وتحديد دورها في العمليات المعرفية، اللغوية وغير اللغوية، داخل بنية الذهن/الدماغ المعرفية العامة؛
- تناول الإجابة عن سؤال التواصل في إطار الإمكانات التي تتيحها النظرية الدلالية النفسية، بخلاف نظرية دلالة شروط الصدق؛ وتأسيس مفهوم التواصل على حاجة المتكلمين إلى تناغم بناءاتهم التصورية سعيا إلى فهم مشترك للعالم.
1 عن وظائف التصورات
ننطلق، في إطار نظرية الدلالة التصورية، من افتراض قاعدي مفاده أن الدلالة اللغوية جزء من نظرية ذهنية (نفسية) أوسع حول الكيفية التي يفهم بها البشر العالم، وأن موضوع الدراسة صورة من صور البنية الذهنية تسمى البنية التصورية، وترمز العالم كما يتصوره البشر.[1]
ومن ثمة يكون على النظرية الدلالية أن تخصص، أولا، نسق البنية التصورية التأليفي، بأولياته ومبادئ تركيبها، الذي تمثله قواعد تكوين التصورات وسلامتها. فتعتبر البنية التصورية التي ترمز معاني الكلمات والمركبات والجمل، نسقا تأليفيا توليديا صوريا مستقلا عن البنية التركيبية وأغنى منها إلى حد بعيد.
وذلك بأولياته المتمثلة في كيانات مثل الأفراد والأحداث والأمكنة والخصائص والمقادير والمحمولات والمتغيرات والأسوار؛ ومبادئه التأليفية القائمة، بخلاف علاقات العلو والترتيب الخطي التي نجدها في التركيب، على علاقات مثل الروابط المنطقية، والدالات وموضوعاتها، والأسوار ومتغيراتها، والأقوال واقتضاءاتها، والنعوت ومنعوتاتها.
هكذا تتعلق هذه المهمة الأولى داخل النظرية الدلالية بالكيفية التي ينظَّم بها مجال المعنى اللغوي وتبنى ظواهره؛ سواء في مستوى دلالة الوحدات المعجمية، أو في مستوى دلالة المركبات والجمل.
كما يكون على النظرية الدلالية أن تخصص، ثانيا، القواعد الوِجاهية (interface rules) التي تسقط بنيات النسق التأليفي الدلالي على البنيات اللغوية الخالصة الأخرى التركيبية والصواتية. ومن بين هذه القواعد الوجاهية، نجد الكلمات التي تربط بين أجزاء من البنية التصورية وأجزاء من البنية التركيبية والصواتية؛ كما نجد القواعد الوجاهية التي تتعامل مع بنيات المركبات والجمل. ويعبر عادة عن هذه المهمة بالسؤال عن الكيفية التي تعبر بها اللغة عن التصورات أو “الأفكار”.
لكن دور التصورات لا ينحصر في هاتين المهمتين اللتين تتعلقان بما يسمى عادة “دلالة لغوية”، وبموقعها داخل المحيط النحوي، بل يشمل خدمة أغراض أخرى يفرضها المحيط الذهني وبيئته المعرفية العامة، ويوجب على النظرية الدلالية تخصيص الوجاهات المتصلة بها.
من ذلك الوجاه المتصل باستعمال التصورات التي تنقلها اللغة لإنتاج تصورات أخرى؛ وهو ما يسمى بالاستنتاج أو التفكير، بما في ذلك رسم الخطط وتكوين المقاصد الهادفة إلى أفعال. والوجاه المتصل بإدماج التصورات في المعارف والمعتقدات التي سبق تحصيلها، وضمنها المعارف المتعلقة بسياقات التواصل ومقاصد المخاطَبين التي تدرس عادة في أبواب الذريعيات.
والوجاهات التي تصل التصورات التي تنقلها اللغة بالأنساق الإدراكية، لنتمكن من الحديث عما نراه ونسمعه ونذوقه ونشمه ونلمسه. والوجاه الذي يصل التصورات بنسق العمل ويمكننا من إنجاز الأعمال الفيزيائية التي نخضع لها العالم ونمارسها فيه، كما يحصل عندما ننفذ عملا جوابا عن أمر أو طلب محمولين لغويا.
وحتى يمكن لهذه الأنساق أن تتفاعل في ما بينها لتمكين الإنسان من بناء تصور موحد للعالم، تحتاج كل هذه الوجاهات إلى أن تلتقي في بنية ذهنية معرفية مشتركة هي البنية التصورية.[2] وهي، كما يتضح مما سبق، ليست جزءا من اللغة في حد ذاتها، وإنما هي جزء من الفكر. وهي المستوى الذي يتم فيه فهم الأقوال اللغوية في سياقاتها الذريعية والموسوعية، وتتبلور عمليات التفكير والتخطيط، وتتصل التصورات بالإدراك والعمل.
2 عن سؤال التواصل
من الافتراضات الأساسية، في النظرية الدلالية النفسية، أن البنية التصورية تنتمي إلى مستعمل اللغة الفرد؛ أي أن معاني الكلمات توجد في رؤوس الأفراد. لكن من البديهي، من جهة أخرى، أن اللغة ظاهرة اجتماعية.
فكيف تصبح البنيات التصورية الفردية اجتماعية؟ وإذا أمكن أن يفرض كل شخص معناه المعرفي الخاص، كيف يمكن، إذن، أن نتحدث عن وجود معنى متفق عليه لعبارة معينة؟ وكيف يمكن للشخص أن يخطئ بخصوص المعنى؟ وإذا كانت الدلالة المعرفية، بإلحاحها على البنيات التصورية الفردية، صائبة، فكيف نتفادى إذن برج بابل؟
ترتبط هذه الأسئلة بسؤال أعم هو سؤال التواصل الذي على أي نظرية دلالية الإجابة عنه – إلى جانب السؤال الانطولوجي والدلالي وسؤال التعلم- وهو سؤال حول كيفية التواصل بالمعاني والتصورات. فإذا كان بناء التصورات فرديا في جوهره، فكيف يمكننا أن نتواصل أو نعتبر أننا نتحدث عن نفس الأشياء؟
إن النظرية الدلالية “الواقعية” (أو دلالة “شروط الصدق”) لا تجد صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال؛ إذ ما دامت معاني الكلمات موجودة في العالم الخارجي، يمكننا أن نتحدث عن هذه الأشياء ما دمنا نتحدث نفس اللغة، أي ما دمنا نشترك في الربط القائم بين العبارات اللغوية والعالم.
فبخلاف النظريات الدلالية التي تعتبر العبارات اللغوية ذات دلالة بفضل علاقتها بتصورات أو بعناصر مماثلة تنتمي إلى لغة ذهنية، فإن المعنى في نظريات شروط الصدق، ينتج عن ربط العبارات اللغوية بكيانات غير لغوية. فتكون إحالات الجمل قضايا تحمل قيم صدق.
وهكذا يكون فهم الجمل قائما على ما يحدد مبدئيا شروط صدقها، أو على “معرفة الصورة التي يجب أن يكون عليها العالم لتكون صادقة”.[3] ولذلك يسمى هذا التصور دلالة شروط الصدق.
ورغم أن مثل هذا الجواب يبدو أنيقا، إلا أنه يزيد على الصعوبات التي تواجهها النظريات “الواقعية” مع سؤال التعلم، صعوبات إضافية. فيصبح السؤال: كيف يمكننا أن نعرف أننا تعلمنا الربط السليم بين اللغة والعالم؟
وعلى النقيض من هذا، فإن السؤال التواصلي يعتبر مشكلا حقيقيا في النظرية الدلالية النفسية التي تربط المعنى بأذهاننا الفردية، ومن ثمة يطرح السؤال حول الكيفية التي يمكننا بها أن نتواصل بصدد الموضوعات.
ذلك أننا لتفسير علاقة الجمل “بالعالم” يجب أن نحدد، ضمن أشياء أخرى، ما هو موجود في العالم كما تؤوله أذهاننا حتى تصدق عليه مثل هذه الجمل. فيرجعنا هذا إلى ضرورة نظرية للتمثيل الذهني تصف نظام العالم كما نؤوله، أي إلى نظرية للدلالة التصورية (النفسية).
وإذا ثبت أن عالم التجربة (“الواقعي”) مدين بهذا القدر لعمليات التنظيم الذهنية، أصبح من الأمور الجوهرية في النظرية النفسية أن تميز بعناية مصدر الدخل الخارجي من عالم التجربة. فيسمى الأول عالما واقعيا ويسمى الثاني عالما مسقطا (projected world).
ولا تكون المعلومات التي تحملها اللغة معلومات بصدد العالم الواقعي. فنحن لا نستطيع الوصول الواعي إلا إلى العالم المسقط، أي إلى العالم كما ينظمه الذهن. ولا يمكن للغة أن تتحدث عن الأشياء إلا في حدود ما يسمح به هذا التنظيم.[4]
إن الكيفيات التي تتم بها التعالقات في النسق اللغوي لا تنفصل عن الكيفيات التي نجزئ بها العالم والتي تقوم على وسائلنا الإدراكية والمعرفية التابعة لقيود جشطلتية مختلفة. ومن ثمة فالمعلومات التي تحملها اللغة لا يمكن أن تكون إلا بصدد العالم المسقط، أي العالم كما تحدد تأويله الكيفية التي بنيت بها ذواتنا البشرية، أو القدرة التعبيرية لتمثلاتنا الداخلية.[5]
بهذا يكون التعارض بين تصوري الإحالة في النظريتين “الواقعية” والتصورية كالتالي:
(أ) الإحالة في النظرية “الواقعية”:
تحيل العبارة ع، في اللغة ل، المَقُولَة في السياق س، على الكيان ك في العالم (أو في العوالم الممكنة).
(ب) الإحالة في النظرية التصورية:
يحكم المتكلم م في اللغة ل على العبارة ع، المقُولة في السياق س، بأنها تحيل على الكيان ك في العالم كما يتصوره م.
إن الإحالة في النظرية التصورية تابعة في أساسها لمستعمل اللغة الذي لا يمكنه أن يحيل على كيان معين دون أن يكون له تصور معين عنه.
وهذا يعني أن الكينونة في العالم كما يتصوره المتكلم شرط ضروري لفعل الإحالة. لكن الكينونة في العالم الواقعي ليست شرطا ضروريا، إذ يمكن للمتكلم أن يحيل على كيانات روائية مثل: ليليان (من شخصيات “قصة حب مجوسية” لعبد الرحمان منيف).
كما أنها ليست شرطا كافيا، إذ يجب أن يكون للمتكلم تصور معين عن المحال عليه. والخلاصة أن الكينونة في العالم الواقعي ليست شرطا ضروريا ولا كافيا لتمكن المتكلم من الإحالة. ويبقى العامل الرئيس متعلقا بامتلاك تصور معين عن الكيان المعني.
إن الإحالة، إذن، علاقة قائمة بين التعابير اللغوية وبين تأويلات المتكلمين للعالم الخارجي، حيث يكون التأويل ناتجا عن تفاعل بين الدخل الخارجي والوسائل الصالحة لتمثيله داخليا.[6] وهذا في إطار نظرية تصورية تعتبر، كما رأينا، أن اللغة والتصورات توجدان معا في الذهن/الدماغ وترتبطان داخله، دون أن يكون هناك ترابط مباشر بين التصورات والعالم الخارجي.
1.2 عن مستويات الإحالة في التواصل
إن المنطلق، إذن، هو أن كل ما يتم إدراكه أو التواصل بشأنه يملك تمثيلا معرفيا في الفضاءات التصورية (لدى الأفراد) التي يمكن أن تبنى بكيفية مختلفة، وأن تتغير الموضوعات ( أو الأشياء) داخلها، أو تظهر وتختفي.
ولنفترض أن لكل فرد في العملية التواصلية مجموعته الخاصة من الكيانات في فضائه التصوري الخاص؛ ولنفترض كذلك أن الوضع التواصلي يقوم على إرادة المتكلم استعمال اللغة لجعل السامع يعَيّن موضوعا معينا.
تنجز هذه المهمة التواصلية، في أسفل مستوى من التجريد، عن طريق أسماء الأعلام. فالاسم العلم يعَيّن موضوعا خاصا في الفضاء التصوري. وإذا كان المتخاطبان يسندان نفس الاسم العلم لنفس الموضوع (بغض النظر عن الاختلاف في الكيفية التي يتمثلانه بها معرفيا)، أمكن للسامع أن يعَيّن الموضوع الذي يقصده المتكلم.
وتشتغل هذه الآلية التواصلية، فقط، في الحالات التي يكون فيها المتخاطبان على معرفة بالموضوع المسمى ويسندان نفس الاسم العلم إليه.كما أن هذه الآلية تقوم على سياق قار تكون فيه الكيانات موجودة في حضرة المتخاطبين.
ونتساءل الآن: كيف يتم تعيين الموضوعات التي لا تقبل التسمية (العَلَمية)؟ للإجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى افتراض مستوى ثان من التجريد داخل مجموعة الكيانات في الفضاء التصوري. إن من سمات العالم المحيط بنا كما ندركه، أنه ليس اعتباطيا؛ وتنحو خصائص الأشياء فيه نحو الارتباط ببعضها؛ ويبدو أن أذهاننا مبنية بكيفية تجعلها قادرة على إدراك هذه الترابطات.
وتظهر هذه الترابطات في الفضاء التصوري في صورة مقُولات من الكيانات. ومن أبرز هذه المقُولات أنها، بخلاف الموضوعات المفردة، يمكن أن تبقى قارة حتى في حالة تغير بعض خصائص الموضوعات أو ظهور موضوعات جديدة أو اختفاء أخرى قديمة.
ولذلك تُعتمَد المقُولاتُ إحالات للكلمات أكثر مما تعتمد الموضوعات المفردة. وحتى في الحالة التي يكون فيها المتخاطبان على معرفة بنفس الموضوعات داخل مقوُلة معينة، فإن تمثيليهما للمقولة يمكن أن يبقيا متشابهين بما فيه الكفاية ليحصل التوافق؛ إذ يكفي أن يتم التعامل مع نفس النمط من الأشياء وأن يكون هناك اشتراك في الممارسات الاجتماعية – الثقافية.
والأداة الأولى للإحالة على المقولة هي الاسم (اسم الجنس). وعوض أن يحيل الاسم على المقولة كلها، يحيل على موضوع يقوم مقام المقولة؛ وهو الذي يعتبر نمطها النموذجي (prototype). وتفسر هذه الآلية لماذا تملك المركبات الاسمية، من حيث الأساس، نفس الوظيفة النحوية التي تملكها الأسماء الأعلام. وباستعماله الاسم، يشير المتكلم إلى أنه بصدد الحديث عن عنصر من عناصر المقولة (هو النمط النموذجي عادة) يكفي لتمكين السامع من تعيين الموضوع المقصود في السياق.
تكتفي الأسماء بتقسيم الفضاء التصوري على أسس عامة. فاستعمال الأسماء لا يقتضي سوى أن يكون المتخاطبون على معرفة بنفس المقولات. لكن حتى هذا الاقتضاء يمكنه أن يحد من القدرات التواصلية في بعض السياقات.
ومثال ذلك السياق الذي يواجه فيه المتكلم والسامع طبقة من الموضوعات تندرج تحت نفس الاسم، فيحتاج المتكلم إلى تعيين موضوع منها لكنه لا يملك له اسما. في مثل هذه الحالة يصبح المستوى الثالث من التجريد ضروريا.
ومن الاستراتيجيات الأساسية للتمييز بين الموضوعات داخل مقولة معينة محددة على أساس خصائص مترابطة، أن يتم تعيين سمة لا تشترك في التغير مع الخصائص الأخرى للمقولة. وهذه هي الآلية القاعدية لتوليد أبعاد (dimensions) التواصل، أو مجالاته (domains). ومثال ذلك أن لون موضوع معين عادة ما لا يشترك في التغير مع خصائص أخرى. ويمكن التعبير عن المجالات التي تبرزها هذه الآلية عن طريق الصفات في اللغات الطبيعية.
فيمكن تعيين لعبة معينة من بين مجموعة من اللعب، مثلا، بقولنا: “لعبة حمراء” (مجال اللون)، أو: “لعبة كبيرة” (مجال الحجم).
ويجد الافتراض القائل إن الصفات أدوات تواصلية أكثر تجريدا من الأعلام وأسماء الأجناس سندا له في المعطيات المتعلقة باكتساب اللغة لدى الأطفال. فتعتبر أسماء المقولات القاعدية (مثل: كلب وكرسي)، من الكلمات الأولى التي يكتسبها الأطفال؛ أما الكلمات التي تحيل على الأبعاد (مثل: أحمر وطويل)، فيبدو أنها لا تفهم إلا في مرحلة متأخرة نسبيا (أنظر).
إن التفاعلات الاجتماعية يمكن أن تولد الحاجة إلى تمثيلات تمثل فيها البنية البُعدية عن طريق عدد قليل من القيم المتعلقة بكل بعد من الأبعاد. وتظهر الوقائع أن الصفات البُعدية تكون عادة في صورة أزواج متقاطبة، مثل: ثقيل-خفيف، طويل-قصير، الخ.
وبهذه الطريقة تولد تأليفات القيم المتعلقة بأبعاد مختلفة شبكة داخل الفضاء التصوري. وعندما نتواصل بخصوص الموضوعات، فإن الشبكة بما يوافقها من تأليفات للصفات، يمكنها أن تولد طبقة من الإحالات القابلة للتواصل بصددها.[7]
هكذا يكون وجود فضاءات تصورية ذات هندسة مشتركة بين المتخاطبين، من الأسس التي تمكنهم من إيصال المعاني إلى بعضهم البعض، ومن السعي إلى التناغم والاشتراك في المقاصد؛ وذلك جوهر سؤال التواصل كما نبين في الفقرة الموالية.
2.2 التواصل والقصد المشترك
إن مما يفسر إمكان التواصل رغم الطابع الفردي لبناء التصورات، أن الناس يبدون في حاجة إلى جعل بناءاتهم التصورية تتناغم وبناءات الآخرين، حتى يكون لهم فهم مشترك للعالم. فما دمنا لا نقرأ الأذهان، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نتناغم هي أن نحكم على سلوكات الآخرين – بما في ذلك أقوالهم- هل لها دلالة أم لا. ومن ثمة الميل إلى التلاقي التصوري، حتى في مجال استعمال اللغة.
إن المتعلم الذي يواجه جماعة يعمل أفرادها على التلاقي، يجد أن مشكل التناغم يكمن في تكييف نفسه مع بناء الجماعة التصوري؛ أو مع “الكيفية التي تسير بها الأمور”. أما إذا واجه جماعة لا يعمل أفرادها على التلاقي، فإنه سيواجه صعوبة في إيجاد السلوك المناسب. ومثلما يصح هذا في التعلم الثقافي والتقاني، فإنه يصح كذلك في التعلم اللغوي.
ومن الطبيعي أن تكون هناك أسباب متعددة لعدم تلاقي الناس في بناءاتهم التصورية. ذلك أنهم يختلفون في ما يملكونه من معلومات بالنظر إلى اختلاف تجاربهم. وتنتج الصراعات عن اختلاف الناس في الأهداف والحاجات التي تؤثر في ما يعتبرونه ذا أهمية في وضع معين.
ويمكن للبناء التصوري القائم لدى فرد معين على ملاحظات أو تخيلات شخصية، أن يصطدم بالبناء التصوري “الشائع” الذي يرغب الفرد في التناغم معه. والوضع الأسوأ هو الذي تلتقي فيه جماعتان ببناءين تصوريين مختلفين، فيؤدي ذلك إلى تعذر متزايد في إمكانات التناغم.
وهناك عدة طرق للبحث عن التناغم؛ منها الاعتماد على “خبير” كما في نظرية “تقسيم العمل اللغوي” عند بوتنم (1975). وهذا يشمل طبعا الكيفية التي يتعلم بها الأطفال ثقافتهم. ومن الطرق أيضا “القيل والقال”، عندما تكون المعلومات اجتماعية. وللفرد الذي يواجه صعوبة في التناغم بعض الخيارات؛ منها الانحياز إلى الإجماع العام؛ أو محاولة إقناع الآخرين بالتناغم معه؛ أو الاستطراد وتغيير الموضوع.
لقد اشترك عدد من فلاسفة المجتمع واللغة، منهم جيلبرت (1989)، وسورل (1995)، وكلارك (1996)، وبراتمان (1999)، في بلورة افتراض لفهم العلاقات التعاونية القائمة على الميل إلى التناغم والتلاقي بين البشر، مفاده أننا قادرون على بناء الأعمال والمقاصد المشتركة تصوريا. فالأمر لا يتعلق فقط بقضية مثل:
- “أنا أقوم عن قصد بكذا وكذا، وأنت تقوم عن قصد بكذا وكذا”؛
وإنما بقضية مثل:
- “نحن نقوم عن قصد مشترك بكذا وكذا، ودوري في ذلك هو كذا وكذا، ودورك في ذلك هو كذا وكذا”.
فالقصد، عادة، بنية معرفية لا تتعلق إلا بعمل شخصي للفرد؛ إذ لا يمكن لفرد معين أن يقصد عمل فرد آخر، إلا إذا كان ذلك بكيفية غير مباشرة: كأن تقصد القيام بشيء معين لتحمل الآخر على القيام بالعمل المقصود. لكن العمل المقصود، في حالة القصد المشترك، يقوم به الشخص والآخرون معا؛ فيلعب العمل المقصود الذي يقوم به الشخص دورا في العمل المشترك.
فكل عضو من أعضاء فريق معين، مثلا، يملك قصدا مشتركا لتحقيق أهداف الفريق، فيلعب بذلك القصد الفردي دورا في عمل الفريق المشترك. ومن أبسط الأمثلة على ذلك نقل مكتب من مكان إلى آخر بمساعدة شخص آخر.
فحملي المكتب من جهة معينة والتحرك به في الاتجاه المناسب، عمل لا معنى له خارج السياق الذي يقوم فيه الشخص الآخر بحمل المكتب من الجهة الأخرى والسير به في الاتجاه المطلوب. لكن للعملين معا معنى باعتبارهما فعلا قصديا مشتركا لنقل المكتب. ويعمم مفهوم القصد المشترك لينطبق على أي سلوك تعاوني مبني على إرادة حرة لدى المشاركين فيه.
ويعتبر كلارك (1996) أن هذا القصد المشترك يعتبر من المظاهر القاعدية للتواصل اللغوي أيضا. ويستدل على أن الفعل اللغوي، تبعا لذلك، يتطلب ليس فقط قصدا من جهة المتكلم لنقل المعلومات، بل قصدا مشتركا من جهة المتكلم والسامع معا للقيام بعمل مشترك لتوضيح المعلومات.
كما يولي كلارك (1996) عناية بالغة بما يتم خلال عملية التواصل اللغوي من تعاملات وإشارات دقيقة تهدف لدى المشاركين في العملية إلى الحفاظ أثناء التخاطب على القصد المشترك والتحقق من أن الأمور تجري بما يقتضيه هذا القصد.
وواضح أن يعتبر هذا حالة خاصة لظاهرة أعم تتعلق بالسلوك التعاوني، وتسمح بمقارنة عملية الحوار أو التخاطب بعمليات تعاونية كالعزف الجماعي في الجوقة الموسيقية.[8] بل إن مظاهر القصد المشترك واضحة كذلك في النشاط التعاوني داخل مجتمعات الثدييات كالذئاب والشانبانزيا.
إن خلق القصد والحفاظ عليه يعتبران طريقة من طرق تناغم البناءات التصورية. وهي طريقة تتميز بكونها غير أحادية الجانب؛ إذ تقوم على تعاون المشاركين في خلق التناغم والحفاظ عليه. وهو تعاون يمكنه أن يصاب بالفشل عندما تتعارض وجهتا نظر الشريكين.
لكن الذي يهمنا هنا أن “التناغم” يبدو آخر المكونات التي نحتاجها لاستكمال بناء موقف تصوري من مسألة الإحالة كما تناولناها في الفقرة 2.
إن عالمنا المُتَصَوَّر لا يشكل فقط واقعنا الخاص بنا، بل إننا نعمل باستمرار على التحقق من أنه يوافق عالم الآخرين. وبقدر ما نحس بالتوافق، نعتبر التصورات المشتركة ناتجة عن “خاصية العالم الموضوعية”؛ في حين، بقدر ما نحس بالتعارض، نرغم على الاعتراف بالذاتية، ويصبح إحساسنا بما هو “موضوعي” أقل استقرارا.[9]
- خاتمة
تناولنا في الفقرات السابقة بعض أهم الأسس التصورية التي يقوم عليها التواصل اللغوي خاصة؛ وذلك انطلاقا من سؤال جوهري مفاده: إذا كانت التصورات عموما، ومنها المعاني اللغوية خصوصا، ذات طابع فردي شخصي، فكيف يمكننا أن نتواصل؟ وإذا كان سؤال التواصل هذا يحظى بإجابة بسيطة مباشرة في نظريات الدلالة “الواقعية” أو “دلالة شروط الصدق”، من حيث اعتبارها اللغة محيلة على العالم الخارجي، فإنه يتطلب، في النظريات الدلالية الذهنية النفسية، إجابة لا تخلو من صعوبة وعسر.
فحاولنا الإجابة من خلال تحديد وظائف التصورات في إطارها اللغوي والذهني العام، بما في ذلك اتصالها برصيد المعارف والمعتقدات الذي يكون مخزنا لدى الفرد، وضمن ذلك المعارف المتعلقة بسياقات التواصل ومقاصد المتخاطبين التي تدرس عادة في أبواب الذريعيات. ومن خلال إبراز بعض أساسيات النظرية النفسية للإحالة باعتبارها علاقة قائمة بين التعابير اللغوية وبين تأويلات (أو تمثيلات) المتكلمين الذهنية للعالم الخارجي.
وبناءا على هذا تناولنا بعض أهم مستويات التجريد الإحالية التي تقوم عليها البنيات التصورية، في علاقة ذلك بالمقُولات اللغوية التي ترتبط بصفة نمطية بهذه المستويات. وهي، تباعا، اسم العلم للموضوعات المفردة، واسم الجنس للمقُولات، والصفة للأبعاد أو المجالات.
وتمثل هذه المستويات التجريدية، بوظائفها المعرفية، مظهرا من مظاهر التصميم الموحد الذي تشترك فيه البنيات التصورية لدى بني البشر، ويشكل الأرضية اللازمة التي تسمح بإمكان التواصل. وهو إمكان اعتبرنا من عناصره الجوهرية سعي الناس إلى جعل بناءاتهم التصورية تتناغم وبناءات الآخرين، حتى يكون لهم فهم مشترك للعالم.
كما اعتبرنا أن من أبرز الافتراضات التي تمكن من فهم هذه العلاقات التعاونية القائمة على الميل إلى التناغم والتلاقي بين البشر، افتراض القصد المشترك. وهو افتراض مفاده أن بني البشر يملكون، بحكم طبيعتهم الأحيائية، قدرة تصورية على بناء الأعمال والمقاصد المشتركة.
- مراجع
غاليم، محمد، 1999، المعنى والتوافق، مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط..
غاليم، محمد، 2007، النظرية اللسانية والدلالة العربية المقارنة، مبادئ وتحاليل جديدة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.
غاليم، محمد، 2008، “أي منهج لدراسة الظواهر الإنسانية والثقافية؟”، مجلة الثقافة الشعبية، السنة الأولى، العدد الثالث، المنامة، البحرين.
Bratman, M. 1999, Faces of Intention, Cambridge University Press.
Clark, H. H., 1996, Using Language, Cambridge University Press.
Dowty, D., Wall, R. and Peters, S. 1981, Introduction to Montague Semantics, Dordrecht, D. Reidel.
Gardenfors, P. 2000, Conceptual Spaces, the Geometry of Thought, MIT Press.
Gilbert, Margaret, 1989, On Social Facts, Princeton University Press.
Jackendoff, R. 1983, Semantics and Cognition, MIT Press.
Jackendoff, R. 1984, “Sense and Reference in a Psychologically Based Semantics”, in: Bever, T.,Carrol, J. and Miller, L.A. (eds), Talking Minds: The Study of Language in Cognitive Science, MIT Press.
Jackendoff, R. 1985, “Information is in the Mind of the Beholder”, Linguistics and Philosophy. 8.1.
Jackendoff, R. 1987, Consciousness and the Computational Mind, MIT Press.
Jackendoff, R. 2002, Foundations of Language, Brain, Meaning, Grammar, Evolution, Oxford University Press.
Jackendoff, R. 2007, Language, Consciousness, Culture, Essays on Mental Structure, MIT Press.
Putnam, H. 1975, “The Meaning of “Meaning””, in: Gunderson, K. (ed.), Language, Mind and knowledge, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Santambrogio, M. and Violi, P. 1988, “Introduction”, in: Eco, U., Santambrogio, M. and Violi, P. (eds.), Meaning and Mental Representations, Indiana University Press.
Searle, J. 1995, The Construction of Social Reality, New York: Free Press.
Smith, L. B., and Sera, M. D. 1992, “A developmental analysis of the polar structure of dimensions”, Cognitive psychology 24.
[1] انظر جاكندوف (2007)، ص. 192؛ وانظر التفصيل في أسس نظرية الدلالة التصورية في نفس المرجع، وفي جاكندوف (2002)؛ وغاليم (1999) و(2007).
[2] انظر جاكندوف (2002)، صص. 271-273؛ وصص. 123-124؛ و(2007)، صص. 192- 193.
[3] انظر سانتمبروجيو وفيولي (1988)، Violi, Santambrogio، ص. 5-6. وداوتي و وول وبترس (1981)، ص. 12. وانظر التفاصيل في غاليم (1999)، الفصل الثاني؛ وانظر كاردنفورس (2000)، صص. 189-190.
[4] انظر جاكندوف (1984)، صص. 56-58، وصص. 61-62؛ و(1983)، ص. 24-25. وانظر غاليم (1999)، صص. 55-58؛ وكاردنفورس (2000)، ص. 190.
[5] انظر جاكندوف (1985)، ص. 24-25. وانظر غاليم (1999)، ص.58.
[6] انظر جاكندوف (1987)، ص. 127-128؛ و (2002)، ص. 304؛ وانظر غاليم (1999)، ص. 59.
[7] انظر كاردنفورس (2000)، صص. 192-196؛ وسميث وسيرا (1992)، ص. 132.
[8] انظر جاكندوف (2002)، صص. 330-331؛ و(2007)، صص. 172-173. وانظر في غاليم (2008) التفصيل في عدد من الأنساق الإدراكية والتصورية التي تنبني عليها المعرفة الاجتماعية التي تمكن البشر من القدرة على التفاعل والتعاون المشترك.