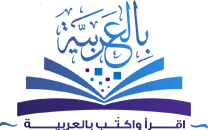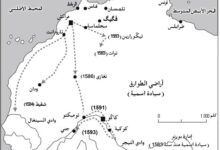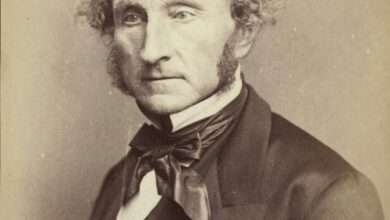لماذا آمن أتباع مسيلمة الكذاب بنصوص تفتقر إلى البلاغة والبيان؟
قراءة في السياق النفسي والاجتماعي والسياسي

قد يبدو غريبا، بل وصادما، أن يجد “قرآن مسيلمة الكذاب“ أتباعا ومؤمنين به، رغم ما تتصف به نصوصه من ضحالة في المعنى، وركاكة في الأسلوب، وسطحية في الفكرة. والسؤال الجوهري الذي يثير الدهشة هنا هو: كيف اقتنع قومٌ من العرب، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، بأن هذه النصوص المضحكة تمثل وحيا يُتلى؟
الإجابة على هذا السؤال تستدعي الغوص في العمق النفسي والاجتماعي والسياسي للمشهد آنذاك، وفهم ما وراء الظواهر، لا الاكتفاء بظاهر النصوص.
- أولا: الطموح السياسي والقبلي: الزعامة أولا، والنص تابع
من أبرز الدوافع التي تفسر تصديق أتباع مسيلمة له، هو أن دعوته لم تكن دينية بقدر ما كانت سياسية وقبلية. مسيلمة أراد أن يكون زعيما على قومه من بني حنيفة، لا تابعا لسلطة دينية مصدرها خارج قبيلته، حتى لو كانت هذه السلطة نبوية.
لذا، فإن أتباعه لم يختاروه نبيا لقوة نصوصه، وإنما لأنهم رأوا فيه رمزا للتمرد على سلطة المدينة، وعلى محمد ﷺ كنبي من خارج نجد. بمعنى آخر، الإيمان بمسيلمة لم يكن فعل اقتناع، بل كان فعل مقاومة.
- ثانيا: الولاء القبلي أقوى من النقد الأدبي
في المجتمع العربي القديم، كان الولاء للقبيلة أقوى من الولاء للحقائق أو المعايير الجمالية. وبالتالي، فإن قبولهم لمسيلمة لم يكن نابعا من إعجابهم بلغة “قرآنه”، بل من إحساسهم بأنهم يحمون مكانتهم وكرامتهم وهويتهم في مواجهة تمدد قبائل أخرى من خلال الرسالة المحمدية.
لقد كان بعض العرب يناصرون شاعر قبيلتهم، وإن كان ضعيفا، فقط لأنه منهم. والشيء نفسه ينطبق على “نبيهم” المزيف.
- ثالثا: فهم خاطئ لمفهوم النبوة
الكثير من العرب في بداية الدعوة الإسلامية لم يكونوا يدركون تماما معنى النبوة ولا ماهية الوحي. لذلك، حين زعم مسيلمة أن الوحي ينزل عليه أيضا، لم يكن لدى البعض المعايير العقدية الدقيقة أو المعرفة العميقة لتفنيد دعواه.
كما أن مسيلمة لم يكن يقدم نفسه كنبي منافس بالمعنى الحرفي دائما، بل روّج أحيانا لفكرة تقاسم النبوة، كما ورد في رسالته إلى النبي محمد ﷺ: “من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإني قد أُشركتُ في الأمر معك…”.
هذا الخطاب الملتبس قد يكون أقنع بعض السذّج بأنه لا مانع من تعدد الأنبياء!
- رابعا: الحاجة النفسية للتماهي مع “منقذ”
في فترات القلق والتحولات الكبرى، يبحث الناس عن رموز يلتفون حولها، حتى لو كانت واهية، إذ أن النفس البشرية تحتاج إلى من يمنحها شعورا بالسيطرة على المستقبل والمصير.
مسيلمة الكذاب؛ كان بارعا في تقديم نفسه كقائد ساحر الشخصية، وكمخلص، لا كنص فصيح. كان يراهن على الخطاب العاطفي، لا البيان المعجز. وبالتالي، فإن الإيمان به كان في معظمه استجابة نفسية لحالة من القلق الجماعي والاضطراب القبلي.
- خامسا: غياب الوعي النقدي الديني والأدبي
رغم أن العرب كانوا أهل بلاغة، إلا أن الوعي النقدي العام لم يكن ناضجا عند جميع الناس. البلاغة والبيان كانت في أيدي النخبة، والشعراء الكبار، لا العامة. لذا، فإن كثيرا من أتباع مسيلمة لم يكونوا في موقع يخولهم تمييز التفاوت الهائل بين القرآن الكريم وبين ما كان مسيلمة يتلوه.
لقد انخدع البعض بـ تشابه ظاهري في القافية أو الألفاظ، دون فهم عمق البيان القرآني الحقيقي، الذي يجمع بين الإعجاز في اللفظ والمعنى، لا التلاعب اللفظي فقط.
- خلاصة:
إن إيمان أتباع مسيلمة الكذاب به وبـ “قرآنه” لم يكن بسبب جودة ما يقول، بل كان بسبب ما يرمز إليه سياسيا ونفسيا وقبليا. لقد مثّل مسيلمة عند قومه المعارضة الداخلية لما رأوه تمددا خارجيا، حتى وإن كان باسم الدين.
وتاريخ الأديان والفكر الإنساني يثبت مرارا أن الناس قد يتبعون الباطل عن وعي أو عن غفلة، إذا كان ذلك يخدم مصالحهم أو يغذي غرورهم أو يشبع احتياجاتهم النفسية.