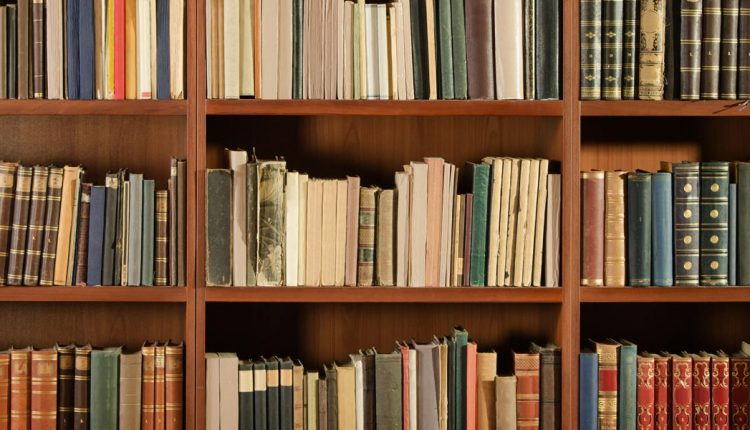هل هناك سرديات عربية؟

قد يبدو هذا السؤال مستفزا للبعض، أو أنه غير قابل لأن يطرح نهائيا، كما يرى البعض الآخر، بناء على ما يُعتقد أن العلم لا وطن له، وأن النظريات لا جغرافية لها. هذا الاعتقاد صحيح إلى حد بعيد، لكن ذلك لا يمنعنا من طرح السؤال عن المساهمة الفعلية العربية في هذه النظرية، أو ذاك العلم. ولعل هذا هو المقصود بالسؤال.
إنه فعلا سؤال مستفز لأنه محرج لمن يدَّعون استحالة الحديث عن سرديات عربية، أو عن نظرية سردية يمكن أن تكون إضافة نوعية إلى النظريات السردية المختلفة، تحت أي نوع من الدعاوى المقبولة أو المرفوضة.
يكمن الاستفزاز في كونه يخلق نوعا من الاستفسار عن المساهمة العربية في هذا العطاء العلمي أو الفكري، وتحميل المشتغلين بالتحليل السردي مسؤولية الجواب عن مدى مساهمتهم فيه.. كما أنه في الوقت نفسه، بالصيغة التي طرح بها، لا يستسلم إلى جاهز التصورات حول العلوم والنظريات، وأنها ذات طبيعة عالمية، ولا مجال فيها لأي خصوصية ثقافية أو لغوية.
إن العلوم والنظريات والأفكار، بصفة عامة لا تتنزل من السماء، إنها تتشكل في أرضية فضاءات جغرافية معينة، وتتطور في جغرافيات أخرى، وتتعدل في جغرافيات أخَر. كما أن هناك جغرافيات أخرى تظل لا صلة تجمعها بها. هذه التشكلات، وما تعرفه من تطورات عابرة للحدود التي ظهرت فيها هي التي تكسبها بعدها العالمي والإنساني.
ومع تطور الزمن يتحدث عنها مؤرخو الأفكار، مبرزين العوامل التي جعلتها تتشكل في فضاء، والأصول المعرفية التي انبنت عليها من خارج فضائها، والشروط التي لعبت أدوارا في استمرارها في الكثير من الفضاءات، عبر انتقالها إليها لتتخذ، من ثمة، موقعا في تاريخ الفكر الإنساني.
عندما نتحدث عن تاريخ الفكر الإنساني، لا نتحدث عنه فقط متصلا بتواريخ تسجل من خلاله حقب وأطوار، لكن أيضا في صلته بجغرافيات معينة تفاعلت مع بعضها، وشاركت في التفاعل والفعل، كي لا نقول التأثير والتأثر. لماذا ظهرت حركة الشكلانيين الروس في الاتحاد السوفييتي في بداية القرن العشرين، ولم تبرز في إيطاليا مثلا؟ ولماذا تفاعلت باريس مع حركة الشكلانيين الروس، وأدت إلى بروز السرديات والسيميائيات، ولم يحصل ذلك في أمريكا، رغم أن الأفكار الأدبية، والسردية ظهرت في كل هذه الفضاءات؟
لا نريد ونحن نطرح السؤال عن «السرديات العربية» ويمكن تعميمه على العديد من معارف العصر الذي نعيش فيه، التفكير بمنطق «الخصوصية» التي يتستر وراءها الكثيرون؟
ما نقوله عن النظريات والعلوم ينسحب على التيارات الإبداعية الأدبية والفنية. لماذا ظهرت المقامة في بغداد القرن الرابع الهجري، والموشحات في الأندلس في أواخر القرن الثالث الهجري مثلا، وانتشرت كل منهما في مختلف البيئات العربية على مرّ الزمن؟ إن للمعرفة والإبداع تاريخا، ولكل منهما جغرافيا.
وحين نلح على الجغرافية العربية للسرديات، نريد أن يكون لها أولا تاريخ يؤكد صلته بالتاريخ المعرفي العام للسرديات، وقد صارت اختصاصا عالميا، عن طريق تفاعله مع تواريخ وجغرافيات تشكلها وتطورها.
تتأطر عندنا، حاليا، دراسات عربية ضمن السرديات، ولدينا مختبرات تحمل اسم السرديات، في مختلف البلاد العربيةن كما صارت لنا مجلات تتصل بالسرد والسرديات. ما هي صلاتها جميعا بالسرديات تاريخيا وجغرافيا؟ ما هو واقع هذه السرديات «العربية»؟ وما هو مستقبلها؟ كيف فكرت في السرد العربي قديمه وحديثه؟ وما مدى قدرتها على المساهمة في تطوير السرديات ما بعد الكلاسيكية العالمية، وقد ساهمت في تطويرها جغرافيات متعددة تجاوزت أوروبا وأمريكا، لتصل إلى آسيا وأستراليا.
هذه هي الأسئلة التي نطرح ونحن ننطلق من الجغرافيا العربية في علاقتها بالسرديات.
إنها فعلا أسئلة مستفزة، إذا أردنا أن نتجاوز التواري وراء «عالمية» العلوم والنظريات والأفكار لنزعم أننا معفيون من طرحها لأنها باطلة، إن الأسئلة المستفزة هي التي تحفز على التفكير، وتدعو إلى بذل الجهد، وتجاوز التقاعس، الذي يدفعنا إلى التسليم بادعاء بطلان السؤال المزعج.
ما أسهل أن نجيب عن غياب علوم إنسانية واجتماعية في فضائنا العربي، أو غياب التفكير في الإنسانيات الرقمية، وغيرها من المعارف والعلوم، بدعوى أن العلم لا وطن له. العلم لا وطن له لأن المساهمين فيه من أوطان متعددة، وهو صيرورة متواصلة تساهم في إغنائه عطاءات متعددة من جغرافيات كثيرة، لكن هناك جغرافيات، مثل فضائنا العربي، حين تظل بعيدة عن المساهمة في إثراء الفكر الإنساني.
فهذا دليل على أنها ليست جزءا من «الوطن» العلمي الذي يغتني بعطاءات مختلف الشعوب والأمم التي تسهم فيه.
لا نريد ونحن نطرح السؤال عن «السرديات العربية» ويمكن تعميمه على العديد من معارف العصر الذي نعيش فيه، التفكير بمنطق «الخصوصية» التي يتستر وراءها الكثيرون؟ نريد أن تكون لنا مساهمة في تطوير المعرفة السردية، وهي ليست حكرا على أمة دون أخرى.
يمكننا الآن أن نتحدث عن منجزات سردياتية عالمية تغتني بما تقدمه مختبرات ومؤسسات معينة تحتضنها جامعة في مدينة، في بلد معين، لذلك نجد أنفسنا أمام اتجاهات وتيارات لها خصوصيتها الثقافية واللغوية. إننا دون تجاوز الأساطير التي نحتمي وراءها لإعلان إخفاقاتنا لا نفتح مجالات للتفكير أو للإبداع.