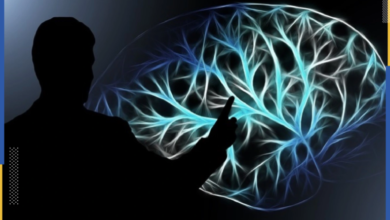محمود درويش وأنا

البياضُ رائقٌ، راضٍ عن حظوظه؛ بل راضٍ عن مقاديره موزَّعةً بعَدْلِ الميزانِ اللونِ، متقدِّمٌ، بلا إفراطٍ، في الصورة: بياضٌ هدنةٌ، أو صُلحٌ.
سوادٌ راضٍ عن نفْسِه؛ عن حكمةِ الأصلِ في عِظةِ اللون؛ مُدرَّبٌ على نَحْتِ الشكل نافراً بآلاتهِ الرماديةِ، في الصورة: سوادٌ هدنةُ، أو صُلحٌ.
لونان هما تاريخ البرهة جمعتنا معاً، محمود درويش وأنا، في ميثاقٍ سوادٍ وبياضٍ من مُبْتكَرِ العام 1973: صورة كبيرة قليلاً لهيئتين نحيلتين، يدُ الأطول منهما على كتف الأقصر، في بيت الشاعر السوري أدونيس.
بضع مساءات التقيت الشاعر الفلسطيني في بيت الشاعر السوري. آثرتُ، أنا الخجول، ابتعاداً لا أُقحِمُ نفْسي في ما يتكلَّفُه المعجبون بشاعر ولد بملعقةٍ في فمه نِصْفٍ من ذهب الشعر قضيَّةً آسِرَةً، ونصفٍ شهرةٍ مجتاحة. أدونيس، الذي طلب مني، وأنا في الثانية والعشرين، جَمْعَ شِعري في كتابٍ طبعَه على نفقته، أهدى نسخة من كتابي الشعري الأول، بنفْسه، إلى محمود، في بيته. تلك النسخةُ أطلقت عَتباً من فم محمود: “أأنتَ تتجنَّبني؟”. أحسَّ ابتعادي، في ردهة الجلوس، إلى طاولة كتابةِ المضيف البعيدة قليلاً، نُفُوراً.
“هَيَا إلى صورة”، قال صديقٌ صحافي. عبرنا، محمود وأنا، بخطواتٍ لونٍ من الحياةِ حركةً إلى الثباتِ المُذهل بياضاً وسواداً، في صورة لم تجمعنا سواها إلاَّ بعد أكثر من خمس وثلاثين سنة، على أرض السويد، بآلاتِ السِّحْرِ الحديثة استخرجها الجالسون من جيوبهم، في قاعةٍ جمعتْنا بالحاضريْنَ لقاءً شِعراً، ولقاءً حديثاً بَوْحَاً، عن علاقة شاعر بشاعر، أدْمَعَ عينيَّ اعترافاً منه بوجودي في وجوده شاعراً وصديقاً.
الصورةُ البياضُ الصُّلحُ أو الهدنةُ، والسوادُ الصلحُ أو الهدنةُ، لن تطلقني من أسْرِ الرماديِّ في اعتناقِ أحدِ اللونين دِيْنَ اللون الآخر رمادياً. تلك الصورة استعارها أخي الأصغر مني فحملها من بيروت إلى دمشق. اعتُقِلتِ الصورةُ، واختفت حتى يومنا هذا، بلا أثرٍ لبياضٍ صُلْحٍ فيها، أو سوادٍ هدنةٍ.
منذ تلك الصورة أكملتِ المصادفةُ الحياةَ نَحْتاً صداقةً بين محمود وبيني؛ قُرْباً نَحْتاً نافراً من قلبٍ على قلبٍ، حتى اليوم الذي سمعتُ فيه صوته، قبل مغادرة الأردن إلى أمريكا بيومين، أملاً في وضْعِ الحياةِ على سكَّةِ شرايين أخرى، أكثر رأفةً بتوزيع الدم عادلاً على كيانه. كان صوتُه مستسلماً قليلاً، لكن ليس في داعيْهِ ما يستوجب حَمْل حقيبةٍ إضافيةٍ لامتاعٌ فيها؛ لا ثيابٌ أو آلةُ حلاقة، أو عطر، أو حذاء، بل روحُهُ في الرحلة إلى الأبدية.
عوَّدنا قلبُه، باكراً، استبدادَ عضوٍ من الجسد بمجتمع الجسد كاستبداد الشعر بالمعاني في توطيدهِ الحياةَ، ثانيةً، على حافَّة غَمْرِها الأصلِ نظاماً فوضى. محمود ألقى بنفسه، قَبْلاً، على الحافة في الشعر قلبيْنِ ينتقلان من اللوعة فَقْداً للأرض إلى لوعة الوجود احتفالاً، في نشيدٍ من جَمْعِ السماءِ زيتوناً على عباءة حريته. ظلَّ حتى آخر نَفَسٍ للشعر فيه بقدمٍ في مَعْقِل الحرية، وأخرى في مَعْقِلِ اللوعةِ مذ كان سليلَها كتاريخِ بلده.
وقد أقمتُ معه في معقل النازع الملوِّعِ من جرحِ بلدٍ سليبٍ مرَّةً، ومرَّةً في معقِلِ تأكيد الحرية للمعاني شعراً حِذْقاً بلا مساومةٍ؛ شعراً يَجْبَهُ نازعَ الفَقْدِ المُبكي. كتبتُ “رباعياته” الأولى على ظهور أغلفة كتبي المدرسية، من غير أن يخطر لي أن هذا الشاعرَ البَذْخَ في اجتماع المصادفةِ على انتخابه قضيَّةً، سيوسِّع لي إقامةً في شعر لن أدوِّنه، بالحروف المجلوَّةِ من لباقةِ الخطِّ، على ظهر أيِّ كتابٍ، بل على ظهر الحياة، وخَثَلَتِها الملتمعة بزيت القُبَلِ أيضاً.
حَمَل قصيدتَه “ليس للكرديِّ إلاَّ الريح”، التي بَرَاها بَرْياً بصداقة السنين، من أرضٍ إلى أرضٍ. في سوريا، حيث ألقاها على مسامع الحاضريْنَ، أبلغه وزيرٌ، ومستشارةٌ، أنني “على الرَّحب” إن عدتُ إلى بلدٍ خرجتُ منه منذ نهاية العام 1971 ولم أعُد إليه إلاَّ بقدمَيْ حنيني الحافيتين.
أَجمَعني بمحمود إحساسُ الفَقْدِ من غير ربطٍ؟ لا. كان الشعرُ الجذْرُ، أولاً وأخيراً، بمراتبه حَرْثاً في المفقودِ الخالد.
قصيدته عني “ليس للكردي إلاَّ الريح”، التي حملها من أرضٍ إلى أرض، القاها على مسمعي أيضاً، في السويد ـ اللقاءِ الجديد، الأخير، سنة 2007، بعد آخر لقاء في باريس، مطلع العقد العاشر من القرن الماضي. لم تره عيناي بعد ذا، بل تتبَّعه بصرُ قلبي إلى طُرقات الأبدية مُنعَطفاً بعد مُنعطف، ومحطة بعد محطة، يلقي أشعار المفقوديْنَ في مجاهل السواد الخالد، على مسمع البياض الخالد، كاللونيْنِ في صورتنا الأولى.
كنتُ معه، أبداً، في القصيدة كتبَها عني مختلِساً من ظلال المكان القبرصيِّ ما يفصِّله لخياله بَوْحاً. أثَّث بيتي، في القصيدة، ثانيةً، بالمتشابهات الكبرى بين الإسمنت والغناء، والمتفارِقاتِ الحِيَلِ الجوهرية بين الحروف والغُرَف. وقد أراد في زيارة اللقاء الأخير إلى بيتي في السويد، أن يؤثِّث، ثانيةً، منزلَ البوح، لا في شِعرٍ هذه المرة، بل في يومياتٍ كحديثٍ ممتدٍّ من أول العمر إلى آخره.
“في سكوغوس”، كانت خاطِرةُ كتابه الأخير حيًّا “أثر الفراشة”. لم يصعد بي، من سطورها، إلى سطوةِ الاستعارات في إيقاف الخيال على قدمين مجرَّحتين قرب قدميِّ الشعر، أو إلى نِسَبِ المعقولِ المُنْجَزِ معقولاً في أوزان الأشعار، ونِسَبِ المعقولاتِ المُفترَضة، الأكثرِ شَغَباً في الوجدانِ الصِّورِ، بل استلهمني، في خاطرته من موقع بيتي ـ سكوغوس الجبليِّ، بعد عشائين طويلين، طاهياً أيضاً: “سكوغوس، من ضواحي ستوكهولم. غابة من أشجار البتولا والصنوبر، والحور، والكرز، والسرو. وسليم بركات في عزلته المنتقاة بمهارة المصادفة التي تهبُّ بها الريح على المصائر، لا يخرج منها مذ صار جزءاً من المشهد، محاطاً بطيور الشمال… وقريباً من أُلْفة السناجب، والأرانب، والغزلان، والثعالب، تلقي عليه التحية عبر النافذة، وتهرب، وتلعب خلف تمارينه اللغوية… وهو إذ يهجس الآن فلا يهجس إلاَّ بالطهو: قصيدة نهاره المرئية”.
وأنا أعترف أنني أطهو على نحو لا يُقلقُ الطهوَ، أو يَغيظُه، أو يَهينُه. أُبقي الطهوَ كريماً، معافىً بين يديَّ، مُذْ أدركتُ أن لا فرقَ بين مَرَقِ اللحم ورباعيَّةٍ؛ ولا فرقَ بين نشيدٍ ودجاجة محشوَّة أرُزًّا وصنوبراً؛ ولا فرق بين ملحمة وشواءٍ لحمٍ مُنكَّهاً بخيالِ الأفاويْهِ إحدى عشرة ساعة: الحياة قِدْرٌ، أو فحمٌ؛ على أجسادنا توابلُ العَدَم القويَّة.
سيرتُه “ذاكرة للنسيان”، عن حصار بيروت العام 1982، لم تَخْلُ مني أيضاً. دحرجني في السطورِ السوادِ الغاضب عشرين صفحةً، ودحرجني في البياض الغاضب بين السطور عشرين صفحة، بالحرف الأول من أسمي “س”. وواكبتُه بالحروف كاملةً في اسمه أربعَ عشرة صفحة من قصيدتي فيه، قبل ثلاث وعشرين سنة:
“فلا تتأفَّفنَّ أيها الصباحُ إنْ زجَّكَ في الملهاة، لأنَّ البطولةَ، التي تتأبَّطُ برسيمَها، وخُوْصَها، ستحيِّيْكَ من المجازات الأسيرةِ في رئتيه، ومن الشفقِ النازفِ لوعةً لوعةً في الأكيدِ العالي، الذي يدحرجُ الشهداءَ فوقَ حريرهِ خُوَذَ الموتِ المكسورةِ”.
لم يَحملْني خيالُ الشاعر الناقدِ فيَّ إلى مساءلةٍ في إنشائِهِ بيانَ قلبهِ شعراً. هو يعود بالشعر مرةً إلى مَأهُوله من الشعريِّ، ويُبقي الشعرَ مرةً في ثقةِ الآخرين بالقضية وضوحاً صِرْفاً. لربَّما وزَّع نفْسَه، بالحيرة من خطف الواقع إلى موافَقَاتهِ في المعاني، ومطابَقَاتِ وصْفِهِ واقعاً، على قلقِ الرغبةِ ذاتها بولائه للبسيط المُحْكم من وجهٍ، وامتداحه للمتراكِبِ المُحْكَم من وجهٍ، ببعض التردُّدِ، مُذْ رأى في المتراكبِ “دَلاَلاً” تُغْدِقهُ اللغةُ على مجاهلِ مقاصِدها. كان على حَذَرٍ من أن يجعل اللغةَ “حلاًّ” لـ “الجرحِ” المُعْضِلِ ـ الوجودِ؛ بل يريدها توصيفاً للجرحِ كقضيَّةٍ ـ هو الفلسطينيُّ ابنُ الفَقْدِ المُنْهِكِ لا يحتمل “رفاهةَ” اللغويِّ في “طيش” مقاصِد اللغويِّ.
“لقد أوجدتَ حلاًّ لمشكل الحياةِ كلِّه”، قال لي مرةً بإطراءٍ. “حلولُك لغوية”.
“وطنُكَ لغويٌّ”، قلتُ له.
كان علينا، بتواطؤٍ لا يُرَدُّ، أن نضحك. حلولٌ لغوية ـ نعم. حلولٌ لا تعويضَ فيها؛ لا نجاةَ؛ لا حكمةً، لا نصرَ؛ لا مفقودَ مُسْتَعاداً، بل تأسيسٌ آخر للخساراتِ أقوى، وللتيْهِ أقوى، وللَّوعةِ كما لن تعرفها لوعةٌ من “هِبَةِ” المفقودات. نحن كَتَبَةٌ ـ ممكناتٌ لغويةٌ بأصواتٍ في الحروف، وأقدامٍ في الكلمات. نعم. عَسْفاً سمَّينا “الحلولَ” حلولاً. هي فَرَضٌ من تصنيفِ التَّسميةِ. حلولٌ بلا حلولٍ. لغةٌ تعديلٌ في نِسَبِ الوجودِ مقاديرَ تليقُ بالذهولِ ـ أبِ النشأةِ.
لربما لم يوزِّع محمود نفْسَه، بخطفه الواقعَ إلى المطابقات في لغته، على قَلَقٍ، بقَدَمٍ في اللغويِّ البسيط وأخرى في الرغبةِ المتراكبةِ وشهواتها؛ أو بكلِّه على قَلَقٍ في الشعر “بلا وفاءٍ” لمقاصد الوجدانِ المنكوبِ بالواقعيِّ المنكوبِ ـ إرثِ الأرض سليبةً. ابتعد أحياناً عن ذائقةِ “المطلوب”، واقترب منها مراراً، كأنما يوازنُ هِبَاتِ الشكِّ في جدوى القطيعة مع “الجرح المعهود”. ظلَّ على ولاءِ البسيطِ باقتدارٍ في استنطاق الأبعدِ فيهِ رحلةً بعد أخرى من رحلات المعاني، وهجرةً بعد أخرى من هجرات “الواقع”، ونزوحاً بعد نزوحٍ للحنين الأولِ عن أناقةِ الحنينِ وفِتنته.
على أية حال، ليس في اقتدار خيالي عرْضُ محمودٍ على خيالٍ نَقْدٍ فيَّ، مُذْ كان التاريخَ الآخر لي ـ تاريخ الحماسة الأولى إلى قهر الخسارة، وقهر العجز في بلداننا المهزومة. وكان تاريخَ صداقةٍ لم أجد فيها أقرب إليه مني. كان من حولي في هاتفه، بلا انقطاع. كانت عروضُه مبذولةً لي بلا انقطاع، حتى ظننتُ، أحياناً، أنني ابنُه.
في اللقاء الأخير على بوابة الشمال الأخير من أطلس العالم، جَمَعَنا عشاءٌ من حَبَّارٍ ـ صَبِّيدجٍ مقليٍّ دوائرَ كالأفلاك لُتَّتْ ببَيْضٍ وطحينٍ، همس وهو ينظر إلى ابني ـ ابن السابعة عشرة: “كسبتُ صداقةً جديدة ـ صداقةَ Rhan”. ابتسمتُ. كان أجدى لو قال: “ها التقيتُ حفيدي”.
لقاءان بالجمهور جَمَعانا، معاً، في معرض الكتاب بغوتنبرغ. قرأنا شعراً في الأول، فيما ذهبَ اللقاءُ الثاني مُرْسَلاً في بوحِ صديقين على أسئلةٍ في صداقتنا إنسانيْنِ، وصداقتنا شاعريْنِ. كان محمود مذهِلاً في تلقائيةِ “اعترافه”، بلا تحفُّظ من شاعرٍ كبير مثله، أنه جاهدَ كي لا يتأثر بي، وفي اعترافه أنه لم يعد يعرف أين الحدُّ بين أن يراني صديقاً، أو يراني ابناً له.
تزوج مرتين ولم يُنجبْ، بقرارٍ قَصْدٍ في أنْ لا يُنجب. كلُّ شاعر أنجب طفلاً أنجب قصيدةً مُضافة إلى ديوانه. وكل شاعر لم يُنجب طفلاً، أنجب الكونَ معموراً بأطفالِ اللامرئيِّ. أبوَّةٌ تكفي الشاعرَ هنا، وأبوَّةٌ تكفيه هناك. لكنْ، بالقَدْرِ ذاتهِ، المذهلِ في عفويته بلا تحفظ، وهو يُحدِّثُ عني في اللقاء بجمهورٍ يتلقَّف كلماته على سويَّةِ المذهلِ اعترافاً، ألقى عليَّ، في العام 1990، في بيتي بنيقوسيا ـ قبرص، سِرًّا لا يعنيه. كلُّ سِرٍّ يعني صاحبَه، لكن ذلك السرَّ لم يكن يعني محموداً. باح به بتساهُلٍ لا تساهلَ بعده، أمْ كان لا يتكلَّف معي قطُّ “أنا الذي أعرف الكثير عنه مما لا يعرفه سوايَ” حجْبَ شيءٍ يخصُّه؟
“لي طفلة. أنا أبٌ. لكن لا شيء فيَّ يشدُّني إلى أبوَّةٍ”، قال. كنا نتبادل كشتباناتٍ من تدريب اللسان على الأبوَّةِ (مُذْ صارت زوجتي حاملاً) قبل تدريب الوجدان على الأبوَّةِ. ليس الأمر أن يكون المرءُ أباً لسليلٍ من لحمه، بل أن تكون الأبوَّةُ، ذاتُها، على قُرْبٍ لَمْساً من السَّليل. أبوَّةٌ لم تَلْمَسْ بيديِّ الجسدِ سليلَها؛ لم ترَ بعينيِّ الجسدِ سليلَها، أبوَّةٌ فكرةٌ. الغريزةُ قُرْباً، والغريزةُ لَمْساً، والغريزةُ علاقةً، هي أمُّ الأبوَّةِ، وأبوها. محمود، حين كلمني عن أبوَّتهِ المتحقِّقة إنجاباً محسوساً، كلمني عن فكرةٍ في عموم منطقها بلا تخصيصٍ.
أنا لم أسأله مَنْ تكون أمُّ طفلته. امرأة متزوجةٌ، اختصاراً، أخذت منه برهة اللحم لذَّةً من لذائذ المفقود المذهل، فاحتوتها كياناً لحماً. هل ستفاتح تلك المرأة ابنتَها، في برهة من برهات نَقْرِ السرِّ بمِنْسَرهِ على اللحم، تحت الجلد، بالدم “الآخر”، فيها؟ لا أعرف إن كان محمود يتفكر في الأمر، الآن، جالساً في استراحة الرحلة إلى الأبدية، على مقعد من برهان الكلمات أنَّ الأبديةَ قصيدتُهُ الأخرى ـ الهدنةُ بلا نهايةٍ.
صارحتْه المرأةُ مرتين، ثلاثاً، في الهاتف بابنته، ثم آثرتْ إبقاءَ ابنتها أملَ زوجها، حيث الحياةُ أكثر احتمالاً بلا فجاءاتٍ؛ أكثر تجانساً بلا فجاءاتٍ. بل الحياةُ، نفْسُها، مفاجأةُ الضرورةِ الصاعقة أسقطتْنا، جميعاً، في الصَّدمة: نحن نسْلُ اليقين الصَّدمات، و”مَصَالح” البلاغة في الترويج للمُحْكم، وتبعيةُ المُطلق للخيال المحدود، وقصاصُ المعاني من نفْسِها بجريرةِ انحراف الكلماتِ عن تسديد الدَّيْنِ للُّغةِ كاملاً، والجرحُ راضياً عن نَفْسِه. نحنُ إِخفاقٌ لونيٌّ.
محمود لم يسأل المرأةَ، حين انحسر اعترافُها، وانحسرتْ مبتعدةً في العلاقة العابرةِ، عن ابنته. أبوَّتُه ظلَّتْ تبليغاً موجَزاً من صوتٍ في الهاتف عن ابنةٍ لم تستطع العبورَ من صوتِ أمها إلى سمع أبيها. لذا محمود بلا أبوَّةٍ، كأنَّ الأمرَ كلَّه اعترافٌ صغيرٌ لصديقِ سنينَ طويلةٍ من عمره، بلا متْنٍ من توضيح في اللغة، أو هوامشَ إضافاتٍ، أو حواشي متجانسةٍ. أنا، نفْسِي، تلقَّفتُ اعترافَه بلا فضولٍ: لكانَ أنبَأَني من تكون المرأةُ لو كنتُ أعرفها. وها الفضولُ، خاملاً، يعبر خاطري بعد اثنتين وعشرين سنة. لابأس. أنا أُلفِّقُ لتلك الأبوَّةِ إقامةً في الكلمات، الآن، مُذْ كُنا إقامةً في الكلماتِ مُلفَّقةً بسطوةِ الشعر وبطشِهِ. لكنه التلفيقُ الأنقى مُذْ كانت الأمكنةُ ناكثةً بوعودِها ـ وعودِ الأمكنة.
بياضٌ هدنةٌ، وسوادٌ صُلحٌ نَحَتا ذاكرةَ العمر صورةً لمحمود ولي. صورةٌ أخرى وصلتني، على الإنترنت، من مشهد لقائنا معاً بجمهورٍ في السويد. صورةٌ ملونةٌ هي الثانيةُ أرانا فيها جنباً إلى جنبٍ. صورةٌ بألوانٍ ليست صُلْحاً أو هدنةً، بل لوعةٌ كالرياضيات، وحنينٌ كالهندسة.
تموز (يوليو) 2012