شعرية الوجود في مواجهة العقول الباليستية
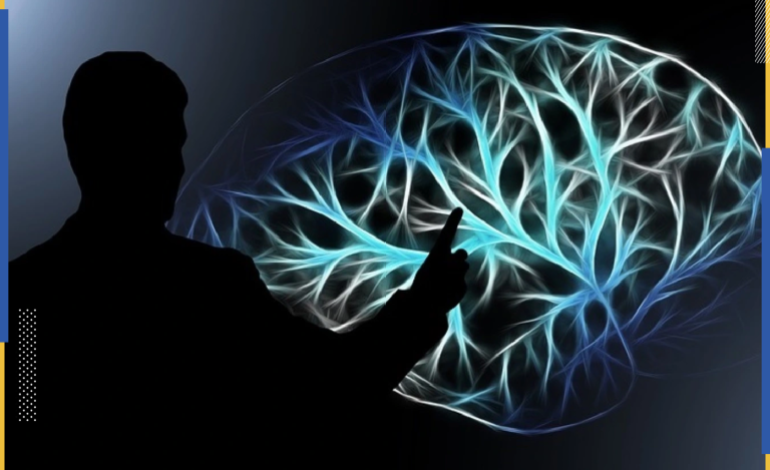
يصبح العقل سؤالا غارقا في إشكالياته المعقدة، حالما يتعرض إلى أعطاب معرفية وتدبيرية، تخرجه من سياقه الطبيعي و الموضوعي، وتحول دون ممارسته لمهامه التنويرية المنوطة به.
و تتجسد مظاهر هذه الأعطاب، في إحساس الشعوب بحالة مزمنة من الانتكاس، خاصة في هذه المرحلة من تاريخ البشرية ، المصابة بتكالب الأوبئة ،و و تزايد الكوارث البيئية المميتة، فضلا عن استفحال مخاطر الفواجع الباليستية ، المنذرة باحتمال تبخر المشاريع الحضارية ،التي طالما تحمست الشعوب لإنجازها .
ما يدعو إلى القول ، بأن التوثيق لمسارات العقل ، هو في حد ذاته توثيق لمجموعة ما يواكبه من أزمات حادة ،تعصف بحياة الأمم، و تجهز على آمالها في الحياة الحرة و الكريمة. و بالتالي، فإن الخروج من هذا النفق ، يتوقف عمليا على اهتداء النخب إلى الأعطاب المؤثرة سلبا على حركية العقل ، و العمل على الحد من تداعياتها .
و كما هو معلوم ، فإن ضبط أسرار العلاقة القائمة بين المنهجية التدبيرية للعقل وبين الأزمات المحايثة له، هي الأرضية التي تأسست وتتأسس عليها كافة الخطابات و السجالات الفكرية و الفلسفية ، منذ الأزمنة الإغريقية القديمة إلى الآن .
ذلك أن مقومات هذه العلاقة ،هي جوهر كل تساؤل فكري و روحي، يتمحور حول هوية الكائن ، باعتباره المعني المباشر بما كان و ما سيكون. و بالنظر لحالة الغموض التي لاحق باستمرار حقيقة هذا الكائن ، فإن العقل هو أيضا ،سيظل محتفظا بغموضه، كي يظل بامتياز الموضوع الأثير للمقاربات الفكرية و الفلسفية .
وسيكون من الضروري في هذا السياق ، الفصل بين تأويلين متضادين للعلاقة القائمة بين انحرافات العقل ، و بين تداعياتها المنعكسة سلبا على حياة الشعوب. فثمة أولا التأويل الذي تهيمن فيه مقولة غياب “القيم الأخلاقية” المؤطرة سلفا بسلطة الواجب ،حيث نستحضر في هذا السياق ،وجهة نظر الفيلسوفة الألمانية “حنا أرندت ” بنبرتها الحداثية المغرقة في تشاؤميتها ، و التي تقدم لنا “عقل المرحلة ” بوصفه طاقة سلبية ، مجردة من الوازع الأخلاقي ،و متخصصة في تأزيم الواقع ، بما يترتب عنه من تداعيات مأساوية.
و كما هو معلوم أن “أرندت ” اعتمدت في بناء أنساقها الفكرية المنتصرة أساسا للعمل السياسي ، على قناعة السلطة العدوانية التي يمارسها عقل ” شرير” ، مؤطر بقوانينه الشمولية ” التوتاليتارية ” التي أتت محارقها الجهنمية على الأخضر و اليابس ، خلال الحربين العالميتين.
و يمكن اعتبار هذا التأويل امتدادا لمقولة “انحراف المسار التنويري” الحاضرة بقوة في خطابات فيلسوف القرن الثامن عشر “إيمانويل كانط”، حينما نبه البشرية إلى وجوب “إعمال العقل” على قاعدة التمسك بأخلاق الواجب وقيمه ، دون أن يعلم بأن نهاية مطاف هذا الأفق التنويري، ستنتهي حتما إلى الاحتراق بلهب عقل مضاد، مغرق في نزوعاته التدميرية.
و هنا تحديدا، سنجد أنفسنا بإزاء تأويل مضاعف ، تتبدد معه الأهمية التي كانت تحظى بها من قبل، منظومة الواجب الأخلاقي جملة و تفصيلا . و مفاد هذا التأويل ،هو ذاك الطريق المسدود، المعبر عنه في خطابات الفيلسوف الألماني “هابرماس” ،حيث يتبين لنا أن الخلل لم يعد مقترنا بالتدبير السيء الصادر عن عقلية الإيديولوجيات المشهود لها بعنف ممارساتها الهيمنية و الإقصائية، بقدر ما أصبح منطق اشتغال آلة العقل التدميري، هو المعني أساسا بالتساؤل.
ذلك أن هذا العقل المتميز بهويته التقنية و التجريبية المتطرفة ، استغل انشغال الخطابات الحداثية بمواجهة الأيديولوجيات الهيمنية ، و الأفكار النمطية ، كي يتفرغ إلى الإطاحة بالمنجزات التنويرية، التي سبق لها أن تحققت في كنف المشروع التحديثي . حيث انبرى تدريجيا إلى ممارسة استقلاليته ،على ضوء منجزاته العلمية و التقنية الخاصة به ، غير عابئ مطلقا بتك المناوشات النقدية و التوجيهية ، التي دأبت على تقفي أثره بالتصحيح و المساءلة.
هكذا ، و في خضم اعتداد العقل بذاته، بوصفه طاقة متفردة ، و قادرة على التجنيح في مجهول عوالمها، شرع في إمطار البشرية بالجديد، و بالمفاجئ من الاختراقات التجريبية المعززة بنيران الإبادة. و الظاهر أن نزوعه التدميري لا يعدو أن يكون في واقع الأمر، امتدادا لتمرده على جبروت اللآهوت، الذي طالما عانى من سلطته و تسلطه.
فمن هذا المنطلق تحديدا ، ينبغي وضع عقل ما بعد الحداثة ، في سياق الانحرافي و العدواني، و العمل على رصد نزوعاته التدميرية المصابة بجنون السلطة و التسلط. أي خارج علاقته القديمة و التقليدية ، التي كانت تضعه سابقا في مواجهة الخرافة، الميثولوجيا، و اللآهوت.
لأن الاقتصار على مساءلته ضمن ملابسات هذه العلاقات التقليدية، من شأنه استبعاد مسار النقاش عن راهنية اللحظة ، التي لم يعد فيها العقل مستعدا للاستمرار في الاضطلاع ب تدبير الفضاءات المعرفية ، بقدر ما انصرف و عن سبق إصرار، إلى تدبير كينونته الخاصة به.
بمعنى أن العقل بصيغته الباليستية الحالية، لم يعد يكتفي بالابتعاد عن أجواء الذات الإنسانية ، بل شرع في الابتعاد عن ذاته أيضا ، انسجاما مع تحولاته الحثيثة و المتسارعة التي طوحت به في مدارات اللآمتناهي التقني، بما هي مدارات تجريبية بحتة ، ليس لآليتها التدبيرية أي وعي بمفهوم الواجب الأخلاقي و الإنساني.
و هي آلية شرعت في ترسيخ مشروعتيها العلمية ، على ضوء ما تحققه تباعا من نجاحات باهرة ، في الحقل القتالي/الحربي المنفلت من عقاله. و كما هو واضح فنحن نحيل هنا على مجموع ما يتوزع على هذه المدارات التجريبية من محترفات ، و مختبرات سرية ، وعلنية ، مكرسة بذلك أزمنة انحراف العقل عن مساراته الموضوعية، التي كان يمارس فيها إلى حين دوره التنويري .
و الجدير بالذكر أن هذا الانحراف حوله إلى مسخ أسطوري ، تتمظهر ملامحه في مختلف أنواع الاختلالات الحالية التي تعاني منها البشرية ، بعد أن أمست -هي أيضا – مندرجة ضمن مشاريعه الاختبارية التي تحتل فيها الحروب التقنية مركز الصدارة. و من أخطر تداعيات هذه الوضعية ، استحداث عوالم غامضة، تتواجد فيها كائنات ” سرية ” بعقل كبير، لكن بدون قلب و لا روح. أي كائنات بعقل هجين ، همجي و متسلط، يأتمر العالم بأوامره ، و يخضع لمشيئته المفرغة من عمقها الإنساني .
و في ظل هذا الواقع المنذر بهيمنته التخريبية و التدميرية ،التي تطال عدوانيتها السماوات و الأراضي السبع ،تبرز الحاجة القصوى إلى رقابة استثنائية ، غير مشروطة بالمرجعيات الدوغمائية المجسدة في ثنائيات الخير و الشر ،الحلال و الحرام، المباح و المحظور ، التي لا تلبث أن تنقلب إلى ضدها في أية لحظة متوقعة أو غير متوقعة ، على ضوء معادلة الغالب و المغلوب.
و الرقابة الرمزية التي تعنينا في هذا التوصيف ،هي رقابة إبداعية بامتياز ، يحتل فيها “الشعري” مركز الصدارة ، بما هو استدعاء ضمني لجوهر الروح الإنسانية ، و الذي يمكن رصده في فضاءات كافة المبادرات الفنية و الإبداعية، كما في شبكة علاقات التواصل المنتصرة للحق في الحياة.
ذلك أن المراهنة على إثراء فضاءات المعيش و المفكر فيه بطاقة الشعري ، لدى العامة و الخاصة ، هي الكفيلة -إلى حدما – بسريان و تدفق ذبذبة اليقظة الإنسانية في أوصال الكون ، و الحد من غلواء العقل التدميري و جبروته.














