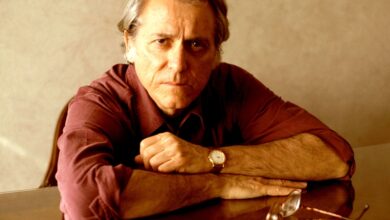“الآلة” التي علَّمتنا كيف نَعيش

- المأوى عبر التاريخ
سكن الإنسان الأرض منذ آلاف السنين، لكنّه لم يبدأ في تشييد مسكنٍ خاصّ به إلّا منذ عشرة آلاف سنة فقط. خلال هذه الفترة، أصبح البيت هو النموذج الأصلي لإقامة البشر على الأرض. أوّلاً، لأنّه ظلّ لفترة طويلة الشكل الوحيد القادر على إيواء البشر. وثانياً، لأنّه متجذّر في خيالنا بشكلٍ فطريّ أكثر من أيّ شكل آخر من أشكال المأوى. واستناداً إلى علم النفس، فنحن جميعاً نمتلك بداخلنا تصوّراً لنموذج البيت الذي يصلح مستقرّاً دائماً.
فمن الكهف الّذي سكنه أسلافنا في فترة ما قبل التاريخ، إلى الكوخ البسيط في غابة، إلى ما وصلت إليه الحضارة اليوم من أشكالٍ معمارية حديثة، تطوّرت ثقافةٌ كاملة حول السكن، بكلّ ما يتطلّب ذلك من ضروريات وكماليات وقوانين، في ارتباطٍ مع درجة تطوّر المجتمع وهيمنة شكل الأسرة النووية.
وإذا عدنا إلى التاريخ، خصوصاً إلى تلك الفترة الممتدة من العصور الوسطى إلى القرن السابع عشر، نجد أنّ البيت كان في كثير من الأحيان مكاناً للعمل أيضاً، وكان يحمل أسماء عدّة، مثل: المزرعة، المتجر، ورشة العمل، القصر، وما إلى ذلك، وعلى هذا النّحو فهو كان يستقبل العديد من الأشخاص الغرباء إلى جانب أفراد الأسرة (سادة، عبيد، خدم، عمّال، فضلاً عن أجيال كثيرة من العائلة الواحدة) بشكلٍ أوسع من نموذج الأسرة النووية المعاصرة. لهذا، كان يصعب التمييز بين المجالين العامّ والخاصّ بداخل البيت، ولم يكن مفهوم الحميميّة قد تبلور بالشكل الّذي نعرفه اليوم، بحيث كان الاختلاط شديداً، ولم يكن الناس قد استأنسوا بعد العيش في عزلة عن الآخرين.
- البيت كوننا الأوّل
وفقاً لعالم النفس جان- لويس لوران، فإنّ البيت هو الفضاء الأكثر تأثيراً في تشكيل مراجعنا المكانية والعاطفية. لأنّ “البيت هو المأوى، هو هذا الجسد الذي يغلّفنا بداخله من كلّ جانبٍ ويحمينا، بحيث يشكّل غلافاً خارجياً مضاعفاً يطوّق رحم الأم”. ذلك لأنّ جسد الأم، من الناحية النفسية، هو المأوى الأوّل للإنسان، أي ذلك المأوى الّذي يحمي، قبل كلّ شيء، من الاعتداءات الخارجية. وبالتالي، فإنّ فضاء البيت يشكّل في البداية – بالنسبة للطفل- امتداداً لجسد الأمّ، وعليه يصبح البيت هو الفضاء الحميميّ للأسرة، الّذي بدوره يتغيّر قليلاً أو كثيراً بحسب العصور والثقافات. وهذا بالضبط ما لاحظه غاستون باشلار من قبل في كتابه “جماليات المكان”، حين قال إنّنا جميعاً مسكونون بالبيت الأوّل الذي وُلدنا فيه، ليس باعتباره بناء مادّياً فقط، ولكن باعتباره مسكناً للأحلام أيضاً.
يرى باشلار أنّ البيت هو رُكننا في العالم. إنّه كونُنا الأول، وهو كونٌ حقيقي بكلّ ما للكلمة من معنى. وبما أنّ كلّ الأمكنة المأهولة حقّاً تحمل جوهر فكرة البيت، فإنّ ما يحقّق هذه الفكرة في الواقع هو الخيال، الّذي يعمل في هذا الاتّجاه أينما لقي الإنسان مكاناً يحمل أقلّ صفات المأوى، ذلك لأنّ الخيال يبني “جدراناً” من ظلال دقيقة، مريحاً نفسه بوهم الحماية، أو على العكس، نراه يرتعش خلف جدران سميكة متشكّكاً من فائدة أقوى التحصينات.
وباختصار، طبقاً لجدلٍ لانهائي، فإنّ ساكن البيت يضفي عليه حدوداً. إنّه يعيش تجربة البيت بكلّ واقعيتها وحقيقتها خلال الأفكار والأحلام. ولهذا السبب، فالبيت، مثله مثل الماء والنار، يتيح استرجاع لمحاتٍ من أحلام يقظةٍ تضيء ذلك الدّمج بين القديم جدّاً وبين المستعاد من الذكريات. وهذه المنطقة التي تنفتح على تاريخٍ سحيق يرتبط فيها الخيال بالذاكرة، كلّ منهما يعمّق الآخر.
- البيت وأحلام اليقظة
من الواضح تماماً أنّ البيت كيانٌ مميّز يحضن قِيم أُلفَة المكان من الداخل، على شرط أن ندرسه كوحدة وبكلّ تعقيده، وأن نسعى إلى دمج كلّ قِيمه الخاصّة بقيمة واحدة أساسية. إنّنا لا نعيش تجربة البيت يوماً بيوم مثلما نعيش تسلسل قصّة. إذ تتداخل في أحلام اليقظة مختلف البيوت الّتي سكنّاها، لأنّها تظلّ حاضرة في الذاكرة مدى الحياة.
لكن ما هي الفائدة الرئيسية للبيت؟ يجيب باشلار بلا تردّد: البيت يحمي أحلامَ اليقظة، والحالمَ، ويتيح للإنسان أن يحلم بهدوء. لأنّ الفكر والتجربة لا يكرّسان وحدهما القيم الإنسانية. فالقيم المنسوبة إلى أحلام اليقظة تسِم الإنسانية بالعمق. ولهذا، فإنّ الأماكن الّتي مارسنا فيها أحلام اليقظة تعيد تكوين نفسها في حلمِ يقظةٍ جديد. ونظراً لأنّ ذكرياتنا عن البيوت التي سكنّاها نعيشها مرّة أخرى كحلمِ يقظة، فإنّ هذه البيوت تعيش معنا طيلة الحياة. ومن المدهش أنّ شاعرنا أبي تمّام قد سبق باشلار في التعبير عن هذه الفكرة بدقّة في بيته الشهير: كَمْ مَنزِلٍ في الأرضِ يألفُهُ الفَتى/ وحَنينُهُ أبداً لأوَّلِ مَنزِلِ.
إنّ هدف باشلار من دراسة البيت، وفق منهجه الظاهراتي، يستند على اعتبار البيت واحداً من أهمّ العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية. وفي رأيه، فإنّ مبدأ هذا الدّمج وأساسه هما أحلام اليقظة. فالبيت في حياة الإنسان يقوم باستبعاد عواملِ المفاجأة ويخلق استمراريّة، وبدونه يصبح الإنسان كائناً مفتّتاً. فهو الفضاء الوحيد الّذي يحفظه من عواصف السماء وأهوال الأرض. لهذا، يستحقّ البيت أن يوصف بأنّه “جسدٌ وروح”، وأنّه “عالم الإنسان الأوّل”. كما يستنتج أنّ الفلسفة التي تنطلق من لحظة “إلقاء الإنسان في العالم” هي فلسفة ثانوية. ويفضّل في مقابلها الفلسفة الّتي تعيد الإنسان إلى مكانه الأصليّ، أي مَهد البيت الذي وُلد فيه. فحين نحلم بهذا البيت، وبينما نحن في أعماق الاسترخاء القُصوى، ننخرط في ذلك الدّفء الأصليّ، في تلك المادّة لفردوسنا المادي. هذا هو المناخ الّذي يعيش الإنسان المحميّ في داخله، وهو ما يمنح للبيت ملامح أموميّة.
- الإقامة شعريّاً على الأرض
من جهة أخرى، لكي نتبيّن مدى ارتباطنا بالبيت الذي وُلِدنا فيه، فإنّ الحلم يساعدنا أكثر من الفكر. إنّ قوة لاوعينا هي الّتي تبلور أبعد ذكرياتنا، فعلى مستوى حلم اليقظة، لا الواقع، تظلّ طفولتنا حيّةً ونافعة شاعرياً في داخلنا. ومن خلال هذه الطفولة الدائمة نحتفظ بشاعرية الماضي. فسُكنى البيت الذي وُلِدنا فيه – حُلميّاً – يعني أكثر من مجرّد سكناه في الذاكرة، إنّها تعني الحياة في هذا البيت (الذي زال) بنفس الأسلوب الّذي كنّا نحلم فيه.
وهكذا، متخطّين القيمَ الإيجابية للحماية، نشحن البيت الذي وُلِدنا فيه بقيمِ الحلم الذي تبقّى بعد زوال البيت. وتتجمّع مراكز الوحدة والضّجر والأحلام لتشكّل بيت الأحلام، وهو أكثر ديمومة من ذكرياتنا المشتّتة عن البيت الذي وُلِدنا فيه. وبالتالي، فالبيت يشكّل مجموعة من الصور التي تعطي الإنسانية براهينَ أو أوهام التوازن، ولتنظيم هذه الصور، يدعونا باشلار إلى أن نأخذ في الاعتبار موضوعين أساسيين: الأوّل، تصوُّر البيت كائناً عمودياً، أي أنّه يرتفع إلى الأعلى فيميّز نفسه بعاموديته، وهو إحدى الدعوات الموجّهة إلى وعينا بالعامودية. وثانياً، تخيُّلنا للبيت كوجود مكثّف، أي أنّه يتوجّه إلى وعينا بالمركزيّة.
لقد علّمنا البيت الأول، أي المكان الذي وُلدنا فيه، كيف نحلم وكيف نقيم في العالم بطريقةٍ ما. وهذه الطريقة سوف لن تغادر أحلامَ يقظتنا إلى الأبد. لذلك، توجد بداخل كلّ واحد منّا صورة عن البيت الأوّل الذي سكناه، وهو بيت من خيالٍ في الحقيقة، لكنّه سيرافقنا في الحلّ والتّرحال عبر كلّ البيوت الأخرى التي سنسكنها طوال حياتنا. وهذا ما يؤكّده أيضاً ميشال دي سيرتو في مؤلّفه “اختراع اليومي”: “إنّ منازلنا المتعاقبة لا تختفي أبداً، نُغادرها من دون أن تغادرنا، لأنّها تعيش بدورها، حاضرةً ولامرئية، في ذكرياتنا وأحلامنا”.
وبحسب هذه النّظرة، لن يعود البيت مجرّد “آلةٍ للعيش”، كما يقول لو كوربوزييه، وإنّما “آلة تعلّمنا كيف نعيش”. إنّها الآلة التي علّمتنا سابقاً كيف نكتشف الأرض، من الحبو على أربع إلى اكتساب عادات العيش في المجتمع. لهذا، ربّما حين يصير الطفل بالغاً، سيحاول في بيته المستقلّ إعادة اكتشاف الأرض من جديد، بالطريقة نفسها التي نشأ عليها في بيت والديه.
نخلص، في النهاية، إلى أنّ البيت ليس فضاءً للسكن فقط، وإنّما هو أوسع من ذلك، إنّه مكان يضع فيه الإنسان موطئ قدم، تسمح له بالإقامة فيما بين الأرض والسماء، باعتباره كائناً فانياً كغيره من الكائنات، وباعتباره كائناً قادراً على الحلم أوّلاً وأخيراً. ولعلّ هايدغر كان على صواب حين ردّد وراء هولدرين بأنّ “الإنسان يقيمُ شِعريّاً على الأرض”.