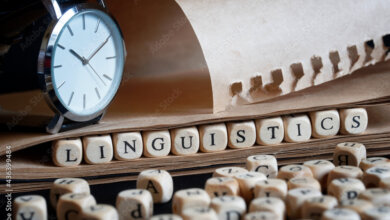الشُّحنة اللغوية للأمكنة

اللغة المكانية ميزة خاصة تختلف عن ميزة اللغة المجردة، وعن ميزة لغة الزمان، لو قلنا: «البيت»، لكانت لغته المكانية تعني لغة الهندسة، والتشييد، والحيز الأنثروبولوجي، والسكن، والألفة، والأسرة، والوطن،… إلخ، وهذه المعاني حديثة،
أي كل ما يتعلق بلغة البيت التأويلية. ولو قلنا «البيت» لغة قاموسية، لاقتربت من لغته المكانية، البيت تعني المبيت، والسكن، لكانت اسمًا أو مبتدأً، ولو قلنا «البيت» زمنًا، لقلنا تاريخًا، أو عمرًا، أو مدة عشنا فيه، اللغة المكانية مشحونة بأشياء وثقافة المكان، ولا تنشأ اللغة المكانية كصفة للمكان، بل استعارة،
فالبيت يكون زمنًا، ويكون مالًا، ويكون أمنًا، ويكون ادخارًا، ويكون وجاهة، ويكون سترًا، ويكون زواجًا، وفلان بيت قومه، أي رئيسهم، والبيت عيال الرجل، والبيت التزويج، وبيَّت الأمر السر الذي يُدبِّره ليلًا، والمبيت الموضع الذي يبات فيه، والبيتوتة دخولك في الليل، وبات يفعل كذا وكذا (لسان العرب) ج2 ص15-16-17.
كل هذه الاستعارات ليست صفات، إنما هي حالات، وشحنات ثقافية وتكوينية، مرتبطة بهوية المكان، وإنشاءاته، ومن ثم فهي لغة من لغات المكان المؤلفة عبر الممارسة التاريخية، وليست لغة الكلمات القاموسية فقط.
فاللغة تلحق بالأمكنة ولا تتقدمها. الشعرية المكانية هي ما تشعر به مكانيًّا، وما تشحنه فيها من شحنات ذاتية مضمرة في بنيته، فالإحساس بالبيت نوعان: نوع يخص بنيته؛ بيتًا، خيمة، دارًا، بيت القصب،… إلخ، كلها بيوت للسكن والألفة والزواج، هذا إحساس وظيفي عام، ويتساوى معه بيت الشعر عندما تسكنه أسرة الكلمات.
النوع الثاني، هو الشعرية، وهذه تتألف من مجموعة شحنات البيت الوظيفية، المكانية والمادية واللغوية والممارساتية الحياتية، والبنى الثقافية، وتاريخية السكن، والتقاليد، والبنى المعرفية التي تُسكنها الأقوام عبر عملها المتطور، ومن ثم كل ما يتعلق بحياة الإنسان؛ يرحل من محيط العمل ليسكن البيوت.
فالمظاهر الدلالية للألفاظ، هي الأصوات والنغمات الخاصة التي تحملها الشحنات المكانية لصور واقعية أو متخيَّلة؛ لتوليد أحلام اليقظة التي ترافقها أحلام الطفولة والسكن والعيش، وأحلام اللاوعي المعرفي الذي تفجره الرؤية القصيدة لأشياء المكان ومكوناته، عندما يصبح الموقد مثلًا أمنًا ودفئًا، يتحول إلى مسبب للكلام، ومن ثم لنشوء الحكاية، الحكاية ترافق الحرارة دفئًا أو نارًا،
الشعرية هنا، تسكن بيتًا من الأشياء والكلمات تسكن نار الحكاية، وتؤجج كلماتها وتشحنها بما يتفق وقدرات المستمع، وليست الشعرية أشياء أو كلمات خارجية تلصق بالأمكنة، أنما هي تلك الروح المادية التي تسري في الأشياء وفي الكلمات.
ما يميز لغة المكان، أنها نابعة من جنس مكوناته، وليس من جنس اللغة التي نتكلم بها، فعندما نقول: هذه نافذة، عتبة، باب، موقد، سطح، جدار… إلخ هذه المفردات التكوينية، هي اللغة، وليست اللغة الإشارية لها تعويضًا عن لغتها الخاصة.
فلغة الجدار، لا تعني أصوات حروف «ا ل ج د ا ر» أبدًا، ما تعنيه إن حملت هذا الاسم، في حين أن لغة الجدار التكوينية هي: المواد المنشئة له، التي عبأت مساحته، وكونته كتلةً حيًّة يمكن أن توظف، هذه اللغة التكوينية هي المعنية باللغة المكانية، لتأتي اللغة التي نكتب بها توصيفًا للغة المكانية، فالنافذة ليست لغةً «ن ا ف ذ ة»، إنما هي لغة العتبة التي تفصل الداخل عن الخارج، والتي يمر من خلالها نور الخارج إلى الداخل ويخرج ضوء الداخل إلى الخارج، لغة الممرات، المشحونة بهواء الخارج والداخل، لغة الضوء المخترق والمنعكس على الجدار الداخلي،
لغة العيون المتطلعة للفضاء الخارجي التي ترتبط بالأمل، لغة الأفكار المحلِّقة في سماوات الذاكرة، لغة الأمس وقد بقيت حروفها خارج الأمكنة، لغة المستقبل وهي تتسلل عبر النافذة لتسلط ضوئها على لغة الحاضر، لغة الإمكانيات في الحرية ونشدان الهواء الطلق، لغة الطيور المحلقة في سماوات خفيضة من أجل جمع القوت، ولغة العتبات، التي لا داخل لها ولا خارج، لغتها تكوينية ليست حيادية، إنما هي ما بينية.
وكذلك لغة الباب، ولغة الموقد، ولغة السرير، ولغة السطح، فكل منشأة لها ما يكونها لا ما يصفها، التوصيف يأتي بعد التكوين، اللغة التي نتحدث بها عن هذه الأشياء لغتنا نحن، أمَّا لغتها فلا يعرفها إلا البناء، ولذلك تكون البنائية هي اللغة التكوينية.
كل شيء يخرج من رحمية كونية لا يملك لغة أخرى غير لغته التكوينية، لا يسمى الطفل باسم إلا بعد خروجه، ويبقى اسمه ملاصقًا لحياته، ويتلاشى في التربة بعد موته، الاسم الباقي ليس لغة، بل صفة خارجية لاسم أطلق جزافًا قد لا يكون معبِّرًا عنه وغير دقيق لما سُمِّي به، في حين أن لغته التكوينية مرتبطة بوجوديته، ومتى انتهى وجوده انتهت لغته.
الشعرية لا تتبع الموتى، ولا أسماء الأشياء، بل تتبع تفاعل مكونات الأشياء أولًا، ثم تنمو في التخييل المادي للأشياء عندما تكون محلومًا بها. اللغة التكوينية ترافقها أحلام يقظة الشعرية هنا، في بيت الحلم، وليس في صورة الشيء.
لن تكون اللغة المكانية غير اللغة التشكيلية، فالمكان أقرب إلى بنية اللوحة الفنية، تتيح الهندسة المعمارية لإمكانية اللغة المعمارية، تشكيلات تكوينية لا تتشابه مع أي تشكيل واقعي، والمُخَيِّلة تتداخل فيها الرؤى الفانتاستيكية والرؤيا الواقعية، ما يسمى بالواقع يأتي لاحقًا على البناء المعماري،
وليس العكس. جرت الرؤية الثقافية العامة إلى إحالة العمارة على الأشجار، هذا تشابه تقليدي مباشر، لكن العمارة ليست شجرة إلا بالهيكلية البصرية، أما في البنية فهي تركيب من خطوط وكتل ونقاط ومجالات مختلفة تجمعها بؤرة تشكيلية عمودية متوازنة؛ لذلك تكون اللغة المعمارية للمكان مخفية في المتشابه الطبيعي، بل تستخلص من التكوين الفني للبناء.
والسؤال يؤخذ من الشعرية «ما اللغة التي لا تحيل إلى أي شيء خارجها؟ إنها اللغة المختزلة إلى ماديتها وحسب، إلى أصوات أو أحرف، إنها اللغة التي ترفض المعنى». (نقد النقد، تزفيتان تودوروف، ترجمة سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط2، 1986م، ص25).
لغة الأمكنة لغة مستقلة كما يقول تودوروف عن لغة الشعر، وذاتية الغاية أيضًا، وهذا يعني أنها لغة مكانية، كل لغة ذاتية ومتشكلة ومستقلة، لغة مكانية، أي أن غايتها «في ذاتها» (نقد النقد: تزفيتان تودوروف)؛ لأن لغة المكان لا تحيل إلى غير المكان، ليس لها خارج، كل لغتها في الداخل التشييدي،
ولذلك ثمة أصوات لها، ولكنها أصوات مرئية، وقد تكون في التخييل مسموعة، بمعنى أن ترى كيفية تشكيل المعنى من عدد من التراكيب الإنشائية، فللنافذة معنى أنشأته الأحجار والفراغ والشباك، وللباب معنى أنشأه الفراغ والخشب والعتبة والخارج والداخل، هذه اللغة الإنشائية مكانية وذاتية، صحيح أن كل الأبواب والنوافذ والسقوف تتشكل وفق بنية قاعدية الأبواب عمودية والسقوف أفقية، والمواقد جوفية دائرية، والسطح أفقي متعامد،
وهكذا تتحكم البنى القاعدية في التشكيلات الهيكلية، ولكن لكل باب وسقف ونافذة لغته الذاتية التي يستمدها من علاقتها بالبنية التي هي ضمنها، وهو ما يجعل اللغة المكانية بصرية ومشيدة عقليًّا وتنظيميًّا ووفق تصور مادي هندسي، هو ارتباطها بالتطور المعماري، من جهة وبهُويَّة من يسكن خلفة من جهة أخرى، فلغة باب البيت للإنسان، هي غير لغة باب حظيرة الحيوانات.
إن الذي يجد في إشغال الفراغات كيفية حوارية مع الفضاءات، هو من يكتشف لغة المكان الإنشائية، وهذه الكيفية تختلف من عمارة وبيت إلى عمارة وبيت آخر، حيث تتحكم فيها جملة اقتصاديات تنفيذية؛ منها: المسافة، والطرق، والبيئة وما يحيط بها، والسكان، والعلاقات مع الأحياء الأخرى، ومواقف الباصات، والترام، والطرقات والحدائق، وكأن لغة المكان التشييدية لا تعطي معنى متكاملًا من دون أن يكون ثمة تنسيق جمالي مع ما يحيط بها.
وبالضرورة، سيكون للبيت في أية عمارة لغته الخاصة التي يستمدها مضافة من لغة ساكنيه، ومن تكوينه المعماري، لكنها ستختلف باختلاف الهيكيلة الهندسية للبيت وللعمارة وللحي، وهذا ما يجعل التمايز بين حي وآخر ليس بطريقة البناء فقط، إنما في إنشاء اللغة المكانية، ونجد ذلك واضحًا في الأحياء الشعبية تميزًا لها عن الأحياء الأرستقراطية.
لا لغة تنطلق من دون معمار فني ينظمها، في سياق معين، ولذلك تصبح اللغة الشعرية شعرًا؛ لأن التنظيم يكشف عن شعريتها، كذلك نجد اللغة المكانية مكانية عندما تكون الأبنية منتظمة وعلى علاقة جمالية مع البيئة وما يجاورها، فتبرز شعريتها من داخل النظام المتحكم في النسق، وهو الأمر الذي يغني الصورة بجمالية مظهرية هي في الأساس مبنية على جمالية نظامية للبنية.
يتحدثون في الشعر والرواية عن النظام العقلي والخيالي، الواقعي والمتخيل، وكأن البيت والأمكنة لا تنتمي إلا لذاتها، فيجردونها من العقل ومن الخيال، وقد يطرح بعض أن المعماري هو من يتكفل بهذه المهام العقلية والخيالية وليس الساكنين أو الرائين أو المشتغلين في حقول السكن والبناء والثقافة والتنمية، ما يقال عن الشعر والرواية والمسرح والموسيقا والرسم،
يقال عن العمارة وتفصيلاتها الكثيرة من بيت وشقق ومجازات وممرات وأسواق ومماشٍ وأشجار وأنهار وغير ذلك، النغمة الطبيعية بنيت على تصور عقلي مشفوعًا بخيال مادي للأشياء، ومصحوبًا برؤية جمالية مختبرة، ومستندة إلى الكفاءة التي يتطلبها السكن المريح.
تتجه اللغة المكانية إلى الرؤية مباشرة، وتبقى هناك ساكنة ما لم نوجه إليها الرؤية القصدية الكاشفة عن ماهيتها التشكيلية، فالأحجار والألوان والأشياء التي تؤلف تكوينًا ذا معنى، تبقى بلا فعل إلا إذا سلطنا عليها الرؤية القصدية التي تتغلغل في تكوينها الصلب وتكشف عن فاعليها وهي في مكانها،
فقد تكون هذه الجزئية مختلة البنية كما لو كانت كلمة في بيت شعر لا تؤدي غرضها مع الكلمات الأخريات، عندئذ يختلّ البناء وتصبح تلك مثلبة تكوينية، والعكس يحدث عندما تكون كل أجزاء البنية المكانية بلغة متضافرة مرئية بعيون مختلفة وترى ما تعمله في تماسكها الصامت من وثيقة أنها تؤدي عملها.
ياسين النصير – ناقد عراقي.