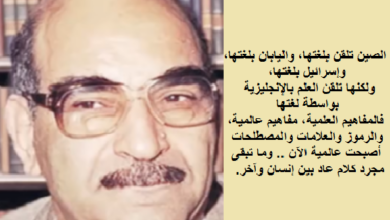الصحافة المكتوبة .. الجُحرُ الذي تُلسَعُ منه اللغة العربية يوميا

استهوتني الصحافة منذ أن كنتُ صغيراً، وكنتُ أَعتبر الصحفيَّ شخصا ذا شأنٍ عظيم جدا، أكبرُ من أستاذَيْنا في الصف الخامس الابتدائي. مازلتُ أذكر يومَ دخلَ أحدُ الأساتذة إلى فصلِنا في الصف الخامس الابتدائي،
وسلَّمَ أُستاذَنا قُصاصاتٍ من ورق الجرائد. تأمَّلها أستاذُنا سريعاً؛ وعلى ما يبدو أنه قرأ العناوين واسم الكاتب. التفتَ إلى الأستاذِ الزائر مُتبسماً ومُنوِّها؛ ثم التفتَ إلينا قائلاً؛ هذا أُستاذُكم فُلان، إنه يكتب في الجرائد. زادتْ هذه الكلمات القليلة من رهبةِ وهيبةِ الأستاذ في نُفوسِنا، وزادَ شأنُهُ عندنا فوق شأنِ أستاذِنا؛ الذي لم يكن يكتب في الجرائد.
لم يَقُلها صراحةً؛ ولكننا فهِمناها من طريقة انبهارِه بالأستاذ الزائر. فلو كان يَكتب هو الآخر في الصُّحف والمجلات لافتخر بذلك؛ ولأحضرَ لنا هو الآخرُ قُصاصاتٍ تحمل مقالاتٍ وأعمدةٍ باسمِه.
كُنا صغاراً، ولم نكن نعرف أي شيء عن الإعلام ولا الصحافة ولا الصُّحف، سوى أنَّ أستاذ اللغة العربية يُمكنُه أن يصبح صحفيا. فالصحافة بالنسبة لنا تخصصٌ جبَّارٌ لا يمكن لأيٍّ كان أن يلتحِقَ به.
بقيت هذه الواقعةُ محفورةً في ذاكرتي، وتمنيتُ لو تُتاحُ لي الفرصة يوماً أنْ أقرأ اسمي على إحدى الصحف.
في مدينتي الصغيرة؛ الكسولة؛ والهادئة والخاملة دائما، كانت هناك بِضعُ مقاهٍ مبثوثة في زوايا بعض الشوارع القريبة من مؤسَّسات التعليم ومن إدارات المصالح العمومية، وكان يرتادُها المثقفون والأساتذة والكُتَّاب العُموميون وأصحابُ قُبعات الجواهري، التي أصبحت رمزاً للمثقفين والأدباء.
يتوزَّعون على كراسِيِّها ويلتفُّونَ حول طاولاتِها وهم يحملون الجرائد، أو يُدوِّنون في مُذكراتِهم، يقطعون نشاطَهم هذا؛ برشفةٍ من فنجان قهوة أو شاي، وبعضُهم يتعمَّد وضع علبة سجائر مع القداحة ومحفظة نظاراتِه على الطاولة.
وكان مُجردُ الجلوسِ في هذه المقاهي يَمنح صاحبَه مُسحةً من هيبةٍ ووقارٍ وشأن؛ تراهُ في أعيُن المارة وهم يمسحون كراسي المقهى ومن عليها من أولئك الاستثنائيّين. أما نحن التلاميذ؛ فكنَّا لا نقطع شارعا ولا نَسلك زقاقاً قطعَه أو سلكَه أستاذٌ من أساتذتِنا خوفا أو وقارا.
ونحن نتقدم في مستويات التعليم، كان حُلمي بأن أصبح صحفيا ينضج ويتقوى بداخلي. وكنتُ حريصا على أن أكون متفوقا في مادة اللغة والأدب كي أستطيع تحقيقَ هذا الحلم. وكنت أحتفظ ببعض النسخ من الجرائد القديمة، أقرأ منها تارة وأحتفظ بقصاصاتٍ منها للمواضيع والمقالات التي تُثيرُني.
وكنت أتابع الأخبار على موجات المذياع وعلى شاشة التلفاز، وكانَ يُوحي لي لَون وشكل ورائحة ورق الجرائد؛ والأشخاص الذين يحرِصون على شرائها وقراءَتِها في المقاهي وأمام المارة، أن كلَّ ما فيها صحيحٌ وحقيقي وواقعي.
ولما بلغتُ المستوى الثانوي، وتخصصتُ في الأدب، وتعرَّفتُ عن قرب على بعض ورُؤساء التحرير وبعض الصحفيين الذين يكتبون للصُّحف الجهوية والوطنية، غيرتُ كثيراً من قناعاتي وصحَّحتُ الكثير من مُسلَّماتي حول الإعلام والصحافة والصُّحف؛ على الأقل؛ في ذلك النَّطاق الضيق الذي باشرتُ الاحتكاك به والتعرف عليه للتو وَعَنْ قُرب.
فسقطت تلك الهالة التي لطالما أحطتُ بها الصَّحفي الذي يكتُب في الجرائد، بعد أن اكتشفتُ أنهم يُمارسون الصحافة دون أن يكونوا أساتذة، واستحضرتُ صورةَ تلك القُصاصات التي انبهرنا بها وبِكاتِبها يوم أن كُنَّا تلاميذَ في المستوى الابتدائي. فودِدتُ لو أتيحَ لي قراءَتُها اليوم، لكي أستطيع أن أحدّد الفرق.
أو ربما سأكتشف أنها مُجرَّد تجميع للكلمات والجُمل، كما يفعلُ هؤلاء، وليست تعويذةً سحرية أو شيئا خارقا للعادة.
أنهيتُ مرحلة الثانوية والتحقت بمركزٍ للصحافة والإعلام، تلقينا دروسا مكثفة في الأجناس الصحفية، وتكوينا معقولا في المراسلات الميدانية، وكوَّنّا فريقا صحفيا شابا، وعمِلنا تحت إشرافِ أساتِذتنا، واستطعنا استصدارَ أولِ مجلةٍ ورقية مُتخصصة في الشأن المحلي لمدينتِنا.
وتحققَ حُلمي القديم بِنشرِ أولِ مقالٍ يحمل اسمي على ورقٍ مُلون فاخر. كان إحساساً جميلا بريئا وصادِقا. توالت بعدها كتاباتي في صُحفٍ جهوية ووطنية، ثم انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني، يومَها كانت الصحافة العربية لازالت تتلمَّسُ طريقَها بتوجس نحو الفضاء الرقمي.
عمِلتُ مراسلا وكاتبَ مقالات تحليلية. لكن الجانب الذي اهتممتُ به أكثر؛ كان “المراجعة والتدقيق اللغوي”. ليس حبا فيه؛ وإنما تجويدا للمُنتجِ الصحفي. لقد شكَّلَ لي المحتوى العربي المُتنامي والمتراكم على الشبكة العالمية، هاجسا بسبب المجال الذي أتاحه لكلِّ من هبَّ ودب للكتابة.
فأصبح بابُ النشر مُشْرَعاً على مصرعيْه، وأصبحتِ اللغة العربية ضحية وفريسة مستباحة لكل مبتدئ وفضولي ومستكشِفٍ وباحثٍ عن الشهرة والظهور في الفضاء الرقمي الجديد. كنتُ دائما أتمنى أن يكون الصحفي أستاذا مثل أستاذنا، أو على الأقل أن يكون بمستواه.
لقد سقطت الصحافة في عيني سقوطا مدويا بسبب هؤلاء الفضوليّون، وأسقطوا تلك الصورة الناصعة التي رسمَه لنا أساتذتُنا عنها؛ باعتبارِها تخصصا ذا شأن وهيبة.
ولم تعد الكتابة الصحفية تُشغلني كثيرا، بقدر ما شغلَني الوسيط اللغوي الذي يَتمُّ به تحرير هذا الكمِّ الهائل من المقالات يومياً. كنت أجوبُ المواقع الإلكترونية العربية المتخصصة في الأخبار والمنتديات؛ وأعُيان حجم الضرر والهدم والتشويه والابتذال الذي تتعرض له اللغة العربية.
وأذكر أنني إلى جانب المقالات التي كنتُ أنشرُها بشكل دوريّ في إحدى الصحف الإلكترونية العربية، كنت في تواصل مستمر مع قِسم المراجعة والتدقيق اللغوي؛ لتصويبِ الكثير من العبارات والكلمات الخاطئة؛ وبعض العبارات الدارِجة في العناوين والمقالات التي تُنشر.
فتلقيت بسبب ذاك رسالة من رئيس تحرير مضمونُها؛ أن الفِكرة أهمُّ من القالب الذي تُقدَّم فيه سواءً أكان لغة فصيحة أو لهجة دارِجة.
فأيقنتُ أن العربية تنحدِرُ بمتوالية هندسية؛ فيما التقويم يتم بمتوالية عددية، وأن لغتنا الأم ستُعاني كثيرا؛ وستُلسع مرارا وتكرارا إلى حد النَّزف من هذا الجُحر الإلكتروني. مُعاناةً أكثرَ وأطولَ مما عانته وتعانيهِ مع الصحافة الورقية.
في الماضي كان الوضع نوعا ما أحسنَ بكثير مما هو عليه اليوم، فقد كانت الصحافة العربية المكتوبة يومَها حديثةَ العهدٍ بالدول العربية، ولاتزال في بداياتِها الأولى، وكانت تنتمي إلى مؤسسة موجودة فعلا تُنظِّم عملَها وتُشرف على مُنتسِبيه، ورغم أن التعليم النظامي هو الآخر كان في بداياتِه؛ مع تأسيس أولى الجامعات في كثير من الدول العربية، ومع الارتفاع في نسبة الأمية آنذاك، فإن المُلتحقين بميدان الصحافة المكتوبة كانوا قلة؛ وكانوا من النخبة المثقفة والمجازة أيضا.
ومن يعود للصحف والجرائد والمجلات التي كانت في فترة الخمسينات والستينات إلى حدود ثمانينيات القرن الماضي، سيجد جودة عالية في اللغة، وجمالية وبلاغة في التعبير واحترافيةً في التقديم وقوة في الطّرح والنقاش.
أما اليوم وبسببِ انفلات عقد المنظومة الإعلامية، وعجز مؤسستِها عن لملمة هذا الشتات والتسيب المُعوْلم، بسبب تنوع وتعدد أليات ووسائل النشر الإلكتروني. وعدم قدرة المؤسسة الإعلامية العتيقة على الابتكار والتطور والمنافسة.
فالكُلُّ اليوم أصبح صحفيا وكاتبا ومدونا وناشرا ومُحللا، بغض النظر عن مستواه وتكوينِه ومضمونِ وجودةِ وفائدةِ هذا الذي يكتُبُه، فاستُبيحت الصحافة طولا وعرضا؛ وطغى الرديئ على الجيد، والتافه على الهام، والمغمور على المهنيّ، والكذِب والتدليس والإشاعة على الحقيقة،. والماديّ على الجودة. وأصبحت اللغة العربية اليوم هي القنطرة والقالب الذي تُقدَّم فيه هذه المواد الركيكة والرديئة والتافهة والمسمومة.
فأصبحت لغتُنا الأم حقلاً مستباحا من القاصي والداني، فتشوهت اللغة وانحدر مستواها التعبيري؛ وفقدتْ كلماتُها وعباراتُها الرونق والجمال، وحلّت الألفاظ والكلمات الدخيلة محلَّ العبارات العربية الفصيحة، وأزاحت العامية قطاعا واسعا من المفردات العربية، فغرقت اللغة في مُستنقع الفوضى والإسفاف والابتدال؛ وانعكس ذلك على الذوق العام الذي تَبَلَّدَ تبعاً للبضاعة الرديئة التي يستهلكُها ملايين المتصفِّحين للمحتوى العربي يوميا.
فأصبحنا نعيش حقبة جديدة من الشُّعوبية التي لا تُقيم وزنا ولا اعتبارا للغتِنا الأم. في غياب صارخٍ لقانونٍ زجري يحمي لغتَنا القومية من الضياع، ويكُفُّ أذى هؤلاء الشُّعوبِيِّين الجُدد.