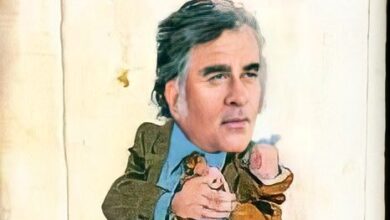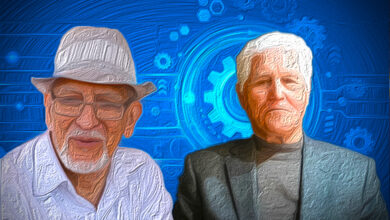جبران خليل جبران يصف نفسَه

“من الناس مَن يعيش للمال، ومنهم مَن يعيش للمجد، أو لخدمة الوطن أو العلم، ولخدمة نفسه والسعي وراء مسرته، ومنهم من يعيش لقلبه نائحًا على حبٍّ مضى منتظرًا حبًّا مقبلًا، ومنهم من يعيش يومه ليومه وساعته لساعته.
ومنهم من يعيش لأسرته أو لبعض أفرادها ولو على حساب الأفراد الآخرين. غايات لا عداد لها تتنوع باختلاف الناس وباختلاف استعداداتهم ومداركهم، فلأيِّ شيء كان يعيش جبران خليل جبران؟
إن الذين تتبعوا كتاباته قد كانوا يظنون أنه يعيش لفنه الثلاثي: من أدب باللغة العربية، وأدب باللغة الإنجليزية، وتصوير يدوي ورسم، ولكنه فى الواقع لم يكن يعيش لشيء من هذا، ها هو ذا يصف نفسه — وبأية بلاغة نادرة فريدة! — في رسائل لم يفكِّر يومًا في أنها ستُنشَر عند وفاته، ولا أنا تخيَّلت مرة أني سأنشر شيئًا منها، وبخاصة في مثل هذا الظرف:
«… صحتى اليوم أردأ نوعًا مما كانت عليه في بدء الصيف، فالشهور الطويلة التي صرفتها بين البحر والغاب قد وسعت المجال بين روحي وجسدي، أما هذا الطائر الغريب (يعني قلبه، وقد كان مصابًا فيه) الذي كان يختلج أكثر من مئة مرة في الدقيقة، فقد أبطأ قليلًا، بل كاد يعود إلى نظامه الاعتيادي، غير أنه لم يتماهل إلا بعد أنْ هَدَّ أركاني وقطع أوصالي.
إنَّ الراحة تنفعني من جهة وتضر بي من جهة أخرى، أما الأطباء والأدوية فمن علتي بمقام الزيت من السراج. لا، لستُ بحاجة إلى الأطباء والأدوية، ولست بحاجة إلى الراحة والسكون، أنا بحاجة موجعة إلى من يأخذ مني ويخفِّف عني، أنا بحاجة إلى فصادة معنوية، إلى يد تتناول مما ازدحم في نفسي، إلى ريح شديدة تُسقِط أثماري وأوراقي.
أنا، يا مي، بركان صغير سُدَّتْ فوهته، فلو تمكنتُ اليوم من كتابة شيء كبير وجميل لشفيت تمامًا، لو كان بإمكاني أن أصرخ صوتًا عاليًا لعادت إليَّ عافيتي، وقد تقولين: «لماذا لا تكتب فتشفى؟ لماذا لا تصرخ فتتعافى؟».
وأنا أجيبك: «لا أدري، لا أدري، لا أستطيع الصراخ وهذه هي علتي، هي علة في النفس ظهرت أعراضها في الجسد.».
وتسألين الآن: «إذنْ ما أنت فاعل؟ وماذا عسى تكون النتيجة؟ وإلى متى تبقى هذه الحالة؟».
أقول: إنني سأشفى. أقول: إني سأنشد أغنيتي فأستريح. أقول: إنني سأصرخ من أعماق سكينتي صوتًا عاليًا، بالله عليك لا تقولي لي: «لقد أنشدت كثيرًا، وما أنشدته كان حسنًا.» لا تذكري أعمالي ومآثري الماضية؛ لأن ذِكْرها يؤلمني،
لأن تفاهتها تحوِّل دمي إلى نار محرقة، لأن نشوفتها تولِّد عطشي، لأن سخافتها تقيمني وتقعدني ألف مرة ومرة، في كل يوم وفي كل ليلة. لماذا، لماذا كتبت تلك المقالات وتلك الحكايات؟ لماذا لم أصبر؟ لماذا لم أضن بالقطرات فأدَّخرها وأجمعها ساقية؟ قد وُلِدت وعشت لأضع كتابًا — كتابًا واحدًا صغيرًا — لا أكثر ولا أقل،
قد وُلِدت وعشت وتألمت وأحببت لأقول كلمة واحدة حية مجنحة، لكني لم أصبر، لم أَبْقَ صامتًا حتى تلفظ الحياة تلك الكلمة بشفتي، لم أفعل ذلك، بل كنت ثرثارًا، فيا للأسف ويا للخجل! وبقيت ثرثارًا حتى أنهكَتْ الثرثرة قواي، وعندما صرت قادرًا على لفظ أول حرف من كلمتي، وجدتني ملقًى على ظهري وفي فمي حجر صلد.
«لا بأس … إن كلمتي لم تزل في قلبي، وهي كلمة حية مجنحة، ولا بد من قولها، لا بد من قولها لتزيل بوقعها كل ما أوجدته ثرثرتي من الذنوب، لا بد من إخراج الشعلة …».
هذا ما يقوله ذاك الذي لم يكتب يومًا إلا الكلمة المجنحة الحية المحيية، هذا ما يقوله ذاك الذي لم تكن كل كلمة كتبها إلا شعلة منفصلة عن شعلة روحه، أي عبقري لا يخجل بكتاباته السالفة، نظرًا لسرعة التطور المكتسح كيانه؟ إن العبقرية الحقة كثيرًا ما تقاس بهذا الخجل الذي ينتاب صاحبها، ولو هو حاز بكتاباته إعجاب العالم.
كتب رسالته تلك بعد إصدار كتابه «النبي» الذي تناولته بالترجمة إلى لغاتها عشرةُ شعوب مختلفة، وكانت مجلات العالم وصحفه تتناقل كلمات جبران ابن الشرق ورسومه التي لا تُضاهَى، رسوم وكلمات لا يأتي بها إلا ذو المواهب الفذة، الذي جرده تهذيبه لفنه من كل زهو وكل دعوى، فسار شوطًا بعيدًا في جادة الوحدة الرهيبة التي لا يقوى على سلكها إلا الخلَّاق المبدع من بني الإنسان.
إن جبران لم يكن ليسير وحده، بل كان شبح الموت يماشيه أنَّى ذهب، كان يعرف نفسه مقبلًا على الرحيل بينما هو يصدر كُتُبه بالإنجليزية «المجنون» و«السابق» و«النبي» و«رمل وزبد» و«يسوع ابن الإنسان» تحفة تلو الأخرى.
فضلًا عن كُتُبه العربية التي نعرفها جميعًا، وفضلًا عن مجموعات رسومه التي كانت مفخرة العبقرية الشرقية بين أقوام تعرف معنى العبقرية ولا يفوتها من خصائصها شيء. وكان آخِر كُتُبه الإنجليزية كتاب «آلهة الأرض» الذي نعكف اليوم على مطالعته — وبأي حزن! — وقد تلقيناه يوم إذاعة نعيه في مصر.
وفيه اثنتا عشرة صورة من رسم يده، تلك كانت شيمة جبران في مؤلفاته الإنجليزية وفي بعض رسائله الخاصة أيضًا؛ إذ كان يلخِّص الجملة والمعنى رسمًا على هامش القرطاس في الغالب، أو هو يشرحه في صورة عجيبة تشغل الصفحة بحذافيرها.
ليعود مرة بعد مرة إلى رسم شعاره التصويري الذي يمثل يدًا تقدِّم كل حياتها وقودًا، وتظل اللهب خارجة من تلك اليد الكريمة وصاحبها يفكر في الحياة كما يفكر في الموت، فيقول في خطاب آخَر كتبه بعد شهور طويلة:
«أتعلمين، يا مي، أني ما فكرت في الانصراف (الذى يسميه الناس موتًا) إلا وجدت في التفكير لذة غريبة، وشعرت بشوق هائل إلى الرحيل، ولكني أعود فأذكر أنَّ في قلبي كلمة لا بد من قولها، فأحار بين عجزي واضطراري، وتُغلَق أمامي الأبواب.
لا، لم أَقُلْ كلمتي بعدُ، ولم يظهر من هذه الشعلة غير الدخان، وهذا ما يجعل الوقوف عن العمل مرًّا كالعلقم. أقول لك، يا مي، ولا أقول لسواك: إني إذا انصرفت قبل تهجئة كلمتي ولفظها، فإني سأعود ثانية لتحقيق أمنيتي، سأعود لأقول الكلمة التي تتمايل الآن كالضباب في سكينة روحي.
أتستغربين هذا الكلام؟ إن أغرب الأشياء أقربها إلى الحقائق الثابتة، وفي الإرادة البشرية قوة واشتياق يحوِّلان السديم فينا إلى شموس …».
إننا ننحني أمام ضريح جديد بعيد، نام فيه ذاك القائل: «إنَّ حنيني إلى الشرق يكاد يذيبني، فمتى، متى أعود إلى بلادي؟» ننحني أمام القبر الذي ينام فيه رجل هو بروحه للإنسانية كلها، ولكنه بجسده غريب بين الغرباء، أننحني لنقول كلمة الوداع؟ لقد جزنا هذا الطور من الغفلة، فصرنا نعلم أن الناس إلى الدار الأخرى متتابعون.
فهنيئًا لكَ برحيلك، يا أخي، لقد أعطيت كثيرًا، وإن أغاظتك هذه الكلمة، لقد أعطيت كثيرًا وقال فيك الشرق للغرب: «ها أنا ذا!» كما قال فيك الشرق الناهض لنفسه: «ها أنا ذا! ها أنا ذا!» حسنًا فعلت بأن رحلت! فإذا كان لديك كلمة أخرى، فخير لك أن تصهرها وتثقفها وتطهِّرها وتستوفيها في عالَمٍ ربما كان يفضل عالمنا هذا في أمور شتى.
حسنًا فعلت بأن رحلت، يا أخي! في ذمة الله وفي رحمته التي تسعنا جميعًا، أحياءً كنَّا أو أمواتًا!”