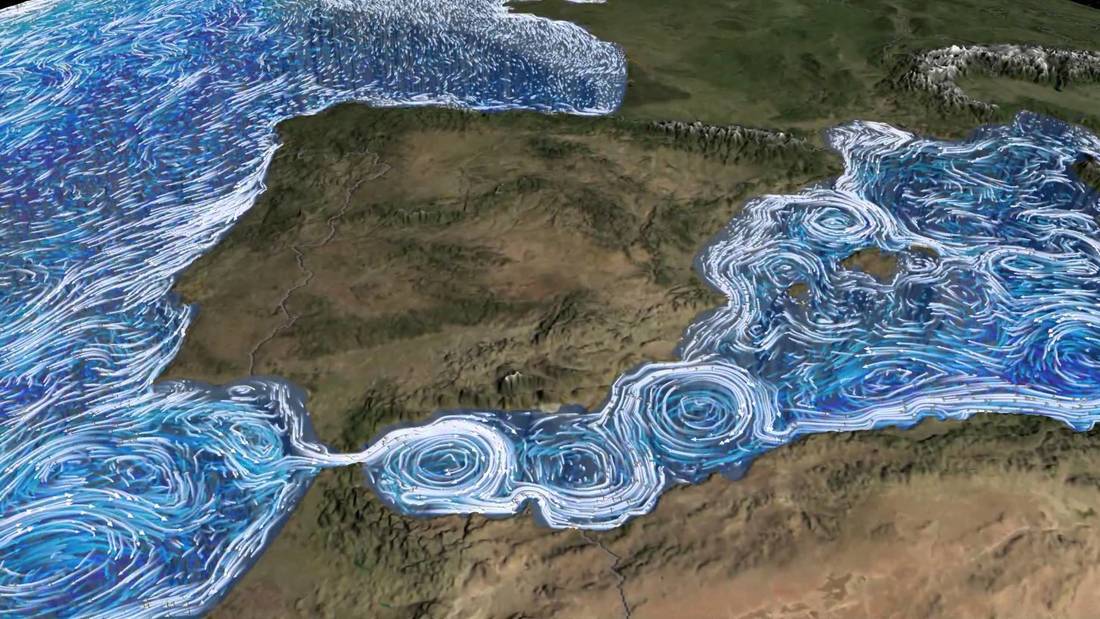قضايا راهنة في الإبداع الفني والأدبي في المنطقة العربية

- مقدمة
يسعى هذا المقال المفصل إلى مناقشة وتحليل خمسة موضوعات ترى الكاتبة أنها أثرّت في المشهد الثقافي في المنطقة العربية خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2016، على الأخص في ضوء التغيرات السياسية والاجتماعية الكاسحة التي شهدها هذا العقد، بإرهاصاتها التي سبقت عام 2011 بأعوام قليلة، مثل الحركات الشبابية والاحتجاجية في عدة بلدان عربية[1].
أثرت نتائج وأصداء هذه الحركات في الحياة الثقافية في المنطقة، سواء تبدّى هذا التأثير في شكل عقبات تعترض الانتاج الفني الآن، أو في شكل إنجازات ومكاسب على الأرض حققها الفنانون المعارضون للأنظمة.
وبينما تمثل هذه التطورات السياسية إطاراً حاكماً، وعاملاً فعّالاً في تكوين المشهد الثقافي في المنطقة العربية، يبقى محتوى هذا المشهد وآليات تفعيله على مسافة تضيق وتتسع من هذا الإطار الحاكم بحسب ظروف كل بلد.
اخترت الموضوعات الخمسة التي يتناولها المقال لأنني أرى فيها المداخل الرئيسة لفهم التحديات التي تعوق وجود حياة ثقافية متنوعة ونشطة في معظم بلاد المنطقة. وهناك سؤال مضمر يرتبط بهذه الموضوعات: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الإبداع والإنتاج الفني والثقافي في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي التي بدأت خلال هذه السنوات العشر، والتي قد تمتد لعقود قادمة؟ هذا السؤال يحمل أيضاً في طياته أسئلة أخرى كثيرة حول تأثير عملية التغيير الاجتماعي في الإبداع والإنتاج الفني والثقافي.
من الهام قبل الدخول في الموضوعات الخمسة النظر في الخلفية العامة للمشهد الثقافي العربي والتي شهدت تحولات كبيرة خلال الأعوام العشرة الماضية. من أبرز هذه التحولات توسع دور المنظمات العربية الثقافية غير الحكومية مثل المورد الثقافي والصندوق العربي للثقافة والفنون[2] اللذان لعبا دوراً أساسياً في تنشيط الحياة الثقافية في المنطقة، سواء عن طريق تقديم فنانين وأعمال فنية جديدة، أو تشجيع التبادل والتعاون بين فنانين ومؤسسات ثقافية مستقلة خارج الإطار الرسمي، أو إغناء هذه الحياة بأبحاث ومعلومات ومهارات كانت قليلة أو غائبة.
تعمل المنظمتان اللتان لا تحصلان على دعم يذكر من أي من الحكومات العربية بآليات عمل وحوكمة تشبه إلى حد كبير المنظمات الثقافية الدولية، وتتسع الأنشطة والبرامج التي تقومان بتنفيذها بشكل مطرد سنوياً. ساهم عمل هاتين المنظمتين بشكل غير مباشر في نشوء عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الثقافة في بلدان عربية مختلفة، كما نتج عنه تحسن في مستوى الحضور الثقافي العربي خارج المنطقة العربية، والذي كان يقتصر على الأعمال والفنانين المرتبطين بالمؤسسات الثقافية الرسمية، أو قلة من الفنانين المعروفين لدى منظمي المهرجانات في الغرب.
من الظواهر الهامة أيضاً خلال هذا العقد الاعتراف الواسع من قبل الفنانين والمثقفين، وحتى من قبل المؤسسات الثقافية العربية الرسمية، بما يسمى ب “القطاع الثقافي المستقل”، ويعني مجمل المنظمات والجمعيات والمؤسسات الربحية وغير الربحية التي تعمل في مجال الثقافة والفنون بشكل مستقل عن الأجهزة الحكومية.
ورغم أن هناك بلداناً في المنطقة مثل لبنان وفلسطين، يعتبر فيها هذا القطاع هو اللاعب الرئيسي في مجال الثقافة، إلا أن بلداناً أخرى مثل مصر وسوريا والجزائر والآردن، لم تشهد طفرة في عدد وتأثير المنظمات والمؤسسات الثقافية المستقلة سوى في العقد الماضي.
من اللافت أيضاً نشوء عدد من المنظمات المستقلة الفعالة والمؤثرة في بلدان تفتقر إلى الحياة الثقافية النشطة، أو في ظروف استثنائية وصعبة مثل الحرب والتهجير، مثل سودان فيلم فاكتوري في السودان الذي يرعى المواهب السينمائية الشابة وينظم مهرجاناً سينمائياً دولياً في بلد يعاني من تحديات سياسية واجتماعية شديدة الصعوبة، ودار السينمائيين الموريتانيين في موريتانيا،
وما تفرع عنه من مجموعات ومؤسسات ثقافية شبابية تشكل الجسم الرئيسي للحركة الثقافية في موريتانيا، و مثلهم مؤسسة أريتي في ليبيا وشركة هيومان فيلم في العراق، ومؤسسة اتجاهات التي تعمل من لبنان لدعم الفنانين والباحثين الثقافيين السوريين. صارت هذه المنظمات، ومثيلاتها، بمثابة المحرك الرئيسي في مجال الثقافة في بلدانها، رغم الجدل المثار دائماً حول معنى الاستقلال ومعاييره.
من ملامح المشهد أيضاً، تنامي الدور الثقافي لدول الخليج العربي، ونشوء مهرجانات وفعاليات ثقافية هامة وصناديق تمويل مرتبطة بها، في مجال السينما بالتحديد، وتأسيس مدارس للفنون ومتاحف كبرى في الخليج في إطار تعاون وثيق، ذي طابع تجاري في الغالب، مع مؤسسات أوروبية وأميركية كبرى،
مثل جائزة البوكر العربية وأكاديمية نيويورك للسينما في ابو ظبي ومتاحف اللوفر وجوجنهايم في أبو ظبي. ومن التفسيرات الشائعة لتنامي الدور الثقافي لدول الخليج هو أن هذا يندرج ضمن استراتيجية هذه الدول لسنوات ما بعد البترول، والتي قد تلعب فيها السياحة الثقافية دوراً هاماً.
هناك كذلك الطفرة التي حدثت في المساعدات الدولية في مجالات الثقافة وأبرزها مساعدات الاتحاد الأوروبي على مستوى البلد الواحد أو في الإطار الأورومتوسطي، وتأسيس مؤسسة أنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات[3]، وتوسع أنشطة هذه المؤسسة في مجالات الثقافة والفنون وعلى الأخص برامج التبادل الثقافي مع أوروبا، بالإضافة إلى مجالات اجتماعية وسياسية أخرى.
باختصار، أدت كل هذه التحولات إلى خروج العمل في الفنون والثقافة من قمقم وزارات الثقافة الذي كان محبوساً فيه منذ بداية أنظمة الاستقلال الوطني في الستينيات، ورافق هذا الخروج زيادة الوعي بمفاهيم كانت تعتبر غامضة أو غير معروفة في المنطقة مثل الإدارة الثقافية والحوكمة الثقافية والسياسات الثقافية.
الموضوعات الخمسة التي يتناولها المقال، ليست مرتبطة ببعضها بشكل منطقي متسلسل، ولكنها معاً، مثل لوحات الفسيفساء، ترسم صورة الحياة الثقافية في المنطقة، وتطرح الأسئلة الأساسية حول مستقبل هذه الحياة.
يتناول المقال أولاً موضوع حرية التعبير الفني والأدبي، وهو موضوع قديم متجدد، سجل العقد المنصرف طفرة في الوعي بأهميته، واكبت ولحقت موجة التغيير السياسي التي بدأت في 2011، بالإضافة إلى اهتمام المنظمات الحقوقية بهذا المجال وتخصص بعض المنظمات في الدفاع عن حرية التعبير الفني والأدبي.
الموضوع الثاني هو بروز اتجاهات جديدة في الإبداع والانتاج الفني، مع القاء الضوء على بعض الأعمال والتظاهرات والمبادرات الفنية المرتبطة بهذه الاتجاهات. بعض هذه الاتجاهات الجديدة ليس جديداً تماماً، ولكنه برز بشكل مؤثر وملموس خلال هذا العقد، مثل الشيوع النسبي لمفهوم “الفنون المعاصرة” ضمن المجال الفني للفنون البصرية.
يأتي الموضوع الثالث أكثر خصوصيةً وتحديداً وهو موضوع الفن تحت وطأة الصراع، والذي يتناول تأثر شروط ومضامين الانتاج الفني بالتغييرات السياسية الكبيرة في المنطقة، وما تبعها من حروب وعنف وتهجير، والتوقعات بتأثير هذه التغييرات في المستقبل.
الموضوع الرابع هو اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز كافة أشكال التعبير الثقافي الصادرة في 2005، والتي رأيت أنه من الهام تناولها رغم أنها لا تخص المنطقة العربية وحدها، نظراً لأن ستة عشرة دولة من الدول الإثنين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية قد وقعت على هذه الاتفاقية التي تلزم الدول المنضمة إليها بسن قوانين وتشريعات، واتخاذ اجراءات تهدف إلى دعم وتشجيع الانتاج الفني والثقافي.
أما الموضوع الخامس الذي يتناوله هذا المقال، فهو السياسات الثقافية السائدة والمستجدة في بعض البلدان العربية، سواء تلك الرسمية التي تسنها وتدعمها الحكومات، أو تلك التي تكتسب شرعيتها من الممارسة، كما يرصد المبادرات التي يقوم بها فنانون وناشطون ثقافيون لتطوير هذه السياسات.
في خاتمة هذه المقدمة أود التأكيد على أن هذا المقال يعبر عن آرائي وخبراتي الشخصية، تدعمها آراء عدد من المشتغلين بالفنون والثقافة في المنطقة. لا يدعي المقال تقديم وصف موضوعي أو محايد للقضايا التي يتناولها، أو اجابات مكتملة على الأسئلة التي يطرحها الواقع الثقافي، بل يسعى إلى الاشتباك النقدي مع هذه الموضوعات الخمسة بهدف طرح أسئلة مفتاحية أدعو القارئ إلى التفكير فيها وتلمس الإجابة عليها.
- ١- حرية التعبير والإبداع الفني
في شهر أغسطس 2016 أحرق الفنان التشكيلي اليمني أيمن عثمان إحدى لوحاته علناً، احتجاجاً على رفض وزارة الثقافة اليمنية منحه ترخيصاً لإقامة معرض للوحاته[4]. هذا الفعل الاحتجاجي الذي قد يراه البعض متطرفاً، أتى تعبيراً عن يأس الفنانين في بلد يعاني منذ عقود من القمع السياسي والفساد والصراعات القبلية والطائفية،
وفشل المنظومة الثقافية الرسمية في القيام بأي دور فعال في نشر السلم الأهلي، أو تقبل الاختلاف بين اليمنيين، أو احترام الإبداع الفني. يتمزق هذا البلد الذي يمر اليوم بأسوأ فترة في تاريخه الحديث، بين ضربات عسكرية خارجية دمرت بنيته التحتية المتهالكة أصلاً، وجزءاً هاماً من مبانيه الأثرية، وبين عنف وتدمير عصابات طائفية مسلحة متشددة ومعادية للحقوق والحريات. في هذا المناخ المفزع، يبدو التعدي على عمل فني أو أدبي أمراً عادياً، بل ومقبولاً لدى الكثيرين.
حالات المنع والمصادرة، والسجن والإعتداء الجسدي أحياناً، التي حدثت خلال العقد الماضي كثيرة جداً، منها المشهور مثل قضية الشاعر أشرف فياض الذي ما يزال يقضي حكما بالسجن في السعودية، بعد ان خفف الحكم عليه بالإعدام، والروائي أحمد ناجي الذي حكم عليه بالسجن عامين في مصر والمغني رامي عصام في مصر الذي قبض عليه من قبل الجيش وعذب، ثم منع من أداء أغانيه واضطر إلى مغادرة البلاد، ومنع عرض فيلم “الزين اللي فيك” لنبيل عيوش في المغرب الذي يتناول قضية الدعارة، والإعتداء على المعرض الفني في العبدلية في تونس من قبل جماعات اسلامية متطرفة، ومنها ما ليس معروفاً مثل منع توزيع رواية “بنات الرياض” لرجاء الصانع في السعودية في 2006، ومنع نشر رواية “وجهان لجثة واحدة” للأزهر الصحراوي في تونس عام 2007، ومنع رواية “فئران امي حصة” في الكويت عام 2015، ومنع أغنية “مطلوب زعيم” لفرقة كايروكي في مصر عام 2012،
ومثل منع الفعالية الشهرية “الفن ميدان” في مصر اعتباراً من اغسطس 2014، ومنع رواية “جريمة في رام الله” من قبل السلطة الفلسطينية مؤخراً، ومنع العمل المسرحي “بتقطع أو ما بتقطع” الذي يسخر من الرقابة في لبنان عام 2013، وكذلك منع فيلم “لي قبور في هذه الأرض” لرين متري في لبنان عام 2015، ومثل حالات سجن الشعراء المتكررة في قطر والبحرين والسعودية.
ليست حالات منع ومصادرة الأعمال الفنية والأدبية جديدة، ولا يبدو أنها زادت أو نقصت خلال العقد الماضي، ولكن ما يبدو أنه زاد هو الوعي بها، أو على الأصح الوعي بأهمية حرية الإبداع والتعبير الفني. ليس من السهل التدليل على هذه الفرضية، ولكن في حالة الفنان أيمن عثمان على سبيل المثال، اتسع التضامن معه ليشمل مئات من اليمنيين ،من مهن وطبقات متنوعة، الذين وقعوا بياناً يستنكر منع معرضه.
تبدو لي هذه الحادثة ذات دلالة، بالذات في وضع اليمن المتردي حالياً، إذ غاب رد الفعل المعتاد الذي كان يتهم الفنانين بلعب دور الضحية وبالمبالغة في الشعور بالاضطهاد. على مستوى آخر، لعب النقاش المجتمعي المفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها شيوعاً في المنطقة هو الفيس بوك، دوراً هاماً في طرح هذه القضية للنقاش في حالات حساسة بعينها، مثل حالة منع فيلم “حلاوة روح” لهيفاء وهبي في مصر، حيث دافع الكثيرون عن عرض الفيلم رغم اعتراضهم على مستواه الفني.
وعلى الرغم من هذا، لا يمكن القول أن حرية الإبداع الفني وصلت إلى أن تكون قضية مركزية على المستوى السياسي في أي بلد عربي. ما زالت هذه القضية تطرح كجزء من قضية حرية التعبير بشكل عام، وعادة ما يتحول النقاش حولها إلى قضية حرية الصحافة والإعلام، وهي قضية ينظر إليها على أنها أكثر أهمية في معظم بلدان المنطقة.
يستلزم الأمر تمعناً في طبيعة ونوع حالات التعدي على حرية الإبداع والتعبير الفني، إذ إنها ليست كلها نتيجة لنفس الأسباب. هناك حالات مارست فيها أجهزة الدولة تعدياً مباشراً، عادة ما استند إلى نصوص قانونية، سواء بمصادرة كتب، أو بمنع أعمال من العرض أو التصوير.
هذه الحالات ليست هي الأكثر عدداً، وإن كانت الأعمق تأثيراً، كون أجهزة الدولة وقوانينها تعبر عن الجوهر القمعي لفلسفة الانظمة السياسية والاجتماعية. كثيراً ما جاءت مثل هذه الحالات لأسباب دينية مثل منع الأزهر لإعادة نشر رواية “سقوط الإمام” لنوال السعداوي عام 2008. ويمارس الأزهر، وهو السلطة الدينية الرسمية في مصر، دوراً رقابياً معروفاً، إذ يقوم بمنع دخول روايات عربية وأجنبية إلى مصر،
وكذلك منع عرض أفلام بعينها، خصوصاً إذا كانت تتناول قصص حياة الأنبياء مثل فيلم “نوح”. لكن معظم حالات منع الأعمال الفنية والأدبية من قبل السلطات الرسمية في البلدان العربية تأتي لأسباب سياسية، مثل اختطاف الأجهزة الأمنية للفنان رشيد غلام، منشد جماعة العدل والإحسان في المغرب، وتعذيبه عام ،2007[5]، ومنع دخول كتاب “جدران الحرية” المنشور في ألمانيا والذي يوثق لثورة يناير في مصر، من قبل أجهزة الجمارك المصرية في 2015،
ومثل منع عرض فيلم Vote Off في الجزائر في نوفمبر 2016 بسبب تناوله لقضية مقاطعة الناخبين للإنتخابات الرئاسية. هناك كذلك حالات للمنع والمصادرة نتجت عن دعاوي قانونية رفعها مواطنون، أحيانا بإيعاز من أجهزة رسمية، أو جماعات دينية، مثل حالة الروائي أحمد ناجي في مصر الذي قام أحد المواطنين برفع دعوى ضده بتهمة “خدش الحياء العام” في روايته “استخدام الحياة”، وحكم عليه بالسجن عامين بهذه التهمة في عام 2016[6].
أما حالات المنع والمصادرة والاعتداء غير القانونية، والتي تنتج عادة بسبب التشدد الديني أو تمسك المجتمع بقيم محافظة، أو المواقف السياسية المتعارضة، فهي كثيرة، وإن كان يصعب تحديدها وحصرها، لأن معظمها غير معلن على نطاق واسع، وغير موثق. من هذه الحالات: الاعتداء على المخرج التونسي نوري بوزيد في ابريل 2011، والاعتداء على سينما أفريكا في تونس العاصمة في شهر نوفمبر من نفس العام، وحملة التكفير التي تعرض لها الشاعر المغربي احمد عصيد في 2013.
تندرج تحت هذه الحالات الحالة الإشكالية لمعرض الفنان يوسف عبدلكي في دمشق في نهاية عام 2016، فرغم أن المعرض لم يتعرض للمنع، إلا أن الفنان تعرض إلى حملة مضادة كان يمكن أن تؤدي إلى التأثير سلباً على جمهور المعرض والفنان، كما أنها كانت يمكن أن تعرض سلامة الفنان للخطر.
يوسف عبدلكي وهو أحد أشهر الفنانين السوريين المعاصرين، معارض يساري معروف للنظام السوري الحاكم، وقد اعتقل من قبل، واضطر إلى الإقامة في فرنسا لأكثر من عقدين صودر خلالها جواز سفره، أقام عبدلكي في ديسمبر 2016 معرضاً في قاعة خاصة في دمشق بعنوان “عاريات”، ضم مجموعة من أحدث لوحاته تصور الجسد الأنثوي العاري.
أثار افتتاح المعرض نقاشاً حاداً، ليس فقط بين النقاد والفنانين كما جرت العادة، بل تعدى النقاش إلى الشباب المنخرط في الحراك السياسي السوري داخل وخارج سوريا. ولا شك أن شهرة الفنان وتاريخه كمعارض للنظام السياسي قد ساهما في اتساع النقاش وحدته. تباينت المواقف حول المعرض، الذي دعا البعض إلى مقاطعته إعلامياً،
فكانت هناك أراء تهاجم اختيار الفنان للعرض داخل العاصمة السورية في وقت كانت فيه قوات النظام تهاجم مدينة حلب بضرواة، ورأت في هذا الاختيار دعماً للنظام السوري ولصورته أمام العالم، وكانت هناك أراء تقول إن اقامة المعرض في دمشق هي فعل من أفعال المقاومة نظراً لمواقف الفنان المعروفة والمعارضة للنظام، وكذلك كانت هناك أراء تقول بأن اختيار الجسد الأنثوي العاري كموضوع للمعرض هو في حد ذاته رسالة بان الفنان يقف مع النظام ضد المعارضة الإسلامية، بل ضد أغلبية المجتمع المحافظة.
إذاً، تمحور النقاش حول 3 نقاط: 1- حق الفنان في أن يقدم إبداعاته في المكان والزمان الذي يختاره، 2- دور الفن في معارضة أو خدمة الأنظمة السياسية، 3- علاقة المحتوى الفني بالسياق الاجتماعي والسياسي. لولا تلاحق الأحداث السياسية والعسكرية الخاصة بسوريا، لكان ممكناً أن يحظى هذا النقاش الهام بمزيد من الاهتمام، ليس فقط من السوريين وحدهم، بل من النخبة الثقافية والفكرية العربية بشكل عام، إذ إن هذه الحالة ربما تحتوي على كل العناصر اللازمة لمناقشة موضوع حرية التعبير الفني.
على النقيض من منع الأعمال الفنية والأدبية، والتعدي على الأشخاص، وحملات التكفير والتشهير والمقاطعة، حدث خلال الأعوام القليلة الماضية تغيير ايجابي بشكل عام في البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالإبداع الفني.
وعلى الرغم من التفاوت الشاسع بين النصوص التشريعية والقانونية وبين واقع الحال، إلا أنه من المفيد النظر في هذه التغيرات. في مصر صدر دستور جديد في عام 2014 أكد في بابه الأول على المقومات الثقافية للدولة، ونص في المادة 48 على حق المواطن في الثقافة، والزام الدولة برعاية الفنون والآداب، وفي المادة 67 على حرية الإبداع الفني والأدبي، رغم أن نفس المادة حملت نصاً يتيح للنيابة العامة تحريك الدعاوي لمنع او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية.[7]
وفي مصر أيضاً تم تعديل قانون الرقابة على المصنفات الفنية، بإضافة نظام التصنيف العمري إلى هذا القانون، كما صدر قرار من وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات الفنية، وهو قرار يهدد حرية الإبداع الفني بشكل مباشر ويتعارض مع الدستور.
وفي اليمن جاءت وثيقة الحوار الوطني الصادرة في 2014 لتتضمن نصوصاً تدعم شرعية ممارسة الفنون[8] وتؤكد على أهمية الثقافة والتنمية الثقافية في التنمية[9]وحماية الإبداع ورعاية الفنون وصون التراث، وضرورة وضع خطة شاملة للثقافة اليمنية.
يعزز هذه النصوص ما جاء في مسودة الدستور اليمني المنشورة في 2015، في المواد 64 و86. ورغم عدم وجود نص صريح في هذه الوثيقة لحماية حرية الإبداع والتعبير الفني، إلا أن ما جاء في هذه النصوص يعد طفرة تشريعية غير مسبوقة في اليمن منذ توحيده عام 1990.
وفي المغرب، يؤكد دستور 2011 في فصليه 25 و26 على حرية الإبداع والنشر والعرض، وعلى دعم الإبداع الثقافي والفني، وفي الفصل 33 على مشاركة الشباب في التنمية الثقافية والاجتماعية. في تونس ينص دستور 2014 بوضوح في فصله 42 على حرية الإبداع وعلى الحق في الثقافة.
لا يبدو إذاً أن المشكلة الحالية في حماية حرية الإبداع والتعبير الفني تكمن في النصوص القانونية والدستورية، وإن كان بعضها يحتمل تأويله بشكل يحد من حرية الإبداع، ولكن تبدو المشكلة في غياب أليات اجتماعية و إرادة سياسية لتفعيل هذه النصوص، في مجتمعات تغلب عليها المحافظة الاجتماعية والتفسير المتشدد للتراث الديني،
قد لا يكون تأسيس واستخدام مثل هذه الآليات سهلاً، ولكن يمكن المقارنة مع موضوعات عامة أخرى فيها قدر كبير من الإشكالية مثل الزواج المبكر أو ختان الإناث[10]، التي أدى تفعيل أليات سياسية واجتماعية بخصوصها إلى إحداث تغيير ايجابي، حتى على مستوى الوعي العام.
في رأيي أن الطريق الأضمن لحماية حرية الإبداع والمبدعين هو الربط بينهما وبين الحق في الثقافة، وهما مرتبطان فعلاً بشكل جوهري، وإن فصلت بينهما عقبات أرستها سنوات من عزلة الفنانين عن المجتمع، وكذلك الأمية وغياب الخدمات الثقافية عن عموم المواطنين. يبدو لي أن طرح قضية حرية الإبداع والتعبير الفني كحق للمبدعين فقط، يحمل انتقاصاً من حق غير المبدعين في تلقي الإبداع الفني والتفاعل معه، كما يعرّض القضية للتهميش في نفس الوقت.
ليس هذا الربط سهلاً، على الأخص في مجتمعات تتبنى قيماً محافظة ومعادية للحريات، ولكنه يضمن على المدى الطويل، أن تتبنى مجتمعاتنا قيمة الحفاظ على حرية التعبير باعتبارها حقاً من حقوقها، وليست ترفاً يخص مجموعة صغيرة من المبدعين، ولا تهديداً لهويتها الثقافية.
٢- اتجاهات جديدة في الإبداع والانتاج الثقافي العربي
هناك اختلاف كبير بين بلدان المنطقة في تقدير ما هو “جديد”، إذ يبدو مثلاً فن “التحريك السينمائي” جديداً في بلد مثل موريتانيا، بينما هو موجود في بلاد أخرى في المنطقة منذ الستينات من القرن الماضي على الأقل. من ناحية أخرى، وبافتراض التقارب والتبادل الثقافي بين بلدان المنطقة سأركز في هذا الجزء على ما هو جديد في المنطقة بشكل عام، والذي ربما بدأ ظهوره في تسعينات القرن الماضي أو في مطلع الألفية الثانية، ولكنه لم يظهر بشكل واضح كاتجاه فني جديد سوى في الأعوام العشرة الماضية.
1- الفنون المعاصرة:
هناك بغض الغموض والجدل يحيطان باستخدام هذا المصطلح في بلدان كثيرة، ويبدو الطريق الأوضح للتعرف على هذا الاتجاه هو من خلال الأعمال الفنية التي يقول أصحابها أنها تنتمي إليه، مثل أعمال وليد رعد من لبنان، ومنى حاطوم من فلسطين، ومعتز نصر من مصر، و حسن دارسي من المغرب. وعلى الرغم من أن هذه الأعمال تختلف فيما بينها كثيراً،
إلا أن ملامحها المشتركة قد توضح ماهية الفن المعاصر: موضوع اجتماعي أو سياسي هام وحاضر، مزج بين الأدوات والوسائط الفنية من رسم وتصوير ونحت وفيديو وغيرها، استخدام للعناصر الصوتية والآدائية أحياناً، في فراغ (قاعة، حديقة، ممر) يعد لهذا الغرض، وجراة تصل أحيانا إلى حد الصدام مع ثوابت اجتماعية أو سياسية.
ليس هناك تاريخ محدد لبدء ظهور هذا النوع من الإبداع الفني في المنطقة، وعلى الأرجح أن الأعمال الأولى بدأت في أوائل تسعينات القرن الماضي، ولكن يمكن القول بقدر كبير من الاطمئنان أن هذا الاتجاه الإبداعي أصبح حاضراً بقوة في مشهد الفنون البصرية في المنطقة منذ حوالي عشرة أعوام. إذ تقلصت تدريحياً معارض الفنون التشكيلية التقليدية من رسم ونحت، واتجه عدد من الفنانين المعروفين بإنتاجهم في هذين النوعين، إلى تجربة التجهيز الفني في الفراغ art installation.
من الهام ملاحظة الدور الذي لعبته فعاليات فنية مفتاحية في المنطقة في تقديم ونشر هذا الإتجاه الإبداعي. من أهم هذه الفعاليات “أشغال داخلية” الذي تنظمه جمعية “اشكال ألوان” في بيروت منذ عام 2002 ، والذي قدم عبر دوراته السبع معظم الفنانين المعاصرين العرب، إلى جوار فنانين عالميين. ولا يقتصر برنامج “أشغال داخلية” على الفنون المعاصرة التي تركز على الجانب البصري،
إذ يقدم أعمالاً من نفس الإتجاه تنتمي إلى فنون الآداء المختلفة، وجلسات للحوار والنقاش في موضوعات سياسية واجتماعية وثقافية. بالإضافة إلى “أشغال داخلية”، قامت فعالية أخرى بدور مماثل على نطاق اقليمي ودولي، وهي فعالية “نقاط لقاء” التي نظمتها مؤسسة صندوق شباب المسرح العربي YATF التي تغير اسمها مؤخراً إلى “مفردات”.
قُدمت “نقاط لقاء” كفعالية تضم أعمالاً من الفنون المعاصرة، ونقاشات ومحاضرات، ثمان مرات في مدن عربية وأوروبية بشكل متزامن أو متسلسل، ابتداء من عام 2002، ورغم طابعها الدولي فقد حضر في برنامجها عدد كبير من الفنانين المعاصرين العرب.
ويعد بينالي الشارقة أكبر الفعاليات الثقافية المخصصة للفنون المعاصرة في المنطقة، ورغم أن بدايته في تسعينات القرن الماضي كانت كبينالي للفنون التشكيلية التقليدية، إلا أن حور القاسمي، إبنة الأمير سلطان بن محمد القاسمي أعادت خلق البينالي كمنصة دولية للفنون المعاصرة اعتباراً من عام 2005. ومنذ ذلك الوقت قدم البينالي في دوراته الستة مئات الفنانين المعاصرين والنقاد والكتّاب،
وكرّس لنفسه موقعاً هاماً على المستوى الدولي. ساعد في بناء هذه المكانة الميزانية الكبيرة المخصصة له من قبل مؤسسة الشارقة للفنون، والتي تتيح تكليف عدد كبير من الفنانين بإنتاج أعمال تنتمي إلى الفن المعاصر، وتعتبر هذه القدرة على تكليف الفنانين بإنتاج أعمال جديدة هي الميزة التي تنقص معظم المؤسسات الفنية العربية الأخرى التي تعمل في نفس المجال.
يطرح هذا الاتجاه الإبداعي عدة أسئلة نقدية، بل واقتصادية. السؤال الأول متعلق بما إذا كان التوجه السياسي والاجتماعي لمعظم هذه الأعمال سيجعلها أقرب للذائقة الشعبية، وأكثر جماهيرية، من الفنون التقليدية مثل الرسم والنحت. كان يمكن بسهولة الإجابة على هذا السؤال بنعم، لولا أن تاثر الكثير من الفنانين العرب الذين يبدعون بهذه الطريقة، بالثقافة الغربية أدى إلى أن تبدو اللغة الفنية التي يستعملونها مستعارة من سياقات اجتماعية أوروبية وأميركية،
ولا تعني الرموز الواردة من هذه السياقات نفس الشيء في بلدان المنطقة، ولولا أن السياق الثقافي الذي تقدم فيه هذه الأعمال، هو سياق نخبوي، فهي تقدم عادة في تظاهرات وجاليريهات لا يرتادها معظم الناس، وكثيراً ما تكون الدعاية عنها بلغات أجنبية. السؤال الثاني يتعلق بكون هذه الأعمال غير قابلة عادةً للإقتناء،
وبالتالي فجدواها الاقتصادية غير واضحة، أو معتمدة على تمويل حكومي أو خاص، وهي بذلك تقترب من كونها “أحداثاً” فنية عن كونها “منتجات فنية”. وفي غياب مؤسسات أهلية فنية كبيرة في معظم البلدان العربية على غرار المتاحف الكبرى في الغرب التي تمول مثل هذه الأعمال، يعاني الفنانون من قلة الموارد المحلية لإنتاجها،
وبالتالي تتركز أغلب معارضهم خارج المنطقة العربية. السؤال الثالث، وهو الأصعب، هو موقعها النقدي التاريخي في سياق تطور الفنون البصرية، إذ ليس من السهل تتبع تطورها منذ نشأتها حتى الآن، ولا تبدو سماتها الفنية قابلة للتمييز بينها بوضوح، مثلما هو الحال مع فن النحت على سبيل المثال، إذ يستخدم كل الفنانين مواداً وعناصر ورموزاً على قدر من التشابه، كما يصعب جداً التنبوء بما ستخلفه في الوجدان الثقافي لشعوبنا، أو بالأساليب الفنية التي يمكن أن تنتج عنها.
2- عودة الفن “الملتزم”:
شهد النصف الثاني من القرن العشرين، بالذات في الخمسينات والستينات منه مولد ما سمي ب”الفن الملتزم”، وهو تعبير ارتبط بفرق موسيقية وغنائية قدمت أغان ذات مضمون سياسي واجتماعي معارض للأنظمة ومؤيد للقضية الفلسطينية. كلنا يعرف الأمثلة: الشيخ إمام، مارسيل خليفة، ناس الغيوان، خالد الهبر وغيرهم كثيرون. ولكن ما أن حلت التسعينات حتى بهت بريق هذا النوع من الفن، وأصبح يقدم كوجبة باردة لزبائن لا شهية لديهم. في نهاية الألفية الأولى بدا وكأن هذا النوع من الفن قد انتهى أمره، وأنه كان مرتبطاً بصعود الفكر القومي واليساري في المنطقة في فترة بعينها.
ولهذا لم يكن متوقعاً ظهور فرق مثل فرقة اسكندريلا الموسيقية في مصر عام 2005، وفرقة زقاق المسرحية في لبنان عام 2006، ثم مجموعات فناني الجرافيتي التي تكونت أثناء وعقب ثورة يناير في مصر، ومن أهم فنانيها عمّار أبو بكر، ومجموعات فنية تونسية مثل “فني رغماً عني”، و”أهل الكهف” التي توقفت بعد بدايتها بأعوام قليلة.
تميزت هذه المجموعات عن أسلافها من القرن السابق بأنها حاولت أن يترافق في أعمالها الإلتزام بقضية سياسية أو اجتماعية مع التطوير الفني، أو على الأقل محاولة تقديم أعمال على مستو فني عال.
رغم أن فرقة اسكندريلا تأسست في مصر عام 2005، إلا أنها لم تصبح فرقة مشهورة إلا منذ بدايات 2011، عندما حضرت في ميدان التحرير خلال الاعتصام الذي دام 18 يوماً قبل أن يضطر حسني مبارك إلى التخلي عن منصبه.
خلال الأعوام الثلاثة التي تلت الثورة، قدمت اسكندريلا ما يقرب من مائة حفل في الشوارع والميادين، إلى جانب المسارح وقاعات الموسيقى. اختار حازم شاهين، ملحن الفرقة وقائدها، كلمات أغلب أغانيها من أشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين، أيقونتي شعر العامية في مصر، وساهم الطابع الحماسي للكثير من أغاني اسكندريلا في انتشارها جماهيرياً، على الأخص خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
تأسست فرقة زقاق المسرحية في لبنان عام 2006 على يد مجموعة من الشباب الذي تخرج من قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة – الجامعة اللبنانية، منهم عمر أبي عازار ومايا زبيب وجنيد سري الدين وغيرهم، وتتبع أسلوباً تشاركياً في إدارة الفرقة.
اتجهت الفرقة منذ بدايتها إلى أشكال مسرحية مرتبطة بالمجتمع مثل المسرح العلاجي ومثل استخدام المسرح في تقديم الدعم النفسي/الاجتماعي لفئات مهمشة أو متضررة، كما عالجت في كثير من أعمالها موضوعات سياسية. تدخل زقاق باستمرار في شراكات فنية دولية، وتجرب أساليب فنية متنوعة، وتستند بعض أعمالها إلى نصوص كلاسيكية أو تراثية، وتحافظ خلال هذا كله على توجهها الاجتماعي الواضح.
جاء تأسيس مجموعة “فني رغماً عني” في أغسطس 2011، كأحد تجليات تأثير الثورة التونسية في الممارسة الفنية، إذ تكونت المجموعة من شباب من خارج المركز الثقافي، منهم سيف الدين الجلاصي وعاطف حمداني وحمدي الجويني، يصفون أنفسهم بأنهم “أولاد شوارع”، ويحرصون في كل أعمالهم على التناقض مع الأشكال التقليدية في انتاج الفن.
تدخل معظم أعمال المجموعة في نطاق المسرح، ولكن الكثير من أعمالها تعتبر أنشطة سياسية واجتماعية أيضاً. من مباديء عملهم استخدام الشارع كمسرح ومنصة للنقاش، وكذلك العمل في مناطق لا مركزية.
لدى المجموعة العديد من المبادرات الفنية/الاجتماعية الهامة في تونس مثل “نحن هنا” الذي أسس مساحات فنية بديلة في المدارس الحكومية في المناطق النائية، ومثل “في مواجهة داعش” وهو سلسلة من الفعاليات الثقافية الساخرة تقدم في المقاهي والشوارع.
يقول بيان حركة أهل الكهف المؤرخ في 27 ديسمبر 2011 في تونس: “إننا نُفضّلُ أن نشارك الأطفال الرسم, والمجانين, والصعاليك, والسكّيرين والعربيدين… لأنَّ أولئك هم أهل الكهف. والفنُّ لا يأتي من النظرياَّت, بل يُولّدها. ثم يبول عليها حين يسكر من جديد”.
بدأت أهل الكهف كحركة فنية راديكالية بشكل سري قبل الثورة التونسية، على يد مجموعة من الفنانين التونسيين الشبان ثم عملت بعدها بشكل علني في الجرافيتي في شوارع المدن التونسية، ولكن عملها توقف تقريباً بعد 4 سنوات من تأسيسها.
يبدو الطرح النظري للمجموعة راديكالياً من الناحية النظرية، إذ يعلن قطيعة مع الأشكال الفنية السائدة، وحتى مع المقولات السياسية المعارضة، ويعتمد الصدمة الناتجة عن استخدام ألفاظ تعتبر بذيئة في أدبياته، ويرفض الانخراط في أي سياق مؤسسي أو اداري. في عام 2012 تعرضت المجموعة إلى منع عملها “اخراج” من العرض في مهرجان قرطاج السينمائي بسبب “تجاوزه الحدود”، وأستدعى هذا تضامناً محدوداً مع المجموعة من قبل عدد من الفنانين التونسيين والعرب. بنهاية عام 2014 بدا وكأن عمل المجموعة قد توقف، وإن لم تصدر إعلاناً بذلك.
في نفس عام تأسيس أهل الكهف، 2011، ظهرت في مصر مجموعات متفرقة من رسامي الجرافيتي، نشطت في القاهرة والاسكندرية بشكل أساسي خلال الصدامات المتكررة مع الشرطة والجيش التي استمرت حتى نهاية 2013. من الملامح المثيرة للإنتباه في هذه المجموعات أنها ضمت فنانين درسوا الفنون في كليات متخصصة إلى جانب هواة بعضهم لم يمارس الفن من قبل، كما أنها – في سابقة اجتماعية – ضمت فتيات اشتهر بعضهن بعد ذلك مثل أية طارق.
الملمح الفني الهام هو توسع الكثير من هذه المجموعات في تعبيرها البصري إلى ما وراء الأسلوب المعتاد لفن الجرافيتي الذي يعتمد على استخدام حروف اللغة وكلماتها. بدا وكأن الكثير من هؤلاء الفنانين يتعاملون مع حوائط المباني كجداريات يرسمون عليها لوحاتهم.
برزت من بينهم أسماء عرف بعضها لاجقاً على نطاق دولي مثل “جنزير” و “التنين” وغيرهم. توقف عمل هذه المجموعات تدريجياً بسبب مطاردة الشرطة والجيش لهم، حتى انتهى تقريباً في عام 2014. ورغم أن السلطات قد أزالت معظم أعمال الجرافيتي من شوارع القاهرة والاسكندرية، إلا أن هذه الأعمال شاهدها الملايين، ووثقت في عشرات الكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية.
من أهم فناني الجرافيتي الذين تصدروا المشهد الفني خلال الفترة من 2011 وحتى 2016، عمّار أبو بكر الذي تخرج من كلية الفنون الجميلة في الأقصر، وتمزج أعماله بين تراث الرسم الشعبي المصري، وجماليات الجداريات الأوروبية الكلاسيكية، مع رسائل سياسية صادمة ومباشرة، وعلاء عوض، وهو ايضاً متخرج من كلية الفنون الجميلة، وتميزت أعماله باستلهام التراث البصري الفرعوني، وبرسائل سياسية فيها قدر من العاطفية وبعض الغموض.
هناك اختلافات فنية كبيرة بين كل هذه التجارب، ولا يجمعها سوى التزامها بالتعبير عن موضوعات وقضايا سياسية واجتماعية، ومعارضتها بشكل عام للأنظمة السياسية وللتيارات الاجتماعية المحافظة، تختلف أيضاً في أسلوب التعبير عن هذا الالتزام، إذا يقتصر هذا الالتزام لدى بعضها على نقل رسائل سياسية واجتماعية واضحة، ويتعداه لدى البعض الآخر إلى الانخراط فعلياً في العمل الاجتماعي والسياسي.
ربما لن تستمر هذه التجارب كثيراً، مثل أسلافها في القرن الماضي، ولكنها بالتأكيد ستترك أثراً باقياً على تصور المجتمعات العربية لدور الفن والفنانين، وعلى تصور الفنانين عن علاقتهم بالقضايا الاجتماعية والسياسية، ربما بشكل أعمق مما حدث سابقاً، نظراً لمواكبتها لعملية التغيير السياسي والاجتماعي التي بدأت في 2011.
3- كيف ولمن تقدم الفنون؟ – فعاليات فنية لها طابع مختلف:
شهدت السنوات العشر الماضية مولد عدة فعاليات فنية تقام سنوياً في مدن عربية مختلفة، لا تشبه المهرجانات العربية المعتادة والتي تنظمها وزارات الثقافة في معظم البلدان العربية، او تلك السياحية التي تقام لجمهور وافد في البلدان الجاذبة للسياحة. جاءت تلك الفعاليات استجابة لاحتياجات اقتصادية أو اجتماعية أو فنية متباينة، ومستقلة عن الأنظمة السياسية. تمثلت الملامح المشتركة بين هذه الفعاليات في تبنيها لطرق حديثة في الإدارة الثقافية، وأساليب غير معهودة في التمويل.
بدأ المهرجان الموسيقي “البولفار” في الدار البيضاء في المغرب في أخر الألفية الماضية، كمبادرة مستقلة من مجموعة من شباب الموسيقيين، منهم محمد مرحاري (مومو) وهشام باجو، ولكن بدءاً من عام 2006، أصبح المهرجان الحدث الموسيقي الأهم في المغرب، وفي شمال أفريقيا، بالنسبة للشباب، واستقطب كل التجارب الموسيقية الشبابية في المنطقة العربية وأفريقيا، وبعض الفرق الأوروبية الهامة.
لم يقتصر “البولفار” على كونه مهرجاناً موسيقياً، بل سعى إلى أن يكون منصة للفنون الحضرية من جرافيتي وتصميم وسينما تجريبية. إتبع المهرجان أسلوباً تشاركياً في الإدارة إلى حد ما، واعتمد على تمويل من شركات تجارية خاصة، وهو الأمر الذي نافسه فيه مهرجان “موازين” شبه الرسمي الذي يحظى برعاية ملكية، ويقدم فنانين تجاريين ومكرّسين في مدينة الرباط القريبة.
نجح البولفار في خلق حركة فنية شبابية وليس مجرد مهرجان سنوي، إذ تنامت أعداد الفنانين الشبان المرتبطين به، ورغم معاناته الدائمة للحصول على موارد مالية، والتي أدت في بعض السنوات إلى الغاء المهرجان، ما زال البولفار قائماً، بل وأضاف إلى انجازاته تأسيس “بولتيك” وهو مركز لإنتاج وتسجيل الموسيقى الحديثة يقدم خدماته للموسيقيين الشبان بأسعار معقولة. يحسب للبولفار أيضاً قدرة مؤسسيه على إحداث توازن بين تقديم فرق وتجارب لها شعبية واسعة، وبين الحفاظ على مستوى فني عال عبر سنواته السبعة عشر.
تبدو تجربة البولفار ملهمة ومشجعة علي إعادة إنتاجها في بلدان أخرى، وهناك بعض المحاولات الشبيهة في مصر ولبنان، ولكن جزءاً غير قليل من نجاح البولفار يرجع إلى الزخم الموسيقي الشبابي في المغرب، وتميز فرقه الموسيقية، وتنوع أساليبها.
على الطرف النقيض من البولفار، ليس فقط من الناحية الجغرافية، وإنما في الشكل والمضمون، يأتي “آرت دبي”، أكبر “المعارض الفنية” في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أسيا، وواحد من أكبر المعارض الفنية في العالم. تأسس أرت دبي عام 2006، ويعد مكوناً أساسياً في خطة إمارة دبي في أن تكون محطة ثقافية سياحية وتجارية هامة على الخارطة العالمية.
ومن البداية ولد الحدث الفني برعاية مباشرة من حاكم إمارة دبي، وبشراكة استراتيجية مع “هيئة دبي للثقافة والفنون”، وبدعم ومشاركة تخطيطية وإدارية من اثنتين من أكبر المجموعات العقارية في المنطقة العربية: مجموعة أبراج ومجموعة إعمار. يمكن اعتبار أرت دبي حدث ثقافي ضخم، ورغم أن ميزانيته ليست معلنة، إلا أنه يمكن افتراض أنه واحد من أكثر الفعاليات الفنية تكلفة في العالم.
ويتكون أرت دبي من عدة مكونات ثابتة هي معرض لمعارض الفن المعاصر في العالم، ومعرض للفن الحديث يركز على أعمال مشاهير الفنانين من المنطقة العربية وأفريقيا وأسيا، وبرنامج للأعمال الفنية التي يكلف بها أرت دبي فنانين بعينهم، وبرنامج لمشاريع دعمها آرت دبي، ومنتدى الفن العالمي الذي يضم نقاشات بين متخصصين ونقاد، وإعلان جائزة مجموعة أبراج السنوية وإقامات فنية في دبي،
وبالطبع سوق فنية تعد من أكثر أسواق الفن مبيعاً في العالم، كل هذا في ثلاثة أيام فقط! الطبيعة التجارية للحدث جزء جوهري منه، ويحسب له اجتذاب جمهور – أو زبائن – لم يكونوا من قبل مهتمين بالفنون، مثل شريحة من الشباب العربي من الطبقات فوق المتوسطة الذين يعيشون في الإمارات ويعملون في شركات تجارية كبرى. ربما يكون التأثير الأهم لآرت دبي هو “صناعة الاتجاه الفني”، إذ أصبح تبني هذا الحدث الفني لفنان أو مجموعة فنانين، أو أسلوب فني معين، كافياً لجعلهم اتجاهاً فنياً رائجاً في المنطقة والعالم.
مهرجان القاهرة للفنون المعاصرة D-Caf نموذج ناجح للتوازن بين المحتوى الفني والمصالح التجارية، ربما بحكم موقعه في مدينة مثل القاهرة لا يمكن فيها تكرار نموذج أنيق ومكلف مثل آرت دبي. بدأ المهرجان في عام 2011 بدعم وتمويل من شركة الاسماعيلية، وهي شركة للتطوير العمراني أخذت على عاتقها مهمة ترميم وتجديد عدة مباني في وسط القاهرة،
بهدف إعادة استعمالها لأغراض سياحية وثقافية وتجارية جديدة. أتى المهرجان كجزء أساسي من هذه الخطة، ليعيد لوسط المدينة ألقاً ثقافياً بهت تماماً عبر السنين، ويضيف عليه بعداً حداثياً وعالمياً. تولى أحمد العطار وهو مخرج مسرحي ومدير ثقافي معروف إدارة المهرجان عبر شركة المشرق للإنتاج التي يديرها، وسعى منذ البداية إلى الفصل بين المهرجان وبين شركة الاسماعيلية،
ونجح في ذلك إلى حد كبير، خصوصاً مع قدرته على توفير تمويل للمهرجان من مصادر متنوعة، معظمها مؤسسات مانحة دولية واقليمية، وإصراره على السيطرة على القرارات الفنية الخاصة ببرنامج المهرجان، واستعانته بفريق من المبرمجين المحليين والدوليين.
يغلب على برنامج المهرجان عروض الفنون الأدائية: مسرح، ورقص، وموسيقى، ولكنه يقدم أيضاً عروضاً بصرية وتجهيزات تنتمي إلى الفن المعاصر. هناك تفاوت في المستوى الفني لبرنامج المهرجان من عام لآخر، إذا يجنح أحياناً إلى اختيارات سهلة ومكررة لفنانين موجودين بالفعل على الساحة ومعروفين،
ولا تقدم عروضهم في المهرجان جديداً يذكر، إلى جانب تقديمه لعروض مسرحية وعروض رقص هامة ولافتة. نجح مهرجان القاهرة للفنون المعاصرة كذلك في اجتذاب جمهور عريض ومتنوع، معظمه من شباب الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة، وفي اجتذاب عدد محدود من المبرمجين الدوليين. ليس واضحاً بعد ستة دورات من المهرجان تأثيره على المشهد الثقافي في مصر والمنطقة،
إذ يركز الحدث على الأسابيع الثلاثة التي يقدم فيها المهرجان، ولا تصاحبه أنشطة تعليمية ولا جلسات نقاش وحوار ذات تأثير كبير. يتبع المهرجان منذ تأسيسه أسلوباً إدارياً محكماً وهرمياً إلى حد كبير، ويعد واحداً من أفضل المهرجانات تنظيماً في مصر التي تعاني من سوء تنظيم معظم مهرجاناتها.
على بعد مئات قليلة من الأمتار من الأماكن التي يقدم فيها مهرجان القاهرة للفنون المعاصرة عروضه في وسط القاهرة، يقع ميدان عابدين، حيث قدمت أكثر من 30 دورة من المهرجان الفني الشعبي “الفن ميدان” خلال الفترة من ابريل 2011 وحتى أغسطس 2014، إذ كان المهرجان يقدم ليوم واحد في السبت الأول من كل شهر. تأسس المهرجان عقب الموجة الأولى لثورة يناير 2011، كمبادرة لتجمع لفنانين ومثقفين أطلق عليه اسم “ائتلاف الثقافة المستقلة”. ورغم أن هذا الائتلاف لم يستمر طويلاً، استمرت الفعالية وامتدت لتفرخ فعاليات شبيهة بنفس الإسم في عدد من المدن المصرية وصل في بعض الشهور إلى 14 مدينة.
كانت الفكرة بسيطة: فتح ميدان عام أو شارع أمام الفنانين من كل الأنواع والأجيال في السبت الأول من كل شهر، واستقطاب جمهور واسع بوسائل دعاية بسيطة وبدون مقابل مادي. كانت علاقة الفن ميدان بالثورة واضحة ومؤكدة منذ بدايته، وأصبح المهرجان الفني أيضاً مكاناً للإحتجاج السياسي والاجتماعي من قبل مجموعات شبابية متنوعة.
مثل المهرجان نموذجاً فريداً في الإدارة والتنظيم والتمويل، إذا لم تقم بتنظيمه مؤسسة ولا مجموعة من الفنانين وإنما مجموعة من المتطوعين الذين التقوا على هامش تظاهرات سياسية وثقافية أخرى، بعضهم له علاقة بالفن والثقافة والبعض الآخر تعرف على هذا المجال من خلال عمله التطوعي في الفن ميدان. كان فريق الفن ميدان في القاهرة يضم مهنيين، وفنانين معروفين،
ومدراء ثقافيين، وربات بيوت، وطلاباً جامعيين، ولم يكن الفريق ثابتاً في كل الشهور، وانما حافظ على استمراره نواة صغيرة من المتطوعين التي كانت تقوم بجمع التبرعات والاتصال بالفنانين المشاركين، والدعاية، والتعامل مع الأجهزة الأمنية والإدارية، والتجهيز التقني واللوجيستي.
اعتمدت الفعالية بشكل شبه كامل على تبرعات صغيرة من الأفراد، وحصلت أيضاً على دعم مالي من وزارة الثقافة في عام 2011، وكانت تنشر بانتظام تقارير مالية شهرية على صفحتها على الفيس بوك. في أغسطس 2014 منعت الفعالية لأجل غير مسمى من قبل الأجهزة الأمنية، وعلى ما يبدو أن علاقتها الوثيقة بثورة يناير والتي كانت سبباً في مولدها ونجاحها، كانت في الوقت نفسه سبب موتها.
تمثل الفعاليات الأربعة نماذج مختلفة وفلسفات ربما تكون متناقضة في الإدارة والتنشيط الثقافي، ولكنها أيضاً تعبر عن تيارات اجتماعية جديدة لم تعد ترى في مهرجانات وزارات الثقافة نموذجاً ذا جدوى. ربما ستستمر مهرجانات وزارات الثقافة لعقود قادمة، ولكن تأكل الجمهور من حولها، وانجذابه إلى فعاليات مثل تلك الأربعة سوف يؤدي في النهاية إلى انقراض مهرجانات الوزارات، وربما تلهم هذه التجارب الجديدة فعاليات أخرى أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها.
٣- الفن تحت وطاة الصراع
ستة أعوام تقريباً من الصراع المسلح في سوريا وليبيا، وأكثر من عامين مثلهما في اليمن، خلّفت وراءها، وما زالت تخلّف، مئات الآلاف من القتلى والمصابين، وملايين النازحين واللاجئين، وتدميراً يصعب حصره وإدراكه للقرى والمدن والبيوت والمدارس والمستشفيات، بل و التراث العمراني القديم والصروح الأثرية التي صمدت لآلاف السنين.
سبق هذا كله، استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وتصاعد القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني في أعقاب الانتفاضة الثانية في 2003، والذي بلغ ذروة غير مسبوقة في الحرب على غزة في 2008، واستمرار الاحتلال الأمريكي للعراق والصراعات المسلحة التي صحبته، والتي أفرخت أكثر التنظيمات الاسلامية المسلحة شراسة وتطرفاً حتى الآن: داعش.
التفاصيل السياسية والعسكرية للصراعات في المنطقة أكبر وأعقد من أن يحتويها هذا المقال، ولكن ما يعنينا منها هو تأثيرها على الإبداع والانتاج الفني والثقافي في المنطقة. سأحاول في سطور قليلة رصد هذا التأثير بجوانبه المختلفة، ولو أن هناك تأثيرات أعمق وأقل مباشرة لن تظهر إلا بعد فترة طويلة، إذ لا يمكن فصل حال الفنون والإبداع عن أحوال الناس المعنوية والمادية.
ليس هناك حصر مؤثق لعدد الفنانين والكتّاب والمدراء الثقافيين والمنتجين والناشرين السوريين الذين تركوا سوريا خلال الأعوام من 2011 إلى 2016، ولكن يمكن تقدير نسبتهم بشكل جزافي بما لا يقل عن 50% من عددهم داخل سوريا قبل قيام الثورة السورية. يشهد على هذا العدد الكبير من المسرحيات والأفلام والمطبوعات والحفلات الموسيقية السورية التي تنتج في ألمانيا وفرنسا وتركيا على سبيل المثال، وكثير منها حاضر في أهم المهرجانات والفعاليات الدولية.
“تسبب الوضع الأمني والسياسي المتدهور في سوريا في انتهاكات صارخة للحقوق الثقافية. إذ ما يزال النظام السوري يمارس الاعتقال بحق الفنانين والكتاب المعارضين كزكي ومهيار كورديللو والفنانة سمر كوكش والكاتب عدنان الزراعي وآحرين. فيما تحيل النقابات الفنية الفنانيين المعارضين إلى محاكم تأديب ومحكمة إرهاب حتى وإن كانوا خارج البلاد عقاباً لهم على مواقفهم.
إذ أصدرت نقابة الفنانين السوريين بلاغاً يقضي بتحويل عدد من منتسبيها المعارضين إلى “مجلس تأديب”، وذلك بسبب “عدم مبادرتهم لتسديد التزاماتهم النقابية”، رغم أن أغلب الذين وردت اسماؤهم في البلاغ مقيمين خارج البلاد، وعليهم أحكام بالسجن صادرة عن “محكمة الإرهاب” التي أحدثها النظام بعد اندلاع الثورة السورية. ومنهم جمال سليمان وعبد الحكيم قطيفان ومي سكاف ومكسيم خليل ولويز عبد الكريم وسميح شقير ومازن الناطور لمعارضتهم النظام.”[11]
لم تقتصر هجرة الفنانين، ولجوئهم في أحيان كثيرة، على الفنانين المعروفين بمعارضتهم للنظام، وانما اتسعت هذه الهجرة لتشمل فنانين ليست لهم مواقف ولا أنشطة سياسية معروفة. قد يكون السبب في ذلك هو اتساع نطاق التدمير والتنكيل الذي مارسه النظام، مما دفع بكثير من الفنانين المحايدين سياسياً إلى أن يحرصوا على ألا يتماهوا معه بأي شكل كان، وقد يكون السبب هو الصعوبة المتزايدة في العمل داخل سوريا نتيجة الضغوط الأمنية والرقابة المتزايدة والأزمة الاقتصادية الطاحنة. لا شك أيضاً أن الخوف من اتساع سيطرة تنظيم داعش على بعض مناطق سوريا أدى إلى هجرة الفنانين الذين كانوا يعيشون في هذه المناطق.
يبدو تأثير هجرة الفنانين السوريين واضحاً على الحياة الثقافية في مدينة دمشق إذ تناقصت عدد الانتاجات المسرحية والسينمائية ومعارض الفن التشكيلي، وحتى الحفلات الموسيقية التي اقتصرت معظم الوقت على دار الأسد ومواقع ثقافية حكومية قليلة، وغابت علامات هامة مثل فعاليات موسيقى على الطريق التي كانت تنظمها جمعية صدى، ومسرح تياترو الذي كانت تديره مي سكاف، ومهرجان دوكس بوكس للسينما الوثائقية الذي كان يديره عروة نيربية، وكلاهما أصبح يعيش في أوروبا بعد الاعتقال والتهديد من قبل السلطات السورية.
كذلك أدى تدهور الوضع الأمني وزيادة حواجز التفتيش العسكرية، والأزمة الاقتصادية إلى عزوف الناس عن التردد على الفعاليات الثقافية. أما خارج مدينة دمشق، فالوضع أسوأ بكثير، حيث دمر عدد كبير من المواقع الفنية في مدينة حلب التي كانت مسرحاً لحرب عنيفة بين قوات النظام وحلفائه وبين فصائل المعارضة، ونفس الشيء بدرجة أقل في حمص وحماة، وما يحيط بهذه المدن من بلدات صغيرة كان بعضها يحوي دوراً للثقافة ومسارح صغيرة.
التغيير الأكبر تاثيراً ربما يكون في هجرة جزء كبير من الجمهور إلى عدة بلدان، إذ زاد عدد النازحين السوريين عن ستة ملايين نازح، منهم 4.8 مليون طالب لجوء[12]. يتوزع معظم هؤلاء بين دول الجوار: لبنان، والأردن، وتركيا، ثم بأعداد أقل في أوروبا، في ألمانيا على الأخص، ثم كندا والولايات المتحدة. يعيش معظم هؤلاء في مجتمعات صغيرة خارج أو على أطراف المدن، وتتفاوت ظروفهم الحياتية تفاوتاً كبيراً بحسب سياسات البلد المضيف وقدراته الاقتصادية والإدارية.
ربما يكون من المبكر التأمل في تأثير نشوء هذه المجتمعات الصغيرة المهاجرة وبقاءها خلال الأعوام القليلة الماضية، ولكن أحد الجوانب الواضحة لهذا التأثير هو انعزالها التام عن الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية، سواء تلك التي يحتويها البلد المضيف، أو تلك الطارئة التي قد يقوم بها فنانون سوريون مهاجرون. في ألمانيا مثلاً، حيث أصبح يقيم عدد كبير من الفنانين السوريين،
نجد أن معظم انتاجهم الفني موجه أساساً إلى الجمهور الألماني، ولا يصل إلا نادراً إلى مجتمعات اللاجئين السوريين في ألمانيا. هناك أعمال قليلة موجهة إلى هؤلاء اللاجئين، ولكنها عادة تكون من انتاج فنانين ألمان، وعليها غالباً صفة “الفن المجتمعي” وبالتالي تصنف على أنها أقل فنياً، وتحمل رسائل اجتماعية وظيفية مباشرة.
في اليمن، حيث كان هناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية الثقافية الناشطة حتى 2014، وحيث حمل الربيع العربي معه وعداً بتيارات ثقافية وفنية جديدة في بيئة محافظة، مثل موسيقى الراب والهيب هوب، وعروض السينما غير التجارية، وفنون الشارع، تبخر هذا الوعد في فترة وجيزة تحت وطأة الحرب بين قوات التحالف العربي وبين قوات الحوثيين. توقفت معظم الجمعيات الثقافية أو جمدت نشاطها مثل مؤسسة العفيف ومؤسسة النعمان ومؤسسة ابحار للطفولة والإبداع ومؤسسة صوت التنمية[13]،
كما اضطر الكثير من الفنانين ومديري المؤسسات الثقافية إلى الهرب من اليمن بسبب التهديد المباشر من قبل قوات الحوثيين واقتحام مقار بعض المؤسسات وتدميرها. في نفس الوقت دمرت قوات التحالف العربي جزءاً من المدينة الأثرية في صنعاء، المسجلة ضمن التراث الثقافي الإنساني لدى منظمة اليونسكو، مع أن هذه القوات تضم بلداناً أعضاء في المنظمة وموقعة على الاتفاقيات الخاصة بحماية هذا التراث مثل الأردن ومصر والمغرب.
من ناحية أخرى، تعاني الجمعيات الثقافية القليلة الباقية في اليمن، أو تلك التي تحاول العمل هناك من خارجه، من صعوبات جمة في العثور على تمويل، إذا دفع بالثقافة إلى ذيل الأولويات الحكومية في ظل الحرب، والأعمال القليلة التي تموّل هي أعمال دعائية سياسية في المقام الأول. ولا تولي الهيئات الدولية المانحة اهتماماً كبيراً بالعمل الثقافي في اليمن، ولا بدعم الفنانين اليمنيين الذين اضطروا إلى الهجرة من اليمن إلى أوروبا او إلى بعض الدول العربية. نتج عن هذا كله اضمحلال سريع في الناتج الثقافي اليمني، يبشر بساحة مفتوحة أمام الأفكار الدينية المتشددة التي تحرّم الفن، وتجرّم الفنانين.
الوضع في ليبيا قريب من اليمن، مع فارق هو قلة عدد الجمعيات والمبادرات الثقافية الأهلية قبل بداية الصراع المسلح، ومعظمها بدأ نشاطه في عام 2011. مع ذلك، شهد العامان التاليان تسارعاً في وتيرة الانتاج الفني والأنشطة الثقافية، ونشطت مؤسسات تعمل بروح جديدة مثل مؤسسات أريتي وتنوير وورق. ولكن الوضع الأمني،
بالإضافة إلى حوادث اغتيال وخطف واعتقال بعض الناشطين الثقافيين مثل انتصار الحصائري وأحمد زورا وجابر زين، أدى إلى تقلص أنشطة هذه المؤسسات وهجرة عدد كبير ممن يعملون فيها. يصف أحمد البخاري مدير حركة تنوير الوضع في ليبيا: “النشاطات الثقافية والفنية كانت تحرّكها في ليبيا عجلة “الأمل”، التي تجعل الفاعلين الثقافيين والفنانيين يقومون بالعديد من الجهد لإقامة النشاطات والفعاليات الفنية والثقافية،
وحين ساد الإحباط بعد الضربات الموجعة للمشهد، وإنحصار الحريات بعد إنتشار السلاح، وعزوف المتلقي عن النشاطات الثقافية التي أصبحت تمثل له رفاهية في ظل الأولويات التي أصبحت الوقوف لساعات طويلة أمام المصارف لسحب النقود في ظل أزمة السيولة أو إنقطاع الكهرباء المتواصل، أو الوضع السياسي المتوتر والبائس، وإزدياد التعصب والترصد في ظل الحرب، وإنحسار الأمان في ظل الفوضى التي لم تعد تسمح بالقيام بأي فعاليات في أوقات متأخرة، أو تجول الفتيات بشكل دائم،
كل هذه العوامل أثرت في المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني التي تدعم وتمارس الفنون، كما أن معظم السفارات الأوروبية والمانحة خرجت من البلاد، وأصبح التواصل صعب للتمويل والمشاركة وتقديم الدعم، وأصبح القيام بأي نشاطات أو فعاليات محفوف بالمخاطر، خاصة المناشط التي لها طابع حقوقي وليبرالي حر”[14].
لا يختلف الوضع في العراق كثيراً، مع اضافة بضعة سنوات إلى عمر التدمير والتشرذم الذي أصاب الحياة الثقافية، والذي اشتدت حدته بدءاً من عام 2006 مع موجات العنف الطائفي التي تلت الإحتلال الأمريكي. تقطعت أوصال الحياة الثقافية بين المدن العراقية،
فأصبح ما يحدث في البصرة لا علاقة له بمثقفي وفناني بغداد، وأدى انعدام الأمن، والوتيرة المتلاحقة للأعمال الإرهابية وتدهور البنية التحتية إلى صعوبة التنقل وتنظيم فعاليات ومشاريع ثقافية على المستوى الوطني، فضلاً عن احتلال داعش لمدينة الموصل، والانفصال الجزئي لإقليم كردستان، والذي على الرغم من استحقاقه سياسياً، إلا أنه أثرّ سلباً على المشهد الثقافي في كردستان، وفي العراق عموماً. تأثرت الحياة الثقافية.
كذلك بالانقسام الطائفي، وبالتوتر السياسي المستمر، وتحزب المسؤولين والفنانين على حد سواء، ومؤخراً بسياسات التقشف الاقتصادي التي حتّمها انخفاض أسعار البترول، والإنفاق العسكري والأمني المتضخم. أدى كل هذا إلى ضمور شديد في المشهد الثقافي العراقي، وكما يقول الشاعر حسام السراي: “واحدة من مشكلات الثقافة العراقية إنها تفتقر إلى التراكم، فما أن تنشأ مؤسّسة لدعم الفنون وانتاجها، حتّى تغيب أو تختفي بتشتّت أعضائها، أين هو غاليري “أكد” الذي عاد إلى المشهد بعد 2003، ثم توقف عن العمل العام 2014، وهو مثال من أمثلة كثيرة”.
في البلدان الأربعة التي مازالت تشهد صراعاً عسكرياً مفتوحاً، نال البنية التحتية المدنية نصيب واسع من التدمير، فهدمت مدارس وكليات جامعية ومواقع أثرية ودوراً للثقافة ومسارح وسينمات. هناك خططاً أعدت بالفعل لإعادة إعمار سوريا، ويقال لأجزاء من العراق، ولكن لا يوجد أي اشارة لذلك بالنسبة لليبيا واليمن، حيث مازال الصراع على السلطة بعيداً عن الحسم. لا توجد معلومات متاحة عن تضمن خطط اعادة إعمار سوريا – على سبيل المثال – لمكونات لها علاقة بالانتاج الثقافي والفني،
ولكن التغيير الديموجرافي الذي حدث ويحدث لمناطق عديدة في هذا البلد، اضافة إلى أن عمليات إعادة الإعمار ستتم غالباً عن طريق شركات اقليمية أو دولية ضخمة، وبدون مشاركة شعبية، يهددان بأن يأتي هذا “الإعمار” خالياً من الحياة الثقافية الطبيعية القائمة على حيوية وتنوع المجتمع.
على مستوى آخر، يعاني تعليم الفنون، سواء على مستوى التعليم الأساسي أو المتوسط أو الجامعي، في البلدان الأربعة من ضعف متزايد نتيجة لهجرة الأساتذة وقلة فرص العمل أمام الخريجين، و تناقص التمويل الحكومي وندرة التمويل الأجنبي، وتدهور البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتعليم الفنون. تمثل معاهد وكليات تعليم الفنون القليلة الباقية في البلدان الأربعة جزراً مهددة بالغرق أو التأكل، وغير قادرة على التواصل مع مثيلاتها في بلدان أكثر تقدماً، نتيجة نقص المعارف وعدم اجادة اللغات الأجنيبة والفارق التكنولوجي الكبير. أحد الحلول غير المستكشفة لهذه المشاكل هو ايجاد مسارات بديلة لتعليم الفنون بتكلفة أقل وباحتياجات تكنولوجية أبسط، تكون في متناول مجتمعات النازحين واللاجئين داخل هذه البلدان وخارجها، مع تسويق اجتماعي للمنتج الفني يجد له مكاناً بين الاحتياجات الملحة لهذه المجتمعات.
تشهد فلسطين ربما الوضع الأصعب – وليس الأسوأ – بين البلدان العربية التي تدور فيها رحى الحرب، إذ يستمر الاحتلال الاسرائيلي لهذا البلد ويصل إلى عقده السابع، دون حسم يرجى لأحد الجانبين. وبالمقارنة مع الأعوام التالية لاتفاقية أوسلو عام 1993 التي حملت تفاؤلاً بإمكانية ايجاد حل وسطي يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة اسرائيل على بعض من أرض فلسطين التاريخية، وصحبت مع هذا التفاؤل تدفقاً كبيراً في المساعدات المالية الدولية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، نال المؤسسات الثقافية منها جانب لا بأس به، أتت الاعوام التالية للإنتفاضة الفلسطينية الثانية التي انتهت عام 2005، بإحساس واسع ضمن الجماهير الفلسطينية بفشل اتفاقية أوسلو، وفقدان الأمل بشكل متزايد في حل الدولتين، وخيبة أمل كبيرة في القيادة الفلسطينية، وازدادت منذ ذلك الحين وطأة الاحتلال الاسرائيلي، متمثلة في اغلاق للطرق وتضييق كبير على العمل الثقافي في مدينة القدس بالتحديد، وبناء لجدار الفصل العنصري، وعزل شبه تام لقطاع غزة. ابتداء من عام 2007 حدث تناقص تدريجي في المساعدات الدولية لفلسطين، وشمل هذا التناقص برامج التمويل الحكومية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وحكومة اليابان وصندوق النقد الدولي، كما شمل برامج التمويل الخاصة بمؤسسات مانحة خاصة مثل مؤسسات فورد والمجتمع المفتوح وغيرها. حدث أيضاً تدهور مضاعف في هذه المساعدات بعد موجات هجرة اللاجئين السوريين في 2012، إذ وجه جزء كبير من المساعدات المالية إلى هؤلاء اللاجئين، في أوروبا وفي بلدان الجوار السوري.
أثر هذا التناقص في التمويل بشكل كبير على الحياة الثقافية والناتج الفني في فلسطين، فتقلصت برامج الكثير من المؤسسات النشيطة مثل مسرح وسينماتيك القصبة، ومسرح عشتار، ومسرح الحرية، وواجه مسرح الحكواتي الإغلاق أكثر من مرة، وأغلقت بالفعل مؤسسة أوغاريت[15]. “اليوم، في عام 2016، وبعد مرور قرابة عقدين على تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومرور أربع سنوات على انضمام فلسطين إلى اليونيسكو، وتوقيعها على ثماني اتفاقيات هامة من اتفاقيات اليونيسكو، منها اتفاقية مؤتمر عام 2005 التي تنص على حماية وتنويع أشكال التعبير الثقافي، ومع إظهار القطاع الثقافي المستقل المزيدَ من النضج في الشكل والمضمون، يحدق بالمشهد الثقافي الفلسطيني المستقل خطر الإزالة، إذ يواجه العديد من المنظمات الفنية والثقافية غير الحكومية في الضفة الغربية والقدس خطر إيقاف عملها وحلِّها نتيجة صعوبات مالية وتنظيمية. حرية التعبير في فلسطين تتراجع بشدة، ما يؤثر على البيئة القادرة على احتضان خلق أعمال فنية مستقلة. كذلك، يبدو القطاع الثقافي خاضعاً لهيمنة لاعبين جدد، وتبدو التعددية الثقافية في خطر. وبطبيعة الحال، يترك الوضع السياسي في الدول المجاورة، في فترة ما بعد الربيع العربي، أثره على فلسطين عموماً، والقطاع الإبداعي المستقل فيها خصوصاً، مع تغيُّر الأولويات الإقليمية والعالمية. يخضع عمل القطاع الثقافي الفلسطيني المستقل في القدس لتضييق شديد وعدائية مستمرة من الحكومة الإسرائيلية، أما في غزة، فيعاني القطاع المستقل من كل الجوانب، منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2006[16]”، ويناضل الفنانون الفلسطينيون القلائل الباقون في قطاع غزة لتقديم أعمالهم في غياب مصادر تمويل وفي ظل رقابة متعسفة تمارسها سلطات حماس.[17]
ورغم هذه الصعوبات الكبيرة، ما زالت العديد من المؤسسات الثقافية الفلسطينية قائماً ونشطاُ وناجحاً، ويرجع هذا إلى قوتها المؤسسية وإلى وجود دعم اجتماعي واسع لها، وإلى الدعم المالي المحدود الذي مازالت تقدمه مؤسسات مانحة فلسطينية هامة مثل مؤسسة التعاون ومؤسسة عبد المحسن قطان. من الهام أيضاً ذكر أن وزارة الثقافة الفلسطينية، على ضعف دورها وقلة مواردها المالية، كانت الوزارة العربية الوحيدة التي أعدت استراتيجية مكتوبة ومعلنة للقطاع الثقافي للأعوام 2011 – 2013، شارك في اعدادها ممثلون لمؤسستي التعاون وعبد المحسن قطان، مع ممثلين للجهات الحكومية ومنظمة اليونسكو. من الملفت أيضاً نموذج تعليم الفنون البديل الذي أسسته فرقة مسرح الحارة في منطقة بيت لحم، وهو يركز على تعليم تقنيات فنون الآداء، ويعنى بإعداد الخريجين لسوق العمل[18].
تنفرد الحياة الثقافية في فلسطين، لأسباب تاريخية متعلقة بالصراع مع سلطات الاحتلال وغياب وجود دولة مستقلة ومؤسسات ثقافية حكومية، بتقديم نماذج لمؤسسات ومبادرات أهلية ناجحة، على الأخص من ناحية التمويل والإدارة الثقافية، ويأتي الحضور الثقافي الفلسطيني المتميز على المستوى الدولي تعبيراً عن هذا النجاح.
بشكل أعم، نال العمل الثقافي نصيب أكبر من الأذى في هذه البلدان الخمسة، ليس فقط بشكل مباشر بسبب الحرب أو الاحتلال أو الانقسام الأهلي، وانما أيضاً بشكل غير مباشر نتيجة لصعود التيارات الدينية المتطرفة واكتسابها تأييداً شعبياً في بعض المناطق داخل هذه البلدان. ولم يقتصر الأمر على حالات المنع المباشر للأعمال الفنية وتهديد الفنانين، بل تعداه لما هو أخطر وأكثر عمقاً: إعادة ترويج المعتقدات التقليدية التي بدت وكأنها اندثرت والتي تقضي بتحريم الفنون، وبالطبع تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، بل بين الأطفال الذكور والإناث، فضلاً عن الاستهزاء بكل ما يتعلق بالإبداع الفني والأدبي واعتباره أمراً تافهاً لا يليق في ظروف الحرب أو الصراع السياسي.[19]
يجد الفنانون والناشطون الثقافيون في معظم هذه البلدان أنفسهم في وسط حلبة صراع محتدم بين التيارات التي يطلق عليها “علمانية”، والتي يصنفون عادة ضمنها، ومعهم أغلب المهنيين والمتعلمين من الطبقات فوق المتوسطة، وتلك التي يطلق عليها “اسلامية” والتي تصطف حولها الشرائح الأوسع من المجتمع من الطبقات الفقيرة وغير المتعلمة. هذا بالطبع تعميم مخل، إذا إن هناك استثناءات كبيرة ولافتة هنا وهناك، ولكن بشكل عام يقل ظهور التيارات العلمانية في القرى والبلدات الصغيرة والطبقات الفقيرة، والعكس صحيح بدرجة أقل. يجد الفنانون أنفسهم في وسط هذا الصراع، وقد انحازوا بقصد، أو بفعل التصنيف الإعلامي، إلى التيارات العلمانية، وبالتالي، وبشكل عام، يعتبرون معادين للتيارات الإسلامية المحافظة، وتعتبر أعمالهم انتهاكاً للتقاليد الاجتماعية والمفاهيم الدينية التي يعتنقها هؤلاء. يزيد من حدة هذا العداء، في البلدان التي تمر بصراع سياسي عنيف، أن نخبة الفنانين والمثقفين قد تلقت دعماً، وناصرت علناً أو ضمناً، الأنظمة السياسية التي تقف أغلبية الشعب، او الشرائح الفقيرة منه، ضدها. كل هذه العوامل تلعب دوراً هاماً في وصم الفنانين والمثقفين بأنهم أبناء الأنظمة الديكتاتورية، أو أنهم خارجون عن قيم المجتمع، أو أنهم في أحسن الأحوال لا يشعرون بالصعاب التي يمر بها معظم أفراد الشعب.
هذا الوصم للفنانين والمثقفين يعيق، بل يجعل مستحيلاً، أن يقوم هؤلاء الفنانون والمثقفون بدور حيوي في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي. إذا كيف لهم أن يقوموا بهذا الدور وأغلبية من يعنيهم التغيير، ومن يقومون به ويدفعون ثمنه، يعادونهم؟ النتيجة الفعلية لعزل الفنانين والمثقفين، وأعمالهم، عن عملية التغيير هي أن هذه العملية تجري دون ما تستلزمه من إعادة النظر في القيم والمفاهيم والبنى الاجتماعية الثابتة، وبالتالي يأتي التغيير في صالح التأكيد عليها وتأصيلها إلى حدها الأقصى، أي في صالح اكثر التيارات الدينية تشدداً. بطبيعة الحال، تؤدي نتائج هذا المسار إلى تضييق مساحات حرية التعبير في المجتمع، وعلى امكانية عمل الفنانين، بل على وجودهم أساساً.
السؤال الأن، ربما المعاد، هنا هو كيف يمكن للفنانين أن يغيروا هذه المعادلة؟ هناك محاولات كثيرة في هذا الاتجاه، ولكنها تطرح أسئلة أخرى عن توظيف الفن، وما يستتبعه هذا من تضحية بجوانب الجمال والتجريب والمغامرة في العملية الفنية، وعن الحدود التي يجب أن تكون بين العمل الفني وأنشطة التوعية والتعليم. هذه الأسئلة كلها هي مطروحة بحدة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وهي أيضاً مطروحة في باقي البلدان العربية، حتى تلك التي لم تشهد تغييراً كبيراً، أو توقفت فيها عملية التغيير.
يبدو لي أن أحد خيوط الإجابة قد يكون في ايجاد موقع للفنانين والمثقفين على مسافة آمنة من القوتين المتصارعتين، وبالتأكيد من الأنظمة الحاكمة، دون أن يصبح هذا الموقع فقاعة معزولة عن الواقع الاجتماعي والسياسي، بل يسمح بالاشتباك مع هذا الواقع، ولكن بشكل أكثير حيدة بين الثنائية القطبية العلمانية الاسلامية، ومن يساندونها من الجانبين. لا أعرف ما إذا كان هذا الطرح ممكناً فعلياً، ولا يمكنني تحديد ملامحه بدقة، ولكني فقط أضعه بين يدي القاريء كمخرج محتمل.
اتفاقية اليونسكو لعام 2005 لحماية وتعزيز كافة أشكال التعبير الثقافي
بنهاية عام 2016، صدقت ستة عشر دولة من الاثنتين وعشرين دولة المنضمة إلى جامعة الدول العربية على هذه الاتفاقية وهي بحسب الترتيب الزمني: جيبوتي – تونس – الأردن – مصر – الكويت – عمان – السودان – سوريا – قطر – فلسطين – الإمارات – المغرب – العراق – جزر القمر – الجزائر – موريتانيا. لم تصدق على الاتفاقية ستة دول عربية هي: ليبيا – السعودية – الصومال – لبنان – البحرين – اليمن. من الصعب التأكد ما إذا كان التصديق على الاتفاقية قد استتبع تغييرات تشريعية وهيكلية في الدول التي صدقت عليها، ولكن ندرة هذه التغييرات تجعلنا نفترض أن التصديق على الاتفاقية لم يتعد كونه اجراءً رسمياً شكلياً. الآداة الوحيدة التي تمكن منظمة اليونسكو من رصد تطبيق الاتفاقية والاستفادة منها هي التقارير التي تقدمها الدول مرة كل أربع سنوات إلى مؤتمر الأطراف الموقعة على الاتفاقية في باريس. وبمعاينة التقارير المقدمة بالفعل والمتاحة على موقع اليونسكو، نجد أن هناك تفاوتاً كبيراً في محتوى هذه التقارير، كما نجد أن معظم البلدان العربية لم تقدم التقارير في موعدها، وأن محتوى التقارير أقل مما تتطلبه الصيغة المنشورة على موقع الاتفاقية.
من اللافت قلة المعرفة بالاتفاقية بين المشتغلين بالثقافة والفنون في البلاد العربية المنضمة إليها، إذ كثيراً ما تقتصر المعرفة بها على عدد قليل من موظفي وزارة الثقافة المخولين إدارياً بالاتصال مع منظمة اليونسكو. كذلك، لا يربط الكثيرون بين الإنضمام إلى اتفاقية دولية وبين التغييرات التشريعية الواجبة لتطبيق هذه الاتفاقية. بشكل عام، يندر استخدام الأدوات التشريعية الدولية من قبل الناشطين في كل المجالات في الدول العربية، فيما عدا ربما مجال حقوق الإنسان الذي تتمتع منظمات المجتمع المدني المتخصصة فيه بخبرة ومعرفة بأهمية الأدوات القانونية الدولية أكثر من باقي مثل هذه المنظمات.
أيضاً، ربما يكون اسم الاتفاقية الطويل، وترجمته العربية القلقة[20]، أحد أسباب قلة الوعي بأهمية هذه الاتفاقية في المنطقة العربية، إذ ليس واضحاً من قراءة الاسم ما الذي يعنيه مصطلح “أشكال التعبير الثقافي”، رغم التعريف الذي تتضمنه الاتفاقية والذي لا يقدم شرحاً وافياً. يضاف إلى ذلك غياب النسخة العربية من المبادئ التوجيهية التشغيلية[21] لبنود الاتفاقية، وهو ما كان يمكن أن يساعد في نشر المعرفة بفوائدها. هناك أيضاً الاعتقاد الشائع لدى الكثير من المشتغلين بالفنون في المنطقة أن اليونسكو ليست معنية سوى بقضايا التراث الثقافي، نظراً للدور الهام الذي قامت به في حماية وانقاذ آثار المنطقة. وأخيراً، لا يعرف الكثير من المشتغلين بالثقافة في المنطقة خلفية اصدار هذه الاتفاقية، والمتمثلة في كونها إحدى الآليات القانونية الهامة في مواجهة الهيمنة الثقافية للدول الكبرى، ربما فيما عدا مجموعة صغيرة من الفنانين والناشطين الثقافيين في تونس، الذين دعوا إلى تطبيق الاتفاقية عقب توقيعها من قبل الحكومة التونسية ودخولها حيز التنفيذ في 2007. يحد كون اليونسكو منظمة أممية حكومية أيضاً من قدرتها على التواصل مع القوى الفاعلة في الحقل الثقافي في المنطقة العربية، والتي تعمل في الأغلب على هامش المنظومة الرسمية.
لهذه الإتفاقية موقع فريد بين اتفاقيات اليونسكو، فهي تغطي مساحة كبيرة جداً ومتنوعة من الجوانب المتعلقة بالحياة الثقافية، على خلاف الاتفاقيات الأخرى التي عادة ما تكون خاصة بنوع محدد من الأنشطة أو الحقوق. فمثلاً تشير الإتفاقية إلى “حرية التعبير” ضمن المبادىء التوجيهية لها، وهي إشارة نادرة في اتفاقيات اليونسكو، إذا عادة ما تذكر “حرية التعبير” ضمن الاتفاقيات الخاصة بالحريات المدنية والسياسية. كذلك نجد أن الاتفاقية تتضمن بنوداً تشير إلى المجالات التي لها اتصال وثيق بالثقافة مثل التعليم (مادة رقم 10) ومشاركة المجتمع المدني (مادة رقم 11)، والتعاون الثقافي الدولي (مادة رقم 12) وإدماج الثقافة كمكون في سياسات التنمية المستدامة (مادة رقم 13)، وفي نفس الوقت، وبشكل محدد وواضح، تلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها باتخاذ تدابير واجراءات لدعم وتشجيع أشكال التعبير الثقافي (المواد 7 و8 و17)، وتدابير لدعم وحماية السلع والمنتجات والخدمات والصناعات الثقافية (المواد 14 و15 و16). ورغم أن الاتفاقية لا تذكر الإبداع الفني بالتحديد، إلا أنها الاتفاقية الدولية الأساسية التي تلزم الدول بدعم وتشجيع مثل هذا الإبداع، من مسرح وسينما ورقص وموسيقى وفنون بصرية، بإعتبار كل هذه الفنون ضمن “أشكال التعبير الثقافي”، أو ضمن “السلع والمنتجات والصناعات الثقافية”.
تتيح الاتفاقية للدول المنضمة إليها عدة أدوات عملية يمكن استخدامها في تطبيقها، بعضها على المستوى المحلي، مثل تكوين فريق على المستوى الوطني يتضمن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، يتولى رصد تطبيق الاتفاقية وتقديم التقارير الدولية، ومثل امكانية عمل تغييرات تشريعية وهيكلية لدعم وتشجيع المنتجات الثقافية المحلية وحمايتها من المنافسة، وبعضها على المستوى الدولي مثل تطبيق المعاملة التفضيلية بين بلدان العالم النامي والبلدان المتقدمة، ومثل برامج التبادل الثقافي الثنائي والإقليمي والدولي، وكذلك الصندوق الدولي لدعم التنوع الثقافي وهو جزء أساسي من الاتفاقية ويقدم دعماً مالياً للمشاريع الثقافية في البلدان النامية المنضمة إلى الاتفاقية.
تتيح الاتفاقية (المواد 1 و4 و6 و16) للدول المنضمة إليها اتخاذ اجراءات تشريعية وتنفيذية لضمان حماية منتجاتها الثقافية في مواجهة هيمنة الدول الأقوى اقتصادياً. ويرى الكثيرون أن هذا هو أهم فوائد الاتفاقية بالنسبة لبلدان العالم النامي، ولكن المشكلة عادة في هذه البلدان تتمثل في أن عملية الانتاج الفني والثقافي في حد ذاتها شبه معطلة، نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي لا توجد منتجات تلبي احتياجات المجتمع، حتى لو لم تكن هناك منافسة لها.
تمثل المادة رقم (13) في الاتفاقية والخاصة بدمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة، رغم ذكرها المختصر في الاتفاقية، المدخل الأوسع لوضع الثقافة في موضعها الصحيح في السياسة العامة للدولة. في حال تطبيق هذه المادة، لن يكون الهم الأكبر لدى المشتغلين بالثقافة هو زيادة النسبة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، وانما تصبح الثقافة جزءاً من البنية التحتية الصلبة والناعمة للتنمية، أي تكون عنصراً فاعلاً في كل السياسات العامة: الصناعة والزراعة والإعمار والتجارة والتعليم والصحة والاتصالات وحتى الأمن. هذا بالطبع هدف بعيد المنال ولكنه ليس مستحيلاً لو تضافرت الجهود مستندة إلى هذه الاتفاقية.
تخصص الاتفاقية احدى موادها، وهي المادة رقم (11) للتأكيد على دور المجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، أي في تنفيذ كل بنود الاتفاقية، بالاضافة إلى الذكر المتكرر لمنظمات المجتمع المدني في المواد (6) و (12) و(15) و(19). يشكل هذا الإطار دفعة قوية لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الثقافة لو كان باستطاعتها استخدام الاتفاقية على المستوى الوطني، وهو أمر ما زال في طور التمني لا الواقع، إذ ربما يرجع عدم استخدام الاتفاقية لدعم منظمات المجتمع المدني راجعاً إلى تقصير هذه المنظمات في التعرف على الاتفاقية وأساليب استخدامها، وليس فقط إلى التضييق على المجتمع المدني في البلدان العربية. هناك حاجة حقيقة لطرح دور هذه المنظمات للنقاش العام في بلداننا وربط هذا النقاش بأدوات تشريعية دولية مثل هذه الاتفاقية.
لكي توضع هذه الاتفاقية الهامة موضع التنفيذ، هناك حاجة ماسة إلى التعرف على بنودها وفهمها من قبل الجماعة الثقافية في كل بلد، كما أن هناك حاجة في معظم الأحيان لشرحها حتى للمسؤولين الرسميين الذين يتولون رصد تنفيذها وكتابة التقارير حول ذلك مرة كل أربعة سنوات. ورغم أن منظمة اليونسكو تتيح أحيانا للدول الموقعة على الاتفاقية، امكانية التدريب في مجالات مختلفة متعلقة بالاتفاقية، إلا أن معظم الدول لا تسعى في سبيل ذلك، وفي حال أجري مثل هذا التدريب، يؤدي غياب التنسيق والتعاون بين وزارات الثقافة ومنظمات المجتمع المدني إلى عدم الاستفادة من نتائجه.[22] ربما يكون المخرج من هذا الطريق المسدود هو برفع وعي واهتمام منظمات المجتمع المدني المشتغلة بالثقافة والفنون بأهمية الاتفاقية، وتشجيعها على الضغط على المؤسسات الرسمية لتطبيقها، وفي الوقت نفسه زيادة وعي المؤسسات الثقافية الرسمية بالفوائد التي يمكن أن يجنيها القطاع الثقافي، سواء كان رسمياً أم أهلياً، من تطبيق الاتفاقية. في الوقت الحالي لا يرى معظم المسؤولين فوائد الاتفاقية، إلا ربما امكانية الحصول على تمويل محدود من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي الذي يشكل جزءاً من الاتفاقية. هناك حاجة إذاً لزيادة محفزات تطبيق الاتفاقية وعدم اقتصار هذه المحفزات على الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، وكذلك حث منظمات المجتمع المدني على لعب دور أبرز في عملية كتابة التقرير الذي يقدم كل أربعة سنوات، أو ربما التفكير في كتابة تقارير موازية Shadow reports، على نحو ما يحدث في تقارير المراجعة الدولية الشاملة التي تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
قد تكون أهم فوائد الاتفاقية هي كونها، باتساعها وشمولها جوانب متعددة، ركيزة ممتازة، ذات صفة شرعية دولية، لوضع سياسات ثقافية على المستوى الوطني، وكذلك لوضع سياسات ثقافية تتعلق بالتعاون والتبادل الثقافي الدولي. وتكمن المفارقة هنا في أن تطبيق هذه الاتفاقية يتطلب وجود أليات حوار ديمقراطي حول الثقافة، يصعب وجودها في غياب سياسة ثقافية وطنية، وبالتالي تجد بعض البلدان المصدقة على الاتفاقية نفسها في دائرة مفرغة: السياسة الثقافية قبل الاتفاقية، أم بعدها؟ ربما كان يمكن تجنب هذا المأزق لو كانت هناك مرحلة تمهيدية للإنضمام إلى الإتفاقية بشكل كامل، تتطلب من الدول الراغبة في الانضمام إرساء مثل هذه الأليات التي تضمن تطبيق الاتفاقية بشكل فعلي، قبل التصديق النهائي عليها. ولكن الآن بعد أن فاتت هذه الفرصة، يبدو أن المخرج من هذه المتاهة يكمن في ايجاد حوافز حقيقية، أهم من الدعم المالي المحدود الذي يقدمه الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، لتطبيق الاتفاقية، وكذلك اجراءات تتخذ سلباً في حال عدم تطبيق الاتفاقية.
سياسات ثقافية عربية، من أجل من؟
هناك تعريفات متعددة لما يعنيه مصطلح السياسات الثقافية، ولكن لغرض هذا المقال سأكتفي بالتعريف شائع الاستخدام وهو أنها تلك الإجراءات والأفعال والقوانين التي تقوم بها الحكومات، أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأهلية لتنظيم أو حماية أو دعم أو تشجيع الإبداع والإنتاج الفني والثقافي، والموارد الثقافية والتراث الثقافي لبلد ما، أو عدة بلدان. وكذلك يتضمن التعريف تلك الاجراءات والأفعال والقوانين التي تحد أو تمنع أو تهدد أو تعرض للخطر ذلك الإبداع والانتاج والموارد والتراث. في المنطقة العربية. بهذا المعنى، يمكننا أن نتفق على أن لدى كل البلاد العربية سياسات ثقافية، ولكن المصطلح لم يستخدم على نطاق واسع، ولا في الوثائق الرسمية الحكومية إلا نادراً، وغالباً بعد عام 2010.
كان لمؤسسة المورد الثقافي فضل ريادة هذا المجال في المنطقة العربية، من خلال البرنامج الذي أطلقته عام 2009، بالتعاون مع المؤسسة الثقافية الأوروبية، لرصد السياسات الثقافية في ثمان دول عربية. جاءت بداية البرنامج على أساس من النموذج الذي وضعه المعهد الأوروبي لأبحاث السياسات الثقافية المقارنة ERICarts ، والذي حدد مجالات رصد السياسات الثقافية في أوروبا، ثم توسع في استخدامه في بلدان أخرى. حاولت مؤسسة المورد الثقافي تطويع هذا النموذج لكي يمكن استخدامه في البلدان العربية، وقامت بتدريب مجموعة من الباحثين على ذلك، وأتى كتاب “السياسات الثقافية في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس” الصادر عن دار بوكمان في هولندا، بالتعاون بين مؤسسة المورد الثقافي والمؤسسة الثقافية الأوروبية، عام 2010، وكذلك النسخة العربية الموازية لهذا الكتاب الصادرة عن دار شرقيات في مصر، من تحرير حنان الحاج علي، ليكون أول نتيجة لهذا الرصد الذي استمر لحوالي عام، وأول كتاب ينشر عن السياسات الثقافية في المنطقة.
بعد إصدار الكتابين، استمر عمل مؤسسة المورد الثقافي في تطوير السياسات الثقافية العربية، فنظمت المؤتمر الأول للسياسات الثقافية في بيروت في يونيو (حزيران) 2010، والذي أفرز مجموعات للعمل على تطوير السياسات الثقافية في عدة دول عربية، ثم مؤتمر “سياسة ثقافية من أجل الديمقراطية” في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، والذي شارك فيه أكثر من 120 فناناً وأكاديمياً وناشطاً ثقافية من 10 دول عربية هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان واليمن والعراق والكويت. انتهى المؤتمر إلى توصيات عديدة كان أبرزها التوصية بمشاركة القطاع الثقافي في قيادة عملية التغيير السياسي والاجتماعي، وسنّ سياسات ثقافية جديدة تحقق ديمقراطية ولا مركزية الثقافة.
أدت هذه الجهود، بالإضافة إلى تبني بعض المؤسسات الدولية والأهلية الأخرى قضية تطوير السياسات الثقافية، إلى وضعها في مقدمة الموضوعات المطروحة للمناقشة عند التفكير في اصلاح منظومة الثقافة في البلدان العربية. خلال الأعوام من 2010 إلى 2015 شهد هذا المجال طفرة كبيرة في عدة بلدان، ففي الجزائر طرحت “مجموعة عمل متكوّنة من فاعلين ثقافيين شباب ولأول مرّة في تاريخ الجزائر لوثيقة سياسة ثقافية جزائرية مقترحة من قبل المجتمع المدني تمّ الإعلان عنها سنة 2013 بعد سنتين من النقاش الميداني المفتوح، وذلك في ظل تضييقات كبيرة من الجانب الرسمي. هذا التجاذب بين الرسمي والمدني توّج برضوخ المؤسسة الرسمية لغير قليل من الأفكار ولو بطريقة غير مصرّح بها كان من نتائجها المباشرة المصادقة المتأخرة نسبيّا على اتفاقية اليونسكو 2005″[23]
وفي اليمن “تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد خلال عامي 2013 و2014، مجموعه كبيرة من السياسات الثقافية والمواد التي اعتبرت ملزمة من الناحية القانونية، ومنها قوانين خاصة بالحقوق الثقافية وثقافة حقوق الإنسان ومواد خاصة بالكتاب وحقوق المثقفين والسينما وتطوير الثقافة و الإعلام و الصحافة الثقافية و ثقافة الطفل والنساء.[24]
ومن ثم جاء الدستور اليمني الذي تم تطويره خلال عام كامل ليفرد مواداً خاصة بالثقافة كحق من حقوق الإنسان فى الدستور اليمني المعدل . ولكن بعد الانقلاب الذى قام على أساس رفض الفيدرالية التي نص عليها مؤتمر الحوار الوطني والدستور ، وهروب الرئيس هادي الى المملكة العربية السعودية وبدء عاصفة الحزم لم يعد هناك اى تفعيل للوثيقة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني أو الدستور اليمني الجديد فى ظل الحرب التي تعيشها اليمن .”[25]
وفي المغرب، يقول الشاعر مراد القادري أن: “أهم ما ميز العشرية الأخيرة: إقرار دستور سنة 2011، والذي يركز في عدة مواد على أهمية التنمية الثقافية والفنية وحق كل مواطن في التعبير الثقافي بكل تنوعه؛ علاوة على تبنيه لقضية اللغات وجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية واهتماهه بالتنوع الثقافي والحق في انتفاع المواطن المغربي بالثقافة واستهلاكها والتأكيد على سهر الدولة على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، من خلال إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية. هذا؛ وقد صادق المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت 2016 على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 والذي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،كمؤسسة توكل إليها مُهمة حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للمغرب ورسم السياسات الثقافية للبلد.”[26]
أما في تونس، فجاءت أهم التطورات في السياسة الثقافية متمثلة في الغاء الرقابة المسبقة على الأعمال المسرحية، ثم إصدار قانون المالية التكميلي في عام 2014، ابان تولي السيد مراد الصقلي وزارة الثقافة، الذي يتيح دعم المشاريع والمؤسسات الثقافية من ضرائب شركات القطاع الخاص، حتى 70% من هذه الضرائب[27]، وهو قانون لا نظير له في أي بلد عربي. ويعد الفصل 42 من الدستور التونسي الذي أقر في عام 2014 من أكثر النصوص الدستورية في المنطقة شمولاً للحقوق الثقافية فهو ينص على: “الحق في الثقافة مضمون، حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرّس قيم التسامح، ونبذ العنف، والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه”.
ويجد الناظر المتمعن في محتوى مقترحات السياسات الثقافية المختلفة، والنصوص والتعديلات الدستورية والقانونية المتعلقة بالثقافة، اهتماماً بالبعد الاجتماعي للسياسة الثقافية، وإشارات متكررة إلى الدور الذي يجب أن يلعبه النشاط الثقافي والفني في مواجهة التطرف والعنف بأنواعه، أو تخفيف الاحتقان الإجتماعي، أو التعبير عن قضايا العدالة الاجتماعية، أو التعبير عن التنوع اللغوي أو الديني أو العرقي. فنجد مثلاً أن المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر[28]قد أنجزت ورقة بعنوان “اطار عام للسياسة الثقافية في مصر” تتضمن استراتيجيات مثل “الحد من مركزية الثقافة” و”التكامل بين السياسة الثقافية وسياسات التعليم”. وكانت هذه الورقة قد قدمت من قبل أكثر من 40 جمعية ومؤسسة ثقافية أهلية إلى لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب (البرلمان)، ونوقشت في اجتماع اللجنة يوم 16 يونيو 2012، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، ولكن حكماً قضائياً بحل البرلمان صدر في نفس اليوم، وانتهت به قصة هذه الورقة.
قصة السياسات الثقافية في العراق هي الأكثر مأساوية بين محاولات البلدان العربية اقتراح سياسة ثقافية وطنية، إذ أغتيل المفكر والكاتب العراقي كامل شيّاع الذي أخذ على عاتقه، إبان عمله كمستشار لوزير الثقافة، مهمة كتابة مسودة للسياسة الثقافية في العراق، ثم قام بتنظيم مؤتمر للمثقفين العراقيين شارك فيه نحو ألف فنان وكاتب ومثقف لمناقشتها عام 2005، تحت رعاية منظمة اليونسكو. عمل كامل شيّاع جاهداً بعد المؤتمر لوضع توصياته، والتي أطلق عليها اسم خارطة طريق الثقافة العراقية، موضع التنفيذ، ولكنه واجه الكثير من العراقيل السياسية والبيروقراطية، حتى أغتيل عام 2008، دون أن يعرف قاتله حتى الآن، ودفن معه هذا المشروع الهام. الملاحظ الآن أن العراق يعاني من فقر تشريعي مؤسف، إذ حتّى الدستور العراقيّ بكلّ موادّه ترد فيه هذه المادّة فقط التي فيها ذكر للثقافة والفنون:”ترعى الدولة النشاطات والمؤسّسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية اصيلة”[29]
لقد أثمرت جهود تطوير السياسات الثقافية في المنطقة العربية زيادة في الوعي بأهميتها، كما أثمرت بعض الإجراءات المفيدة والعملية على مستوى تمويل الثقافة، وكذلك نصوصاً هامة لحماية حرية التعبير الفني في دساتير وقوانين بعض الدول، ولكنها قلّما نتج عنها اقتراحات عملية بإصلاحات هيكلية جوهرية في منظومة الثقافة الرسمية.[30] ومن البديهي أنه لا يمكن تطوير السياسة الثقافية لدولة ما، دون إعادة النظر بشكل جذري في مؤسسات وأليات رعاية الثقافة فيها.
مازالت الهوة واسعة بين هذه المحاولات المخلصة لتطوير سياسات ثقافية تستجيب بشكل أكبر لاحتياجات المجتمعات العربية، وبين ما تتبعه معظم المؤسسات الثقافية الرسمية التي يقتصر دورها في كثير من الأحيان على مصاحبة وتجميل الشخصيات والأحداث السياسية الرسمية. من ناحية أخرى، تحتاج محاولات تطوير السياسات الثقافية الجارية في المنطقة إلى الكثير من العمل على محتوى هذه السياسات، وعلى أليات النقاش والاتفاق حولها، لكي تصل إلى تبنيها من قبل شرائح اجتماعية عريضة، فمازالت معظم هذه المقترحات قاصرة عن تناول قضايا اجتماعية ملحة مثل البطالة والتهميش الاقتصادي والاجتماعي للريف والمناطق العشوائية والبوادي، وكل ما يخرج عن نطاق الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة في العواصم والمدن الكبرى. وحتى الآن، لا تتناول هذه المقترحات بشكل جدي المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر في انتاج واستهلاك الأعمال الفنية والأدبية، مثل الأمية ورداءة التعليم.
على أرض الواقع، هناك سياسات ثقافية غير مقننة تحكم العمل الثقافي في معظم البلدان العربية. هذه السياسات تسنها في المقام الأول الممارسات العملية للمؤسسات الثقافية الرسمية، وتراكمات الإجراءات واللوائح التي تحكم عملها، والتي أحياناً ما تحتوي على تناقضات ومفارقات. وتتوقف فعالية هذه السياسات غير المقننة على كفاءة واخلاص من يقومون على تنفيذها، فنجد في أحيان قليلة طفرات ايجابية في أداء مؤسسات ثقافية رسمية في بلد ما، لأن شخص الوزير، أو كبار موظفيه، لديهم رغبة حقيقية في تنشيط العمل الثقافي[31]. عادة ما تفشل محاولات هؤلاء في احداث تغيير حقيقي في السياسات الثقافية لأسباب متشابكة منها الواقع السياسي الذي يضع العمل الثقافي الحكومي في موضع المروّج للأجندة السياسية للنظام، ومنها معاداة الجهاز البيروقراطي الرسمي لأي تغيير جذري.
في المقام الثاني يأتي تأثير السياسات الثقافية التي تتبعها المؤسسات المانحة الدولية التي تدعم الثقافة في المنطقة العربية، وأهمها من ناحية يحجم التمويل ووضوح السياسة الثقافية هو الاتحاد الأوروبي، وتليه مؤسسات أميركية وأوروبية خاصة مثل مؤسسة فورد Ford Foundation التي تتميز بأن لديها برنامج مخصص لدعم الثقافة والفنون، وله أولويات واضحة، ومؤسسات دروسوس Drososودون Doen Stichtingوالمجتمع المفتوح Open Society Foundationsوأنا ليند Anna Lindh Foundationالمؤسسة الثقافية الآوروبية European Cultural Foundationوغيرها. بشكل عام – مع أهمية ملاحظة الاختلافات – تتبنى هذه المؤسسات سياسات توازن بين دعم تطوير المؤسسات الحكومية وتدريب العاملين بها، ومشاريع حماية التراث التي تتولاها أجهزة حكومية من ناحية، وبين دعم المؤسسات والمنظمات والمشاريع الثقافية غير الحكومية، بالقدر الذي تسمح به القوانين المحلية التي كثيراً ما تحد من هذا الدعم. من ناحية أخرى. تجدر الإشارة أيضاً إلى الدعم الذي تقدمه بعض المؤسسات والمراكز الثقافية الأوروبية مثل المجلس الثقافي البريطاني The British Councilومعهد جوتة Goethe Institutومؤسسة بروهلفسيا Pro Helvetia في إطار التبادل الثقافي والدبلوماسية الثقافية، والذي يقدم لمشاريع وبرامج ثقافية يصممها ويشارك فيها أوربيون، والتي ربما يكون تأثيرها أكبر على القطاع الثقافي في البلد الأوروبي الذي يقدم هذا الدعم.
لا شك في أن المؤسسات والحكومات المانحة الدولية لعبت دوراً هاماً في تطوير منظومة الثقافة خلال الأعوام العشرة الماضية، على الأخص في البلدان التي تفتقر إلى مؤسسات ثقافية رسمية فعالة، والتي نشأت فيها منظمات ثقافية أهلية صغيرة، مثل ليبيا وموريتانيا والسودان واليمن، وكذلك على المستوى الإقليمي من خلال دعم هذه المؤسسات المانحة لمؤسسات اقليمية تقوم بدورها بدعم مشاريع ثقافية في بلدان عربية عديدة مثل الصندوق العربي للثقافة والفنون والمورد الثقافي ومؤسسة أنا ليند. ما يفتقد في سياسات هذه المؤسسات الدولية هو فهمها لعمل بعضها البعض، والحوار بينها، وتلمس امكانيات التنسيق والتعاون لتعظيم تأثير مواردها المالية. من التحديات التي تواجه هذه المؤسسات أيضاً ضعف قدرتها على التأثير في المنظومة الثقافية الرسمية، وفي القوانين والتشريعات المحلية التي يحد بعضها من حرية التعبير، ومن امكانيات الانتاج الفني. كذلك تتسم السياسات الثقافية لبعض هذه المؤسسات المانحة بقصر النفس، وتغيير الأولويات والموضوعات بشكل سريع، ودون علاقة واضحة مع معطيات الواقع في المنطقة، فنجد بعضها يعطي أولوية لموضوع أو مجال ما، الفنون المعاصرة أو حرية التعبير على سبيل المثال، ثم يقوم بتغيير هذه الأولوية دون أن يكون قد حدث تغيير على أرض الواقع يبرر ذلك. من المآخذ الأخرى على الدور الذي تقوم به المؤسسات المانحة هو أن بعض المؤسسات الثقافية المستقلة،والفنانين، يقومون بصياغة مشاريعهم وخططهم بحيث تتفق مع أولويات هذه المؤسسات، والمفترض هو العكس. في رأيي، يرجع هذا إلى ضعف المؤسسات الثقافية المستقلة وقلة مواردها المالية، وربما حتى غياب الرؤية والخطط الواضحة لدى بعضها.[32]
من الملفت ملاحظة مدى تأثير تمويل المؤسسات المانحة الدولية على القطاع الثقافي في البلدان العربية، مقارنة بتأثير التمويل الحكومي للثقافة. على سبيل المثال، ورغم أن المعلومات الدقيقة الموثقة غير موجودة، يقدر التمويل الحكومي للثقافة في مصر عام 2011 بحوالي 147 مليون دولار،[33] بينما لا يمكن أن يزيد مجمل تمويل المؤسسات المانحة الدولية لقطاع الثقافة في مصر على خمسة ملايين دولار في العام نفسه، ومع هذا نجد أن أكثر المشاريع الثقافية ظهوراً وتأثيراً في مصر هي تلك الممولة من مؤسسات مانحة دولية مثل مهرجان دي كاف، وأنشطة المؤسسات الثقافية المستقلة مثل تاون هاوس جاليري ومحطات وآرت اللوا ومركز الصورة المعاصرة وغيرهم. ربما يكون أحد أسباب ضعف تأثير التمويل الحكومي للثقافة هو أنه معظمه ينفق على الهياكل الإدارية الضخمة، ولكن الأسباب الأخرى تشمل غياب سياسة ثقافية لها أهداف محددة، أو حتى رؤية عمومية تعمل هذه المنظومة على تحقيقها.
موضوع السياسات الثقافية هو الأهم عند الحديث عن إصلاح أو تطوير منظومة الثقافة، ولكنه يطرح أسئلة صعبة وملحة لا توجد إجابات واضحة عليها، ولا اجابات تصلح لكل البلدان والظروف:
– كيف يمكن جسر الهوّة بين المؤسسات الثقافية الرسمية وبين جهود تطوير السياسات الثقافية التي تقوم بها مجموعات مستقلة، في ظل غياب – أو ضعف – أليات الحوار الديمقراطي في مجتمعاتنا، وهيمنة أنظمة غير ديمقراطية؟
– هل هناك قواعد أو مبادئ لإدارة ودعم العمل الثقافي يمكن طرحها للنقاش والاتفاق عليها داخل المجتمعات التي تمر بصراعات عنيفة؟ هل هناك حد أدنى مشترك بين الأطراف المتصارعة يمكن الحفاظ عليه، وكيف؟
– كيف يمكن وضع دور المؤسسات المانحة الدولية في الحسبان عند وضع السياسة الثقافية الوطنية، وما هي الآليات المطلوبة لإشراك هذه المؤسسات في الحوار حول هذه السياسة؟
– كيف يمكن لعملية تطوير سياسات ثقافية جديدة، ولمحتوى هذه السياسات، أن يستجيبا لمشاكل الشرائح الاجتماعية الأوسع، والتي تعاني من الفقر والتهميش، وليس لديها وعي كبير بدور الثقافة في تحسين حياتها؟
بدون محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، ستبقى جهود تطوير السياسات الثقافية في البلدان العربية ضمن إطارين: أن تكون عملاً تنشيطياً ودعائياً من قبل مجموعات من المثقفين والفنانين المستقلين، يستهدف في المقام الأول انتقاد المنظومة الثقافية الرسمية، وتقديم بدائل لعملها لا تطبق عملياً، أو أن تكون وثيقة رسمية يسنها مسؤول أو مجموعة مسؤولين، دون مساندة او تبني لا من الجماعة الثقافية، ولا من شرائح اجتماعية مؤثرة، وفي أحيان كثيرة: دون نية حقيقية لتطبيقها بشكل عملي. في كلتا الحالتين ستبقى الشرائح الأوسع من المجتمع: الفقراء – الأميون – سكان الريف والبوادي والعشوائيات – معظم الشباب والأطفال، دون سياسة ثقافية تلبي احتياجاتهم. كل هذا بالإضافة إلى التجاهل التام للاحتياجات الثقافية للأعداد الكبيرة من النازحين والمهجرين في بلدان مثل لبنان والأردن وتونس وليبيا والعراق.
- خاتمة:
بالعودة إلى السؤال المضمر وراء هذا التناول للموضوعات الخمسة، وهو ماهية الدور الذي يمكن أن يقوم به الإبداع والإنتاج الثقافي في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي التي تمر بها المنطقة، وتأثير تلك العملية في شروط ومضامين هذا الإبداع والإنتاج، أود أن أختم هذا المقال بطرح خلافي أدعو القاريء إلى الاشتباك معه:
التحدي الأصعب الذي يواجه عملية التغيير الإجتماعي والسياسي هو منظومة القيّم والمفاهيم الاجتماعية المستندة إلى الدين، والتي تشكل رافعة اجتماعية هامة للحركات والتنظيمات الاسلامية المتشددة. الفراغات السياسية التي تحدث خلال عملية التغيير تعطي فرصة لهذه الحركات والتنظيمات للسيطرة على المجال العام بدرجات تتفاوت بين بلد وآخر، وتفرض حينها على الجميع أنظمة اجتماعية وسياسية قامعة للحريات الخاصة والعامة، وبالطبع معادية لحرية الإبداع الفني. مهما كانت درجة التذمر ضمن المجتمعات التي تسيطر عليها – ولو مؤقتاً – تلك الحركات والتنظيمات، إلا أنها لا تصل إلى درجة التناقض معها جوهرياً، نظراً لتشاركها في منظومة القيّم الاجتماعية المشار إليها سلفاً. تمثل هذه الحالة، الشائعة بشكل أو بآخر في المجتمعات العربية، ايضاحاً جلياً لكيفية تعطيل عملية التغيير الإجتماعي والسياسي، إذ كيف يمكن لهذا التغيير أن يحدث دون إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بوضع ودور المرأة، وبحق الأفراد في الخصوصية، وبالامتيازات التي ترتبط بالثروة أو التقدم في العمر، على سبيل المثال؟
إعادة النظر هذه تقصر عنها الأحزاب والحركات السياسية التي تصف نفسها بالمدنية أو العلمانية أو التقدمية، إذ أنها تحاول باستمرار، كي تضمن وجود بعض التأييد الاجتماعي لها، عدم الدخول في صدام مباشر مع هذه المفاهيم، بل وأحياناً ما تحرص على تأييد بعضها. على مستوى آخر، يحول شيوع الأمية ورداءة التعليم في معظم بلدان المنطقة بين أن يكون هناك نقاش عام حول هذه المفاهيم يثيره ويقوده مفكرون وفلاسفة ومنظّرون اجتماعيون.
يبدو لي أن مجالات التعبير والإبداع والإنتاج الفني مؤهلة أكثر من غيرها، بحكم كونها تطرح مواقف ووقائع متخيلة، وبحكم قدرتها على الوصول إلى قطاعات كبيرة من المجتمع، لأن تقوم بهذه المهمة الصعبة في فحص ونقد المفاهيم الإجتماعية السائدة، بهدف خلخلة جذورها في المجتمع، واستقطاب كتلة بين الشباب على الأخص يمكنها تطوير خطاب اجتماعي نقدي جديد، يحلّ مفاهيم احترام الحقوق والحريات الشخصية والعامة محل المفاهيم ذات الجذور الدينية التي ترسخ للتمييز بين الجنسين، والعنصرية، والقمع والظلم الاجتماعي. هذا الدور مرهون لا شك باقتناع عدد كبير من المبدعين ومنتجي الأعمال الفنية والثقافية، واستعدادهم لمواجهة قطاعات مؤثرة في المجتمع والسلطة، وقدرتهم على تحمل الأذى الذي قد ينتج عن هذه المواجهة.
ربما سيشعر بعض من يعملون في الإبداع والإنتاج الفني بأن هذا الطرح قد يثقل كاهل المبدعين بمسؤولية ربما لا يستطيعون – أو لا يرغبون – في حملها، وهذا أمر مفهوم طبعاً، ولكني أرى أن هذا قد يكون الاختيار الوحيد أمام المبدعين في المنطقة العربية، إذا كانوا يريدون الاستمرار في عملهم داخل بلدانهم، دون أن يضطروا إلى مغادرتها، أو إلى العمل في فقاعات صغيرة معزولة عن مجتمعاتهم، وكذلك إذا كانوا يطمحون إلى أن يتركوا للأجيال القادمة أرضاً للإبداع الفني أقل وعورة وتصحراً.
- هوامش:
[1] شهدت الأعوام من 2006 إلى 2010 نمو حركات مثل كفاية و6 ابريل والحمعية الوطنية للتغيير في مصر وحركة حق في البحرين والحركات الاحتجاجية التي تلت اغتيال رفيق الحريري في لبنان، والتي سرعان ما انتظمت في سياق الانقسام الطائفي اللبناني، والحركات الاحتجاجية الأمازيغية والاسلامية في المغرب – الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي، تحرير عمرو الشوبكي وإصدار منتدى البدائل العربي.
[2] تأسس المورد الثقافي في ربيع 2004 بمبادرة من مجموعة من الفنانين والناشطين الثقافيين العرب منهم بسمة الحسيني وحنان الحاج علي وروجيه عساف وطارق أبو الفتوح وعز الدين قنون وعلياء الجريدي وعادلة العايدي وغيرهم. اتفق المؤسسون وقتها على أن تكون مهمتهم الأولى هي ضخ دماء جديدة في شرايين الحياة الثقافية العربية عبر دعم شباب الفنانين الجدد، وعبروا عن اهتمامهم بإيجاد مصادر تمويل مستقلة للنشاط الثقافي والفني من خلال تأسيس صندوق مستقل للفنون العربية. بعد عامين من تأسيس المورد الثقافي واطلاقه لبعض من برامجه الأساسية، شارك مع مؤسسة المجتمع المفتوح في تأسيس الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، والذي يعد أول وأكبر مؤسسة مانحة مستقلة للفنون في المنطقة العربية.
مؤسسة أنا ليند: مؤسسة حكومية لدول أوروبا والبحر المتوسط، تأسست عام 2004 وبدأت عملها في 2005 وتهدف إلى تعزيز الثقة والتفاهم بين شعوب هذه الدول. تسترشد المؤسسة بمبادئ عملية برشلونة وتعمل من خلال مجموعة من الشبكات القومية في الدول الأعضاء[3]
[4] من رسالة من نبيل الخضر، الناشط الثقافي وعضو المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في اليمن رداً على أسئلتي في يوليو 2017.
[5] من رسالة من مراد القادري، رئيس بيت الشعر وعضو المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في المغرب، رداً على أسئلتي في يوليو 2017
[6] طعن في الحكم وأفرج عنه بعد أن قضى عاماً في السجن
[7] المصدر: دراسة للدكتور عماد أبو غازي نشرت في كتاب “الثقافة في الفترات الانتقالية” الصادر عن مركز الأهرام للدراسات عام 2014
[8] المصدر: وثيقة الحوار الوطني في اليمن 2014 – القرار 18 في فصل الحقوق والحريات “احياء الثقافة الفنية بإعادة مادة التربية الفنية وتشمل المسرح المدرسي إلى المدارس”
[9] نفس المصدر السابق: القرارات 53 إلى 61 في فصل التنمية، وكذلك الجزء الخاص بالتنمية الثقافية في نفس الفصل
[10] المصطلح الأصح والأٌقل شيوعاً هو “تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية”
[11] من رسالة من عبد الله الكفري، الكاتب المسرحي ومدير مؤسسة اتجاهات – ثقافة مستقلة، رداً على أسئلتي في يوليو 2017.
[12] المصدر: التقرير العالمي لمنظمة هيومان رايتس واتش 2017.
[13] من رسالة من نبيل الخضر، الناشط الثقافي وعضو المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في اليمن، رداً على أسئلتي في يوليو 2017.
[14] من رسالة من أحمد البخاري، ناشط ثقافي ومعلوماتي ومدير حركة تنوير، رداً على أسئلتي في يوليو 2017.
[15] المصدر: تقرير السياسات الثقافية في فلسطين لعام 2016 – موقع السياسات الثقافية العربية
[16] المصدر: استشراف مستقبل العمل الثقافي في فلسطين – فاتن فرحات – موقع السياسات الثقافية العربية.
[17] في عام 2011 منعت سلطة حماس فيلم “ماشو توك” لظهور فتاة لا تغطي شعرها في الفيلم، كما منعت هذه السلطات حفلاً للفنان الفلسطيني ذي الشعبية الكبيرة محمد عساف في 2014.
[18]من رسالة من مارينا برهم – مدير مسرح الحارة، رداً على أسئلتي في يونيو 2017.
[19] هناك أمثلة عديدة على منع داعش لأي مظهر من مظاهر الاحتفال في المناطق “المحررة” في سوريا، بالاضافة إلى قيام الفصائل المسلحة بتغيير كلمات الأغاني الشعبية واستخدامها في الدعاية السياسية، وبالطبع الرقابة الصارمة التي يمارسها النظام السوري تجاه الأعمال الفنية منذ عقود طويلة. معظم هذه الأمثلة وغيرها مذكور في مقال “الفن السوري في المناطق المحررة، أوركسترا بلا قائد” – موقع عنب بلدي – 2016
[20] The 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005
[21] http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/operational-guidelines/
[22] على سبيل المثال قامت اليونسكو بتدريب مجموعة من 28 شخصاً من وزارة الثقافة وقادة منظمات المحتمع المدني، عقب انضمام فلسطين إلى اليونسكو وتصديقها على الاتفاقية في 2011، وانتهى التدريب بتوصيات هامة – منها تكوين لجنة تقنية تتولى رصد تطبيق الاتفاقية وكتابة التقرير الدوري عنها، ولكن هذه التوصيات لم تنفذ، وقامت وزارة الثقافة منفردة بتقديم التقرير بعد عامين من موعده. المصدر: فاتن فرحات، الخبيرة لدى اليونسكو في مجال الحوكمة الثقافية.
[23] من رسالة لحبيبة العلوي، الشاعرة والأكاديمية، وعضو المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في الجزائر، رداً على أسئلتي في يوليو 2017.
[24] من رسالة لنبيل الخضر، الناشط ثقافي وعضو المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في اليمن، رداً على أسئلتي في يوليو 2017
[25] المصدر السابق
[26] من رسالة لمراد القادري، رئيس بيت الشعر وعضو المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في المغرب، رداً على أسئلتي في يوليو 2017.
[27] وفقاً للمنتج الفني والناشط الثقافي التونسي حبيب بالهادي، ورداً على أسئلتي في يوليو 2017.
[28] بدأت تلك المجموعة عملها في 2010 تحت مظلة مؤسسة المورد الثقافي واستمرت في العمل حتى 2013
[29] من رسالة للشاعر حسام السراي عضو المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في العراق، رداً على أسئلتي في يوليو 2017.
[30] من الأمثلة القليلة انشاء صندوق لتمويل الفنون في تونس
[31] من الأمثلة على ذلك محاولات مراد الصقلي في تونس، وعماد أبو غازي في مصر خلال توليهما منصب وزير الثقافة في تونس وفي مصر
[32] من الأمثلة على ذلك انخراط بعض المؤسسات الثقافية والفنانين في مشاريع تحت عناوين مثل “حوار الحضارات” و”بناء الجسور”، عندما أعلنت مؤسسة أنا ليند عن دعمها لمثل هذه المشاريع
[33] دراسة مقارنة عن بعض جوانب السياسات الثقافية في الجزائر وتونس والمغرب ومصر – عمار كساب ودنيا بن سليمان – كراسات في السياسات الثقافية – المورد الثقافي 2013.