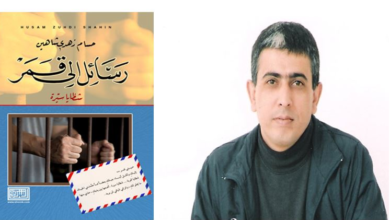لا طير يطير في “تل الزرازير”

تحمس “خالد” لفكرة رفيق الشقاوة “جمعة” وزينها لي، أخذ يشرح بكلمات مثيرة فائدة المغامرة التي اقترحها علينا “غنونة” (اسم الدلع لجمعة)، أخرج من جيب سرواله السكين القابلة للطي المشهورة باسم “موس السبع طقات”، قال لي بلهجة الواثق بنفسه:
- انظر سكينتي الأصلية ما أحدَّها وأقواها، إنها تذبح جمل، فهل تجسر الكلاب على الاقتراب منا؟
من دون أن أنظر إليها، أجبته متردداً:
- ربما تنبح كلاب ضيعة “الأنصاري” علينا وتهاجمنا قبل أن تشهر “الموس الكبّاس” وتفتحها، فما زلتَ بطيئاً في استخدامها.
تجهم وجه خالد وظهرت عليه علامات الامتعاض، فقد جرحتُ اعتزازه بمهارته في إشهار الموس الكبّاس، لقد تدربَ كثيراً على سحبِها من خصره وفتحِها بحركة واحدة منذ شرائها، حاول تقليد فتيان حينا اليافعين أمثال “الديب” و”الفارس” و”ناصر” الشجعان، جرح يده عدة مرات حتى بلغت مهارته باستخدامها مثلهم، في البداية استطاع فتحها على الطقة الخامسة، ثم تمكن من فتحها على الطقة السادسة، وأخيراً، نادراً ما تفتح معه سبع طقات على الآخر، بنترةٍ قوية خاطفة من يده اليمنى كما يفعل أولئك الفتيان القبضايات.
بعد برهة، زالت علامات الامتعاض عن وجه خالد، وبدت علامات الجدية محلها حين أزال مخاوفي بقوله:
- لا تخف يا جهاد، سيسبقنا غنونة في استخدام “المقلاع” الفتاك، كذلك أنت أشطر واحد في استخدام “النبلة” في حي “السكري” كله، لماذا أنت خائف من نزهتنا لصيد العصافير في “تل الزرازير”، هل نسيت يوم لاحقنا “أبو العمرين” إلى بساتين “جسر الحج” وكشفنا سره؟
عرف خالد كيف يثير شجاعتي ويهزم مخاوفي ويقوّم كبريائي، قلت له بتأثير كلماته السحرية:
- ولو، كيف أنسى “سر أبو العمرين”.. لقد أقنعتَني يا ابن عمي، هيا نجهز العدة ونتكل على الله.
فرح خالد بموافقتي على خوض المغامرة اللذيذة، ابتسم وقال:
- هيا بنا، فصديقنا جمعة يجرب مقلاعه الآن في “مزبلة حج نجيب” بانتظار قدومنا، هيا نناديه لنستمتع بصيد الطيور وأكل لحمها اللذيذ.
بعد قليل، مضينا نحن الثلاثة الشجعان (أنا وخالد وجمعة) لمواجهة أشرار ضيعة الأنصاري، كالفرسان الثلاثة في رواية “ألكسندر دوما” المشهورة، اجتزنا آخر بيوت حي السكري من جهة بيت المختار “أبو جلال”، سرنا باتجاه الوادي الذي يفصل بين الحي وبين بساتين تل الزرازير، كان جمعة يروي لنا مغامراته البطولية طوال الطريق ويقهقه ليشد أزرنا، ويقوي ثقتنا المزعزعة، أو على الأقل، ليقوي ثقتي المضعضعة بنفسي، أنا وحدي دونهما على ما أظن.
فثقتي بشجاعة جمعة لا تهتز بمقدار شعرة، كذلك ثقته بنفسه كبيرة، فهو أشقى فتى في حارتنا، يعادل شقاوة “اصطيف” أو يتفوق عليه بعض الأحيان.
أما خالد، فقد كان أشجع مني لاقتنائه الموس الكبّاس وتدربه عليها بعيداً عن أعين عمي (أبوه) وأخواته الكبيرات، فرغم هزال بنيته الجسدية، فإنه يمتلك مقدرات أكبر مما توحي به سنّه وجسده، ففي الركض مثلاً، كان أسرع صبيان الحارة، وخصوصاً في لعبة “التوش” والهروب بعد قرع أبواب الجيران، كما كان أشطر مني في فك وتركيب الآلات الميكانيكية، نظراً للخبرة التي اكتسبها من التعدي على دراجة أبيه النارية، كذلك كان يملك يدان قويتان نظراً لعمله مع عمي في أعمال “الزريقة” بالعطلة الصيفية.
أما أنا فقد كنت أستمد شجاعتي بالتخيّل فقط من وراء قصص مجلة “أسامة” التي بدأت بقراءتها مؤخراً، لكن على أرض الواقع، كنت جباناً خوّافاً من الكلاب، أخاف منها أكثر من خوفي من أولاد الحارة الزعران، أتخيلها وحوشاً تأكل بني آدم بلا رحمة كالضباع.
فكثيراً ما رافقتُ أمي وأم خالد وأم أحمد إلى أطراف بساتين تل الزرازير، للتفتيش عن “الخبّيزة” وغيرها من الأعشاب القابلة للطبخ وقطافها، فما أكثر ما نبحت علينا الكلاب المربوطة بالأشجار قرب بُرك السقاية في تلك البساتين، وكم طرَدَنا أصحابُها وقاموا بتهديدنا بإطلاق الكلاب الشرسة علينا،
فكنت أتخيلها تمزقني بأنيابها مثل الوحوش المفترسة في الكتب المدرسية ومجلة أسامة، حالما أسمع صوتها أبكي خوفاً وأتشبّث بملحفة أمي السوداء، فتمسكني من يدي وتجرني خلفها وخلف رفيقاتها الراكضات خوفاً من التهديدات، فأركض مع أمي ومن خلفنا نباح الكلاب يلاحقنا حتى نخرج من تخوم البستان إلى برّ السلام.
لاحظ خالد ترددي كلما اقترب صوت الكلاب من أسماعنا، يمدّ يده ويسحبني من يدي لأمشي بموازاته، بينما قائدنا جمعة المقدام يسبقنا في المقدمة.. نحثّ الخطى ونمشي بجواره، نسبقه بخطوة أو يسبقنا بخطوتين، نمشي في الدرب البري المفضي إلى حي “الراموسة” الصناعي في أحد أيام الجمعة – على ما أذكر – من أول أيام عطلتنا المدرسية الصيفية الرابعة، ويوم الجمعة هو يوم العطلة لمعظم العمال الذين يعملون في تصليح السيارات بالراموسة، لذلك لم نصادف الكثير من أبناء الحي العائدين إلى بيوتهم عصر ذلك اليوم.
كان الفرح يغمرنا بالفعل، فالجو لطيف، والطبيعة جميلة والكلاب بعيدة.. نضحك، نغني، نركض، نصفر مقلدين صوت البلابل والعصافير ونلهو كثيرا، قبل أن ينتهي الطريق الصاعد باتجاه الراموسة، وقريباً من أرضٍ زراعية كثيرة الأشجار، سمعنا الطيور تصدح بعذب الألحان وشاهدناها تطير فوق الأشجار، توقف جمعة ودعانا لدخول البستان خلسةً بعد أن جال بنظره شمال – يمين، وأمام – خلف، لم نسمع صوت كلاب ولا صوت آدمي إلا من بعيد جداً، قال لنا مرشدنا البطل غنونة بصوت خفيض:
- هيا اتبعاني وأخرجا سلاحكما، سنغير على عصافير هذا البستان، هيا بنا يا شباب.
أحنى جمعة ظهره باتجاه الأرض، سار ببطئ وهو يلتقط منها حصى تناسب حشوة مقلاعه بها، فعلتُ مثله وأنا أدعو بقلبي ألا يعترضنا أحد الكلاب أو الأشرار، أما خالد فقد التقط بضع حصوات من باب الإحتياط والدعم والإسناد.
وعلى مهل وبحذرٍ شديد، بدأنا نقترب من أجمة الأشجار وشدو الأطيار، وفي ذروة هذا المشهد الشاعري الجميل، خرج علينا كلب شرس قبيح الوجه، قذر الجسم، ضخم الجثة، مكشراً عن أنيابه الحادة الصفراء بنباح قوي مخيف، لم يكن مربوطاً بحبلٍ أو لجام، بل كان يقود عصبة من الكلاب الضالة للهجوم على الفتيان (نحن) الضالين.
فوجئ قائدنا جمعة بمنظر الكلاب ونباحها الصاخب، استدار خلفاً وركض هارباً قبل أن ندرك ماذا جرى، ركضنا خلفه بغريزتنا بأقصى ما نملك من سرعة وقوة، ننشد النجاة بأرواحنا وسلامة أجسادنا من فك الكلاب التي نسمع صوتها خلفنا!
بثوانٍ معدودة أصبحنا في عرض الطريق الترابي الواصل بين الراموسة والسكري، ومن حسن حظنا ولطف القضاء والقدر، صادفنا ثلاثة شبان عائدين من شغلهم إلى الحي، قام الشباب الثلاثة برمي الكلاب التي كانت تركض وتنبح خلفنا بالحجارة، فعادت أدراجها تلوي ذيولها وتعوي كالذئاب.
يا الله كم كنا في تلك اللحظة بحاجة لنصرة ناصر، وسرعة فارس وفروسيته، وشجاعة الديب، وحش شباب حارتنا الأشداء.. لكن الحمد لله الذي عوّضنا عنهم بهؤلاء العمال الثلاثة الشجعان، فلولاهم لهلكنا بأنياب الكلاب قبل أن ننتبه إلى استخدام أسلحتنا الاستراتيجية.
فمن هول المفاجأة وحجم الفزع، لم يخطر ببالنا مطلقاً أن نواجه الكلاب ونقارعها بالمقلاع والنبلة والموس الكبّاس، ومن خجلنا من هؤلاء العمال المنقذين، افترقنا عنهم حال وصولنا إلى مشارف حي السكري، لم نخبرهم بحقيقة مغامرتنا، ولا باسم حارتنا، ولا بشيء يكشف هويتنا، تجنباً للفضيحة والقيل والقال.
تسكعنا قليلاً في حينا الأمين الذي دخلناه من حارة “الملجأ” للتمويه على هويتنا، ثم توجهنا حوالي الغروب إلى حارتنا، وبقرب محل “أبو بشير” الفوّال، صادفنا ابن جيراننا “حمودة” الصغير مع بضعة أولاد، فتصيدناهم بما تبقى معنا من حجارة من بعيد، تمويهاً على هزيمتنا النكراء، ولتغطية فشلنا في اصطياد العصافير بتل الزرازير.
أما أنا فزدت على رفيقيَ خالد وجمعة، بأنني طمست مؤخرة ابن الجيران الصغير “جمال” بقذارته، فقد كان يفضل أن يخلع ثيابه ويتغوط في منتصف الشارع قدام بيتنا وبيتهم، فلطالما زجرته وشكوته لأمه ولم يرتدع، فلما ضبطته بالجرم المشهود مساء عودتنا من مغامرتنا الفاشلة، عاقبته ذلك العقاب الشافي لي وله، فما عاد جمال الصغير يكرر فعلته السيئة، وشفيت أنا من جروح هزيمتي المريرة، فنمت ليلتها قرير العين هانيها.
للأسف لم يَدُم هذا الهناء بخلاصي من كلاب تل الزرازير طويلاً، ففي الصف السادس الإبتدائي، بعد عام ونيف من تلك المغامرة المشؤومة، تم نقلنا إلزامياً من “مدرسة الثورة” في الحي، إلى “مدرسة تشرين” في تخوم ضيعة الأنصاري، التي أضحت حياً من أحياء حلب باسم حي الأنصاري الغربي.
انتابني الخوف الشديد حالما سمعتُ بقرار مديرية التربية، لم تشفع توسلاتي وتوسلات بقية تلاميذ الصف السادس، ولا توسط المختار، ولا رجاء أهالينا، بعدم نقلنا من مدرستنا السابقة، أعطانا المدير أوراقنا وقال لنا مودعاً:
- اذهبوا يا أبنائي للتسجيل والحضور بمدرسة تشرين، إنها مدرسة جديدة مبنية على الطرز الحديث وسط الطبيعة الخلابة، في الطريق إليها تشاهدون الطيور والحيوانات الأليفة والأشجار الباسقة والخضرة الدائمة والمياه المتدفقة في السواقي بأرض البساتين، فما أجمله من طريق، وما أجملها من مدرسة نموذجية، هيا يا أولادي سارعوا بالالتحاق بمدرستكم المسماة باسم حرب تشرين التحريرية، ادرسوا بجد لكي تحرروا الجولان والقدس، يا رجال المستقبل الواعد، يا جنود التحرير..
صفقنا للسيد المدير، رغم أننا نعلم أن خطابه الجزل لا يحرك ذرة تراب من مشاعرنا المحبطة، فالواقع الذي نعرفه عن موقع المدرسة الجديدة مظلم ومخيف، لا يوافق وصفه الشاعري بحرفٍ واحدٍ.
اجتمعتُ ثاني يوم مع عدد من رفاقي بساحة مكتب المختار في آخر خط الباص، التحق بنا كذلك صديقي أحمد ابن المختار، بحثنا مخاطر تنفيذ قرار النقل الجماعي الإلزامي والخيارات المتاحة أمامنا، فقال أحدهم: ما رأيكم أن نتسلح بالمدى والخناجر والحجارة؟
ضحكت من كل قلبي عندما سمعت اقتراح الزميل، تذكرت مغامرة صيد العصافير التي لم تنفع معها أسلحتنا البيضاء، فرجعنا منها إلى بيوتنا بوجوه سوداء.
قطع ضحكتي صوت زميل آخر جاء رداً على اقتراح الزميل الأول، قال مستنكراً: هل نحن ذاهبون لطلب العلم أم لطلب الثأر؟ وهل تسمح لنا إدارة المدرسة الجديدة بحمل السلاح؟
ردّ عليه تلميذ آخر: نطلب من أهالينا حراستنا في الذهاب والإياب.
صاح به صوت زاجر: اسكت يا هذا، ما أسخف هذا الاقتراح، أساساً أهالينا ما عرفوا كيف يتخلصوا منا، فكيف نطلب منهم مرافقتنا إلى مدرستنا البعيدة، ربما يخافون مثلنا من الكلاب والأشرار!
أخيراً قال صديقي أحمد بحكمة أبيه المختار: دعونا نذهب جماعة لا متفرقين، فالكثرة غلبتْ الشجاعة، ليحمل كل واحد منكم بعض الحصى في جيوبه، سنحاجر الأولاد الأشرار إذا لزم الأمر، ونردُّ الكلاب على أعقابها إذا أفلتوها علينا، مع أني لا أظنهم (الأشرار) يجرؤون على مهاجمتنا، فهم يعرفون من أنا ويعرفون أبي.. ثم هناك من رفاقنا مَن جاء مِن ضيعة الأنصاري ليدرس معنا في مدرسة الثورة، مثل “ابن الزنكاح” القوي المخلص لنا،
بالتأكيد لن يسمح لأبناء ضيعته أن يهاجمونا، لا.. لا أظن أحداً يجرؤ على مواجهتنا، هيا جهزوا أنفسكم وأدواتكم المدرسية وأوراق النقل والحقائب، نجتمع هنا أمام مكتب والدي في السابعة من صباح الغد، الله معكم وإلى اللقاء.
كانت الشمس مشرقة في خريف ذلك اليوم، حرارتها تبعث الدفء في نفوسنا مع نسمات الصباح الباردة، ومع حرارتها وحرارة اجتماع الرفاق، كسرنا الخوف والبرد والتردد، انطلقنا بصحبة زعيمنا ابن المختار باتجاه الوادي، قطعنا الوادي بأمان ودخلنا أراضي ضيعة الأنصاري من جهة بساتين تل الزرازير بوجلٍ حذرٍ، شاهدنا بناء المدرسة الكبير يلوح لنا من بعيد، أسرعنا الخطى نحو البناء المهيب بعزيمة وثبات طالما نسلك الطريق بأمان، وكلما اقتربنا من المدرسة تبينت لنا معالمها العالية المميزة عن الدور والحظائر المنخفضة المحيطة بها.
كانت جدرانها الخارجية الصفراء جديدة كاملة النظافة، ونوافذ الصفوف الزجاجية البراقة تعكس أشعة الشمس وترحب بنا، وبينما كنا نحث الخطى ونعلل أنفسنا بالآمال، على حين فجأة أمام إحدى حظائر الماشية بين بيوت الضيعة المتفرقة، خرجت علينا عصبةٌ من الأولاد الضخام الأجساد، يرتدون ثياباً فضفاضة متسخة من قطعة واحدة (كلابية)، ينتعلون جزمات طويلة الساق عليها آثار الطين، بأيديهم حبال مربوطة برقاب كلاب سوقية تعوي وتتوثب للهجوم علينا..
كم كانت صدمتنا كبيرة مباغتة، وكم كانت خيبتنا أكبر حين ميزنا وجه زميلنا حليفنا ابن الزنكاح، كان واقفاً باعتزاز بين الفتية الأشرار كأنه زعيمهم، بيده عصا غليظة يهش بها على الكلاب المفترسة، لكن ليس من أجل أن يردعها عن النباح والهجوم، بل أخذ يشتمنا طالباً من رفاقه أن يفلتوا الكلاب من حبالها، لتهجم علينا وتمزقنا إرباً إرباً كالكباب!
أفلتَ ابن الزنكاح كلبه من عقاله نحونا قائلاً بلهجة آمرة:
- هيا يا كلبي، اهجم عليهم، هيا جيبو..
حاول بعض الشجعان من رفاقنا أن يتصدى لهجوم الكلاب التي تبعت كلب الزعيم، فقاموا برميها بالحجارة على قدر المستطاع، والأقل شجاعة ردوا على شتائم عصابة الأشرار بمثلها وأكثر فحشاً وعدداً، أمّا الجبناء من أمثالي، فأخذنا نسابق ابن المختار في الركض السريع حتى وصلنا قبله إلى الوادي الرحيب، هناك حيث تقع مسافة الأمان، توقفنا عن الجري لبرهة من الوقت، التقطنا أنفاسنا، وأحصينا خسائرنا، ورتبنا هندامنا ونظفناه، ثم أكملنا الطريق مشياً إلى حينا الآمن الحبيب.
بعد ذلك اليوم، أضربتُ عن الذهاب إلى المدرسة، كذلك فعل صديقي ابن المختار وبعض الزملاء، بحث أهالينا عن مدارس أخرى تقبل تسجيلنا فيها، فوجد لي أبي مدرسة “المعتصم” في حي الفردوس، و وجد آباء باقي الزملاء مدرسة “الطلائع الثورية” في حي بستان القصر، صحيح أن مدرستي ومدرسة صديقي أحمد ابن المختار أبعد من مدرسة تشرين عن حي السكري، إلا أنَّ الطريق إلى كلتا المدرستين، معبدٌ بالأسفلت، مزودٌ بوسائل المواصلات، خالٍ من الكلاب.
من الطبيعي أن لا أقتربَ من تل الزرازير بعد الأهوال التي شهدتها فيه بطفولتي، كذلك ابتعدتُ عنه وعن حي السكري في شبابي، فقد سكنت عائلتي بعيداً عنهما في عدة أحياء من حلب، خلال شبابي زرت تل الزرازير بعد زواجي في زيارات عائلية لبعض الأصدقاء،
تل الزرازير الذي زرته لأول مرة في شبابي، لا يمتّ بصلةٍ للتل الأخضر الذي عرفته في طفولتي، اختفت الأشجار والخضروات والسواقي من أرضه، وحلَّ محلها عمارات طابقية عشوائية وبعض الدور العربية، شاهدت أيضاً مشاريع بناء وحدات سكنية نظامية على أراضي حي الأنصاري الغربي، بعضها انتهى وتم سكنه، والبعض الآخر قيد البناء.
أُلحقَ تل الزرازير وقتذاك بحي السكري من جهة الجنوب، وأصبحت مواصلات حي السكري العامة تجول فيه، ثم اتصل فيما بعد بحي العامرية الذي بنته الدولة لسكن العساكر على أراضي ضيعة الأنصاري سابقاً، ومن جهة أخرى توسع البناء العشوائي المخالف للأنظمة والقوانين في التل حتى اتصل بحي الراموسة الصناعي، كانت بعض قطع الأراضي البور تتخلل الأبنية، لكنها خلَتْ من الخضرة والطيور بانتظار تاجر البناء الشاطر.
زرت تل الزرازير آخر مرة في حياتي قبل ربيع عام ٢٠١١ بسنوات قليلة، فلم أجد قطعة أرض جرداء من مخلفات البساتين الخضراء، لم يترك تجار البناء بقعة أرض إلا و أقاموا عليها أبنية رمادية شوهاء، كان يتم بناء العمارة ليل نهار طمعاً في المال، فقد صرّح أحدهم أنه يشتري سكوت البلدية لمدة معينة برشوة محددة السعر حسب الطوابق وعدد الأيام، فعلى الغالب، وفي غضون أسبوع واحد من الزمان، يكون التاجر الشاطر قد انتهى من بناء عمارة من أربع طوابق وما فوق، وفوق ذلك، يكون قد انتهى من بيعها بالكامل!
بدأتْ بعض البنايات العشوائية تتهدم على رؤوس ساكنيها في العقد الأول من الألفية الثالثة، سقطت أرواح كثيرة بسبب جشع تجار البناء، وفساد رجال البلدية، وغياب الشفافية والمحاسبة الجدية..
توالت عمليات الهدم المقصودة بعد ربيع عام ٢٠١١ على أثر الخراب الكبير الذي حلّ في البلاد والعباد، فتهدمت الأبنية في تل الزرازير، وحي العامرية، وحي السكري، بسبب البراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف، التي سقطت من السماء على البنايات والبيوت حتى سوّتها بالأرض، فسقطت البيوت المدمرة على رؤوس ساكنيها الفقراء، وامتزجت الأشلاء بالركام والأنقاض والدماء..
أين أنت يا أستاذ غسان، تعال انظر ماذا حلّ بالخضرة والطيور والماء الجاري والطبيعة الغنّاء؟
أين الجنان التي حدثتنا عنها عندما نقلتَنا – نحن تلاميذ الصف السادس – من مدرسة الثورة بحي السكري، إلى مدرسة تشرين في تل الزرازير؟
انظر الآن معي إلى صور الخراب والدمار، فلا طير يطير في تل الزرازير، ولا وحشٌ يسير إلا الوحوش البشرية، انظر كيف تخرّجَ بعض تلاميذك من مدرسة تشرين، وثكنات الجيش، كجنود أبطال كما توقعتَ لنا، لكن ليس لتحرير الجولان والقدس كما قلتَ لنا، بل لقصف مدرسة الثورة وتشرين، ومدن الوطن وسكانها الآمنين بدل العدو المبين!.
جهاد الدين رمضان – في فيينا ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ .