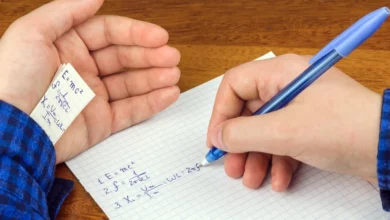الواقع العربي وأزمة ممارسة الديمقراطية

تعددت مفاهيم الدولة خلال التاريخ، واختلف المفكرون والسياسيون حول هذه المفاهيم التي تنوعت وتغيرت، بحسب مراحل التطور التاريخي، وبحسب مصالح الأطراف المتعددة التي حددت ماهيتها ومضامينها في ضوء هذه المصالح.
أعطى البعض للدولة السلطة الكليّة على الحياة والناس، وأوكل إليها إدارة شؤونهم دون رقابة جدية، وطالبهم بالخضوع لها وقبول قراراتها، بينما رأى بعض آخر ضرورة إخضاعها للرقابة وسلطة الشعب، وقرر طرف ثالث أن وظيفة الدولة هي التنسيق بين مصالح فئات المجتمع وتياراته، في إطار توافقهم على عقد اجتماعي.
وبناء على ذلك، لا تتجاوز سلطتها هذا التنسيق وتحقيق التوازن دون أن تملك، وقال آخرون بعدم ضرورة الدولة من حيث المبدأ، لأنها قوة قمع لطبقة بعينها، وأن استمرارها مرتبط باستمرار التفاوت الطبقي في المجتمع، وأن زوالها حتمي إذا ما أزيل هذا التفاوت. وهكذا ظلّ مفهوم الدولة ووظائفها أمرًا إشكاليًا يتغيّر من زمان إلى زمان، ومن مرحلة تطور إلى أخرى.
تداخل مفهوم الدولة بمفهوم السلطة أيضًا، فمن قائل بأن الدولة هي مفهوم ووعاء يستوعب الأرض والمجتمع والثقافة والانتماء، وهي لجميع مواطنيها بغض النظر عن مصالحهم وتياراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفلسفاتهم وأديانهم،
على حين أن السلطة هي وسيلة يتوافق الناس عليها ويختارونها اختيارًا حرًا، ويكلفونها بحراسة عقدهم الاجتماعي أو دستورهم أو اتفاقهم المسبق على أسس العيش المشترك وتحقيق مصالح المجتمع وقبول التداول السلمي للسلطة، وعلى ذلك؛ فالدولة للجميع والسلطة للأغلبية التي يتم اختيارها في إطار آليات متفق عليها.
أخذت الدولة الحديثة، منذ بدء النهضة الأوروبية، تستكمل معاييرها وقواعدها وأسسها ومفاهيمها وعلاقاتها بمواطنيها، ثم علاقتها بالسلطة، وبالرغم من تعدد مواصفات هذه الدولة بين بلد وآخر، ومذهب وآخر، ومجتمع وآخر، فإن التجارب الإنسانية في مختلف البلدان ولدى مجمل الشعوب والثقافات والحضارات اتفقت على إطار عام يُحدد مفاهيم الدولة، أساسه أنها دولة مواطنين أحرار في مجتمع حرّ.
وأنها لجميع مواطنيها الذين من حقّهم أن يختاروا نظامهم السياسي الاقتصادي اختيارًا حرًا، أي من حقهم ممارسة الديمقراطية في اختيار السلطة التي تدير الدولة ومؤسساتها في إطار توافقات مجتمعية تُلزم الجميع، سواء في القواعد والضوابط أم في الوسائل التي تؤهل لهذا الاختيار.
لعلّ معظم مجتمعات عالمنا المعاصر أصبحت ترى أن مهمات الدولة الحديثة السياسية هي حماية السيادة الوطنية، والمحافظة على وحدة أراضي الوطن، والدفاع عن شعبه، وفي الوقت نفسه تحقيق سيادة المواطن المتمثلة بحفظ حقوقه الأساسية وتأمينها، وعلى رأسها حقه بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة والتعددية وإقامة مؤسساته السياسية والمجتمعية،
وحقّه بتكافؤ الفرص والحوار والوصول إلى المعرفة، وأخيرًا حقه برقابة السلطة، سواء بطريق المؤسسات التي يقيمها أم بوسائل الاتصال التي يملكها، على أن يلتزم المواطن بواجباته التي يحددها العقد الاجتماعي أو الدستور أو القانون الأساسي أو أي اتفاق يتوافق عليه المجتمع ويتعهّد بعدم الإخلال بمضمونه.
في ضوء ذلك، فإن من أسس الدولة الحديثة الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة، وبحق المجتمع في إقامة تنظيماته السياسية والمجتمعية، وفي رقابة السلطات التي أوجدها لحراسة عقده الاجتماعي، ومن ذلك احترام حقّ الأقلية في نشر برامجها والدفاع عنها وإيجاد المناخ الملائم لها لتتحول إلى أكثرية، ومن حق الأكثرية إدارة البلاد بهدف تحقيق برامجها.
إن حراسة هذه التوافقات المشار إليها تقتضي أن يُقيم المجتمع سلطات ومؤسسات تابعة له، يختارها بحرية وفي إطار آليات ديمقراطية مهمتها تطبيق مضامين هذه (العقود) والإشراف على حسن تطبيق المعايير والتوافقات، وهذه السلطات -كما هو متعارف عليه- هي التشريعية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى مؤسسات إدارية عديدة، مهمتها تنفيذ قرارات هذه السلطات وتوجهاتها، وهي مؤسسات الدولة وإداراتها.
أصبح من المسلّم به فصل السلطات بعضها عن البعض الآخر، وضمان استقلالية كلّ منها، وتعتمد صحة الديمقراطية وجدواها وفعاليتها على جدية فصل هذه السلطات، ومراقبة كل منها الأخرى، وتأدية وظائفها بكمال وشفافية، وهكذا فالسلطات منفصلة ومتصلة في الآن نفسه، في إطار سياق عام يحترم خصوصياتها ومهماتها وواجباتها وحقوقها.
لا يستكين المجتمع في الأنظمة الديمقراطية، ويكتفي باختيار ممثليه وبإقامة هذه السلطات ثم تفويضها بإدارة شؤون الدولة ومصالح الناس، بل عليه أن يقيم مؤسساته السياسية والمجتمعية والمهنية، كالأحزاب والمنظمات الاجتماعية والجمعيات والمنابر الثقافية والصحف ووسائل الإعلام وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي يُساهم من خلالها في تنشيط الحراك الاجتماعي، وتشكيل وعي المواطنين، ومراقبة السلطات،
ويكون ذلك لرفد نشاط الدولة وليس على الضد منه، وبالتوازي مع مؤسساتها، وليس على التعارض معها. ومن شأن هذا كله تأسيس الدولة الحديثة والسلطة الديمقراطية والمجتمع الفاعل وضمان حقوق المواطنين وتشخيص واجباتهم.
لم تستكمل الدولة العربية الحديثة مواصفات الدولة ومعاييرها، بسبب موجات الاستعمار الحديث، ثم بسبب الغزو الصهيوني وما تبعه من حروب وعدوان، وأخيرًا بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسلطات الشمولية.
وبناء على ذلك كله، لم تعترف الدولة العربية الحديثة بأن الرابط الوحيد الأساس بين السلطة والمواطن، والدولة والمواطن، هو رابط المواطنة، وأن المعايير الوحيدة التي تقوم عليها هي معايير المساواة بين المواطنين وحرية القول والعمل والحوار والتعبير وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، كما لم تعترف بأن المجتمع هو سيّد السلطة ومالكها ومصدر السلطات وصاحب الحق بتقرير مصيره.
لذلك لم تفسح لهذا المجتمع الطريق لإقامة نظامه السياسي الذي يريده، باختياره الحر وبآلياته الخاصة، ورفضت قبول مبدأ التداول السلمي للسلطة التي غالبًا ما يتم الاستيلاء عليها بطرق استثنائية لا يُشارك فيها الناس، وبقيت معايير الدولة بعيدة عن المعايير الحديثة، كليًا أو جزئيًا، وبناء على ذلك، يصعب وصف الدولة الشعبية حتى الآن بأنها دولة لكل مواطنيها، إذ تعذّر عليها جعل رابطة المواطنة معيارًا وحيدًا للحقوق والواجبات.
ومن العدل الإشارةُ إلى بدء نشوء بعض تجارب لدول عربية حديثة، إلا أن هذه التجارب انتكست ثم تلاشت، بعد أن تولت فئات بعينها السلطة أو استولت عليها، وأعطت لنفسها حقوق ملكية الدولة، ولم تكتف بإدارتها بمعزل عن المجتمعات.
لقد أعطت السلطات العربية الحاكمة لنفسها الحقّ في الهيمنة على الدولة كلها، بجميع سلطاتها ومؤسساتها، وحلت الفئات الحاكمة واقعيًا محلّ هذه السلطات، ووظفتها في خدمة النظام السياسي بالدرجة الأولى.
وفي الوقت نفسه، حيّدت المجتمع وصادرت مؤسساته السياسية والمجتمعية وتنظيماته المدنية، ومنعته من إقامة غيرها كالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والصحف ووسائل الإعلام… وفرضت قوانين الطوارئ والأحكام العرفية، ووضعت البلاد في مناخ استثنائي.
وهكذا شهدت العديد من الدول العربية منذ استقلالها أنظمة سياسية مستبدة، لم تُختر اختيارًا حرًا ديمقراطيًا، ولم تذق هذه البلدان طعم فصل السلطات أو مراقبتها، وقبضت العصبة الحاكمة على كامل السلطات، وتحول المواطنون إلى رعايا، وأُغفل دور المجتمعات، وخاصة في الأنظمة “التقدمية” الناجمة عن انقلابات عسكرية،
فقد استعادت هذه الأنظمة بعض الشعارات القومية والاشتراكية والتقدمية وشعارات الديمقراطية الشعبية، ولكنها في المضمون لم تخرج عن كونها غير ديمقراطية بل استبدادية، حيث إنها صادرت الحريات، واستولت على جميع السلطات، ورفضت مبدأ التداول السلمي للسلطة، وحلّت الأحزاب، وألغت النشاطات السياسية، وأمّمت النقابات والمنظمات الشعبية والمهنية، وألغت حرية الصحافة والثقافة، وطبّقت الأحكام العرفية، وأنشأت المحاكم الاستثنائية، ووسّعت صلاحيات أجهزة الأمن.
ونتيجة هذا؛ تم عزل المجتمع عن دولته، وتم تجويفه من بذور الإبداع والمثابرة والاهتمام بالهمّ العام، ومن مؤسساته المدنية وحقوقه السياسية، وخلق فجوة واسعة بينه وبين الدولة، حتى صارت الدولة هي الآخر بالنسبة إليه، والسلطة هي الأول والآخر، بمعنى القدرة والقوة والنفوذ،
وأصبحت متداولة ومشهودة ونمطية ممارسات القمع والعسف وفرض الأحكام العرفية وخرق القانون وإلغاء الحريات ووأد الحياة السياسية والنشاطات المجتمعية وانتشار الفساد وتراخي الرقابة ومصادرة المجتمع وثرواته وإمكانياته وإبعاده عن الاشتراك في تدبير شؤونه وتقرير مصيره.
- وقد أوصلت هذه الحالُ المجتمعات العربية إلى نتائج مدمرة، تبدّت في:
أولًا – فشل خطط التنمية العربية لأسباب عديدة، أهمّها عدم إشراك المجتمع في وضعها، أو المشاركة في تنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ ونقدها وتقويمها، حيث كانت هذه الخطط غالبًا خططًا غير عادلة، تستجيب لحاجات السلطة الحاكمة أكثر من استجابتها لحاجات الناس، يضعها البيروقراطيون، ويشرفون على تنفيذها، مما أدى إلى فشلها.
ثانيًا – لم تستطع الأنظمة العربية، بسبب مسارها غير الديمقراطي وغير الجماهيري، أن تحقق أهدافًا وطنيةً كبرى، يحتاج تحقيقها إلى موقف وطني شامل موحد تشارك فيه كل فئات المجتمع، كما حال محو الأمية أو نشر الثقافة الديمقراطية أو التربية على حقوق الإنسان، وانعكاس ذلك على سلوك الناس.
ثالثًا – اضطرت السلطة غير الديمقراطية، لتعزيز سلطتها، إلى التعاون مع قوى تقليدية، من بقايا منظمات وتنظيمات وتجمعات ما قبل الدولة، فحال ذلك دون تطوير هذه الأنظمة ومن ثم تطوير الدولة، كما فتحت الأبواب في الوقت نفسه لجموع الانتهازيين وأصحاب المصالح الخاصة، ليشاركوا الحكّام شيئًا من السلطة وشيئًا من الثروة، وأدى ذلك إلى تدمير الطبقة الوسطى التي تُشكّل عادة نسغ حياة المجتمع والمغذي لحراكه ونشاطه.
رابعًا – رغبة السلطة الحاكمة الجامحة في الاستمرار بالشروط نفسها جعلت سلّم أولوياتها هو الأساس، متغافلة عن سلّم أولويات المجتمع، وفي ضوء ذلك، أهملت أولويات أساسية وجوهرية، مثل تمكين المرأة ومشاركتها في حراك المجتمع وقيادته وتوطين التقانة وبناء مجتمع المعرفة وتخليص التراث من شوائبه وإعادة بناء الثقافة القومية، وعدم الخروج من مستنقع القطرية، والاكتفاء بما هو داخل الحدود، وإهمال الأمة التاريخية وضرورة تواصلها مع الثقافات والحضارات الإنسانية.
أخيرًا؛ يمكن القول إن الأزمة هي أزمة مجتمعات، وليست فقط أزمة أنظمة وأزمة ديمقراطية، وعلى ذلك، فإن إقامة أنظمة ديمقراطية تحتاج إلى مناخ وشروط وظروف جديدة، وإعادة تربية مجتمعاتنا المجوفة، وهذا يقتضي مزيدًا من الوقت والجهد ومشاركة جميع القوى الحيّة، ولا يمكن تحقيق ذلك، لا بانقلابات، ولا بثورات، ولا بأيّ ممارسات مشابهة.