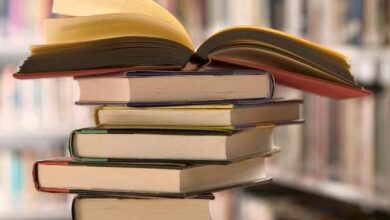يعتبر كتاب ‘القضية الفلسطينية’ لمؤلفه إدوارد سعيد كتاباً جيداً ومفيداً لا يقل في أهميته عن كتاب ‘الاستشراق’. وهو الكتاب الذي حقق الشهرة لهذا المفكر الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية، والذي كان يدرّس الأدب المقارن في جامعة كولومبيا. كما يضع هذا الكتاب إحدى ‘وجهات النظر الفلسطينية’ القليلة حول تاريخ فلسطين بين يدي الثقافة الغربية.
ولا يزال هذا الكتاب، الذي نُشر قبل حوالي عشرين عاماً، يعرض جوانب وموضوعات متميزة تستحق الدراسة والتمحيص. كما يتيح هذا الكتاب لنا أن ننظر بعمق إلى الجذور التاريخية التي تقف وراء ما يحصل على أرض فلسطين في هذه الأيام، من حيث الفشل الذريع الذي لحق باتفاقيات أسلو، ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية في العملية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين،
واندلاع الانتفاضة الثانية التي تسعى إلى تحقيق الاستقلال التام للشعب الفلسطيني، وتدمير ما تبقى من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بعد أربعين عاماً من سني الاحتلال العسكري، وتقويض منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية، والمجازر التي لا تكاد تنتهي بحق اليهود، وقبلهم الفلسطينيين.
وأظن أن ما يجعل كتاب ‘القضية الفلسطينية’ لإدوارد سعيد ذا قيمة لا يستهان بها هو محاولته إعادة وضع ‘قضية فلسطين’ في سياق المنظور الفلسطيني – وليس إلى المنظور العربي أو الإسلامي العام – والانطلاق من نقطة بداية الأحداث: والتي تتمثل بولادة الحركة الصهيونية، وبثّ أيديولوجيتها في سياق الثقافة الاستعمارية الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر من القرن الماضي وتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين.
وفي نفس الوقت، يعرض سعيد في كتابه نبذة موجزة حول تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث يقدم عرضاً شاملاً حول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية التي يتميز بها هذا الشعب.
وكما يقول المؤلف، يتعين علينا أن ننطلق من هذه العناصر إن كنا نريد ‘أن نفهم’ القضية الفلسطينية. وبالتوازي مع الاقتراح المنهجي، تعني عبارة ‘أن نفهم’ أن نُلقي الضوء على التواصل التاريخي والأيديولوجي الذي يربط عدداً ضخماً من الأحداث مع بعضها البعض ضمن سلسلة طويلة تشمل الموجات الأولى من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين،
وتأسيس دولة إسرائيل، وتوسعها الإقليمي المتزايد، وتشريد الشعب الفلسطيني عام 1948، وإنكار الهوية الجماعية للفلسطينيين (من قِبل الإسرائيليين والعرب على حد سواء)، والاحتلال العسكري لجميع الأراضي الفلسطينية، والانتفاضتين الأولى والثانية، والتفجيرات الانتحارية الإرهابية التي تعبّر عن أحد أكثر أشكال الوطنية الفلسطينية الراديكالية.
ومن خلال جمع عدد كبير من الوثائق وتفسيرها بلغة قوية، يتضح لنا أن سعيد يصرّ على مسألة مهمة. فبين القرنين التاسع عشر والعشرين حينما كانت القوى الأوروبية – وعلى رأسها إنجلترا – تعمل على تحديد مصير فلسطين وتشجع الحركة الصهيونية على احتلالها، لم تكن فلسطين صحراء لا سكان فيها.
بل على العكس من ذلك، كانت فلسطين بلداً عامراً بمجتمع مدني ذي كيان سياسي يناهز عدد أفراده 600,000 نسمة، كانوا يعيشون في هذه الأرض بصورة شرعية لقرون خلت.
وقد كان الفلسطينيون الذين يتحدثون العربية في معظمهم من السُّنة ويعيشون جنباً مع الأقليات المسيحية والدرزية والشيعة، الذين ينطقون العربية كذلك.
وبفضل مستواهم التعليمي العالي، كان يُنظر إلى أبناء الطبقة المتوسطة في فلسطين من بين النخبة في الشرق الأوسط؛ حيث كان المفكرون والمقاولون وموظفو البنوك الفلسطينيون يتبوأون مناصب بارزة في الدول العربية والإدارات الحكومية والمنشآت الصناعية في العالم العربي.
ولم يزل هذا الوضع الاجتماعي والديموغرافي يَسِم فلسطين في العقود الأولى من القرن العشرين، كما بقي هذا الوضع قائماً حتى أسابيع قليلة قبل إقامة دولة إسرائيل في ربيع عام 1948. وفي ذلك الوقت، كان السكان الأصليون الذين قارب عددهم 1,500,000 نسمة يعيشون في فلسطين (في حين كان عدد اليهود – وعلى الرغم من الأعداد الضخمة التي تدفقت إلى فلسطين خلال حقبة ما بعد الحرب – يزيد عن 500,000 بقليل).
ونحن نرى أن القصة الكاملة للغزو الصهيوني لفلسطين وإعلان دولة إسرائيل من جانب واحد يتمحور حول كيان أيديولوجي ستجسده في مرحلة لاحقة استراتيجية سياسية منهجية تتمثل في إنكار وجود الشعب الفلسطيني.
وفي التصريحات التي كان يبوح بها الزعماء الصهيونيون البارزون – من ثيودور هرتزل إلى موزيس هيس ومناحيم بيغين وحاييم وايزمان – نستشف تجاهلاً منقطع النظر لوجود الشعب الفلسطيني. وفي أحسن الأحوال، نرى هؤلاء الزعماء يصفون الفلسطينيين بالبرابرة والمرتزقة والكسالى ومنفلتي العقال.
وترتبط بهذه الصورة النمطية الاستعمارية التي كان الزعماء الصهيونيون ينشرونها الفكرة التي تقول بأن مهمة اليهود كانت تتمثل في امتلاك زمام الأمور في إقليم متخلف هجره سكانه بهدف إعادة بنائه من أساسه وتحديثه’.
ووفقاً لإحدى التفسيرات الراديكالية لـ’المهمة الحضارية’ التي كانت تقودها أوروبا و’استعمارها الذي يهدف إلى إعادة بناء الدول المستعمرة وإعمارها’، عملت المؤسسة السياسية والاقتصادية الإسرائيلية على استبعاد أي شكل من أشكال التعاون مع سكان فلسطين الأصليين، ناهيك عن إخضاعهم واستعبادهم (في حين فتحت الدولة الإسرائيلية ذراعيها لاحتضان كافة اليهود من جميع أنحاء العالم).
وليس من الغريب أن أول صراع من الصراعات الكبرى التي أُجبر الفلسطينيون على خوضها بعد قيام دولة إسرائيل كان يناهض استئصال وجودهم التاريخي في فلسطين. وقد كان الهدف الرئيسي من هذا الصراع ينصب على مطالبة – إسرائيل والدول العربية كمصر والأردن وسوريا – بالاعتراف بهويتهم الجماعية وبحقهم في تقرير مصيرهم.
وفي مرحلة لاحقة لم تر النور حتى عام 1974، أضحت الأمم المتحدة تعترف بوجود طرف دولي يسمى فلسطين بصورة رسمية، كما تعترف بياسر عرفات ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني.
إن إنكار وجود شعب على الأرض، التي كان من المقرر إقامة دولة يهودية عليها، يمثل وصمة عار استعمارية وعنصرية تَسِم الحركة الصهيونية منذ نشأتها كحركة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوى الاستعمارية الأوروبية التي تدعمها وتساندها بمختلف الطرق والأساليب.
وبعد زمن طويل من وضع الخطط لإقامة الدولة اليهودية في الأرجنتين أو جنوب أفريقيا أو قبرص، ركزت الحركة الصهيونية أنظارها على فلسطين. ولم يكن ذلك لأسباب دينية، بل لأن عدداً كبيراً من أتباع هذه الحركة كانوا يعتقدون أن فلسطين كانت تمثل ‘أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض’، بحسب مقولة إسرائيل زانغويل.
وفي سياق ها المنطق الاستعماري، تم تهجير أعداد ضخمة من الفلسطينيين – حوالي 700,000 فلسطيني – من أرضهم. وقد جرى تنفيذ هذا المخطط من خلال الأعمال الإرهابية التي مارستها المنظمات الصهيونية، وفي مقدمتها عصابة “شتيرن” التي كان إسحاق شامير يقودها وعصابة إيرغن زواي ليئومي التي تزعمها مناحيم بيغين.
وقد ارتبط اسما هاتين العصابتين بالمسؤولية عن المجرزة التي راح ضحيتها ما يزيد عن 250 مواطناً فلسطينياً من سكان قرية دير ياسين.
وعقب انتهاء الحرب الأولى التي دارت بين العرب والإسرائيليين، توسعت الأراضي التي كانت إسرائيل تحتلها، حيث زادت عما كانت نسبته 56% من أرض فلسطين الانتدابية، التي مُنحت لإسرائيل بناءً على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى 78% من الأرض الفلسطينية، بما فيها كامل منطقة الجليل ومعظم مدينة القدس.
وكما يعلم الجميع، قامت إسرائيل بعد حرب الأيام الستة التي اندلعت عام 1967 بالاستيلاء على المساحة المتبقية من فلسطين (وهي 22%)، كما قامت بضم القدس الشرقية إلى إقليمها بصورة غير قانونية، وفرضت نظاماً قاسياً من الاحتلال العسكري على سكان قطاع غزة والضفة الغربية الذي يناهز عددهم المليونين.
وترافقت جميع هذه الإجراءات مع مصادرة أراضي الفلسطينيين بطريقة منهجية، وهدم آلالاف من منازل المواطنين الفلسطينيين، ومَحْو قرىً فلسطينية بأكملها من الوجود، وإنشاء عدد كبير من الأحياء في المناطق العربية من القدس والناصرة.
وعدا عن ذلك، توفر المستوطنات الاستعمارية التي تقيمها إسرائيل في الأراضي المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية دليلاً دامغاً على الأساس الذي ترتكز عليه النظرة ‘الاستعمارية’ للأحداث التي يستعرضها إدوارد سعيد.
فإن لم يكن الأمر كذلك، فكيف يمكننا أن نفسر أن دولة إسرائيل – بعد أن احتلت 78% من أرض فلسطين وبعد أن ضمت القدس الشرقية ووطّنت ما لا يقل عن 180,000 مستوطن يهودي في الأراضي المحتلة – قد شرعت في عملية استعمارية لا يهدأ لها أوار فيما تبقى للفلسطينيين من أرض لا تزيد مساحتها عن 22% من مجمل أراضي فلسطين، وهي الخاضعة أصلاً للاحتلال العسكري؟
وكما نعلم، فقد قامت إسرائيل منذ عام 1968، وبناءً على مبادرات الحكومات اليمينية والحكومات التي يشكّلها حزب العمل، بمصادرة ما يقرب من 52% من أراضي الضفة الغربية، وإقامة أكثر من 200 مستوطنة فيها. وفي قطاع غزة الذي يشهد اكتظاظاً سكانياً وفقراً مدقعاً قلّ لهما نظير، فقد أقدمت إسرائيل على مصادرة ما تقارب مساحته 32% من أراضي القطاع وأقامت عليها أكثر من 30 مستوطنة.
وفي هذه الأيام، لا يقل عدد المستوطنين الذين يقطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن 450,000 مستوطن يهودي يسكنون في منازل محصنة. وترتبط المستوطنات التي يقيم فيها هؤلاء المستوطنون مع بعضها البعض ومع إسرائيل بشبكة من الطرق (التي تعرف بـ”الطرق الإلتفافية”) التي يُمنع الفلسطينيون من السفر عليها والتي تقطّع أوصال ما تبقى لهم من أرض وطنهم.
ولذلك، يمكننا أن نستنتج، جنباً إلى جنب مع إدوارد سعيد، بأن ‘الخطيئة الكبرى’ التي اقترفتها دولة إسرائيل تتمثل في طبيعة الصهيونية المتأصلة فيها، والتي ترفض العيش بسلام بجوار الشعب الفلسطيني. والأسوأ من ذلك أن إسرائيل لم تنجح في تعزيز تجانسها الديموغرافي دون اللجوء إلى ممارسات قمعية واستعمارية وعنصرية في جوهرها.
وكل ما يمكن للأيديولوجية الصهيوينة أن تكسبه – مستفيدةً في ذلك من مزاعم اضطهاد السامية ومأساة الهولوكوست – يتمثل في الاستيلاء على جميع أراضي فلسطين ‘من الداخل’. فلا تفتأ إسرائيل تقدّم للعالم – وليس للغرب فقط – الفكرة التي تفيد بأن الشعب اليهودي هو الشعب الأصلي في فلسطين، وبأن الأجانب هنا هم الفلسطينيون.
وتكمن المأساة الحقيقية التي صعقت الفلسطينيين والسبب الرئيسي في الهزائم المتلاحقة التي لحقت بهم في أن كانت الصهيونية تمثل أكثر من مجرد شكل من أشكال الاحتلال والحكم الاستعماري ‘من الخارج’؛ فقد حققت هذه الحركة نجاحاً كبيراً وضمنت مساندة الحكومات والشعوب في أوروبا، وهو ما لم يسبق أن حصل فيما ماثلها من المشاريع الاستعمارية الأخرى.
وأياً كان الأمر، فقد أقدمت النخبة السياسية الإسرائيلية والنخبة اليهودية في الولايات المتحدة، اللتين طالما اتفقتا على الخيارات السياسية والعسكرية التي تتخذها إسرائيل، على ارتكاب خطأ جسيم؛ فالشعب الفلسطيني كان موجوداً في فلسطين قبل إقامة دولة إسرائيل،
وهو لم يزل يحيا فيها على الرغم من قيام هذه الدولة على أرضه، كما لا ينفك هذا الشعب متمسكاً بأسباب الحياة والبقاء فيها على الرغم من جميع الهزائم التي لحقت به، والذل الذي لا يزال يتعرض له وتدمير ممتلكاته وقيمه.