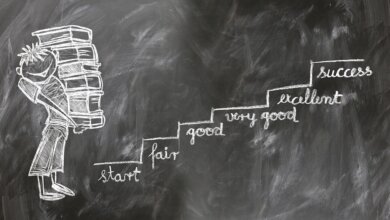لمن نكتب أبحاثنا بالعربية ؟

ساهمت عدة عوامل في تأخر دراساتنا وأبحاثنا الأكاديمية والثقافية والفكرية بصفة عامة، وجعلتها دون مستوى الأبحاث والدراسات والأطاريح التي تنجز خارج فضائنا العربي. أُرجع واحدا منها إلى إحدى العادات التي تكرست لدينا، حتى إنها صارت جزءا من ممارساتنا المترسبة في لاشعورنا الجمعي، التي تتلخص في الجواب عن: السؤال لمن نكتب أطاريحنا وأبحاثنا؟
إن طريقة التعليم التي تسود واقعنا، من الثانوي إلى العالي، تتخلص في أننا نكتب لمتلق محدد، وإليه نتوجه بخطابنا، الذي ندبجه مراعين مزاجه، وأحاسيسه ومواقفه وانفعالاته. إنه الأستاذ الذي يدرسنا أي مادة من المواد التي نتلقاها، خصوصا في المرحلة الثانوية، التي ستتكرس في العالي في رسائلنا وأطاريحنا الجامعية.
ولما كان الأساتذة مختلفين على المستوى المعرفي والأخلاقي، تربينا على مخاطبة كل أستاذ بما يعجبه، ويرضيه، فنجامل كل واحد منهم بحسب تعرفنا عليه من خلال طريقة تدريسه، والعلامات التي يوزعها على التلاميذ حسب شخصيته. فنخاطب ذا التوجه الديني منهم بلغة تبرز فيها بعض النفحات الدينية، واليساري بالمصطلحات التي تتصل بميولاته، والمزاجي بما يرضي ذائقته، وهكذا.
هذه العادة الدالة على نباهة التلاميذ في التعرف على طبيعة الأستاذ تدفعهم إلى الانسياق وراء ما يتوافق مع مزاجه للحصول على نقاط أو علامات جيدة. أتذكر في مرحلة الثانوية كيف كان التلاميذ من خلال الاتصال مع الأساتذة يصبحون قادرين على التمييز بينهم.
ولقد سألت مرة أحد زملائي لماذا لم تجب عن السؤال بهذه الكيفية المختلفة عن التي قدمها، فكان الجواب: إن الأستاذ لا يعجبه، وسيعطيني صفرا، ولذلك فأنا أخاطبه بما يدغدغ عواطفه. انتقلت هذه العادة إلى العالي، فصرنا نجدها في أبحاث الماجستير والدكتوراه.
تبرز تلك العادة بصورة واضحة في الرسائل والأطاريح التي تنجز في الكليات العربية من خلال وضع صورة الأستاذ المشرف في مخيلة الباحث عبر عدة طرق منها: مراعاة الاستشهاد به، ولو كان ما يكتبه خارج الموضوع الذي اشتغل به الأستاذ، ويقوم الطالب بالشيء نفسه في مراعاة أعضاء اللجنة المحتملين، من جهة، والتقيد بما تفرضه مواصفات الكتابة كما هو متعارف عليها، من جهة أخرى.
وفي الحالتين معا تكثر عبارات التقريض لهؤلاء المتلقين المفترضين، مع استبعاد الاستشهاد بمن يعتبرون خارج الدائرة المرسومة لدى الأستاذ المشرف وبمن يمكن أن يحيط به، سواء على الصعيد القطري أو العربي.
إن التعليم المبني على التلقين والذاكرة لا يمكن أن يقدم أي نتيجة، وحين لا تنبني علاقة الأستاذ بالطالب على التحفيز على التفكير والاجتهاد، وتقديم الجديد، والتفاعل الإيجابي لن تتقدم أبحاثنا ودراساتنا.
كما تظهر تلك المخيلة أيضا على مستوى الصياغة في تغييب ضمير المتكلم في البحث، حيث نجد في الرسالة عبارات مثل: يرى البحث، وإن الباحث، وهذه الرسالة… سألت طالبا من دولة عربية لماذا لا يستعمل ضمير المتكلم، ويجعل الرسالة وكأنها هي التي تتحدث؟ فأجابني بأن التقليد عندهم هو هذه الصيغة، ومن استعمل ضمير المتكلم، يتهم بأنه لم يصل إلى مرتبة طه حسين ليتكلم بهذا الضمير؟ ويمكننا قول الشيء نفسه عن اختيار الموضوع والمنهج.
فما هو مطروق مرفوض، وعلى الطالب أن يبحث عن مادة مختلفة عن التي سبقت دراستها. ألا يمكنني دراسة الرواية نفسها بالمنهج نفسه الذي سبقني إليه باحث آخر؟ في المواصفات المشتركة يرفض هذا الاختيار، ويعوض بالبحث عن رواية غير مدروسة، ولو بمنهج معتمد. وليست النتيجة سوى تكرار الأشياء نفسها. فإذا سبقني أحدهم إلى دراسة الحجاج في رواية زيد، أقدم أنا على البحث في الحجاج في رواية عمرو. وهكذا.
تنبني الطريقة التي تعلمنا بها، ونعلمها للأجيال القادمة على الاقتداء بالآخر، والسير على المنوال الجاهز والسابق، وبهنا ينعدم الإبداع، كما أنها تحول دون التعبير عن الذات، بقتل الاجتهاد والتفكير المختلف عن السائد. ينتج عن هذا المتخيل الجماعي في البحث التكرار والاجترار.
ويبرز ذلك في عبارتين متناقضتين تتواتران في مخيلتنا وخطاباتنا: «بضاعتنا ردت إلينا» و»خالف تعرف». فأولاهما تعني الخضوع للجاهز والسابق، والثانية لا تعني سوى عدم التفكير في الخروج عن المعتاد.
إن التعليم المبني على التلقين والذاكرة لا يمكن أن يقدم أي نتيجة، وحين لا تنبني علاقة الأستاذ بالطالب على التحفيز على التفكير والاجتهاد، وتقديم الجديد، والتفاعل الإيجابي لن تتقدم أبحاثنا ودراساتنا، لذلك كنت أرفض دائما هذا التصور، وكان شعاري أبدا مع طلبتي يتلخص في ما يلي: إنك لا تكتب إليّ، لترضيني، ولا تستشهد بي لتحرز نصيبا من رضاي عنك.
انس أنني المشرف، واكتب لاثنين من المتلقين، واجعلهما في ذهنك وأنت تكتب: أحدهما يعرف كل شيء عن الموضوع الذي تكتب فيه، فلا يمكنك أن تتطاول عليه، أو تحتال عليه بما صارت لك به معرفة لم تكن لديك سابقا. والثاني قارئ لا يعرف شيئا عن الموضوع، وعليك أن تقرِّب إلى ذهنه الخالي من كل ما تعرفه، أو قرأته وتكوَّن لديك من أفكار وتصورات.
إن التفكير في متلق محدد، وكيفما كان نوعه، دليل على متخيل خاص لدى الباحث والمبدع معا. ومتى كان المتلقي مقصودا بعينه ابتعدت الكتابة عن المستقبل. قل لي: من تتصور حين تكتب؟ أقل لك: ما ستكتب.