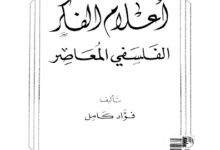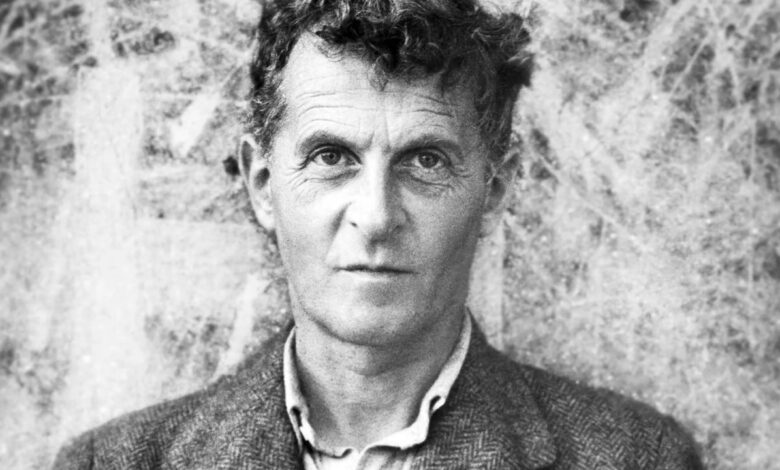
تولد المشاكل الفلسفية، حسب فيتغنشتاين، من سوء فهم لمنطق اللغة الإنسانية. وهكذا، فكتاب التراكتاتوس tractatus logico-philosophius المكتمل في 1918 يباشر دراسة اللغة باعتبارها تسمح بوضع حدود واضحة لما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه.
ومع ذلك، فنشر أبحاث فلسفية، بعد وفاة فيتغنشتاين، هذا النص غير المكتمل الذي تم تحريره بين 1936 و1949، سيضع بعض الخلاصات التي يبدو أن الكتاب الأول قد وصل إليها موضع تساؤل. (الكتاب الفلسفي الوحيد الذي ظهر في حياة المؤلف).
إننا معتادون على التمييز بين فيتغنشتاين “الأول” وفيتغنشتاين “الثاني” مما يجعل تأويل أحد أنواع التفكير الأكثر أصالة والأكثر تأثيرًا في هذا القرن صعبًا بقدر ما هو مثير للاهتمام.
1 – فيتغنشتاين “الأول”
المنعطف المنطقي اللساني
– تحت رعاية فريجه
يخضع التراكتاتوس لتأثير فريجه بشكل واضح، ذلك أن كتاب المنطق، الذي ظهر في 1879، يدشن بطريقة ما الفلسفة المعاصرة. إنه يعرض في الواقع كتابة جديدة للأفكار، أو كتابة رمزية، تسمح بخلق” لغة نموذجية من التفكير الخالص على نموذج اللغة الرياضية”.
والحال أن المنطق يختلط هنا مع الفلسفة ذاتها حيث تكون الوظيفة الحصرية، رغم ذلك، هي تطوير لغة رمزية لتسلسل الأفكار، ومركبة من علامات مكتوبة لها تحديد صارم ومتواطئ، وهذا دون نسيان مشروع لايبنتز حول لغة كونية أو حول “أبجدية التفكير”.
يتعلق الأمر بربح صرامة أكبر دائمًا من خلال تفادي العيوب الخاصة باللغات الطبيعية – كالإغريقية والفرنسية – تلك العيوب التي لا تصححها الرياضيات ذاتها. والحال، أنه لا يبدو ممكنًا مراعاة اللجوء إلى الحدس وإلى البداهات الخادعة للغة، إلا باكتشاف نسق العلامات الذي يبين ميكانيكيا، من خلال اللعبة البسيطة لكتابته، بنية استدلالاتنا.
- – بحثًا عن التواطؤ
إذا كانت اللغة الطبيعية تشكل موضوع نقد كلي في كتاب فريجه، فلأنها تتحكم في كيفية قيامنا بالتصنيف والاستدلال. فاستعمالها الأساسي باعتبارها وصفًا للتجربة العامة، الذي يرغب في الاستدلال من خلال هذه اللغة لن يكون له إلا أداة سيئة التكيف “حيث يتحدد البناء من خلال حاجات غريبة كليًّا عن الفلسفة”.
وإذا كان برغسون من خلال ملاحظة مماثلة (5chapitre) لا زال يفكر في قدرته على الاعتماد على الحدس، فإن فريجه يريد، على العكس من ذلك، الانفلات نهائيًا من فخ اللغة الأصلية، بعدم منح اعتباره سوى للترقيمات الرمزية المتواطئة بشكل جيد.
وهكذا ففي حين أن فعل “الكينونة” له ثلاث وظائف، فإنه يعبر عن نفسه عادة بنفس الطريقة: “القط (يكون) أسود” (“الكينونة” هي الرابطة التي تربط محمولاً بموضوع). “4 تكون هي 2+2” (“الكينونة” تعبر هنا عن الهوية)، “إنه (تكون) أماكن حيث” (“الكينونة” تصلح هنا للتعبير عن وجود شيء ما).
لذلك تتطلب الصرامة تطابق ثلاثة ترميزات متميزة عن هذه الوظائف الثلاث، إذا كنا لا نريد أن نناقش إلى ما لا نهاية المشاكل الخاطئة التي لا تأتي إلا من خلال عدم دقة لغتنا. ويؤكد فيتغنشتاين، من خلال أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، على ضرورة اللجوء إلى لغة ذات دلالات مشتركة، إذا كنا نريد تفادي الأخطاء المتولدة عن غموض بين دلالات نفس الكلمة.
- تفسير الخطاب
مع ذلك، فالتراكتاتوس هو قبل كل شيء عرض لفلسفة وليس درسًا في المنطق، ورغم أن فيتغنشتاين يرقم كل واحدة من الفقرات القصيرة التي تشكل هذه الدراسة القصيرة، فإن النظام المتبع ليس هو ذلك المتبع في الاستنباط.
وهكذا، فالكتاب يدهش بداية من خلال خاصية التنافر مع أنواع التفكير التي يعرضها، دون أن يكون البرهان الذي قاده إلى تشكيله قد أعيد وضعه من طرف المؤلف أبدًا. إن الأساسي في هذا الكتاب الصعب، والذي لن يكون ملخصًا إلى حد يبدو محتويًا على ألغاز غير محلولة بعد، يمسك بالفكرة المبتكرة التي يصنعها فيتغنشتاين من الخطاب.
- – القضايا كصور للعالم
إن القضايا التي تشكل العالم ستكون كصور أو رسوم تمثله. وهكذا، مثلما أن تصميم الميترو أو العمارة صورة عن العالم، فإن الجملة أيضًا رسم له.
بالتأكيد، فالسلم والرموز المستعملة (لرسم مدينة أو محطة حسب نموذج ما) تتعدد، بالتأكيد، حسب الاتفاقات المبرمة. ومع ذلك، فتنظيم العناصر التي تشكل تصميمًا في الفضاء، يناسب تنظيم العناصر الموجودة في الواقع، إذا كانت الخارطة تامة.
والحال، أن الأمر يجري أيضا مع اللغة التي ليس لها نقطة مشتركة مع الواقع سوى تنظيم صيغة ما للعناصر. وهذه الصيغة المشتركة هي ما يسميه فيتغنشتاين “الصيغة المنطقية”.
وهكذا، فالقضايا اللغوية ليست إلا نوعًا، من بين أنواع أخرى، من صور العالم.
- – الحقيقة ومعنى القضايا
إن القضية لا تكون صادقة إلا بشرط أن تشير إلى حالة شيء واقعي، ولكنها لا تستطيع القيام بذلك إلا إذا كان لها، في البداية، معنى. بمعنى إذا كانت صورة لتوليف ممكن بين الأشياء.
هكذا، فالحقيقة لا تختزل هنا في تطابق الشيء والفكر (acdequatiorei et intellectus حسب الصيغة السكولائية القديمة). بل يجب أيضًا أن يكون لها معنى قبل حتى أن يكون ممكنًا مقارنتها بالواقع. والحال أن هذا المعنى ذاته يكتسب من خلال صيغته المنطقية. إن القضية ليست إذن شيئًا آخر عدا تناسق عناصر لا يكون لها معنى إلا إذا كانت بنيتها متوافقة مع الشكل الممكن للأشياء في العالم.
– القضايا الخالية من المعنى (sinnlos) واللامعنى (unsinnig)
يسمي فيتغنشتاين بالمقابل أشباه- قضايا، تلك التي لا تمثل أي شيء. وهكذا، فالمنطق، الرياضيات، علوم الطبيعة، الأخلاق، وأيضًا الفلسفة، تحتوي على أشباه- قضايا، بمعنى قضايا لا يمكن أن تكون لا صحيحة ولا خاطئة لأنها ليس لها معنى.
يجب إذن على القضية، وبشكل مفارق، أن تمتلك إمكانية أن تكون خاطئة لكي تكون قضية أصيلة. إن القضايا المنطقية مثلاً، كونها دائمًا صحيحة، كأنها تثبت تحصيل حاصل (في الإغريقية toutolegein “قول الشيء نفسه”) أ=أ، ليست حقًّا قضايا.
إن القضية التي تقول دائمًا نفس الشيء، في الحقيقة، لا تقول أبدًا أي شيء، لأن قول شيء ما، هو قول شيء ما حول العالم، إخبار عن حالة العالم. إن تحصيل حاصل مثل “الأرض دائرية أو الأرض ليست دائرية” يكون خال من المعنى.
ومع ذلك، إذا كان تحصيل الحاصل هو شبه قضية لا تقول شيئًا، فإنها تقول ما يمكن أن يقال عن العالم (“الأرض دائرية”، الأرض ليست دائرية”) وتحدد بالتالي بنية هذا العالم. في الواقع، لا نستطيع أن نتصور، عالمًا حيث تكون الأرض في نفس الوقت مسطحة ودائرية.
إن تحصيل الحاصل لا يكون له، مع ذلك، نفس الوضع الذي لأشباه القضايا الأخلاقية والفلسفية التي، من جهتها، تكون بدون معنى، عندما لا يسمح أي شيء في الواقع بتأكيدها ولا نفيها.
الصمت الميتافزيقي
-“ما لا يمكن قوله، يجب السكوت عنه”
من البديهي أن امتياز المعنى يعود إلى قضايا علوم الطبيعة وحدها. والسؤال الجلي إذن هو معرفة ما يتم التوصل إليه في كل بحث يتمحور حول معنى الحياة. هل يتعلق الأمر بالنسبة لفيتغنشتاين بمحاكمة كل بحث ميتافزيقي؟ وهل نحن، هنا، مجبرون على الصمت كما يبدو من خلال ما تشير إليه القضية الأخيرة في التراكتاتوس (“ما لا يمكن قوله، يجب السكوت عنه”)؟
تبدو الفلسفة، كما لو أنها تختزل هي ذاتها في هذا النشاط الوحيد الذي يرتكز على الـ”توضيح المنطقي للفكر”. وهكذا يجب عليها التخلي عن كل طموح مذهبي، من أجل التفرغ لإسقاط انحلال أشباه-القضايا التي تخلق أشباه- مشاكل.
والتفلسف، لن يكون بالنتيجة أي شيء آخر غير “وضع حدود للأفكار” التي ستكون بدونه ضبابية وغامضة. والحال، إذا كان الخطاب الفلسفي ليس إلا هذا المجموع من “القضايا الواضحة” فسيكون واضحًا أنه عندما يكتمل العمل، يجد نفسه محكومًا بالصمت.
مفارقة أخيرة: ما دام أن قضايا التراكتاتوس ظهرت من أجل ما تكونه، فإنها تتبخر كحامض مذيب للمدنس والغامض، لكي لا تترك للرؤية غير مرآة صقيلة لخطاب مثالي يعكس العالم.
– مبدأ القابلية للتحقق
“إن المنهج الصحيح في الفلسفة: هو عدم قول إلا ما يدع نفسه يتحدث، أي قضايا العلوم الطبيعية – كقضايا لا علاقة لها بالفلسفة إذن – وبعد ذلك عندما يريد شخص ما التحدث عن قضايا ميتافزيقية، نبين له بأنه أغفل، في هذه القضايا، إعطاء دلالة لبعض العلامات”.
إذا كانت هناك كلمة ليس لها معنى إلا بشرط أن تكون قابلة للتحقق من خلال التجربة، فإن “كلمة الله” تكون مجردة عن ذلك كليًّا. ذلك هو الوضع الذي يأخذ به أنصار الوضعية الجديدة (أو الوضعية المنطقية)، خصوصًا كارناب وفلاسفة حلقة فيينا، الذين يعطون للخلاصات التي رسم فيتغنشتاين في التراكتاتوس مظاهرها الأكثر اكتمالاً. إن المشروع بسيط: يتعلق الأمر بالعمل على “تجاوز جذري للميتافزيقا” إن شئنا استعادة صيغة كارناب.
إن القضايا الميتافزيقية ليست خاطئة في ذاتها، ما دامت جوهريا وببساطة قضايا بدون معنى. وهكذا، فالقضية ” الله موجود” لا يمكن أن تكون موضوعًا لأي تحقق تجريبي لأنها شبه – قضية.
إن مبدأ التمييز بين القضايا هو ذلك المتعلق بالقابلية للتحقق، حيث اقترح فلاسفة حلقة فيينا عددًا من الصيغ، يمكن أن نستحضر من بينها صيغة فايسمان: ” إذا كانت لا توجد أية وسيلة للقول متى تكون قضية ما صادقة، فإن هذه القضية إذن ليس لها معنى، لأن معنى قضية ما هو وسيلة التحقق”.
هكذا، فالقضايا التي ليس لها قوانين منطقية ليس لها معنى إلا إذا كانت قابلة للتحقق اختباريًا.
– مشكلة وجود ما يفوق الوصف
سيكون من السهل كشف رخاوة منطق الخطاب الديني من خلال التسلح بهذه المبادئ. فهو، في الواقع، خطاب يطمح، من جهة للحديث عن وقائع (واقعة وجود الله مثلاً)، ومن جهة ثانية، لا يستطيع الاكتفاء بمبدأ القابلية للتحقق، ما دام أن هذه الوقائع تكون متعالية. إن الوضعية الجديدة تخلص صراحة إلى عدم الصلاحية الجذرية لكل تساؤلات تطرح حول وجود الله.
والحال، إذا كان فيتغنشتاين يصف بوضوح القضايا الميتافزيقية بأشباه- القضايا. وإذا كانت المحاكمة الضمنية لكل ميتافزيقا معلنة من خلال فلاسفة حلقة فيينا باسم متطلبات العقلانية، تبدو متضمنة من خلال قراءة متشككة للتراكتاتوس (003-4)، يبقى أن هذا الكتاب يكتمل من خلال الاعتراف “بشيء ما يتعذر تفسيره” ذو طبيعة “روحية”، ويمكن أن “يتجلى”.
ألا يتعلق الأمر هنا بالاعتراف بحدود الخطاب، (ما يتجلى لا يمكن أن يقال)، وبالاستسلام للذهاب إلى إحساس بالقلق أمام العالم، حيث النزعة العقلانية الباردة قليلاً للوضعيين لا تمنح “تعبيرًا”، لكن يمكن، بالعكس، أن تسمح ببعض المقارنة مع هايدجر؟
- 2 – فيتغنشتاين “الثاني”
صمت عشر سنوات يفصل كتابة التراكتاتوس عن عودة فيتغنشتاين إلى الفلسفة، في حدود 1929. والحال أن الأبحاث الفلسفية، التي لم تعرف النشر إلا بعد وفاته في 1953 لا تثير الاندهاش. إن فيتغنشتاين، في الواقع، يعيد النظر في الامتياز الممنوح للخطاب المثالي للمنطق، ويدخل مفهوم “لعبة اللغة” الذي يعد انعطافا جذريًا في فلسفته، ويفصلها بوضوح عن أطروحات الوضعية المنطقية التي كان التراكتاتوس، مع ذلك، قد ساعد على ولادتها.
- ألعاب اللغة
– وظائف اللغة و”صيغ الحياة”
إن مفهوم “لعبة اللغة” يشير إلى المجموع الذي يتشكل من الكلمة والنشاط الإنساني الذي تستعمل داخله. في الواقع، توجد عدة طرق لاستعمال اللغة، لجعلها تمارس لعبة ما. وهكذا، فاللغة تبنى بشكل مختلف، حسب ما إذا كنت أصدر أمرًا أو أبلغ، أجيب أو أشير.
ويمكن القول بشكل آخر بأن معنى قضية ما يكون تابعًا للاستعمال الذي أقوم به. فكما أن مختلف الألعاب لا تخضع لنفس القواعد، توجد مجالات لاستعمال اللغة تتحكم فيها “قواعد لعب” خاصة.
والحال، أنه من خلال واقع ملاحظة غير اختزالية لتنوع الوظائف اللغوية، تخلى فيتغنشتاين عن المشروع الأولي للتراكتاتوس، الذي كان هو الكشف عن الصيغة العامة للقضية، وهو وظيفة اللغة. في الواقع، يزداد مفهوم “المعنى” ذاته توسعًا في دلالته،
ما دام الأمر لا يتعلق بمنح امتياز للوظيفة التمثيلية للغة، بشكل خالص، على حساب الوظائف الأخرى، بمعنى إدراك كل قضية كصورة للواقع. فحسب ما إذا كنا نتحدى شخصًا أو نعبر عن جاذبيته، مثلاً، فإن نفس القضية المرسومة من خلال ألفة مفاجئة، يمكن أن يكون لها معنى تهديد أو اعتراف بالحب.
هذه التصرفات الشمولية للتواصل، يسميها فيتغنشتاين “صيغ حياة”: إنها هي التي ترتب الألفاظ اللسانية والأفعال المشتركة، لكن مثل هذا الترتيب يشكل وقائع واعية، صادرة عن اتفاق واضح، أقل منها وقائع اجتماعية. “إن الخضوع لقاعدة، والقيام بتواصل، وإعطاء أمر، وإنجاز جزء من لعبة الشطرنج، هي عادات (استعمالات، ومؤسسات)”.
– استحالة اللغة الخاصة
هكذا، تتبع لعبة اللغة قواعد محترمة من طرف الجميع. والحال، حسب فيتغنشتاين، أن وحدة هذه القواعد هي وحدها التي تضمن فاعلية التواصل. وبالعكس ف”اللغة الخاصة”، بمعنى تلك اللغة التي لا تشير إلا إلى تجارب معروفة من طرف الشخص الذي يتكلم فقط، تكون مستحيلة تماما.
إننا نعرف ذلك، فالألم ككل الأحاسيس الداخلية والمباشرة، يبقى دائمًا غير قابل للتعبير عنه. وبنفس الطريقة، إذا افترضنا بأن دلالة كلمة “فيروز” لا توجد إلا في تجربتي الخاصة المتعلقة بالـ”إحساس الفيروزي”
فلا شيء أبدًا يؤكد لي بأنني أتكلم مع الغير حول نفس الشيء، ما دام أنه لا شيء يثبت هوية أحاسيس الغير وأحاسيسي. من البديهي إذن بأن الفرضية التي ستكون من خلالها اللغة، بداية، لغة خاصة قبل أن تكون أداة للتواصل مع الغير، تقود إلى نتائج ارتيابية.
- – تفنيد النزعة الارتيابية
إن هذه التحاليل الأخيرة للغة تكون وظيفتها الأساسية هي المساعدة على تفنيد النزعة الشكية في نهاية المطاف. ويسعى أحد النصوص المتأخرة جدا لفيتغنشتاين المعروف تحت عنوان، حول اليقين، إلى تأكيد استحالة الشك الكوني، سواء كان من نوع ارتيابي أو ديكارتي.
إذ من الوهم، اعتقاد القدرة على تعميم ممارسة الشك، على مجموعة المعتقدات، كما يرغب في فعل ذلك هوسرل. فالشك يفترض في الواقع، صوغًا للشك، بمعنى استعمال الكلمات التي يجب أن ترتبط بها دلالات لا يمكن أن تكون قابلة للشك، إذا أردنا أن يكون عرض الشك نفسه له معنى.
هنا تظهر ببراعة الاستحالة الجذرية لصوغ شك قطعي، وهي استحالة ترتبط ببنية اللغة نفسها. كل صوغ، بما في ذلك المرتبط بالشك يفترض دائمًا وجود “لعبة اللغة”.
- تصنع اللعب
إن وجود ألعاب لغة هو إذن، بالنسبة لفيتغنشتاين الواقع الأساسي، واقع لا يمكن أن يكون موضع شك مادام كل خطاب يفترضه.
- – تحليل الوقائع
من الآن فصاعدًا، يمكن للتحليل أن يحاول، بطريقة شرعية، التساؤل حول “قواعد” ألعاب اللغة. ومع ذلك، فإن امتلاك خطاب ما امكانية أن يحلل كـ”لعبة لغة” لا يمنحه أية شرعية.
إن الخطاب الديني، مثلاً، له قواعده الخاصة: وهذا ما يسمح له أن يكون مأخوذًا به، ومسموعًا. لكن على أية حال فوجود قواعد ما لا يكفي لتأمين حقيقة ما. ومن جهة أخرى، توجد أيضًا ألعاب لغة ضد – دينية تشكل كذلك وقائع قابلة للتحليل.
وفي كل واحدة منها تتبلور خيارات وجود مختلفة. ولا يوجد مبرر للميل إلى الانخراط، بشكل خاص، في هذا أو ذاك من الخطابات، ولا حتى تفضيل الصمت عن موضوع وجود الله.
- – لعبة بدون أساس
يبدو إذن، أن تحليل اللغة ليس له من وظيفة سوى “تفسير” خطابات موجودة، في الواقع، لكن هذا التحليل لا يكون أبدًا في الوقت ذاته مثبتًا لشيء ما فيما يخص حقيقة ألعاب اللغة التي يطبق عليها. ألن تكون هذه “الألعاب”، إذن، بشكل دقيق، ألعابًا فقط، بمعنى، أشياء غير جدية تمامًا؟ ومع ذلك أليس للغة صلة بالأشياء وبالحقيقة؟ إن فيتغنشتاين لا يجيب، تاركًا بين قوسين ما يسبب كل المشكلة اللغوية، أي الواقع الذي يمكن أن يذهب أبعد من ذاته.
“إن لعبة اللغة لا تقوم على أي أساس، إنها ليست مقبولة (ولا حتى غير مقبولة)، إنها هنا تشبه حياتنا”. وبالنتيجة يجب علينا ربما الرضى بالنسبية الثقافية: إن التنوع غير المختزل للطقوس، الرموز، والأساطير، هو واقع لا يمكن إلا أن يشعرنا بالإغراء.
والفلسفة لم يكن لها إذن من وظيفة علاجية سوى تفسير هذا الواقع، حيث دلالات الكلمات والجمل لا تكون أبدًا مرتبطة سوى بأنشطة تخدم سياقها.
- المصدر:
Alain Graf, Les grands philosophes contemporains, Editions du Seuil, mars 1997, pp14- 24
ترجمة: محمد بعدي / باحث في الفلسفة والتربية – المغرب