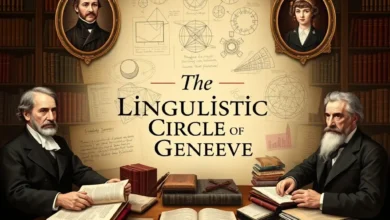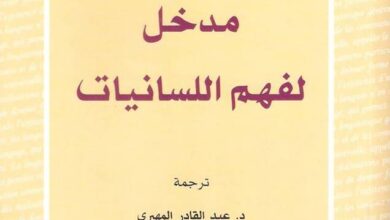كُلنا لسانيون .. ولا أحد

سألتُ طالبةً في سِلك الدكتوراه عن تخصُّصِها، فأجابتْ مباشرةً ودون تفكير؛ (لسانيات تطبيقية). خمَّنتُ أنها خريجةُ لغاتٍ ومُهندسة معلوميات، فلما طلبتُ منها توضيح مقصودِها باللسانيات التطبيقية، أطرقتْ؛ وبدأت تفكر في امتعاض، وأجابت إجاباتٍ كثيرةٍ متداخلة؛ بما يُفيد أنها طالبة في الأدب، وتُعِدُّ رسالتَها في تحليل الخطاب.
عدمُ قدرة هذه الطالبة على تبريرِ تخصّصِها والدفاع عنه، رُغم حرصِها الشديد على الانتساب إليه؛ مَردُّهُ إلى عدم قدرتِها على تمثل هذا التخصص وضبابيَّتِه بالنسبة إليها.
وددتُ لو أسألُها عن علاقة كل ما ذكرتْه باللسانيات؟ وبالتطبيقية تحديداً ؟! لكنني أحجمت.
واضحٌ أن هذه الطالبة لم تُسأل هكذا سؤال من قبل، وكانت إجابتُها في كلِّ مرة تلقى القبول أو التقبُّل على نحو ما، للدرجة التي صدَّقتْ فيها نفسَها أنها مُتخصصة في اللسانيات. وفي الشق التطبيقيّ منها!.
هذه الطالبة؛ مُجردُ نموذجٍ لما هي عليه الحالة العربية في موضوع التموقع المعرفي والتموضُع العلمي تحديداً؛ حيث تغيبُ ثقافة التخصص إيماناً وممارسة. تعوِّضُها الموسوعية؛ أو بتعبير أدق (الثقافة العامة)، فالباحث العربي عموما؛ مهووسٌ بتعقُّب المعلومات والمعارف وتجميعِها ومُراكمتِها حتى دون ترتيب؛ أكثرَ مما يهمُّه الفهم والاستيعاب والتمثُّل. ومردُّ هذا كلِّه في تقديري الشخصي؛ إلى سببيْن أساسييْن، أوَّلُهما:
وَهْمُ العِلم؛ ففي مجال الإنسانيات بشكل عام، يندر أن تجد عُلماءَ عَرَباً بالمفهوم الدقيق للكلمة؛ إنهم مَعدودون على رؤوس الأصابع، وتجدُ بدلاً عنهم جيوشاً من الباحثين والواصفين والناقلين والمُترجِمين، وفي أحسنِ الأحوال نُقاداً ومُحلَّلين. كلُّهم يدَّعون العِلمية أو تُلقى عليهم فيُصدِّقون.
هناك جهلٌ وهناك عِلم؛ وهناك مَوْضِعٌ بينهما، التموْقع في هذا الموضِع؛ يمنعك من الاعتراف بجهلِك ولا يُبلِّغُك العلم. وأحسب أن كثيراً من الباحثين العرب رهائنُ هذا الموضِع لا يُبارحونَه
السبب الثاني؛ سِحرُ المُصطلح: غياب العِلمية (التخصص) يُعوِّضُه الباحثون العرب بموضة المصطلح، اعتقاداً منهم أن المُصطلح هو العِلم، فيما لا يعدو المصطلَحُ كونَه “مفتاحا للعلوم” فقط. فأصبح الباحث العربي يُراكم المصطلحات من حقول وعلوم ومباحث مختلفة وأحيانا متباينة؛ وبمفاهيم خاطئة وأحيانا مُتناقضة. للدرجة التي أصبح فيها هاجس المصطلح هو الغاية عندنا وليس العلم وليس التخصص. ومصطلحُ اللسانيات أوضحُ تعبيرٍ عن هذه الحالة (الفوْضوية) التي يَصحُّ أن ننعتَها بـ”تضخم أنا المصطلح” عند الباحث العربي.
ولك أن تسأل أي (لسانيٍّ) أو باحثٍ عربيٍّ مُتخصص في اللسانيات عن؛ “ماهية هذه اللسانيات ؟؟” فسيجيبُك بسرعة واطمئنان بجوابٍ واحد طويلٍ عريض؛ هو في الحقيقة عشرون جوابا كلُّها خطأ.
ومردُّ ذلك؛ إلى كون هذه اللسانيات حالة طارئة على البحث اللغوي العربي القديم، وليس تطوراً عنه. أي أن ما يُسمى باللسانيات العربية لم تتطور عن النحو القديم أو عن فقه اللغة أو عن الدراسات المعجمية …، وإنما تم استيرادُها كقالبٍ جاهز للتوظيف، مثلما حدث مع المناهج.
وبالتالي غابت الأسئلة المحدَّدة والجوهرية التي كان يجب أن تنطلق منها اللسانيات العربية لتحديد موضوعِها أولا؛ ثم المبادئ النظرية والأسس المنهجية التي ستقوم عليها هذه اللسانيات كعلم.
هذا الاضطراب؛ أدى إلى تصوراتٍ خاطئةٍ عن اللسانيات والمنهج والتطبيق، فكانت المردودية ضعيفة جداً، ولا تتعدى ما تم تحقيقُه في الدراسات اللغوية العربية منذ قرون عديدة. وباتت سمة التكرار وإعادة إنتاج الخطاب اللساني العربي هي الطاغية على كل ما يجد من دراسات وبحوث، فيما لا تزال كثيرٌ من الإشكالات اللغوية العربية قائمة من دون حلول ولا بدائل.
ومرد ذلك كله؛ إلى مقولات عربية قديمة راسخة ومتوارثة تقول؛ ” هذه بضاعتُنا رُدَّت إلينا / ليس بالإمكان أبدع مما كان / …” فبدل أن يقيس الباحثون العرب المُنجَز اللغوي القديم باللسانيات، قاموا بقياس اللسانيات بالموروث اللغوي العربي؛ اعتقادا منهم أن كلَّ ما جاءت به اللسانيات الحديثة قد سبقهم إليه سيبويه والخليل ومن جاء بعدهم من النحاة، فتمَّ شلُّ هذه اللسانيات ومنعُها مِن أن تتقدَّم بالدراسات اللغوية العربية وتنقُلها إلى التخصيص والتدقيق والعلمية.
في المقابل؛ استطاعت اللسانيات الأوروبية؛ خاصة في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وإسرائيل؛ أن تُحقق الكثير، لكونها جاءت كامتدادٍ وتطورٍ عن الدراسات اللغوية التأسيسية في هذه الدول تحديدا، وفي غيرِها من الدول بِنِسَبٍ متفاوتة.
حيث ترصد لنا المراجع المختلفة أن اللسانيات قد تكون نشأت حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، ثم أعيد إحياؤها مع فرانس بوب 1816م، ثم مع سوسير 1916م، ثم تروبتسكوي 1926م، ثم مع تشومسكي 1956م. فكانت اللسانيات في كل مرة تحتوي نموذجها القديم وتطوره، من خلال ديمومة المراجعة والتدقيق.
وهذا ما أهل اللسانيات الغربية إلى أن تفرض وجودَها ضمن العلوم الإنسانية نظريةً ومنهجاً. من خلال تحديد موضوعها أولا، ثم ضبط المفاهيم وإنشاء مصطلحية خاصة بها. ما أهلها إلى أن تستقل وتستوي علما قائما بذاته. وهذا ما لم يتحقق للسانيات العربية إلى اليوم.
لقد أوصلتنا حالة “وهم العِلم” هذه إلى أن نُصبح أمة الأجوبة الجاهزة باستحقاق، وهذه سمة الأمم المتأخرة والمتخلفة، أما الأمم المتقدمة؛ فهي تلك التي تطرح الأسئلة، تلك التي لا تتوقف عن التساؤل.
واللسانيات أوضحُ تعبيرٍ عن هذه المفارقة، فما يُسمى باللسانيات العربية؛ هي في الحقيقة جوابٌ عن أسئلة لم تُطرح بَعد. فيما اللسانيات الغربية انبثقت عن أسئلة جوهرية ومُحدَّدة في الموضوع والمنهج والنظرية.
من هذا المنطلق يحق لنا جميعا أن نتساءل حول ما تم إنجازُه عربيا حتى الآن في مجال الدراسات اللغوية؛ هل يندرج فعلا ضمن اللسانيات أم هو شيء آخر غير اللسانيات؟ هل المشتغلون بالتراث وبالنحو العربي القديم لسانيون ؟ هل عندنا علم لساني عربي؟
هذا الوضع؛ يفرض علينا ألا نُغالي في تصديق أنفسِنا؛ وتوهُّم أن الآخرين كذلك يُصدقوننا، وأن علينا التسلح بالتواضع التام والشجاعة الكافية لتقبل هذه الأسئلة أولا؛ ثم الانخراط في الإجابة عنها من خلال تصحيح مسار البحث الذي يُفترض فيه أن ينتقل من الأسئلة وصولاً إلى الإجابات لا العكس.