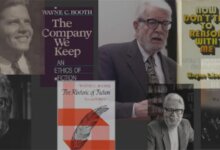هدى بركات تفتح وتفضح «بريد الليل»

هدى بركات روائية لبنانية، بلغت ذورة نضجها الفنى، وهى تلج العقد السابع من عمرها. تقيم منذ الحرب الأهلية متنقلة بين بيروت وباريس وعواصم عالمية أخرى، تتشرب بهذه الطريقة روح المهاجر المقيم فى لغته والمغترب فى مقاهه دون أن تبرحه هموم وطنه، تكتسب من الأجواء الأوروبية جرأة الكشف وفحش التعبير حينا، وصعوبة القبض على جمرة الواقع العربى الملتهب حينا آخر؛ إذ تطاردها أشباحه، وتؤرقها نماذجه، فتنصب لهم فخاخ السرد لتقتنص القاتل والمومس والمثلى والغادرة بأهلها، وهم يبوحون بفواجعهم ويسجلون تفاصيل مشاعرهم فى لغة تسيل حينا، وتتكثف، وتتقطر فى معظم الأحيان، تتخذ إطاراً فنياً له نمط رواية الرسائل بعد تطويعها لمغامرة التجريب والتحديث؛ إذ تقدم خمس رسائل لا تنتظم فى أية وحدة مألوفة، لا يجمعها شخصية المرسل ولا المرسل إليه، فهى لأصوات متباعدة ومخاطبين مختلفين، قد يربط بينها خيط أوهن من خيط العنكبوت الذى يلفه غبش الليل، وكلها لا تصل إلى من وجهت إليه، قد يقع بعضها بالصدفة البحتة فى يد المرسل الآخر.. دون مزيد من أية علاقة منطقية.
وإن كانت تعبر فى صميمها عن جوهر التعاسة؛ فلا الهارب ينجو من مصيره، ولا العاشقة يبتل ريقها بلقاء محبوبها الذى افتقدته طيلة عمرها، ولا السارقة تغفر لنفسها جرمها، ولا المثلىّ ينفض عن قلبه رهبة أبيه وهو يتمرد على سلطته!
الوعى الشقى، والمصير الموجع هما الرابط بين الأصوات الساردة وهى تتقلب فى قلق المطارات وجحيم المطاردات، وكأن عذاب الضمير الذى يجتاح الإنسان العربى، ذكراً كان أم أنثى مغلفاً باللامبالاة والعدمية هو ما تراه المبدعة فى إيقاع هذه الأصوات المنبعثة من الطبقات السفلى فى الجحيم. وهى تبتكر فى إطارها السردى توزيعاً ثلاثياً يضم الرسائل الأولى بعنوان «خلف النافذة» والتعقيب الشارح الذى يزيدها التباساً بعنوان «فى المطار» ثم تربطها فى حزمة وهمية أخيرة بعنوان «خاتمة»، حيث يبعثرها «موت البوسطجى» وكأن الكاتبة تريد بذلك أن تجعل بنْية الرسائل تلتئم فى نسق مقطعى يضمن لها الحد الأدنى من التماسك، لتنتقل بها من الحبات المتناثرة إلى ما يشبه العقد الذى يضم أقاصيص شديدة التركيز كأنها الثمالة التى تتبقى من الكأس المترعة، وقد حازت هذه الرواية جائزة البوكر العربية هذا العام، واكتنف فوزها بعض الضجيج لملابسات ومنافسات لا تخلو منها الجوائز، لكنها انتصرت على رواية مهجرية أخرى لا تقل عنها عرامة ونضجاً وشعرية هى «النبيذة» لإنعام كاجه جى.
حاولت هدى بخبرتها السردية المعتقة أن تستهل عملها بما يشبه اللحن الرومانسى الشجى الذى يعزفه الراوى الأول بالكلمات وهو يخاطب محبوبته مستحضرا اللحظات الأسيانة فى طفولته فيقول «يبقى ذلك المغيب فى رأسى مهما تكن ساعات اليوم، هو نفسه المغيب الذى تختفى فيه الشمس عند الأفق، والذى يبكى فيه كل الأطفال، ويحزن كل الرومانطيقيين، من إحسان عبدالقدوس إلى ريلكة، كآبة تلف الكائنات اللطيفة الجميلة، تكتب السيدة المتخصصة فى علم نفس الأطفال «لا تجزعى أيتها الأم من نوبات بكاء الساعة السادسة، إنه اختبار، فالطفل يعرف غريزيًا أنه (وحيدًا ومتروكًا من أمه) سيموت حتما، بكاؤه هو نداء للتأكد من وجودها، وهو إذن لن يموت»..
تنخرط هذه الفقرة فى سياق البوح الحميم بمأساة الراوى الذى تركته أمه فى الصباح الباكر فى القطار كى يلتقى مصيره هناك بعيداً عنها، فزرعت فى نفسه الوحدة والوحشة والرعب والعدوانية، ثم حملته الكاتبة عصارة ثقافتها التى تعتبر إحسان عبدالقدوس كاتباً رومانسياً بالقياس إلی واقعية المهجرين الطاحنة، وعرفته بنتائج علم نفس الطفل فى تحليل لحظة البكاء فى السادسة مساء، ولم يبقَ سوى أن تتذكر لوركا فى مرثيته «فى الساعة الخامسة مساء» وهكذا بضبط الروائية المثقفة وهى تصب خلاصة خبرتها فى فم الراوى وكأنها تتماهى معه فى بعض خواطره وحالاته، لكنها تبلغ مدى بعيداً فى تجسيد قسوة الأم التى شكلت وجدان هذا (الأفاق)، وجعلته يتردد بين الوشاية بالناس وتجارة المخدرات ويتفادى خدمة الإسلاميين حتى يفقد هويته وأوراقه ويقتله الملل، فأمه «كانت تعنى بالدجاجة المريضة، تطعمها الحب بيدها، وتمسّد على رقبة النعجة، وتغنى لها وتزغرد حين ترى الحمل يتحرك فى مشيمتها، إلا أنا، لم تكن تلتفت ناحيتى، أنا لم يكن لى أى فائدة لا بيض ولا حليب ولا لحم، كنت مجرد بطن فاغر فاه، ثم أبعدتنى إلى مكان لا تعرف عنه شيئاً».
ومع أننا نلمس فى كتابة هدى نفحات عطرة من بلاغة جبران وميخائيل نعيمة فى تجسيد مشاهد الجبل اللبنانى، فإنها تغرق فى تمثيل الوعى الشقى بمبالغات حادة، وإن كانت تلامس الواقع بإتقان عندما تجعل روايها يقول لحبيبته فى النهاية: «لماذا أخبرك بكل هذا؟.. لا أكتب إليك لأستردك، ليس عندى أوهام، على أن أجد امرأة متقدمة قليلاً فى العمر، أرملة أو ما شابه، ترضى بى زوجاً فأحصل فى البدء على أوراق إقامة، ثم ربما على أوراق تجنيس.. والله عبث، أكثر أيامى تنقصنى عبثاً فى عبثً».
هذه النبرة الأليمة هى التى تجسد واقع المهاجرين العرب إلى أوروبا فى الحقبة الأخيرة، وهذا ما سيتكرر فى الرسالة الثالثة مع صوت آخر، يجد هذه المرأة بالفعل، وتضفى عليه من الحنو والعشق والرعاية ما يزيد على حاحته، لكنه فى نهاية الأمر يقتلها مللًا وعدوانية، لكن هدى تبدع حقيقة وهى تصور نموذجها النسائى الآخر فترصد ما تطلق عليه «محرك ذاكرة النساء» الذى يختلف بالضرورة عن الرجال، فتقول: «فعل التذكر بعد سن الخمسين يصير سهلاً، لكن بلا جدوى، تعود حياتك السابقة فى سيلان عجيب من دون أن تستدعيها، تحضر أشياء بعيدة منسية، أمكنه وروائح ووجوه، أناس وتفاصيل لا أهمية لها على الإطلاق، مثل كلام كانت قد قالته الجارة منذ سنين بعيدة عن نجاعة فرك النحاس بالليمون والرماد وأنت ليس عندك آنية نحاس.. هذا غريب.. غريب أن أتمنى رؤيتك إلى هذا الحد، أنا على فكرة قلما أسافر، البلدان القليلة التى سافرت إليها أصابتنى بالخيبة، ليس بسبب أن بلادى جميلة أكثر، وخصوصاً وهى فى نار الحروب، بل لأن وعود شركات السياحة كلها كاذبة».
الرواية تنتقل من التأملات الذاتية عن الذاكرة وطبيعة نشاطها فى مراحل العمر المختلفة لترصد لا جدوى هذه الذكريات، مع أنها فتات الحياة التى يعجن بها الروائيون مادة سردهم وحكايات مشاعرهم وخبراتهم، فيطعموننا مذاق التجربة ممزوجاً نخمر الإحساس ومخلوطاً بسحر الزمن، ثم تقفز فى سردها فجأة لتتحدث عن غرابة نزقها عندما اتفقت مع صديق كندى قديم غامرت معه مرة فى صباها كى يلتقيا بعد سنين طويلة، تكتب له هذه الرسالة قبل أن تقفل راجعة عن انتظاره فى المطار، ونعرف من تعقيبه فى الجزء الثانى أنه بدوره قد استخف بموقفه بعد أن تأخرت طائرته عشر ساعات، فانصرف دون أن يلتقى بحبه القديم إشفاقاً من التغيرات التى حدثت لهما معاً، الإشارة الواردة فى الفقرة السابقة عن السفر وخيباته والوطن وجماله على الرغم من الحروب المنهكة- نلمس فيها بطبيعة الحال ظلاً ثقيلاً لما يجثم على أنفاس أهل الشام كلهم فى العقود الأخيرة، ابتداء من الهجرات الفلسطينية المتتالية إلى اللبنانية والسورية التى مزقتهم أشلاء فى أنحاء الأرض مكرهين أو مختارين، فأخذ المبدعون منها يصطادون فراشات الذكرى الملونة ويحاولون إقامة ربيع متخيل من أفواجها المحلقة فى سماء منافيهم فى المدن البعيدة، لكن الزمن كان قد أنهكهم وبدأت الشيخوخة تصيب فقرات ظهورهم والأسى يغمر أرواحهم كما يتجلى ذلك فى إبداعهم، وربما نجد فى «بريد الليل» صدى لمهاجرى بعض الأقطار الأخرى.
فالرسالة الرابعة مثلاً تكتبها عاملة نظافة بائسة لأخيها الذى يطاردها بعد خروجه من السجن لتدفع عن نفسها تهمة قتل أمها ولو بالإهمال لأنها تركتها تموت دون الاستعانة بطبيب، وتتميز بقدر كبير من التكثيف السردى وهى تحكى مآسىَ جيل من الضائعات فى أوطانهن بما لا يبعد عما نشهده فى الحالة المصرية مثلاً، وبخاصة عندما تبوح هذه التعيسة بقولها: «صرت أتذكر من ألمى وقهرى أن أمى كانت سب زواجى التعس وأنا بعد لم أتم الرابعة عشرة من عمرى، وهى لم تغفر لى طلاقى ولا أنت، بل كنتما سبب هجرتى إلى هذا البلد وعملى خادمة فى بيون الناس فى تنظيف وسخ بشر لا أعرفهم فى حمامات المطاعم وغرف الفنادق، كانت أمى راضية فى تلك الأيام لأنى ابتعدت عنها أنا وفضيحة طلاقى، ولأنى كنت أرسل لها المال بانتظام..
صرت أسمع برحلات البنات المتكررة إلى البلد، كيف تصل الواحدة محملة بالهدايا ذات الماركات، كيف تعرض (مصاغها) على الزوار الكثر، ولا أحد يسأل نفسه من أين هذا كله؟ بما أن البنت محجبة، وأحياناً كثيرة منتقبة، فكيف لأحد أن يشكك فى أخلاقها».. هكذا يغطى التدين الشكلى على التحلل الحقيقى فى مجتمعاتنا العربية المعاصرة فى المشرق والمغرب، والواقع أن كثيراً من مواد هذه الرسائل ليست فى الحقيقة سوى قصص قصيرة مكثفة، تنتظم فى عقد واهن، تمثل حباته خلاصة تجارب يمكن لكل منها أن يمتد فى رواية كاملة تقدم مشاهد اجتماعية ومفارقات إنسانية هى التى تشكل جوهر الفن الذى لا يعتمد على مجرد الحكايات المسرودة، لكن هدى بركات تجرب فى هذ الصيغة الجديدة تقنية «الانصباب التى تتآزر فيها القطع السردية لتأكيد دلالة محورية، هى بؤس هذه العوالم واستغراقها فى الجهل والخيبات المتلاحقة، وتختم الكاتبة هذا العنقود بسطور طريفة تعبر فيها عن شجون ساعى البريد الذى آذن «الإنترنت» بموته فيقول فى أسًى «كنت أسير فى مناطقنا البعيدة، أينما توقفت دراجتى كان حسن الاستقبال يذهب بالناس حتى دعوتى إلى الأكل، عدا تحميلى بالقوة بخيرات المطبخ، وأحلاها أرغفة الخبز الساخنة».
هذا الحنين والشجن للزمن الماضى هما اللمسة الرومانسية التى تخفف، وتلطف جهامة الحكايات الثقيلة، وتضفى عليها قدراً من التشتت والشفافية والشعرية على غرابة بنيتها وعبثية مصائرها، لكنها تعتصر رحيق اللحظة الراهنة فى الحياة العربية منظورًا إليها بحدقة فنانة شديدة الحساسية، ترقب تحولات الزمن وفواجع الأفراد المغتربين من أبناء الشعوب الفقيرة، دون أن تبرر إثمها بنبرة الإشفاق، ودون أن تفقد التّحنان والحس الإنسانى العادل الجدير بالتقدير.