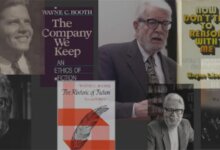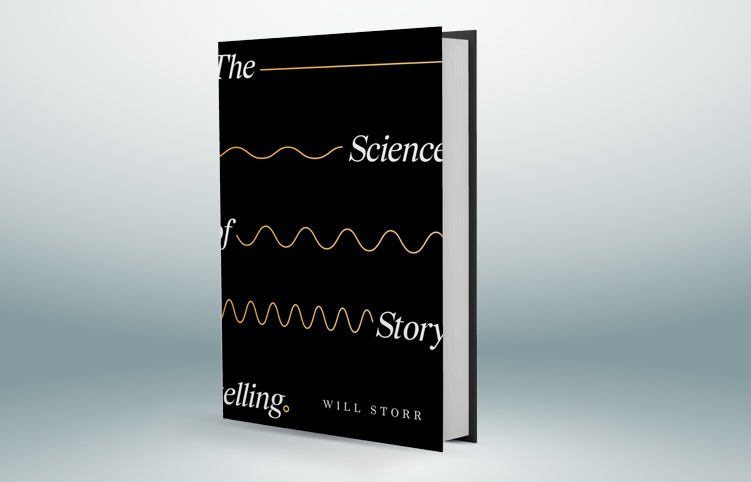الأطروحة وطُقوس الاستئنـاس

1- “الاطروحة ” والبناء الروائي
تروي “الشراع والعاصفة” قصة بحار – محمد بن زهدي الطروسي – فقد مركبه إثر عاصفة هوجاء، وعاد إلى الشاطئ وفي جعبته أمنية واحدة هي العودة إلى البحر على ظهر مركب جديد. وفي انتظار ذلك سيعيش على مردود مقهى بدائية بناها على شاطئ البحر في جوف صخرة، وأثناء مقامه على اليابسة سيكون شاهدا على أحداث متنوعة أهمها تعرفه على الأستاذ كامل، ذلك المناضل الشيوعي الذي سيعمل على استقطابه للحركة النضالية التي كان يخوضها الشعب السوري ضد الاستعمار الفرنسي وأذنابه المحليين، وعلى يده أيضا سيكتشف العمل السياسي .وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سيعود من جديد إلى البحر على ظهر مركب جديد مسلحا هذه المرة بفكر جديد وسلوك جديد ورؤية جديدة.
إن البنية التركيبية، أي البناء العام للقصة، تتحدد، كما يشير إلى ذلك الفصل التمهيدي، في وجود إخلال بمسار حياتي عادي لشخص عادي : بحار فقد مركبه وانقطع ما كان بينه وبين البحر من أواصر. إن نمو القصة وتطوراتها سيركزان على هذه الحادثة/ الخلل من أجل البحث عن نظام حديد.
إن هذه ” الحالة ” رغم أنها هي ما يشكل القصة وما يبرر الفعل، فليست معطى أصليا لازما لحياة شخص ما ( كان من الممكن أن يتخلى الطروسي عن البحر من أجل مهنة أخرى ). فالفعل لا ينطلق من وضع أصلي لتجاوزه، وإنما ينطلق من ضرورة العودة إلى وضع تم الاخلال به :
بحار قهوجى بحار
وعلى هذا الأساس، تبدو ممكنات الفعل السردي محصورة في إسقاط عالم الماضي على وقائع الحاضر لـ “إقناع ” المتلقي بضرورة العودة إلى وضع كان.
وإذا كان الانفصال، باعتباره حالة تبرر الفعل المستقبلي، مرتبطا استرجاعيا بالماضي ( زمن الاتصال الأصلي) ومرتبطا استباقيا بالمستقبل ( إلغاء حالة الانفصال )، فإنه يشكل الكوة الأساسية التي سينفذ منها الفعل السردي إلى سرد قصة السياسة والفعل السياسي من خلال التمثيل لأفعال هي من صميم ما يفرضه الاتصال البشري والعلاقات الإنسانية، وهذا ما سيسمح ببروز ” قصص ” أخرى تشكل عماد النص الروائي ككل.
فما بين الانفصال كحالة ماضية ( ماضي القصة، فالانفصال لا يدرك إلا من خلال الإشارات إلى غرق المنصورة )، والاتصال كحاضر للقصة ( إبحار الطروسي على ظهر مركب جديد )، تنتصب مجموعة من الأفعال منفصلة عن حالة الانفصال وعن حالة الاتصال في الوقت نفسه. إن هذه الأفعال مرتبطة بدائرة تحول من نوع آخر ومكونة لقصة أخرى.
من هنا، فإن اللحظة السردية التي تفتتح بها الرواية لحظة توترية. إنها لحظة تحيد بالخيط السردي عن مساره الأصلي والزج به في مسار جديد : إنها لحظة الانزياح الأولى عن مقتضيات المسار الأول واستشراف آفاق مسار أو مسارات أخرى. إنها تراجع لقصة البحر وتقدم لقصة البر: لم تصبح العودة إلى البحر هي الهاجس الرئيسي للطروسي، بل ضمان حياة مستقرة على البر.
يتكون هيكل النص الروائي من فصول ثلاثة، ويشكل كل فصل وحدة لها قوامها ومنطقها واستقلالها النسبي. إن كل فصل يُبنى من خلال “فعل مركزي” ستنسج حوله مجموع العناصر المشكلة للرواية:
– سيشهد الفصل الاول ” فعلا كبيرا ” يتلخص في معركة الطروسي ضد صالح بن برو. وحول هذا الفعل ستلتف مجموعة من اللقطات التي تفسر هذا الفعل وتُفَسَّر عبره وهي أيضا عماد الفصل ككل.
– ويشتمل الفصل الثاني على “فعل /معلمة”، ويتعلق الأمر بإنقاذ ” الشختورة ” وهي مركب للصيد كان على وشك الغرق لولا تطوع الطروسي للإبحار بحثا عنه وتخليصه وتخليص الرحموني صاحبه من أنياب الأمواج العاتية.
– أما في الفصل الثالث، فسيتطوع الطروسي ، مع بعض البحارة لنقل السلاح إلى المناضلين الذين يقاتلون المستعمر الفرنسي.
إن كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة يشتغل كنواة سردية تعد نقط مركزية في سيرورة بناء الأثر الدلالي ( الآثار الدلالية ) المتولد عن مجموع البناءالروائي. وهذه الأفعال نفسها هي التي تجعل من النص الروائـي يعيـش على وقـع انشطار داخلي يجـمع بين رحلة البحـث الفردي ( العودة إلى البحر ) وبين رحلة البحث السياسي (الانتماء السياسي، أي الانخراط في فعل لا ينجز إلا جماعيا ). فعبر الرحلة الأولى تتشكل خيوط الرحلة الثانية، وعبرهما معا ستتحدد معالم النمو الداخلي للنص الروائي، وآفاق تطوره بعد تخلصه من تراكمات “الكم الحدثي” ذي الطابع الخطي.
إن التخلص من هذا “الكم الحدثي” يمر عبر إمساك استبدالي بمجموع الوقائع النصية من خلال تكسير الخطية الزمنية التي يستدعيها أي تناول توزيعي للمعنى. فنهاية مسار القراءة الخطية، وكذا مسار الحركة السردية يمكن أن تتحول، في أفق استرجاع البناء العام للنص الروائي، إلى نقطة بدئية يتم عبرها تجميع هذا الكم في وحدات دلالية قابلة لاستيعاب مجموعة كبيرة من العناصر المشخصة.
وبناء عليه، فإن تمفصل النص الروائي في رحلتين متقابلتين من حيث الوسائل ومن حيث الغايات ومن حيث الدلالات، يجعل من الرحلة الثانية ( العمل السياسي) نقيضا للرحلة الاولى. ويعود هذا التناقض إلى طبيعة الرحلة الاولى؛ فهي فردية في الوسائل وفردية في الغاية وفردية في الدلالة، في حين لا يمكن التعامل مع الرحلة الثانية إلا من خلال بعدها العام وغايتها الجماعية. إن الرحلة الأولى لا تتطلب أي تحول أو تغيير في ماهية وكيان القائم بالفعل، في حين يرتبط نجاح الثانية بتحول يمس الفعل والفاعل معا.
ولعل هذا التقابل هو الذي يجعل من النص الروائي يدفع بالخيط السردي في اتجاه تحقيق الرحلة الثانية مع الإبقاء على مضمون الرحلة الأولى حيا يُشار إليه من حين إلى آخر. إن الانتصار للرحلة الثانية هو وضع الفعل السردي ضمن دائرة دلالية تقود من حد إلى حد عبر سلسلة من الوقائع المشخصة : الطروسي البحار الأمي الفردي النزعة سيتحول، من خلال لقائه بالاستاذ كامل، إلى مناضل سياسي. إن هذا التحول سيأخذ قاعدة لإنجازه مجموعة من القيم التي يلج من خلالها الطروسي إلى مسرح الأحداث. ويمكن رسم معالم هذا التحول عبر سلسلة من التقابلات التي يعمل النص، عبر لحظات سردية متنوعة، على إبرازها في شكل مواقف وصفية أو فعلية.
وهكذا، فإن المسار السردي الرئيسي للرواية يتشكل من هذا التقابل الذي يجمع من جهة بين لحظتين سرديتين داخل المسارالحياتي للطروسي :
الخروج من البحر (م) العودة الى البحر
لحظة اللاسياسي ( م) السياسي.
ويجمع من جهة ثانية بين قيمتين دلاليتين كتركيب تجريدي للوقائع المشخصة:
جهل النفس (م) معرفة النفس
صحيح أن الغطاء العام لهذا المسار ينطلق من قصة عادية لشخص عادي لكي يجنح بعد ذلك إلى طرح قصة السياسة، إلا أنه بإمكاننا، انطلاقا من مبدأ الاستبدال، تغيير هذه القصة وتغيير تفاصيلها وشخصياتها، لكن ما لا يمكن تغييره هو هذا البحث المضني عن الحقيقة، حقيقة النفس وحقيقة الآخر وحقيقة المجتمع ككل. إن القصة هنا تُبنى كذريعة لكي ” يقول” النص أشياء أخرى.
إن هذا التقابل بين قصتين، قصة تحكي مشاكل الفرد المنعزل، وقصة تحكي هموم المجتمع، هو الوجه الآخر للمحور الدلالي السابق. إلا أن هذا التقابل بين عالمين لا يمكن رده إلي بنية عامة وشاملة في الرؤية والموقف والمصير، ويمكن تحديدها في :
الزيف ( م) الحقيقة
ذلك أن الرواية في تشكلها كبنية تامة لا تنطلق من “لحظة الزيف” لتسقط “لحظة اللازيف” في أفق انتقاء ” لحظة الحقيقة”. إن عملية التمثيل التشخيصي تضعنا أمام حالة فردية مغرقة في تفردها، ولكنها تحتوي على كل القيم الأصيلة. إنها قيم فردية ولكنها قيم إنسانية ذات بعد كوني.
إن النص الروائي يقدم الطروسي ( الشخصية الرئيسية في النص) من خلال سلسلة من القيم التي تتمثل في “الرجولة” و”الشهامة”و”الكرامة” و”الشجاعة” الخ . إنها قيم مثمنة في ذاتها ولذاتها، وليست مرتبطة بأي ” إطار” سوى خصائصها الذاتية، أي لها علاقة بكل ما يمكن أن يمجد الإنسان كإنسان. إنها- حسب الرواية – قيم “الشعب” و”أخلاق الشعب” التي يجب الكشف عنها وإبرازها، ويكفي العودة إلى النص الروائي في مستواه الخطي لنكتشف وجود مسارات تصويرية تكثف هذه القيم وتردها إلى كيان أشمل وأعمق من الفرد، إنه الشعب : > هذه هي الصخرة التي ينهض على أمثالها البناء. صحيح أنه ليس عاملا، ولا فلاحا ولكنه من الشعب، من أبناء الشعب المخلصين، من فروع سنديانتنا الضاربة جذورها في الارض < (ص 328 ).
إن الفعل السردي لا ينطلق من هذه القيم بهدف إلغائها وتعويضها بقيم جديدة، وإنما يقوم بذلك بهدف إعادة تعريفها وفق نسق آخر، أي تحويل مضمونها ومنحها بعدا جديدا هو البعد الجماعي. وبعبارة أخرى، فإن الفعل السردي يقوم باستثمار هذه القيم في اتجاه مردودية سياسية مستندة إلى إيديولوجيا محددة المعالم.
إن هذا التواصل بين عالمين : “عالم الفرد ” و” عالم الجماعة”، بين “رحلة الفرد” و”رحلة العمل السياسي الجماعي”، هو المحدد لطبيعة البناء الدلالي للنص الروائي، إنه يبنى ويؤول انطلاقا من “قراءة ” إيديولوجية لقيم موجودة خارج حدود الإيديولوجيا، إن الأمر يتعلق بتحويل لمحتوى القيم وفق غايات الإيديولوجيا كنوع من تعميم هذه الإيديولوجيا ومنحها بعدا “شعبيا ” عبر خلق مصالحة بين البنيتين: بنية الرحلة الفردية ومقتضياتها، وبنية الفعل السياسي ومقتضياته أيضا.
وبعبارة أخرى يجب عقد مصالحة بين القيم الفردية والبعد السياسي لأي فعل إنساني. فمن أجل استمرارية ومقروئية الفعل السردي، كان لابد من إيجاد مبرر للانتقال من حالة النقص الأولى (حالة فردية ) إلى خلق حالة نقص ثانية ( حالة جماعية ).
إن هذا الربط يتم من خلال عنصرين : العنصر الزمني باعتباره الوعاء الذي تصب فيه كل التجارب الانسانية وتؤول عبره . وعنصر الفضاء باعتباره السند المادي الذي يحتوي الأفعال ويجسدها.
– فعلى المستوى الأول يتم الربط بين الماضي والحاضر من خلال سلسلة من الأفعال كعملية إسقاط لحظة زمنية على أخرى لقياس حجمهما السردي. وهذا الإسقاط يتم من خلال إعادة إنتاج معادل ” حاضري ” للماضي من خلال إنجاز مجموعة من الأفعال المطابقة لأفعال تمت في الماضي:
الماضي الحاضر
حب ماريا حب أم حسن
معركة ضد إيطالي معركة مع صالح بن برو
غرق المنصورة إنقاذ الشختورة
تهريب الزعماء نقل السلاح
إن الرواية تروي في الماضي قصة حب عاشها الطروسي قديما. فلقد أحب امرأة اسمها “ماريا” في ميناء من الموانئ البعيدة التي كان يزورها على مركبه ” المنصورة “، كما تروي قصة معركة خاضها ضد إيطالي تجرأ وهتف باسم موسيليني وشتم العرب. وتروي أيضا قصة غرق المنصورة وعودته إلى البر. هذا بالاضافة إلى قصة تهريب الزعماء من جزيرة أرواد.
أما في الحاضر، فإنها تروي قصة حب الطروسي ” لأم حسن ” العاهرة التي ” سيعتقها ” ويتزوجها في نهاية الرحلة. وفي الوقت نفسه تروي قصة معركته ضد صالح بن برو الذي هاجمه واعتدى عليه في مقهاه. كما تروي قصة تطوع الطروسي لإنقاذ ” الشختورة ” وصاحبها، وتطوعه لنقل السلاح إلى المناضلين.
إن هذا التوازي بين الماضي والحاضر البادي من خلال وجود سلسلة من الأفعال المتشابهة هو ما يسمح بالإمساك بالمستقبل، وهو ما يسهم في خلق تواصلية في الخيط السردي الرابط بين الماضي والحاضر.
إن إسقاط الماضي على الحاضر ( وهو إسقاط يتم بهدف الإمساك بالخيوط التي تنسج ثوب المستقبل ) عبر نوع من التطابق بين الأفعال، يقود إلى خلق تناظر دلالي يضم في ثناياه مجموع العناصر الضامنة لانسجام مقروئية النص. إن هذا الأمر ممكن من خلال وجود تواصلية زمنية تشير إلى تواصلية على مستوى القيم.
إن غياب القطيعة بين كون قيمي وآخر يجد تفسيره في هذا التوازي بين قصة الماضي وقصة الحاضر. ومن هنا، فإن وعي الذات لنفسها ووعيها لعالمها الخارجي لا يتم عبر إلغاء الزيف للوصول إلى الحقيقة. فلا وجود لزيف في ماضي البطل، أي في أفعاله وصفاته. ولقد أدركت ذلك الرواية جيدا وجعلت من “الحس السليم ” المنطلق الرئيسي لعملية التمثيل التشخيصي. إن هذا الحس قابل لأن يتحول إلى “وعي سياسي” منظم كتجسيد كلي للحقيقة ( الأمر يتعلق هنا بحقيقة ايديولوجية).
وهكذا، لا يجب البحث عن التحول الذي عرفه الطروسي في شيء آخر غير هذا “الحس السليم” ( كان الطروسي يحب الفقراء من الصيادين وعمال الميناء، ويكره “الصيد بالديناميت” ولا يحب الواشين والبلطجية، ويكره الاستعمار، وكان أيضا معتزا بعروبيته، وفي نفس الوقت كان فحلا وشهما وشجاعا وزير نساء).
– وعلى المستوى الآخر، أي المستوى الفضائي، يؤول إسقاط الحاضر على الماضي كإسقاط لفضاء محدد ( البر- سوريا – اللاذقية بالتحديد ) على فضاء لامحدد ( البحر- الموانئ البعيدة) داخل نفس الكون القيمي ( التواصل المشار إليه سابقا ). فاللامحدد ( العام-الشمولي) يصبح، من خلال ارتباطه بالمحدد، قابلا للتحديد والمعاينة من خلال ارتباطه بكون قيمي مجسد في شخصية ( الطروسي ) تتحرك داخل كون معطى بكل تفاصيله ( الأفعال والصفات). فداخل سيـــرورة التفاعــــل بين هذيـــن الفضاءين ( أنماط الارجاع المتــتاليــة : هنا (م) هناك، هناك (م) هنا )، يصبح “المحدد” مركزا محوريا يستطيع عبره “اللامحدد” أن يتشكل كفضاء قابل للتخيل ( يستطيع القارئ، وهو يتعرف على الطروسي من خلال الحكي في الحاضر، أن يسحب هذه الصورة على الماضي). إن الـ”هناك” ( الماضي ) هو الكوة التي نستطيع من خلالها الإمساك بـ ” الهنا ” الحاضر الممتد في فعل السياسة كقيمة جديدة.
ومع ذلك فإن درجة مقروئية الأول تختلف عن درجة مقروئية الثاني. فالأول يحيل على حياة بكاملها، حياة شخص تتوزعه المقهى والميناء والشاطئ و”عش الحب” وشوارع المدينة، إنه يمتلك سلطة التمثيل المباشر. أما الثاني، فإنه انتقائي جزئي غير كامل ومتحيز ( نحن لا نعرف إلا الجوانب المضيئة في حياة الطروسي ). إنه لا ينفذ إلى نص الحاضر إلا عبر الإشارات التي لا تملك بنية خاصة بها.
إن هذا الفضاء لايقوم إلا بانتقاء مجموعة صغيرة من الأفعال ليضيفها إلى الأفعال التي أنجزت في الحاضر لتصبح رافدا ماضويا يسهم في تشكيل الصورة النهائية للطروسي، ورسم حدود “كينونته” كما يسهم في مفهومية الأفعال المنجزة في الحاضر من طرف الذات. وعلى هذا الأساس يمكن وضع ثنائية :
البحر / البر
عمادا للفعل السردي، أي منطلقا لتمثيل مجموعة من القيم الدلالية عبر وقائع مشخصة تستمد قوتها من جهاز الإيديولوجيا.
فإذا كان البحر باعتباره فضاء كليا غير قابل للتجزيئ ( على عكس البر الذي لا يدرك إلا من خلال ” وقائع ” فضائية محددة ) فإنه يشير إلى بنية دلالية للفعل التركيبي كوجه مشخص للعلاقة الدلالية:
البحر الهزيمة ( غرق المنصورة (
(م) (م)
البحر الانتصار ( انقاذ الشختورة (
وإذا كان فضاء الهزيمة هو فضاء الانتصار أيضا، فإن الانتصار يمد خيوطه في اتجاهين:
– تحقيق البعد الفردي للرحلة : سيعود الطروسي إلى البحر على ظهر مركب جديد “ريسا ” كما كان.
– تحقيق البعد السياسي لهذه الرحلة : سيعتنق الطروسي الفكر السياسي الجديد ويعلن عن انتمائه إلى الحزب.
فإذا كان البحر يشير إلى الانفصال أولا كطرف محين ( غرق المنصورة ) وإلى الاتصال كطرف محتمل ( إمكان العودة إلى البحر)، فإن البر هو مكان استرداد القوة ( القوة الفردية والقوة السياسية ) والعودة من جديد الى البحر.
وما بين البر والبحر ينتصب “الشاطئ” ( الفضاء الذي قضى فيه الطروسي مدة طويلة في انتظار العودة إلى البحر) حيزا فضائيا غير محدد الانتماء. إنه ليس برا، فهو امتداد للبحر، ولكنه ليس بحرا فهو امتداد للبر؛ إنه فضاء “البين بين “. إن “حياده” هذا هو الذي يجعل من زمنه ( زمن مكوث الطروسي في الشاطئ ) “زمنا للاستئناس” ( temps d’initiation). وزمن الاستئناس يوجد خارج التجربة ( تجربة الانتماء) إنه ما يوجد بين زمنين فاصلين في تجربة حياتية تقود من حالة إلى حالة أخرى، تماما كما هي تجربة المريد الذي يود الانتماء إلى زاوية أو فرقة أو طريقة ما.
إن حلقة الفعل هاته المؤدية إلى انتشار سردي أحادي القيمة والغاية والوسيلة والأبعاد، تمر عبر وعي مركزي يجسده في مرحلة أولى سارد مطلق المعرفة يُسرب عالمه عبر الطروسي ” الحس السليم ” وعبر الاستاذ كامل ( المناضل الشيوعي الذي يعمل على توسيع دائرة الحزب ونفوذه ) “الوعي الايديولوجي العلمي “.
وفي هذا الاتجاه، فإن الكشف عن بنية المادة المسرودة وأشكال تجليها، يبرز وجود نواة سردية دائمة تتكرر عبرها نفس البنية السردية بنفس الأدوار والنتائج. فمن الفصل الأول إلى الفصل الثالث مرورا بالفصل الثاني، تطرح هذه النواة ركيزة تتوزع عبرها سلسلة من القيم ذات الطابع التصاعدي :
– الفرد ……… : سيقاتل الطروسي دفاعا عن نفسه ودفاعا عن حقه في العيش على الشاطئ في انتظار ساعة الإبحار.( الفصل الأول)
– الطبقة …….. : سيغامر الطروسي ويبحر ليلا وسط الأمواج بحثا عن ” الشختورة ” وبحثا عن البحارة الذين يهددهم الموج العاتي. ( الفصل الثاني )
– الوطن ……. : سيتطوع الطروسي ويسافر بحثا عن السلاح ونقله إلى المقاتلين دفاعا عن الوطن . ( الفصل الثالث )
ومن هذه الزاوية، فإن البنية السردية الكبرى ( أي البناء الروائي في شكله النهائي) تتماهى في كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة. وبعبارة أخرى، فإن بنية كل فصل ليست سوى وجه مصغر للبنية الكبرى التي تقوم القراءة ببنائها.
- 2- الرحلة أو زمن الاستئناس
لقد اقتصر تحليلنا في الصفحات السابقة على تقديم تصور “كلي ” للبناء الروائي بتمفصلاته ومفاصله الكبيرة. وبإمكاننا الآن النظر إلى هذه الوقائع من زاوية علاقتها بعنصرها المولد، أي الجهاز الذي تشكلت في أحضانه وتبلورت أشكال وجودها. إن الأمر يتعلق بالإرغامات التي يفرضها “الجهاز الإيديولوجي ” على نمط بناء وبلورة القيم الدلالية التي يعد النص مهدا لها ولاحقا لوجهها التجريدي.
وهكذا إذا كان الحكي يحتوي، بالإضافة إلى بعده الخطي التوزيعي، على بعد آخر غير مرئي في مستوى التجلي المباشر للفعل السردي، فإن عملية الربط بين البنيات الصغرى والبنية الكبرى لا تتم إلا من خلال قراءة استبدالية تؤكد الطابع التراتبي للمستويات.
وبناء عليه، يمكن من جهة، ربط مجموع القيم الدلالية الصغرى ( الصفات التي تُعين عبرها وضعيات مشخصة ) بالبنية الدلالية الكبرى ( قصة الوعي الثوري ونمط انتقاله من محفل إلى آخر ) من خلال رد مجموع هذه القيم إلى العنصر المولد، أي محاولة إيجاد رابط يجمع بين مجموع الوحدات القيمية ويوحد مضامينها ويجعلها قابلة للقراءة.
ومن جهة ثانية يمكن الربط بين مجموع التجارب ( الأحداث التي عرفها النص ) كخطاطات سردية صغيرة داخل التركيب السردي العام باعتباره الأداة المنظمة للمجموع السردي ( الوقائع الصغيرة التي تبنى عبرها الوقائع الكبيرة ).
– في الحالة الأولى يمكن أن يقودنا العد التصاعدي للقيم، الذي يتشكل عبر مجموعة من الثنائيات ” الصغيرة “،وهي ثنائيات مرتبطة بنسق ايديولوجي يظهر – سرديا- على شكل وقائع متنوعة المضامين :
سياسي (م) لا سياسي
واع ( م ) لاواع
مستغَل ( م ) مستغِل
الشعب ( م ) البرجوازية
الخير ( م ) الشر
الاشتراكية ( م) الرأسمالية،
إلى إبراز تقابل دلالي يفصل بين عالمين لارابط بينهما ولا يمكن عقد مصالحة بينهما؛ وعلى أساس هذا التقابل يشيد النص ويقرأ ويؤول، ويتعلق الأمر بـ :
جهل النفس ( م ) معرفة النفس
وهذه الثنائية محددة داخل جهاز إيديولوجي خاص ( الماركسية) وسابق على النص ومولد له، بل إن الرواية ليست سوى شكل من أشكال تجلياته.
– وفي الحالة الثانية فإن التجارب الصغيرة ( “المعارك ” التي خاضها الطروسي ) هي الجسر الذي يقودنا إلى استشراف آفاق المعركة الكبرى ( معركة تغيير المجتمع ) التي لن نشهد منها إلا قرار خوضها. ذلك أن السرد في خلقه للتراكمات الحدثية، يقود إلى إشباع ينتهي بتوجيه الرواية إلى أن تتفتح على عالم يشيده القارئ من عنده ( عندما يلتحق الطروسي بالحزب سيدرك القارئ طبيعة الفعل الذي سينجزه ).
إن الحالتين معا تشيران – في مستوى نمط بناء النظام الدلالي – إلى الطابع الاستئناسي ( caractère initiatique) للقصة المروية داخل النص الروائي. والاستئناس هو التحول دائما من حالة إلى حالة : تطهير وتغيير وطقوس الارتقاء إلى عالم أكثر “نضجا”، إنه التخلي عن نمط في التفكير لمعانقة نمط جديد؛ وهو أيضا الخروج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والرجولة ( طقوس الرشد في أفريقيا )، طقوس “الحضرة ” للانتماء إلى “طريقة ” ما الخ .
والاستئناس هنا هو الوجه الآخر للأطروحة، أي طريقة وأسلوب في التعامل مع القيم الدلالية وطريقة في تسريدها. فالنص – كما تؤكد ذلك مساراته السردية والخطابية – ينطلق من مقولة إيديولوجية ليمنحها وجها مشخصا.
وهذا الإجراء يفرض على النص سلسلة من الإرغامات التي يجب أن يخضع لها دون أن يقلل من قيمته الجمالية. فعلى أساس وجود جهاز إيديولوجي يتحكم في تنظيم المادة المسرودة خطابيا وسرديا، تُبنى الرواية كهيكل يتجنب كل أسباب التعقيد (التعقيد الدلالي والتركيبي).
وهكذا، فإن النص في تقدمه نحو إرساء قواعد نهايته لا يضع أبدا موضع شك ما تم إنجازه في مرحلة سابقة. ومن ثم فإن النظام الداخلي للرواية يسير وفق خطة تقود من فعل إلى فعل ومن قيمة إلى قيمة داخل سلم تراتبي صارم. وكل فعل يتم إنجازه يعد “مكسبا” نهائيا يوضع في حساب الشخصية : إن الانتماء إلى العالم الجديد – المبني إيديولوجيا على شكل ثنائيات، والمسقط سلوكيا على شكل أفعال وصفات – يتم من خلال إخضاع الذات لسلسلة من التجارب يشكل تحققها تبريرا لهذا الانتماء ويؤكد أحقية الذات في هذا الانتماء.
وهذا ما تؤكده ” طقوس الاستئناس “، أي الأفعال المسجلة في كل فصل على حدة حيث ستشهد الرواية أخيرا اعتراف “الشيخ” (الاستاذ كامل) “لمريده ” ( الطروسي ) باجتيازه لامتحان الارتقاء إلى الوعي الصحيح ويؤكد تغييره : يتحدث الطروسي عن نفسه : >… فهل يستطيع منع بؤس هذا الشيخ، هل يستطيع منع بؤس كل الشيوخ؟ ” صدق الأستاذ كامل، القضية ليست قضية فرد، بل مجتمع، ينبغي إصلاح المجتمع < ( ص 364)
وهذا الطابع الاستئناسي هوالذي يفسر أيضا طبيعة البناء الحكائي للنص الروائي. إن هذه الطبيعة تتجلى أولا في طغيان العنصر الوظيفي وهيمنته على مسارالخيط السردي. فالسلوك الانساني الممثل يُدرك أولا وأخيرا من خلال بعده الوظيفي بعيدا عن عناصر الرمز والأمارة ومجموع أشكال التواصل الأخرى، لأن هذه العناصر قد تشوش على نقاء الإرسالية الإيديولوجية وصفائها ( إن الأساطير التي يوردها النص لها وظيفة التوضيح وليس وظيفة التنويع الدلالي ).
إن الرواية تدرك، كبناء تام من خلال “الأفعال الكبرى” على أنها تجارب مؤدية بشكل أحادي التوجه إلى غاية محددة داخل الشكل البنائي نفسه. وهذه الخاصية هي ما يميز الحكايات الشعبية. إذ إن العناصر الوظيفية تعد عماد هذه الحكايات ولا تلعب العناصر الأخرى سوى دور ثانوي جدا. وتتجلى الطقوسية ثانيا في تسريد الفضاء وتوزيعه على الأفعال. ويتميز هذا الفضاء بالسكونية، وما نعنيه بالسكونية هو غياب التلازم بين حركة الزمان وحركة الفضاء.
ذلك أنه على الرغم من أن أحداث الرواية موزعة على عشر سنوات، فإن الفضاء الذي يستوعب هذه الأحداث سيظل ثابتا كما تم تحديده مع البدايات الأولى للرواية.
إن غياب التلازم هذا يفسر أولا بإقصاء الزمن كعنصر حاسم في التطورات المسجلة في النص، ذلك أن الفعل يدرك كقيمة لا كتجربة زمنية. إن تعريف الفعل يوجد خارج الزمنية، إنه يشير إلى لحظة داخل الايديولوجيا وليس إلى سيرورة داخل التاريخ.
وسيتضح ثقل الايديولوجيا وإرغاماتها أكثر لحظة الحديث عن الشخصيات وتصورنا العام لها وعن بنائها : كيف تنتقي الرواية سكانها وتوزع عليهم أدوارا وأنماط سلوكية وأفعالا توضع للإنجاز؟ .
إذا كانت الشخصية باعتبارها سندا لمضامين متعددة هي البؤرة التي تتجلى فيها وعبرها كل العوالم الدلالية التي يعد النص وعاء لها، فإنها لا تدرك إلا باعتبارها الأثر المتولد عن تسنين مجموعة من أنماط السلوك وإسنادها إلى كائن يحمل اسما علما أو يحمل رمزا يدل عليه، وكذا ما يترتب عن فعل القراءة كفك لرموز التسنين والكشف عن هذا الأثر.
إن النص الروائي يستند في بناء هذا الكيان إلى معرفة سابقة تحتوي على الأفعال والأدوار والصفات والمصير أيضا. إن الأمر يتعلق بجهاز إيديولوجي له الكلمة الفصل في تأسيس الشخصية ومثولها أمامنا ككائن يتحرك على شكل صفات وأفعال مسننة داخل عالم تجريدي، إنه عالم القيم، كما تم تعريفها ضمن عقيدة خاصة حيث تتحول المادة المضمونية إلى قاعدة صارمة ينطلق منها السارد في مراقبة “نمو” شخصياته وأنواع ” سلوكها”.
وهكذا وضعنا السارد أمام تحديد ثنائي للعالم الانساني،(الخير -الشر، الصدق- الكذب، الشعب – البرجوازية …) وبقدر ما يتحدد هذا العالم الثنائي كتقليص لكل أشكال الصراع الممكنة ( مجموع العلاقات الانسانية المحددة للفرد، التي لا يمكن اختزالها في بعد إيديولوجي واحد )، كانت الشخصية تضمحل وتتحول إلى رمز أو أمارة تحيل على موقع محدد داخل جهاز إيديولوجي واحد ووحيد. ويُستعاض عن هذا التقليص في عمق الشخصية وأبعادها وسلوكها، بالإحالة المتكررة على نسق إيديولوجي ” يغني” عن “الوجه الحياتي” المباشر لهذه للشخصية.
إن الآثار المباشرة لتحديد تقليصي من هذا النوع هو اختزال السلوك الإنساني في خانة واحدة تلغي كل أشكال التقاطعات الثقافية داخل المجموعة البشرية الواحدة.
ولقد كان النص – من هذه الناحية – موزعا، إجمالا، على مجموعتين من الشخصيات، وكل مجموعة محددة من خلال “رأس لائحة” يمثل أقصى درجة في التمثيلية الإيديولوجية والسياسية والفكرية : فمن جهة يقدم الأستاذ كامل ومن معه كممثل للفكر النقي وكرمز للخير والصدق وصوت للشعب، ومن جهة ثانية كان هناك أبو رشيد كوجه قبيح ممثل للشر والخبث والرأسمالية والاستغلال.
ولا يمكن أن يفسر هذا التحديد الصارم للشخصيات إلا بالبحث عن ” مردودية ” للجهاز الإيديولوجي في السلوك الإنساني وفي طرق تمثيله داخل النص. وللوصول إلى هذا الهدف استندت الرواية، في تأسيس شكل مضمونها، إلى مادة مضمونية جاهزة وضعت أساسا لتشكيل كل المستويات المكونة لكيانها.
إن هذا النمط نفسه في توزيع الشخصيات، وفي بنائها وفي تحديد اشتغالها أيضا، هوالذي يفسر النمط الذي يخضع له تسريد المادة الزمنية وتوزيعها وتداولها ووضعها أساسا للتحول، وأساسا في تشكيل كيان الشخصيات ( الزمن هو العنصر الأساسي الذي تتطلبه عملية سرد الأحداث لكي تتحول إلى قصة، وخارج الزمن لا نصادف إلا القيم التي تفتقد إلى سياق يحتضنها).
فالملاحظ أن الزمن داخل النص الروائي لا يطرح إلا إطارا فاصلا بين التجارب، ويقتصر دوره على تحديد مقروئية النص ومقروئية التحولات من خلال تصنيفها داخل وعاء زمني معين. ولعل النقطة الزمنية الوحيدة التي تخبر عن التحول هي تلك التي يتحرك داخلها “المريد” أي الطروسي. إلا أن هذه النقطة نفسها لا تشتغل أساسا لهذا التحول، بل موضوعة كأمارات زمنية تدل على الانتقال من حالة إلى أخرى، ومن فعل إلى آخر دون أن يكون لها أي دور في التحول، فالتغيير يوجد في الإيديولوجيا لا في الزمن المروي.
إن تغييب الزمن كمستودع للتجارب الإنسانية من جهة، وكباعث على التحول الذي يمكن أن تخضع له شخصية ما من جهة ثانية، يعود بالأساس إلى أن الرواية – بحكم انتمائها إلى نوع محدد – رواية الاطروحة – تعالج الحياة من زاوية قيمية. وبعبارة أخرى، فإن السلوك الإنساني لا ينظر إليه من خلال انضوائه داخل الزمن المحدد لكل تحول، ولكن من خلال ما يحيل عليه من قيم لها موقعها – السلبي أو الايجابي – داخل النسق الايديولوجي السابق على النص كتجربة زمنية في المقام الاول.
وليس غريبا أن نلاحظ أن توزيع الصفات على الشخصيات يتم بشكل نهائي مع البدايات الأولى للفعل السردي. ويتخذ هذاالتوزيع طابع الكلية والشمولية لدرجة أن الرواية، في نموها وتطورها وجنوحها نحو موتها، لا تقوم بتعديل الصورة الممنوحة لهذه الشخصية أو تلك، إنها تكتفي فقط بالكشف عن العناصر الموجودة في الصفات عبرالأفعال، وعن العناصر الموجودة في الأفعال عبر الصفات.
إن هذه التحديدات المتنوعة المرافقة للفعل السردي تقف في حدود تفجير هذه الصفات في أفعال ( وظائف ) وأنماط سلوكية مرئية ومتوقعة من خلال الصفات ذاتها : إن الصفة تجد صورتها دائما في الوظيفة، وكل صفة ما هي إلا سلسلة من الأفعال الممكنة القابلة للتحقق جزئيا أو كليا في ” نسخة محددة” الأطراف. ويدل على ذلك “الثنائية الشخوصية” المهيمنة على المتن الحكائي : هناك من جهة الطروسي، وهناك من جهة ثانية الأستاذ كامل، إنها ثنائية تشكل حالة متميزة داخل النص ( وهي نفس الثنائية التي يؤسس حولها الكون الروائي في ” الثلج يأتي من النافذة ” : خليل العامل وفياض المثقف ). فالطروسي يتحرك داخل النص وفق النمط الحكائي الشعبي كبطل ممثل للخير كله. إن الرواية لا تحكي قصة رحلة تقود من السلب إلى الإيجاب. فالبطل لا يتعلم الخير ولا يبحث عنه لأنه هو صورة هذا الخير.
إن حركته داخل الزمن – وداخل الفضاء أيضا – حركة تقود من صورة مثلى للفرد المعتز بفرديته ( الصفات المشار إليها سابقا ) إلى الصورة المثلى للفرد الذائب وسط المجموع ( نجاح المريد عبر طقس الاستئناس ).
وما بين الصورة الأولى والصورة الثانية تنتصب الإيديولوجيا، باعتبارها جهازا فوقيا، بؤرة للتحول الذي لا يغير من الطروسي ولكنه يكشف داخله عن عناصر كانت موجودة قبل تدخل الإيديولوجيا على شكل إرهاصات وأحاسيس وأنماط بسيطة للسلوك.
وفي المقابل يتحرك الأستاذ كامل خارج إطار أي سياق وخارج إطار أي تطور ( الزمن ) سوى سياق الإيديولوجيا التي يعد صورتها المثلى. ومن هنا، فإن الرواية لا تخلق له دورا ولا تحدد له صفة، ولا تكشف له عن سلوك؛ ما دام دوره وصفته وسلوكه عناصر محددة في نص آخر سابق على النص الروائي، لذلك فهو لا يموت بموت الرواية. إنه الشكل الدائم المستمر المستعد لاستقبال مضامين جديدة. ودوره داخل هذا النص ليس سوى تحقق خاص ضمن تحققات أخرى ممكنة وقابلة للاستخراج من مقولة سياسية مثبتة داخل النص السياسي.
فإذا كان الأستاذ كامل هو أداة التوسط بين المحفل الذي تصدر عنه المعرفة وبين الذوات التواقة إلى هذه المعرفة ( الطروسي والآخرين )، فإن هذا المحفل لا يمكن أن يتشكل ككيان يتحدد من خلال شفافيته كسلوك أو ككائن يصيب ويخطئ، إنه على العكس من ذلك صوت سردي يتحدد داخل النص كحقيقة مطلقة متعالية، سابقة على الخطاب السردي وسابقة على تحققه الخاص. وبعبارة أخرى، إنه كيان يظهر من خلال خطابه ( الخطاب المرجعي الدائم ) ومن خلال خطابات الاخرين، ككون قابل للادراك من خلال إسقاط ” أناه” الأخرى (أي الطروسي). إنه نواة مرجعية للفعل السردي وللقيم الدلالية التي ينشرها هذا الفعل.
إن هذه النواة المرجعية الدائمة الحضور تأخذ كامل أهميتها من خلال النسق الإيديولوجي الذي يلف تحرك الذوات داخل النص الروائي. فالحكي باعتباره وحدة دالة مركبة يقوم بنشر المعرفة عبر الخطابات ويطرحها كأداة رئيسية لأي فعل وكعنصر ضابط لوضع كل الذوات ووضع كل الخطابات. ومن خلال هذه الخطابات تتحول هذه الذوات إلى عنصر تابع للذات أو المحفل المالك للمعرفة.
وعلى هذا الأساس، فإن المعرفة ( الإيديولوجيا ) لا توجد في السلوك، ولا توجد في جزئيات الحياة اليومية، بل تتأسس من خلال القول ( صوت السارد الذي يقوم بخلق القيم ونشرها )، وتنبعث من فضاء آخر غير فضاء النص. إن الإيديولوجيا في هذه الحالة تضع في حسابها كل ما يعود إلى السلوك النقي.
وبالتاكيد فإن القوة الموجهة والضابطة للحكي، تكمن في تأسيس هذه البؤرة وتحديد موقعها كصوت مولد للقصة. ومن هذه الزاوية، فإن هذه النواة تلعب دورا حاسما في الربط بين كل ” الأنات” الممكنة ” بأنا ” واحدة هي “أنا” التلفظ كشكل من أشكال المراقبة والضبط الذاتي للنص، وهذا ما يسمح للسارد بطرح سقف واحد للقيم تقاس عليه وتنطلق منه وتعود إليه كل الخطوات العملية الصادرة عن هذه الذات أو تلك سلبا أوإيجابا.
ففي حالة الإيجاب، يعمد السارد إلى خلق تطابق كلي بين خطابه وبين خطاب الشخصيات وفعلها، إنه الجسر الرابط بين عالم النص وعالم الإيديولوجيا. وفي حالة السلب يشير السارد، بكل الطرق إلى كل ما يميز نصه عن نص الشخصيات : إنه الغاء لعالم النص وتثمين لعالم الإيديولوجيا.
وعلى هذا الأساس، تكون أساليب السرد المعتمدة في تسريد كل معطيات النص، متطابقة مع المضمون الاستئناسي الذي لم تكف الرواية من بدايتها إلى نهايتها عن تطويره. ويتجلى هذا المضمون في انتزاع شخصية معينة ( الطروسي ) وتحديدها كمريد يكتشف ذاته ويكتشف الآخرين من خلال الخضوع لسلسلة من التجارب التي ستقوده إلى الوصرل إلى أقصى درجات الكمال بمعانقة الفكر السياسي الجديد : أي لحظة التطابق المثلى بين عالم السارد وعالم الشخصية، التحام “أنا” التلفظ بـ “أنا” الملفوظ.
إن الرواية، بمجموع عناصرها، رحلة ؛ رحلة من البحر إلى البر، ومن البر إلى البحر، ورحلة من الجهل ( جهل النفس ) إلى المعرفة (معرفة النفس )، ومن قضايا الفرد إلى معانقة هموم الجماعة، ومن الارتباط بالطبقة إلى استشراف آفاق الوطن، ومن الانعزال إلى التفتح. إنها تدشن زمنا للاستئناس ينطلق فيه المريد من معرفة ” وافدة” نحو الوصول إلى نفسه من خلال الخضوع لما يشير عليه الشيخ به : الخضوع لسلسلة من التجارب التي تحدد حجم قناعاته وصلابتها. إن إنجاز هذه الأفعال يقود الرواية إلى خلق مصالحة بين عالمها وبين المتناص الذي تنطلق منه، وخلق مصالحة بين عالم الفرد وعالم الجماعة، إن الأمر يتعلق بقراءة إيديولوجية لقيم لا يبدو أنها وليدة نسق إيديولوجي بعينه.
إن قراءة هذه الرواية وقفت في حدود ضبط آليات اشتغال النص عبر المتناص الايديولوجي، وضبط آليات “المتناص الايديولوجي” عبر مكونات النص. إنها ليست قراءة كلية وليست نهائية، إنها تصور خاص محكوم بمنطلقات تتعلق بتحديد اشتغال هذا النمط من الروايات.
* الشراع والعاصفة ، حنا مينه ، دار الآداب ، الطبعة الرابعة مارس 1982.