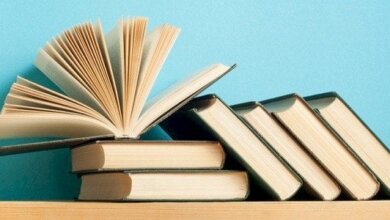عبيد الشعراء

من بين تلك العبوديات التي تضج بها مدونات القهر، يمكن الحديث عن أحد أنماطها الغريبة، التي تسعى إليها صاغرة بعض النفوس المنتمية على سبيل الادعاء، إلى عالم الإبداع، ونخص بالذكر منها العبودية التي ينضوي تحت حظوتها، أغلب من خانتهم ملكاتهم، في تأسيس سكن شعري خاص بتطلعاتهم الفكرية والجمالية، حيث يكونون تبعا لذلك، مجبرين على تكريس حياتهم الثقافية والإبداعية، لخدمة «سادتهم» في الشعر، كما في الحياة.
طبعا، لا جدال في أن ما من شاعر إلا وتحتفظ ذاكرته بلائحة طويلة أو قصيرة، برسم رموزه الشعرية الأكثر انسجاما وتفاعلا مع ذائقته الإبداعية. باعتبارهم مناراته التي يأمل أن يهتدي بها إلى سكن قصيدته المنتظرة.
وهي الرموز ذاتها التي تتشكل بأغصانها شجرة نسبه الشعري الدال على خصوصيته. كما لا جدال في أن الظاهرة جد طبيعية، وجد موضوعية، لاسيما في المراحل الأولى من مراحل بحث الشاعر عن مساراته الشخصية.
فالشاعر في بداياته يكون مدعوا لامتلاك معرفة وافية، متعددة المرجعيات، بأسرار انبناء القول الشعري، سواء على المستوى الفكري أو الجمالي. ومن المؤكد أن الأسئلة المطروحة على هاجس البحث، تقود الشاعر إلى الاندماج في تجارب اختبارية، يتعرف خلالها على حدود تماهيه مع النماذج العليا المستبدة بافتتانه وإعجابه.
ولعل الغاية المركزية المطلوبة من لعبة التماهي هذه، هي التخلص من ضغط المسافة الفاصلة بين طموحه الشعري، وتعالي النموذج، حيث يقتنع تدريجيا بمشروعية انتمائه عمليا، إلى ما يعتبره شجرة نسبه الشعري، الممثلة في رموزها الأكثر إشعاعا.
وبموازاة هذا الاقتناع، يشرع في اجتراح مساره الشخصي، على قاعدة المسلمة النظرية التي مفادها، أن قيمة النص الشعري، تتحدد في تفرده التام بجماليته الاستثنائية التي يستقل بها عن غيره من النصوص. ذلك أن هذا البعد الاستثنائي، هو الذي يضفي على الكتابة الشعرية خصوصيتها، كي لا تتحول إلى مجرد نسيخة، تنحصر وظيفتها في إعادة إنتاج ما هو جاهز سلفا.
وبالتالي، فإن أي تعامل نقدي جاد وموضوعي معها، سيكون حتما مدعوا لحشرها ضمن ظاهرة التراكم، الناتج عن تعدد المحاولات، المتطلعة عبثا إلى تقليد النموذج الأصلي. بمعنى أنها لا ترقى إلى مستوى الكتابة، بقدر ما هي أسيرة محاولات ذات طابع مدرسي صرف.
ومن المؤكد، أن القراءة الخبيرة بأسرار الكتابة الشعرية، تقر بأن أغلب ما يدبج من قصائد، على امتداد الأمكنة والأزمنة، لا يعدو في واقع الأمر، أن يكون محض تمارين مدرسية، تنجز على هامش النصوص الكبيرة.
وكما هو معلوم، فإن ما يتم توصيفه بـ»مرحلة التمدرس» لدى الشاعر، يكتسي أهمية بالغة في هندسة مساراته، باعتباره شرطا أساسيا من شروط ولادة ذلك الكائن المقدس والملعون في آن، خاصة أن التمدرس هنا هو المجال الحقيقي والطبيعي، الذي يتشبع فيه الشاعر بما يكفي من إواليات المعرفة، التي تضيء حركية اجتراحاته الفنية والجمالية.
غير أن ذلك لا ينفي كون مراوحة المتمدرس في المكان ذاته، تعني بشكل أو بآخر، عجزه الصريح عن تملك هوية الشاعر، بما يحيل عليه مفهوم الهوية هنا من عمق وخصوصية. وسيكون من الضروري في هذا السياق، التمييز بين واجب الاحتكام للمعرفة الشعرية، سواء خلال قراءة النصوص أو كتابتها، ضمن رؤية شعرية متفردة ومستقلة بقوانينها، واعتمادها أولا وأخيرا، في تقفي نموذج شعري بعينه، بغاية التماهي التام والمطلق معه.
إن الأمر يتعلق بقابلية كبيرة لدى هؤلاء للخضوع الاختياري والتلقائي لعبودية عمياء، يحتمون بها من غيلان ذلك الفراغ، المتلذذة بالإجهاز على كل آمالهم في الكتابة، أو القول، منتمين بذلك إلى مدرسة عبيد الشعراء، بدل الانتماء إلى مدرسة عبيد الشعر.
ففي الحالة الأولى، سنكون بصدد كتابة تستند إلى مبدأ امتلاك خبرة وافية بآلية اشتغال أصوات الآخرين، تفاديا للوقوع الإرادي أو اللاإرادي في مطب تكرارها، وإعادة إنتاجها.
فيما تطالعنا الحالة الثانية ببؤس ذلك الصوت، الذي لا تستقيم نبراته إلا من خلال تهافته، وذوبانه التام واللامشروط في أصوات الآخرين، عبر النسج المجاني والعشوائي على منوالهم.
وإذا ما كنا في الحالة الأولى، بصدد التفاعل مع تجارب نموذجية تعمل على تطوير خبرتها المعرفية، قصد الارتقاء الواعي بمشروعها الفكري والجمالي، فإننا سنجد أنفسنا في الحالة الثانية، أمام ظواهر هجينة بالمعنى السالب والقدحي للكلمة، تتخذ من المعرفة وسيلة للتمرس بتقنية الانتحال والاستنساخ، وفي الآن ذاته، للإعلان عن عبوديتها المطلقة للنموذج «القدوة».
وسيكون من الضروري هنا، التأكيد على أن مصداقية المعرفة الشعرية، لا يمكن أن ترقى إلى مكانتها اللائقة بها، إلا على ضوء تجديدها لرؤيتها الشعرية، التي ينبغي أن تكون باستمرار موضع تساؤل ومراجعة، ممارسة بذلك محوها المتتالي لذاتها، بحثا عن ذلك الطيف الشخصي، والحي، المتخفي وراء صخب القول، وهرج المعيش.
إنها/ المعرفة، المعتمدة من قبل الشاعر المسكون بهاجس التجاوز الخلاق، كأداة عملية لتمثل الأزمنة الشعرية، وقهرها لسلطة ثوابتها، بموازاة تحريرها لذاكرة اللغة، ولذاكرة المعيش والمتخيل. وهي الحرية التي تشتغل في جميع المسارات الممكنة والمحتملة، بحثا عن إشارات مغايرة، ومؤهلة لانتزاعنا منا، والزج بنا في أتون حركية لاهبة، تمضي بنا حيث توجد أطياف المنسي واللامفكر فيه، موقظة في دواخلنا ذلك الفضول، الذي يحرص على إعادة قراءة المرئي، والكشف عن خباياه.
إننا لا نكون إذاك بصدد تهجي ما سبق ليد شاعر ما أن خطته بشكل أو بآخر على بياض الصفحة، بقدر ما نجد أنفسنا مدعوين لمعايشة المختلف والمغاير، ذاك الذي يتوجه إلينا من تضاريس جغرافيات شعرية، لم يكن لنا من قبل علم بمداخلها، أي اكتشاف العلاقات القائمة بين الكون المحتجب خلف الكون.
بما يعنيه ذلك من اكتشاف منطق جديد للتفاعل مع الكلام، بوصفه عالما مضاعفا وتركيبيا، موجودا على طريقته الخاصة، خلف السجف التي ما فتئ العالم يشوش بها صفاء رؤيتنا.
وكما هو معلوم، ففي غير قليل من الأحيان، وبمنهجيات لا تمت بصلة إلى منهجية الوعي الشعري أو كتابته، يلح عديمو القرائح، إلى إثارة دوامات وزوابع، ترافقهم في الحل والترحال، متيحة لهم إمكانية البقاء في دائرة الضوء، بصرف النظر عن مصادره، وعن دلالة دائرته! وفي حالات أخرى، يتحول هاجس الإثارة إلى حمى منطوية على هوسها المرضي، بالوجود الدائم والمجاني، في بؤرة الهالات الكاذبة والمزيفة.
وفي سياق إشارتنا للمنهجيات الموظفة في هذا الإطار، يحضرنا من جديد الانبهار المفتعل للظواهر ذاتها، ببعض الرموز الشعرية الحاضرة بقوة في المشهد الكوني، والمنتمية أساسا إلى المراكز الغربية. انبهار، يتجاوز حدود الإعجاب الطبيعي والمشروع، كي يبلغ مستوى قداسة لا تستند إلى الحد الأدنى من القناعة الذاتية المبررة علميا ومعرفيا.
إنها القداسة المفترى عليها، والهادفة أساسا إلى تأجيج حالة الإيهام بالقرب من الحدائق السرية لهذه الرموز، وخدعة الانتماء إليهم.
وتبعا لذلك، سنخلص إلى القول، إن الأمر يتعلق بقابلية كبيرة لدى هؤلاء للخضوع الاختياري والتلقائي لعبودية عمياء، يحتمون بها من غيلان ذلك الفراغ، المتلذذة بالإجهاز على كل آمالهم في الكتابة، أو القول، منتمين بذلك إلى مدرسة عبيد الشعراء، بدل الانتماء إلى مدرسة عبيد الشعر.