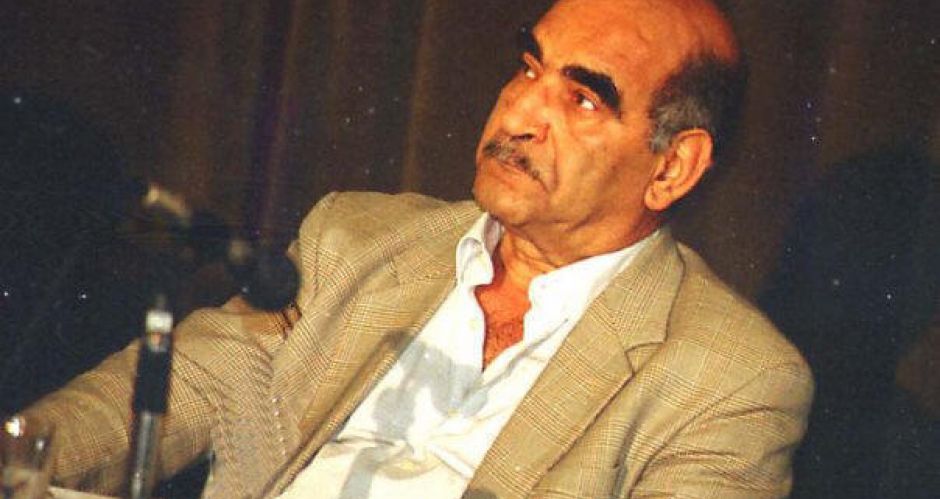إضاءات موغلة في الوضوح على الداخل السريّ

أتناول في هذه الوقفة الحديث عن شهادات الأسرى الكتّاب التي تضمنها كتاب “الكتابة على ضوء شمعة”. شاركني في إعداد الكتاب وتحريره الأستاذ حسن عبّادي، وصدر عن دار الرعاة وجسور ثقافيّة، (رام الله وعمّان، 2022)، واشتمل على ستّ وثلاثين شهادة، تحدّث فيها أصحابها من الأسرى والأسيرات عن معاناتهم في الكتابة، ويعدّ الكتاب مثالاً جيّداً على نوعٍ معيّن من أنواع كتابة المضطهدين، كما سيأتي بيانه لاحقاً.
يُعرّف الاضطهاد بأنّه “تجاوز الحدّ في السلطة وإِرهاق [آخرين] بتدابير عنيفة وجائرة”، ويحمل هذا المفهوم في طيّاته “إساءة المعاملة النظاميّة لفرد أو مجموعة من قِبل فرد أو مجموعة أخرى”. ويختلف هؤلاء المضطهدون من مجتمع لآخر، ففي المجتمعات الشرقيّة العربيّة الإسلاميّة تحديداً قد تكون المرأة الكاتبة من ضمن المضطهدين، عدا المضطهدين من الكتّاب سياسيّاً، أو المضطهدين اجتماعيّاً، أو المضطهدين بسبب العرق أو اللون أو الدين أو المهنة أو بسبب الوضع الاقتصادي، أو المضطهدين بسبب الحروب، كالمعاملة التي عامل بها الأوربيّون المواطنين الروسيّين على خلفيّة الحرب الأوكرانيّة الروسيّة الأخيرة،
وكانت هذه المعاملة نهجاً عامّاً أوروبيّاً، وليس تصرّفاً فرديّاً، بل كانت مشمولة بقوانين دوليّة؛ على مستوى الدولة الواحدة أو مجموع دول القارّة الموصوفة بالقارّة “العجوز”، وشملت تلك المعاملة محاربة الأدب الروسي الكلاسيكي وأعلامه، ومنع تداول مؤلّفاتهم وتدريسها في الجامعات الأوروبيّة، ما شكّل حالة خاصّة من الاضطهاد الثقافي المعاصر الذي يندر أن يوجد بهذه الصورة في دول تدّعي الديمقراطية وتطبيق قواعد حقوق الإنسان، لولا هذه الحرب التي غيّرت- أو كادت تغيّر- كثيراً من القواعد والقوانين والأعراف الدوليّة.
كلّ أفراد تلك الفئات المضطهدة، الروس وغيرهم، يشتركون في أنّ “السلطة القائمة” أو “المسؤولة” لا تعاملهم معاملة طبيعيّة، ويفترض هذا المفهوم وجود مستويين من المعاملة، ونوعين من القوانين على أقلّ تقدير، ولها في المجتمع كثير من الظواهر والتجلّيات التي تشير إليها وتفضحها، كالزواج والتعليم، والممارسات السياسيّة العامّة، والحصول على الوظائف، والتنقل الداخلي أو الخارجي (السفر)، أو تقوقعهم في مكان معيّن أو جغرافيا خاصّة منغلقة، أو اقتصارهم على مهن محدّدة.
يدخل في مفهوم “كتابة المضطهدين” كلّ من مارس الكتابة للتعبير عن هذا الاضطهاد بشتّى أشكاله، أو كَتَب خاضعاً لشروطه، أو أنّه كتب من أجل التمرّد عليه، كالكتابة النسويّة، جندريّة الطابع والقضيّة، وكُتب المعتقلين، وكتب المنفيّين، والمهجّرين قسراً عن بلادهم، وكتب المهمّشين، أو من يعانون من عنصريّة دائمة أو مؤقّتة، أو الواقعين تحت طائلة التنمّر بسبب أوضاع صحيّة كذوي الاحتياجات الخاصّة، أو اجتماعيّة أو قومية أو جنسية أو أفكار معيّنة، والذين يكتبون تحت أسماء مستعارة بدافع الخوف على حياتهم، أو من أجل أن يحظَوْا باهتمام ما؛ كنشر مجموعة من الكاتبات كتبهنّ بأسماء رجال، وقد خصّصتُ للحديث عن “مضطهدات الكتابة” وقفة مستقلّة.
يعدّ الاعتقال السياسي شكلاً من أشكال ممارسة الاضطهاد، حيث يجرّد صاحبُ السلطة هؤلاء المقهورين المضطهدين من الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة؛ جميعها أو معظمها، ولذلك فإنّ هذه الشهادات التي تضمّنها كتاب “الكتابة على ضوء شمعة” وأمثالها ذات قيمة تاريخيّة واجتماعيّة وسياسيّة غاية في الأهمّيّة في أنّها تفضح أساليب المتسلّطين (مصلحة إدارة السجون ومن ورائها الدولة بوصفها الكيان الغاصب) تجاه مجموعة من المعتقلين المقهورين فيما يخصّ موضوع الكتابة، وما يتّصل بها من حرّيّة التعبير.
وتكمن أهمّيّة هذه الشهادات في أنّها تضيء على كتابات الأسرى، بوصفها نوعاً من أنواع كتابة “المضطهَدين” الذين ينتجون كتاباتهم وهم خاضعون لهذه السلطة خضوعاً مباشراً، وهم داخل السجن، وواقع عليهم في كل آن فعل الاضطهاد، بأشكاله كافّة المعنويّة والمادّيّة، وهي بهذا تختلف عن الأنواع الأخرى من كتابة الكتّاب المضطهدين الذين يتعرّضون للاضطهاد بشكل غير مباشر، ولا يشكّل المسئولون لديهم همّاً مرهقاً محسوساً في أيّة لحظة من يومهم في المكان الذي هم فيه.
كما أنّ لهذه الشهادات قيمة أدبيّة عالية؛ فضلاً عن قيمتها التوثيقيّة السابقة، إذ تعمل على توضيح عمل الكاتب السجين. إذاً، ثمّة مواضعات وظروف نحن لا نستطيع أن ندركها تمام الإدراك، ولو قرأنا عنها، فليس الخبر كالمعاينة، لقد جاءت هذه الشهادات لتقول لنا الكثير عنها، خاصّة لمن لم يجرّب حياة السجن، وظلّت هذه الحياة غائمة عنه في تصوّراتها، وما يُبنى عليها من اعتقادات واجتهادات ورؤى نقديّة وأدبيّة.
إنّ الأسرى يعيشون أوضاعَ قهر حقيقيّة، كفيلة بتحويلهم إلى مجرّد كائنات صامتة، نادمة، خائفة، خانعة، إلّا أّنّ من يقرأ هذه الشهادات الإبداعيّة يخرج بصورة مختلفة تماماً عن هذا التصوّر، لنجد كتّاباً مناضلين، ومملوئين طاقة وحيويّة، وما زالوا محرّضين على العمل الثوري، وغير نادمين، بل إنّهم أكثر قوّة من قبل، كأنّ العيش في بؤرة الزلزال تجعل المرء حجارة ثائرة. هذا ما عرّض كثير من الكتّاب إلى الاعتقال مثلاً، أو إعادة الاعتقال، أو العزل أو الحرمان من بعض الحقوق على تواضعها في الأصل. يثبت الكتّاب في هذه الشهادات أنّ الكتابة أداة من أدوات الصراع، حقيقة لا مجازاً.
تبيّن هذه الشهادات الخطوط العريضة والعامّة لعالم الكتابة في ظروف الاعتقال، ببعديها العامّ والخاصّ، وتحاول أن تجيب عن أسئلة الصنعة الكتابيّة، تلك الأسئلة التي لا يكفّ الكتّاب عن طرحها في العالم كلّه، سواء أكانوا أسرى أم لم يكونوا، أسئلة من قبيل: ما الذي يجعل الكاتب كاتباً؟ وكيف؟ ولماذا يكتب؟ ولمن يكتب؟ وما هي الظروف اللازمة لصنعة الكتابة؟ وما هي الأدوات اللازمة لهذه الصنعة؟ ومتى يكتب؟ وأين؟
كما أنّ هذه الشهادات تجري خلف الكشف عن أثر الكتابة في نفس الكاتب أوّلاً، لاسيّما وأنّ كثير من هؤلاء الأسرى من ذوي الأحكام العالية، المؤبّدة، واكتشفوا أنفسهم على ضوء تجربة السجن، فصاروا كتّاباً بفضلها- إن كان لهذه التجربة فضل ما. لقد منحتهم هذه التجربة أيضاً شيئاً من التأقلم القسري مع هذه الجدران التي تحيط بهم، فغدت تمثل عوالمهم جميعها حتى في أحلامهم لم يستطيعوا إلا تصوّر هذه العوالم،
إنّهم كمن ولد وعاش في هذه الحدود المغلقة، ولهذا كان في بعض تلك الشهادات الحديث عن عالم السجن والغوص فيه، وتأمّل الكتابة من خلاله، كأنّ أصحاب تلك الشهادات- وهم قلّة- يبحثون عن تحسين أوضاع الكتابة داخل السجن، كما يبحثون عن تحسين أوضاعهم المعيشية الإنسانيّة، إذ اقترنت الكتابة بوجودهم هذا المشخّص المحصور، وصارت نشاطاً ذهنيّاً وروحيّاً واجتماعيّاً، إضافة إلى أنّه نشاط ثقافي أدبي، يصوّر هذه الأوضاع وهذا الوجود، ويبحث عن التأقلم معه.
ولا يعني التأقلم البحث عن الرضا الواقعي بالمكوث داخل الأسوار، وإنّما البحث عن صيغة حقيقيّة أو متوهّمة ليستطيع الأسير أن يعيش وهو يتمتّع بشيء من القدرة، على أن يعيش ويشعر أنّه حيّ، ويتصرّف كإنسان طبيعي جدّاً، كأنّه ليس سجيناً، ويقاوم عوامل نسيانه من العالم الخارجي، ويذكّر سجّانيه أنّه يعمل، ويحبّ، ويتزوج، وينجب أطفالاً (ولو بالنطف المهرّبة)،
ويكتب، وتنشر له الكتب، وتشارك في معارض الكتب الدولية، وتقرأ من القرّاء والنقّاد، وتعقد لها الندوات، فتتوسّع بفضل ذلك كله سلطة هؤلاء الكتّاب المعرفيّة، فلا يظلّون محصورين محاصرين منسيّين خلف القضبان. وهم- مع كلّ يتّصل بما يكتبونه- يحقّقون مكاسب معنويّة، تجعلهم أقدر على التعايش بأقلّ الخسائر مع هذه التجربة المريرة، وغير الإنسانيّة.
وبالمجمل، فإنّ طول مكوث الأسير الكاتب في السجن جعلته يفكّر على نحو مختلف عن الكاتب المحكوم بضعة أشهر أو حتّى بضع سنوات، وهو يرى أنّ الزمن الذي سيتحرّر فيه قادم، أمّا الآخرون من الأسرى المؤبّدين، فلم يعودوا يرون غير السجن وعوالمه، فبحثوا عن مثل هذا التأقلم، وقلّت لديهم نبرة الأمل في الخروج، ولم يعودوا يحلمون به، فلن يتمّ هذا الخروج إلّا بمعجزة، أو عمل عسكري كبير، أو اتّفاق منصف، وكلّ هذه الخيارات لا شيء منها في الأفق المنظور،
فارتدّوا إلى الذات والأحلام فكتبوا عن هذا المتخيّل الذي يحميهم من الجنون، ولعلّ الأسير كميل أبو حنيش بحسّه النقدي التأمّلي العميق أدرك هذه المعادلة، فانعكست في أعماله، شعراً، وسرداً، وفي شهاداته المتنوّعة على الكتابة ذاتها، وقد خصّص لها كتاباً، غير هذه الشهادة المودعة في كتاب “الكتابة على ضوء شمعة”، وأقصد بذلك كتابه المخطوط الذي جعله تحت عنوان “الكتابة والسجن”، وشرح فيه كيف كتب أعماله في المعتقل خلال هذه السنوات الطويلة، وأضاء بشكل جيّد على شتّى أشكال المعاناة التي عاناها في كلّ مرحلة من مراحل الكتابة مع كلّ كتاب ألّفه.
كما أنّ هذه الشهادات تسعى لبيان علاقة الكاتب الأسير بالمتلقّي ثانياً، وطبيعة هذا المتلقّي، سواء أكان متلّقياً مع أو ضدّ، لذلك حضر- كثيراً في هذه الشهادات- “المتلقّي العدوّ”، النقيض، الغريب، الذي يحاول بشتّى الطرق القضاء على نزعة التحرّر، ولو كانت حلماً عبر ممرّ الكتابة. لتخرج بسؤال حادّ وصعب للغاية: لماذا يحاول السجّان دائماً محاربة الكتابة لدى الأسرى؟
في هذه الشهادات يجيب الكتّاب عن هذا السؤال إجابات مطوّلة، لكنّها تتمركز حول قضية الإمعان في السيطرة والإذلال والمهانة، وإفراغ الوقت، وقت الأسر، من القيمة الحقيقيّة. فالكتابة مرتبطة في هذا العالم الضيّق بالوعي الوطني والإنساني، والتمرّد على كلّ من يحاول حرفه أو السيطرة عليه، ومن الطبيعي- إذاً- أن تشملها أفعال الاضطهاد المقصودة التي يمارس السجّانون عن إصرار ووعي كاملين.
ذهبتْ بعض هذه الشهادات كذلك، من باب آخر، نحو تقديس عمليّة الكتابة، لتكون أشبه بالطقوس الدينيّة، كالعبادة تماماً، وعلى الطرف المقابل، ثمّة من أضفى عليها ظلالاً من السرّيّة الشبيهة بممارسة العمليّة الحميمة، فاستعار الكتّاب أفعالَ التقبيل والملامسة وفضّ البكارة والاستلقاء، والعري، كأفعال مقابلة لفعل الكتابة نفسه. وهذه الفكرة على طرافتها وأهمّيّتها ودلالتها النفسيّة في الردّ على إجراءات الاضطهاد كأنّها غير موجودة، وهذا بحدّ ذاته إمعان في مقاومة تلك السلطة المتجبّرة، ليست من ابتكار هؤلاء الكتّاب، بل هي قديمة، وكثيرون من أشاروا إليها، خاصّة في الشعر، كما عند أبي تمّام في قوله على سبيل المثال: “الشعر فرج ليست خصيصته طول الليالي إلّا لمفترعه”.
ومع أنّ هذه العمليّة تحتاج إلى السرّيّة التامّة، وهنا تبدو المفارقة، إذ لا سرّيّة في السجون، فكلّ ما يحدثُ سيحدث تحت أعين الجميع، وعمليات التحايل في الانعزال وإيهام العزلة ما هي إلّا توظيف لقدرات التخييل للانفصال عن هذا الواقع الضيّق الفاضح، المليء بالضوء.
لذلك ربّما وجد القارئ المتفحّص لهذه الشهادات بعض التحدّي، تحدّي الواقع الموجود، وتحدّي النفس في القفز على هذه الرغبة المطلوبة. كلّ هذا يحيل الدارسين إلى تمعّن “سيكولوجيّة” الأسير الكاتب، أو الكاتب الأسير الذي يقع تحت تأثير المفاضلة بين الصمت وبين الكتابة ضمن معايير وشروط غير كتابيّة، بمعنى الرضا “بطقوس اللّاطقوس” في الكتابة، لأنّ الكتابة- باختصار- فعل مقاومة بالدرجة الأولى. وهي طقوس كما جاء في واحدة من الشهادات “طقوس تحكمها الضرورة لا الاختيار”. وعليه فهذه الشهادات تطيح بأهمّ شرط من شروط الكتابة المتوهّمة لدى الكتّاب خارج السجن، وهو: هل فعلاً يحتاج الكاتب- وهو يكتب- إلى العزلة والانفراد، وألّا يراه أحد؟ هنا سنجد كتّاباً يكتبون دون عزلة، فعالم السجين عالم منتهك في خصوصيّته الفرديّة.
هذه الظروف بهذه الجوّ الممعن في القتامة والبعد عن كلّ شرط موضوعي لتحقّقها، يفتح المسألة على موضوع آخر مهمّ، وهو موضوع الإلهام، والوحي، إذ تنهار هذه المسألة في هذه الشهادات، ففعل الكتابة في السجن ليس خاضعاً لهذا الوهم المستقرّ في نفوس المبدعين قديماً وحديثاً، إذ لا ينتظر الأسرى الإلهام والوحي ليكتبوا، بل يقتنصون اللحظة المناسبة- مهما كانت- ليكتبوا،
فالكتابة هنا بأنواعها كافّة متعالية على هذا الوهم، وهي قصديّة، تُعلي من شأن الموهبة، وليس من شأن الإلهام الخارجي، وتركّز على الاستعداد الذهني والنفسي للكاتب ليكتب في أيّ ظرف، وفي أيّ مكان متاح له، وبأيّة أدوات كتابيّة متوفّرة، إنّها بالفعل تشير إلى عمليّة موازية للكتابة التي قد تجد لها نقيضاً متوهّماً عند الكتّاب خارج السجن. فالكاتب داخل السجن مجهّز لمواجهة كلّ شيء قد يحبطه، فيواجهه قبل أن يحدث، كالمداهمات والمصادرات، والعقوبات، والعزل، والتنقّلات بين السجون، وضياع المخطوطات ونسخها، كلّ هذه الإجراءات لا تجدها في عالم الكتابة خارج هذه الظروف.
لعلّ من يعمل في مجال الكتابة ودراستها من حيث هي عمليّة إبداعيّة، سيجد في هذا الكتاب ثروة لغويّة ومعجميّة مرتبطة بحقل دلالي مفتوح على مصطلحات جديدة لها علاقة بالكتابة داخل السجن غير موجودة عند من كتب عن الكتابة من الكتّاب الآخرين؛ من يكتبون خارج السجن، وهذه المصطلحات- باعتقادي- تشكّل رافداً حقيقيّاً لمن يعمل على جمع تلك المصطلحات وتبويبها ودراسة ظروف نشأتها، ولن يكتمل تصوّر عالم الكتابة إلّا أن تكون حاضرة مع غيرها في هذه المعاجم التي تكون بطبيعة عملها استقصائيّة، وتبحث قدر الإمكان عن الشمول والإحاطة.
ينظر الأسرى الكتاب إلى عالم الكتابة خارج السجن أنّه عالم وردي، رومانسي، حافل بكلّ ما هو جميل ومشجّع على الكتابة، ربّما كان ما هو خارج السجن أرحمَ قليلاً من داخله، لكنْ ثمّة مشاكل حقيقيّة وبنيويّة تواجه الكاتب خارج السجن، لم يلتفت إليها الكتّاب، باعتقادي لأنّ أغلبهم أصبح كاتباً داخل السجون، فلم يرَوْا الكاتب وهو يبحث عن الهدوء في بيته، والهموم التي تلاحقه من متطلّبات الحياة القاصمة للظهر التي قد تصرف ذهن الكاتب عن الإبداع والاستمرار فيه،
إنّها مشاكل حقيقيّة يغرق فيها الكتّاب الآخرون، فثمّة كتّاب لا يجدون وظيفة يعتاشون منها، ولا يجدون بيتاً آمناً واسعاً ملائماً للكتابة، ويجدون من حولهم يثبّط من عزائمهم بالتندّر عليهم والحطّ من شأنهم، وإن وجدوا من يشجّعهم لا يشجّعهم على الكتابة إلّا لأنّها عمل مناسب لتزجية وقت الفراغ، فهي عمل لا جدوى منه، وقد أضاء على هذه المعاناة القاصّ اليمني عبد الله سالم باوزير في قصّة له بعنوان “الفقيد” المنشورة في مجموعته القصصيّة “الحذاء”. وممّا جاء فيها هذا السطر الدالّ: “للأديب ظروفٌ كثيرة قد تَحولُ بينه وبين الكتابة، وأحياناً تحول دون مواصلة الحياة نفسِها”. لقد تشابه الفريقان في صلب المعاناة وروحها، وإن اختلف السبب وتباينت الظروف.
في هذه النقطة الأخيرة سيجد القارئ أنّ كتّاب السجن، ككتّاب الخارج، لا يكتبون من أجل المتعة، أو من أجل تمضية وقت الفراغ، وليست الكتابة- إذاً- نوعاً من الترف، بل تكتسب الكتابة لديهم أهمّيّة وجوديّة توازي أهمّيّة الحرّيّة ذاتها أو الحياة نفسها في مقاومة مظاهر الاضطهاد والتعالي- ما أمكن- على “السلطة” وعلى تلك الظروف التي وضعوا فيها جبراً عنهم، وكلّ كتابة لا يُنظر إليها على أنّها مسألة وجوديّة لا يُعوّل عليها، وليس في باطنها ثمار صالحة لتعيش طويلاً.
وتأسيساً على هذا، فإنّ هذه الشهادات، وما أشارت إليه من موضوع الكتابة عن الذات، يفسّر على أنّ هذا النوع من الكتابة ذاته يرسّخ مفهوم مقاومة الاضطهاد، مقاومة فرديّة إبداعيّة لها آثارها في نفوس الكتّاب أنفسهم، “فأنا أكتب إذاً أنا موجود”، ليس مجرّد شعار رفعه أحد الأسرى الكتّاب في هذا الكتاب، بل هو عينه ما أراد الكتّاب أن يقولوه ليس في شهاداتهم وحسب، بل أيضاً في كلّ ما أنتجوه من شعر وقصّة وبحث وكتابة رسائل، وليس فقط هؤلاء،
إنّما هذا ما يطمح إليه الكتّاب جميعاً، لكنّه بالنسبة للأسرى يأخذ معنىً أكثر حضوراً ودلالة على تحقيق هذا المبدأ في تصوّر الشغف بمهنة الكتابة والإصرار على فاعليّتها داخل المعتقلات، كما هو عند الكتّاب الذين يعانون من الاضطهاد، وسخّروا ما يكتبون لإثبات الذات في مواجهة الظلم والتعسّف، كما لاحظت هذا الشغف عند الكاتبات اللواتي تعرضنَ للاضطهاد، إذ يزيد لديهنّ الولع بالكتابة أكثر من غيرهنّ، وينظرن إلى مسألة الكتابة أنّها مسألة توازي الحياة ذاتها أو هي أن تعيش الحياة بحرّيّة وكرامة، فيكثرن من الحديث عن الكتابة ذاتها والغوص في فلسفتها ومنافعها المعنوية؛ كأنّها أصبحت لديهنّ ملجأ أو حارساً أو متنفّساً، وقد وُجد شيء من ذلك عند الكاتبات الأسيرات في شهاداتهنّ حول الكتابة في كتاب “الكتابة على ضوء شمعة”.
بدا هؤلاء الأسرى الكتّاب أيضاً يتمتّعون بسمات شخصيّة جدير أن أشير إليها بعجالة، وتتلخّص هذه السمات في أنّ الكتابة أكسبتهم مزيداً من العناد والصبر والتحمّل في مواجهة الآخر العدوّ، وفي مواجهة الناقد المتربّص بهذه الكتابات. هذا الناقد الذي يعاني من الوهم أيضاً الذي لا يرى ما يجب أن يُرى، فأتت هذه الكتابات لتزيد هذا العالم وضوحاً، لتقول للناقد “الفذّ” عليك أن ترى المسألة من جميع جوانبها، هذا لا يعني بحال من الأحوال أن يغضّ النقّاد الطرف عن الكتابة الضعيفة الميّتة،
إنّما على الأقلّ هناك ظروف موضوعيّة تؤثّر في صنعة الكتابة على الناقد أن يكون حصيفاً وذكيّاً وهو يقارب تلك الإبداعات التي هي بكلّ تأكيد انتصرت على القيد، فرفرفت بجناحين من لغة ومقاومة؛ لتحطّ على أغصان شجرتنا الكبيرة الوارفة الظلال، لتكون الصورة أوضح وأشمل، وأفردتُ لهذه المسألة نقاشاً خاصّاً موسّعاً في كتابي “نظرات في الكتابة النقديّة”؛ فلكلّ تجربة إبداعيّة مقاييسها النقديّة المتولّدة من التجربة الإبداعية ذاتها.
ربّما دفعت هذه الشهادات النقّاد، أصحاب نظريّة “موت المؤلّف” إلى مراجعة هذه النظريّة التي ستكون قاصرة، والنقّاد يقاربون مسائل الأدب الاعتقالي بناء عليها، فثمّة امتدادات خارج النصّ لها علاقة بنيويّة داخله، لا يُفهمُ النصّ الاعتقالي فهماً صحيحاً دونها.
لقد أثبتت كتابة الأسرى أهمّيّة النقد الاجتماعي، وآلياته، فلكي تفهمه كاتباً عليك أن تعرفه إنساناً، على الرغم من صلاحية نظريّة “موت المؤلّف” فيما تصلح له من نصوص، لاسيّما إذا كانت تلك النصوص ذات قدرة على أن تستقلّ بظروفها التي أنشأتها، وكان الأديب قادراً على إخراجها بصورة تجعلها مستقلّة عن ظروفها المحيطة بها. وهذا الشرط باعتقادي فيما اطّلعت عليه من شهادات في هذا الكتاب،
أو ما أنتجه الكتّاب الأسرى من كتب لن تكون مؤهّلة لهذا البعد النقدي أو للدراسة ضمن هذا المجال من التحليل إلّا إذا كان فهم الناقد مقصوراً على مفهوم النظريّة على ألّا يتدخّل الكاتب نفسه في تفسير النصّ، وهذا ما بتّ مقتنعاً فيه شخصيّاً في فهم هذه النظريّة دون استبعاد كامل للظروف الموضوعيّة التي ساهمت في ولادة النصّ. وسبق لي أن فصّلت فيه القول في مقالين منفصلين منشورين سابقاً. (يُنظر: مقال: “لماذا يجب أن يصمت الكاتب؟”/ أمد للإعلام 30/8/2022، ومقال: “لماذا يجب أن يموت المؤلّف؟” الرأي الأردنيّة، 7/12/2019).
إنّ الأدب الفلسطيني لا يُفهم حق الفهم- من وجهة نظري- دون أن يكون الأدب الاعتقالي في بؤرة النقاش الأدبي الفلسطيني، وحتّى تؤدّي الصورة فاعليّتها الصحيحة “غير المقلوبة” جاءت هذه الشهادات لتقول ما قالت، ولنبني عليها الكثير من الأسس النقديّة والمنطلقات الأدبيّة في هذا النقاش الدائر حول الكتابة وجدواها أوّلاً، وحول الأسلوب والطريقة واللغة التي صيغ بها هذا الأدب ثانياً،
وأخيراً حول الموضوع وكيفيّة تناوله، كلّ هذه هي عوامل الإبداع ومحدّداته، كشفت عنها بوضوح كبير هذه الشهادات لهؤلاء الأسرى الكتّاب.