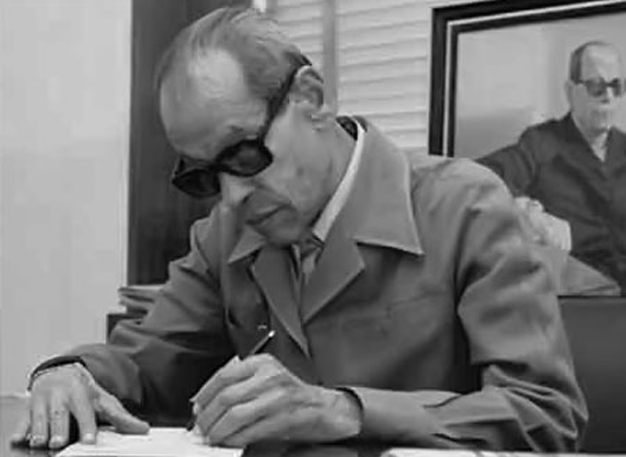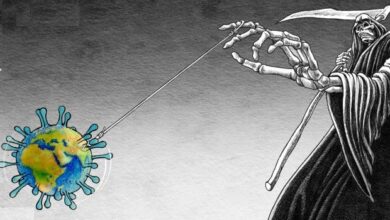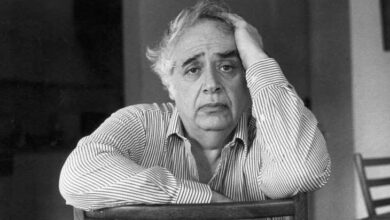عصر المُؤخرات

من ذا الذي لم يَلْفِ صاحبة مؤخرة مكتنزة تمشي متبخترة في قارعة الطريق، وهي تتمايل يمنة ويسرة، وكأني بها تسبِّح بحمد الله وتكبِّر لقاء ما أنعم عليها من خير عظيم يخطف الأنظار ويسحر الأبصار؟ ألم يَعُدْ معيار إثبات الوجود في زماننا هو التَّشمير على المؤخرات وليس على السواعد؟ ألم يصبح ارتداء سراويل ضيقة تخفي بقدر ما تظهر هو الطريق المَلكية نحو بنات جلدتنا لقضاء مآربهن؟ ألا يقول لسان حالهن: أنا أملك مؤخرة، إذاً أنا موجودة؟ هل يتعلق الأمر بكوجيطو جديد؟ وإلا فبماذا نفسر انتعاش صناعة المؤخرات في زماننا، وإقبال الطلب على امتلاكها من جهة، واستهلاكها من جهة أخرى؟
لم تَعُدْ المؤخرة في زمننا المعاصر تَنْهَضُ بالوظيفة الطبيعية فحسب متمثِّلة في إنتاج الفضلات، إنما صارت في زمننا المعاصر تنتج الفرجة؛ إننا، هنا، أمام مشاهد استعراضية لمؤخرات تفتح شهية الزبائن، وتخطف النظر، وتسحر البشر، وتذيب قلوب الحجر؛ هذا ما تشهد عليه فيديوهات تطلع علينا كل يوم في مواقع التواصل الاجتماعي، دون استشارتنا، بين من تقدِّم نفسها خبيرة في فن تكبير المؤخرة، وجعلها بمثابة المستديرة التي تسحر جماهير كرة القدم؛ وبين من تتكرَّم على أعزائها من المشاهدين والمشاهدات بتمثيل حقيقي لطقوس تكبير المؤخرة وهي تئِنُّ تحت وطأة التدليك والشد والجذب؛ وبين من تعرِض المنتوج النهائي للعصر في سراويل مختلفة الأشكال والألوان.
إننا، والحالة هذه، نكاد نكون أمام اقتصاد جديد يستثمر في صناعة المؤخرات التي صارت لها هالة كبيرة في المخيال الاجتماعي لبادئ الرأي، بل صار المقياس هو: قولي ما هو حجم مؤخرتك، أقول لك من أنتِ؟ مقياس جعل بنات جلدتنا يستمدن قيمتهن من حجم مؤخراتهن، نتيجة الفشل الدراسي، والتعثر المهني، وانعدام الوعي النقدي، وبالتالي يتهافتن على الوصفات الطبيعية منها والصناعية لتكبير مؤخراتهن، حتى ظهرت للعلن تجارة مربحة تستهدف إغراء النساء بالحصول على مؤخرات مثيرة، وبعروض مختلفة، وأسعار تفضيلية.
وَلَمَّا غَدَتْ السُّرعة مَيْسَمَ عصرنا، فلم يعد الاعتماد على الوصفات الطبيعية مُقْنِعاً لتكبير المؤخرات، نظرا لنتائجها البطيئة، إنما صارت الأغلبية يتهافتن على حلول صناعية سريعة تخرق قوانين الطبيعة، ساعية لامتلاك المؤخرات المثالية التي تسوِّق لها قنوات الدعاية والإشهار. فكيف نفسر هذا التحول؟ كيف تم الانتقال من مؤخرة تنهض بالأدوار الطبيعية دون اهتمام يذكر، إلى مؤخرة اصطناعية تتصدر المشهد الإعلامي، ومدار حديث الساعة؟ ألم تُقِمْ مؤخرة الفنانة جينيفر لوبيز القيامة ذات مشاركة لها في مهرجان موازين بثَّته قناة مغربية رسمية للعموم؟ فأنى لهذه المؤخرة القُدْرَة الهائلة على حجب المَطالب الاجتماعية، والمشاكل السياسية للشعوب، وتوجيه كل النقاش، بين ليلة وضحاها، نحو مؤخرة، ليست في الواقع إلا كتلة من لحم؟
لا نهدف من الأسئلة المطروحة إلى محاكمة امرأة تملك مؤخرة، أو الحَجر على ممتلكاتها الخاصة؛ كلا، ما هذا مرادنا، إنما غرضنا الرئيس هو محاكمة بادئ الرأي، ومحاولة فهم مسلماته، وكشف مطموراته، وفضح مخياله؛ ومن ثمة رفع القداسة عن عضو طبيعي قدَّرَت له الطبيعة النهوض بوظيفة بيولوجية، وسرعان ما تحول إلى مركز للاهتمام المبالغ فيه، إن لم نقل التقديس، والحال أنه لا يعدو عضو من جملة أعضاء لا تقوم له قائمة دونها.
لقد كان الفيلسوف مارتن هايدجر على حق عندما اعتبر أن التقنية تمثل اكتمال الميتافيزيقا، نظرا لسعيها لخلق الوحدة، وحجب الاختلاف، ولعل هذا الطرح يسري على صناعة المؤخرات في زماننا، حيث لم يعد مخيال العصر يقبل إلا بمؤخرة كبيرة وبارزة تتخذ من الدائرة، وهي أكمل الأشكال الهندسية في التقليد العِلمي القديم، نموذجا لها، أما ما عدا ذلك من مؤخرات فهي مهمَّشة، ولا تحظى بالاهتمام، اللهم إن سارعت صاحباتها لطلب نجدة خبراء العصر الذين يتفننون في صناعة الفرجة، ويحيطون علما بتكنولوجيا المؤخرات، وتسليع الجسد وفق معايير السوق، وشروط العرض والطلب.
لقد بات ملحوظا أن العلاقات الإنسانية تغيرت؛ إذ لم يعد الوجه هو المرآة نحو الغير، إنما بالأحرى المؤخرة، فتمَّ بذلك الانتقال من زينة الوجوه إلى فتنة المؤخرات، بل صارت هاته تغني صاحبتها عن الاعتناء بوجهها، بل أكثر من ذلك صرنا نشاهد في الآونة الأخيرة “سِلْفِيات” من نوع آخر؛ حيث تَمَّ الانتقال من “سِيلْفي” يسلِّط الضوء على الوجه، إلى آخر يسلط الضوء على المؤخرة؛ إننا، والحالة هذه، أمام سِيلفي مقلوب، تستمد فيه صاحبته قوتها من خَلْفِهَا لا من أمامها، أو قل، باختصار، من مؤخرتها لا من وجهها، وهو ما يَخْرُجُ عن الصُّور الشِّعرية المتوارثة، ويؤسِّس لذوق جديد، ويجعلنا نتساءل، ولو على سبيل السخرية: أليس عصرنا هذا عصر المؤخرات؟