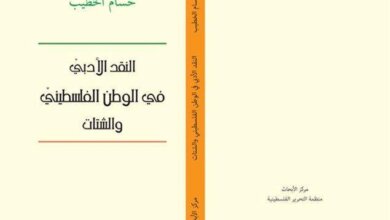الرؤية بين الأيديولوجيا واليوتوبيا في روايات ربيع جابر

تتجلّي علامات العصر في روايات ربيع جابر، كما يَبين شخصية في بعض نصوصه، يتردّد بين الماضي والحاضر، الواقع والحلم، فيمثّل ذاتًا لإنسان خبِر الحروب اللبنانية ومفاعيلها، في إلحاح رواته على تذكّر وقائعها، وإظهار عبثية الموت وابتذال العيش؛ لتشترع نصوصه إذّاك، عالمًا «ممكنًا» ذا قابلية على حمل المعاني الوجوديّة والاجتماعيّة العميقة تتيح النفاذ إلى عمق النص وتأويله لفهم حقائقه “الإمكانية”.
تتجلّي علامات العصر في روايات ربيع جابر، كما يَبين شخصية في بعض نصوصه، يتردّد بين الماضي والحاضر، الواقع والحلم، فيمثّل ذاتًا لإنسان خبِر الحروب اللبنانية ومفاعيلها، في إلحاح رواته على تذكّر وقائعها، وإظهار عبثية الموت وابتذال العيش؛ لتشترع نصوصه إذّاك، عالمًا «ممكنًا» ذا قابلية على حمل المعاني الوجوديّة والاجتماعيّة العميقة تتيح النفاذ إلى عمق النص وتأويله لفهم حقائقه «الإمكانية».
وفي إعلان الروائي أن العمل الوحيد الذي يريد أن يقوم به في هذه الحياة هو كتابة الروايات، يذهب بي إلى قراءة مشروعه السردي، وليس قراءة النصوص فقط. حسبها قراءة لإجلاء «نقشه لذاته»، متوخّية فهم التعالق السردي التاريخي، في استعادة الأحداث وارتباط الزمن بالتجربة والهويّة وتحوّلاتها، ومحاولة أن تكشف مدى تمكّن الروائي، وهو ينشئ كونه الحلمي، من تحقيق مشروعه في اختيار وجوده، وتجاوزه الواقع نحو نظام جديد من القيم يؤسّسها؛ إذ أنّ الانفتاح النصّي على ثقافات ممتدّة عمقًا في التاريخ والتراث الإنسانيّين، وانتشارًا في الحاضر، يُستدلّ به على طرح الروائي أسئلة الفهم، كما على وجوده في وضعيّة مأزقيّة تدفعه إلى محاولة مجابهتها في توجّهاته وقيمه ومواقفه. وهي وضعيّة الواقع في منطقة «المابين»، بين طلب الفهم من جهة، والضبابية والعوائق والقهر من جهة أخرى، حيث لا إجابات إطلاقيّة قارّة.
- الانفتاح خطابًا تجاوزيًّا
تنجدل الأسباب والنتائج، بحيث تفضي كل قضيّة إلى أخرى، تلازمها، أو تكون نتيجة لسابقتها؛ إذ لا يستقيم الفهم بتجاوز الرؤية الأيديولوجية إلى قضية الانفتاح في صراعه مع الانغلاق الذي يقبع في العمق المؤسّس لبنى الروايات كافّةً. الشاهد الأبرز على هذه المأزقيّة تكرار ثيمة الحروب الطائفيّة. والصراعات الدمويّة كانت بمعظمها نتيجة الانغلاق ورفض الآخر المختلف عَقَديًّا، وكراهيته، والخشية المتبادلة بين الجماعات متباينة العقائد.
في ظلّ هذه القتامة لتاريخ الصراعات الدمويّة، تضيء بعض المواقف الانفتاحيّة درب الإنسانيّة، وصفحات من تاريخ لبنان تحديدًا، تُلمح في روايتي “يوسف الإنجليزي” و”دروز بلغراد”، وهي مواقف فرديّة لذوات تفلّتت من الخطاب العام للجماعات التي تنتمي إليها، تكفي لتدلّ على موقف الروائي النقدي المستنكر الانغلاق والتعصّب الطائفي، وهو الجبلي الذي يعيش في بيروت، والمنفتح على تيّارات عَقديّة مختلفة، بل أكثر من ذلك، إنّه متزوّج زواجًا مختلطًا لا طائفيًّا.
ليس غريبًا على الطبيعة الإنسانيّة أن تدفع بالذات إلى تبديل موقعها، أو انتمائها العقدي المتجلّي لغويًّا في خطاب مؤدلَج يختصّ بفئة ما. الانتقال والتحوّل هذان يكرّسان رؤية الروائي المتلفّظ بالخطاب الانفتاحيّ، فنخاله يؤيّد يوسف جابر الثالث، والقسّ ألكساندر شافرد سينيور، وكارنيليوس فاندايك، ومعزّ الدين الطويل وعبدالأحد، في رواية “يوسف الإنجليزي”، والأخوة عزّالدين الأربعة: قاسم ونعمان وبشير ومحمود، وحنّا يعقوب، في رواية “دروز بلغراد”، ويوسف بابازواغلي في رواية “الفراشة الزرقاء”؛ ذلك لانتقالهم من ضفّة الانغلاق، إلى ضفة التسامح. كما اتّضح موقفه في الحوار المنفتح بين بعض أصحاب المكانة الاجتماعيّة والنفوذ السياسيّ، أمثال: الشيخين ملحم البستاني وربح نكد، وفي ما يمثّله سكان بيريتوس من تسامح، فلا أحد يهدّد أحدًا في المدينة (بيريتوس مدينة تحت الأرض).
تتداخل العوامل والمستويات في نسج الخطابات، فالمستويان السّياسي والقومي حاضران بفاعليّة لإذكاء الفتنة الطائفيّة، ليبرز زعماء الجبل اللبناني، والأميران الشهابيّان، يوسف وبشير، شرّ من يحمل خطاب الفتنة المذهبيّة، وتنضوي تاليًا العامة إلى لوائه، سكّان دير القمر على وجه الخصوص. صراع اليوسفين: يوسف أبوشقرا ويوسف الشهابي السياسي ولّد صراعًا طائفيًّا دمويًّا، على غرار صراع البشيرين: بشير جنبلاط وبشير الشهابي. أمّا المبشّرون الإنجيليّون المتمسّكون بكتابهم المقدّس بوصفه حامل الحقائق الكونيّة، فينتمون إلى فئة المتكلّمين بلغة الانغلاق، وإن لم تلامس لغتهم حدّ العنف أو الإكراه (يوسف الإنجليزي).
الأساس الأيديولوجي لهذا الصّراع، يعود إلى إعلاء شأن الذات الجماعيّة لدى كل فئة مؤدلجة، وتبخيس قيمة الفئات الأخرى وحضورها. يتكشّف الصراع سرديًّا، في وجهة أولى، في ملفوظات حالة انغلاقيّة تتجلّى في الخشية من الآخر، كما لدى سكّان بيريتوس دائمي القلق من «ناس الوحل» الذين لا يراهم أحد، ظنًّا منهم أنّهم يتربّصون بهم شرًّا خلف الأسوار وخارج بوّاباتهم، فيؤثرون البقاء محصّنين داخلها، لا يريدون التفكير بالعالم البرّاني، «كل أعمارنا عشنا هنا، داخل هذا السور». وكما حدث لحنّا يعقوب الخائف دومًا، في السجون البلغاريّة، من أن يُكشف أمر انتمائه إلى الديانة المسيحيّة، “في الكابوس رأى حنّا أحدهم يركع على صدره ويخنقه لأنه مسيحي… نظرة صفراء من بشير باتجاهه تقلق نومه” (دروز بلغراد). أو في ملفوظات حالة تتراءى في التمركز الذاتي والشعور بالتفوّق على الآخر، كما في أفعال التبشير ونشر الفكر البروتستانتي الإنجيلي، بوصفه المرجعيّة العليا الوحيدة للحقائق الغيبيّة كما يراها أصحابها (يوسف الإنجليزي).
ويتمظهر، في وجهة ثانية، في ملفوظات فعليّة حين لا يقتصر الصراع على المحاجّة الفكريّة، إنما يتعدّاه إلى قمع الآخر ومنعه من ممارسة شعائره الدينيّة، ورفضه في المجتمع بوصفه غريبًا لا ينتمي إلى محيطه، كما حدث لأليكساندر شافرد سينيور حالما اعتنق الإسلام، وفي أسوأ الحالات، مقاتلة الآخر المختلف لتدميره ومحو ثقافته، كما تبيّن ملفوظات الاقتتال الطائفيّ في الجبل اللبناني، والشام، وبلاد البلقان (يوسف الإنجليزي).
وإذا ما رفد هذا الخطاب تقوقع قومي، تمسي الصراعات أشدّ فتكًا وأطول أمدًا، وإن خبت نيرانها تبقى جذوة الكراهية مخبوءة إلى حين بروز فتنة سياسيّة تذكيها. فقد تكرّرت الحروب الأهليّة اللبنانيّة في الأعوام 1845-1860-1865 و1975، وما تلاها من قلق عودة الفتنة عقب تفجيرات عام 2005. جاء على لسان سمعان يارد «في آذار قلنا ستقع الحرب: شيعة ضد سنّة ودروز ومسيحيّين.
أول الصيف بعد الانتخابات، قلنا ستقع الحرب مثل ‘سنة الخامسة والسبعين’: شيعة وسنة ودروز ضد المسيحيّين. قبل أيام جادل جنبلاط السنيورة قلنا ستقع الحرب: شيعة ودروز ضد سنّة ومسيحيّين…”، ويتابع الراوي: “الجرذ الكبير إذا خرج إلى عالم الأحياء قلب المدينة. سنة 1990 خلد إلى النوم. ارتجّ الجبل بعد الانفجارات الأخيرة المتعاقبة 14 انفجارًا.. لماذا أيقظوه بهذا الدويّ؟” (تقرير ميليس). وملفوظات الحالة والسّرد مماثلة في الحروب الصربيّة-العثمانيّة (دروز بلغراد).
لم يبقَ الانفتاح على الآخر في مستوى ملفوظات الحالة، إنما تعدّاه إلى ملفوظات سرديّة. أرقى ما تبيّن من إنسانيّة كان في موقف الأخوة عزّالدين تجاه حنّا في رحلة النفي والترحيل، بدءًا بالمرفأ في بيروت، مرورًا بالباخرة ودروب البوسنة وسجون قلعتي بلغراد والهرسك، انتهاءً بسفوح جبال رودوب في رواية “دروز بلغراد”. فيورد الراوي مواقف متفرّقة للأخوة «سامحنا يا حنّا.. إنّنا نعاقب لأننا جلبناك إلى هنا.. أنت هنا لأنّ أبي أخذ أخانا إلى البيت.. نحن ندفع”. اعتناؤهم به أبقاه حيًّا، وهو هزيل البنية، ضعيف الشكيمة، وغير معتاد على قسوة العمل، “قبض نعمان على كاحل حنّا وهو على السّور، هزّه من صدمته وأنقذه من رصاص الصرب. بينما ينادي عليه، شعر نعمان بشيء غريب، كأنّه يحب هذا الرجل، كأنّه يحزن إذا رآه ميتًا… كأن دم الرجل البيروتي الصغير سبّب له بردًا”. كذلك، موقف قاسم الذي عاهد نفسه بالابتعاد عن العنف الدمويّ وأدواته.
وثمة واقعة جاءت محاورة للواقع المرجعي، وحدثت بين معزّ الدين الطويل من وادي التّيم وعبدالأحد في رواية “يوسف الإنجليزي”، حين خلّص الأخير الأول من موت محتوم، بعد أن رآه من قاطع مزرعة الشوف، عالقًا ينزف بين الصخور في هوة، في طريق عودته من معركة جزّين. فما كان من الطويل إلا أن منحه سيفه وخنجره، وأعطى اسم “عبدالأحد” لأول ذكر أنجبته زوجته نسب، عرفانًا بالجميل. وحين سأله معزّ الدين عن دوافع إنقاذه، قائلًا “بسيفي وخنجري قتلت من قومك رقمًا ما عدت أقدر أن أحصيه؛ كيف تنقذني بدل أن تقتلني؟” أجاب عبدالأحد “أنقذتك لأنّك لم تكن ذلك الرجل وأنت معلّق فوق الشير وحصانك مذبوح بالصخور”.
في الرواية نفسها، وفي الحوار بين ملحم البستاني وربح نكد في دير القمر، بإفصاحهما عن عدم الرغبة في الاقتتال الطائفي، يعبّران عن انفتاح إنساني، ونبذ الكراهية. البستاني يحاور نكد، في جلسة صداقة وجيرة، قائلًا «إذا تواجهنا يومًا أضربك بالمسبحة العنبر، وتفقس عليّ غدّارتك [أهداه إيّاها بزنادها المكسور]؛ فلا تؤذيني”. غير أنّ النتائج جاءت بعكس ما اشتهياه. كان الخطاب السياسي الفتنوي قاهرًا، ملأ القلوب ضغينةً، وقوّض التعايش السلمي. وما كان من سكان بيريتوس المنهكين في حروب سابقة هربوا على إثرها، إلا أن نسوا الصلاة، ولم يبدوا رغبتهم في حيازة الكتب الدينيّة في مدينتهم. هذه الكتب كانت، بطريقة أو بأخرى، سبب وجودهم في مكان كئيب كهذا، وبيئة دائمة التهديد لهم، لا يشغلهم تهديد بعضهم لبعضهم الآخر، بل كيفيّة العيش بوئام، وتلبية احتياجاتهم اليوميّة.
هذه “حواريّات” لغويّة تؤكّد الرؤية السرديّة إلى الواقع الذي استحال دوّامة عنفيّة بين أيديولوجيّات، دينيّة على وجه الخصوص، لا نهاية لها.
- الذات بين الشّك والتصديق الديني
تشهد النصوص الروائية حالات من النفاق والمداجاة لدى الطبقة الدينيّة المقتحمة عالم السياسة. لتنتشر المفارقات في الرؤية إلى مفهوم الدين، وتطبيق أحكامه، والممارسات وفقه أو خلافًا له، وإلى الجدوى من وجوده في حياة الإنسان والجماعات. تفضي هذه التباينات إلى طرح الأسئلة عن الأسباب التي دفعت ببعض الشخصيات إلى الشّك أو الكفر، وعن تفشّي الانحلال الأخلاقي والعنف بحضور الدين وفي غيابه على حدّ سواء، وإلى ازدياد أعمال التبشير لنشر الوعي الديني.
الصراع في المستوى الديني يقبع في الخلفيّة، في البنية العميقة للأفعال المؤسّسة لسيرورة الأحداث. فتُطرح قضيّة الإيمان وإشكاليّة الخطيئة، من جملة القضايا المطروحة، في رواية “كنت أميرًا”. كما تبدو بعض الشخصيات عالقة بين الخطابين: الشّك والتصديق الدينيّ، مثل شخصيتي أوفيد ويوسف جابر. وأخرى انتقلت من فئة المؤمنين إلى فئة المشكّكين بالدين، وبضرورة الصلاة. نجد تعبيرًا عنها في شخصيّة هيلانة التي حاولت البحث عن إجابات عن أسئلتها الوجوديّة، فلم تعثر في الصلاة عمّا ينير لها الطريق، ولم تستوعب حجم الظلم بحقّها وبحق زوجها حنّا (دروز بلغراد). ظلّت لسنوات تبكي في العتمة وتصلّي، مناجية السماء: لماذا يفعل الرّب هذا معها؟ أعلنت عصيانها على الكنيسة، وتركها الصلاة بعد سلسلة من الأسئلة عن التصوّر الغيبي للجحيم، إذا كان ما تعيشه هو الجحيم بعينه. ماذا بعد؟ وهل ثمّة مزيد من العذاب؟!
كما يُدرج، في جملة الصراعات، خطاب النفاق الديني للولاة والحكام العثمانيّين المسلمين الذين أمعنوا ظلمًا وقهرًا للشعوب التي حكموها، وأكثروا من تشييد المساجد. ومداجاة الرهبان المتملّقين في وصف فعل الخمر الجيّد، وليس خمرة المسيح. فيعزّز الراوي تدخّله بالقول “حقًا، النبيذ الجيّد يصنع الخطيب الجيّد. لهذا السبب يحسن الرّهبان تنميق الكلام” (كنت أميرًا). على ذلك، يتجذّر غياب المعنى الجوهري للدين رغم طغيان المظاهر الدينيّة.
على عكس هؤلاء، تظهر فئة غير مؤمنة بالكتب السماويّة، وبعيدة عن الممارسات الطقسيّة الدينيّة، بيد أنّ سلوكاتها وصفاتها تُظهرها أعمق إيمانًا وأشدّ صدقًا وأكثر إنسانيّة، يعبّر عنها سكان بيريتوس، في أدلّ تجلٍّ للاجتماع البشري، حيث أنّهم يستقون شكل انتظامهم في المعيّة البشريّة السويّة من القيم الإنسانيّة الرفيعة، وهي عصارة ما خبروه من تعاليم دينيّة سابقة قد تمثّلوها.
يتقدّم أوفيد في “كنت أميرًا” شخصيّة مضطربة الإيمان؛ فقد إيمانه بالمسيح نتيجة الغدر، وظنّ بماريا أنّها مؤمنة هي الأخرى، وترتّل مزامير العهد؛ بينما كانت تمارس الزّنا الذي نهى عنه الكتاب المقدّس. وفي مشهد مناجاة، يصف تصوّره الواهم عمّا تفعله ماريا قبيل دخوله عليها. فعقد الراوي مشاهده، باستخدام تقنيّة “اللصق” (collage)، بين هذه التصوّرات الساذجة لأوفيد بالتوازي مع الواقع المسِفّ في المشهد العشقي بين توكا وماريا.
بقصد أن يحاكي بسخرية اجتماع المقدّس والمدنّس. انسحب تشكيك أوفيد على سلوكه مع أبناء جنسه في النقمة عليهم؛ غير أنّه بقي في حالة بينيّة من التقلقل، بين اللاتصديق، وتسليمه بعجز عقله عن الفهم، وإيمانه بمفهوم العناية الإلهيّة، والمشيئة بأن ما يصيب الإنسان هو خير له مهما بدا سيّئًا وقاهرًا. يبرز هذا التذبذب نتيجة انغلاق الفهم، في تفكّراته المتضاربة “ربما كانت تلك العجوز ما كانت ترمي لعنة عليّ.
كانت تمنحني حياة جديدة بطريقتها الخاصّة… الرب هكذا طرقه غامضة لا يستوعبها دماغ إنسان”. ذلك بعد أن رفض إعطاءها شيئًا لتقتات به، متّهمًا إيّاها بالمراوغة والادّعاء، وبأنّها قد تكون وثنيّة. إنما تبنى الرواية برمّتها على مشاهد تهكّميّة من هذه البينيّة للإيمان بسموّ الإنسان أو الشّك في ارتقائه؛ ولنزوعه نحو الترفّع عن الغرائز وتلبية حاجاته وفق تعاليم المسيح، أو الوقوع في الخطيئة نظير ضعفه.
شخصيّة أخرى عانت التشوّش في إيمانها، تتمظهر في يوسف جابر -الإنجليزي- حينما ابتعد عن بيئته التي ترعرع فيها، وورث تصوّراتها الدينيّة لمعنى الوجود. غيّر فضاءه واختار كتابًا آخر، يجد فيه بعض الإجابات. وهو إن التبست عليه مفاهيم «الحكمة التوحيديّة”، فقد وجد ضالّته في تعاليم “الإنجيل”، إذ أصبح في لندن، يقرأ في رسائل الحكمة المقدّسة كل ليلتين، ويحاول أن يجد شيئًا يضيء له الدرب… بعد مدّة من الزمن، خبّأ كتاب الحكمة داخل بيت جلدي وأقفل عليه الجارور.
عليه، يطرح المنظور الروائي مسألة الاختيار لمصدر المعنى الهادي لوجود الإنسان، كما حدث، في الرواية نفسها، مع القسّ المتأسلم ألكساندر شافرد سينيور، وقد أحبّ الأذان ووجد فيها سحرًا ربانيًّا. لكنّ المسألة دقيقة، وحسم الجدل فيها ليس على هذا النحو من التبسيط، لأنّ السؤال الذي يطفو بشأن حقيقة إيمان كلّ من يوسف وشافرد، يتعلّق بتشابك الهويّتين الممنوحة والمكتسبة داخلهما، وصراع تصوّرات لا فكاك منه، واختلاط مفاهيم تتنازع الذات، فتجد نفسها في حركة ذهاب وإياب لعقد المقارنات. فيمثّلا تاليًا، نموذجين للذات الإنسانيّة العالقة بين فضاءين وجوديّين: لموروث ديني انطبع في الذاكرة بمنطوقات لا تفتأ تنجلي عنه، ولرافد ثقافي مغاير تجاور مع الأوّل، وطفق يتوسّع ليمحوه شيئًا فشيئًا.
وفي قطب الإيمان والتصديق تبرز فئة طالبي الحقائق الغيبيّة عن طريق الاسترشاد بالكتب الدينيّة. ينطق بمقولاتها كلّ من باولو، والحجّاج إلى مكّة المكرّمة، والدراويش، والمبشّرين الإنجيليين. وإذا كانت هذه الشخصيات تعبّر عن نماذج إيمانيّة بسيطة، وتطبّق أحكام شرائعها، وتعمل وفق تعاليم دياناتها بغير سؤال أو اعتراض، مسلّمةً بعجز العقل البشري عن فهم حقائق تفوق قدرته على التصوّر، كما التسليم بلاجدوى بحثه فيها؛ فإنّ وضع العالِم لويس باستور فيه التباس، حين سيق مثالًا للعالم المؤمن إيمانًا مسيحيًّا لا يهتزّ (الفراشة الزرقاء). بذلك يتجاور العلم، بطرقه البحثيّة التجريبية، مع الدين، بمعجزاته وخوارق قصصه، ومقولاته الغيبيّة. التساؤل بشأنه يحيل إلى قلق لدى الراوي يسرّبه إلى القارئ، تاركًا له الإجابة الممكنة عنه.
الازدواج القيمي يظهر من جديد في وصف طريق الحجيج. وهو طريق عودة حنّا يعقوب إلى دياره، متخفيًا بهيئة درويش مسلم. طريق يمتدّ بين مدن مسقوفة بالمآذن، تجلّله التقوى والورع والإحسان؛ حيث هبط ملاك الرحمة على حنّا، مقارنةً مع طريق الجلجلة من بيته إلى السجون والقلاع والدروب بينها. الأمر الذي يولّد مأزقًا منطقيَّا في جدوى العبادة، وبغيتها التسامح، وبعض النفوس -لا سيّما نفوس الحكام- أبعد ما تكون عن المعبود. إنما التعارض ينجلي إذا ما عقدنا مقارنة بين سلوك الذات الجماعيّة للمؤمنين وسلوك الحكام؛ كأنّ العبادة وطقوسها تخصّ عامّة الناس لا السياسيّين، بل باستطاعتنا الاستدلال على أنّ الاستبداد لم يترك للفقراء سوى الدين والإيمان رجاءً لهم.
في معرض الإضاءة على دور التبشير البروتستانتي، وسياقه التاريخي في حقبة أمنيّة-سياسيّة سيئة، تُفهم الأسباب المؤدّية إلى ازدياد التبشير وانتشار الدعوات الإصلاحيّة، استغلالًا لترهّل السلطنة العثمانيّة، حيث تتيح للنفوذ الغربي (الأوروبي والأميركي) بأن يتغلغل في مستعمراتها بذريعة دينيّة. ذلك من خلال خطاب رؤيويّ ساخر يتّكئ على تنضيد المشاهد المتناقضة، أو “فسيفسائيّة”” الخطابات المتباينة، بإظهار التقابلات بين الملفوظات السرديّة لكل من يترجم العهدين القديم والجديد، ولمن يحفر رسوم الأحرف العربيّة المشكَّلة للمطبعة في بيروت، في مشهد أوّل، ولمن يجهّز لمعارك سياسيّة-طائفيّة في مشهد ثانٍ. فهو يبتغي، استطرادًأ، إشاعة الاعتراض على المفاهيم السائدة لعبثيّة الحروب المدبّرة، بانتهاز خصوصيّة مجتمع متنابذ العائلات الروحية.
- الذات المتسائلة في دائرة الواقع-الحلم
للإنسان خطّان في تشكيل هويّته: خط ثابت، وخط متغيّر. أي أنّه قيد التشكّل وفق هويّة ممنوحة له، وهويّة يكتسبها بفعل التجربة. وبمعنى وجوديّ، هو «ليس ما كانه فحسب، بل هو أيضًا ما سيكونه، لأنّه وجود آني صائر، في حركة تساؤليّة”. لذا، تتراءى الذات ذاتين: ذات واقعيّة، وذات حلميّة تبقى في استباق دائب لوجودها.
العلاقة الجدليّة بين الفضاء والتحوّل تنجلي بشكل لافت في وضع زهيّة التي تركت قريتها ومنزل والدتها بحثًا عن معيشة كريمة، ولبناء ذاتها بطبيعة الحال (الفراشة الزرقاء). غدت امرأة عاملة وفاعلة في المجتمع، تكافح في وجه العوز والشقاء، وتواجه بصلابة الفضاء الخانق لكرخانة غزل خيوط الحرير.
وياسمينة أيضًا لم تألُ جهدًا في سبيل الخروج من متاهة بيريتوس، أي في سبيل تغيير فضائها الذي يشيّئ وجودها، ويبقيها في دائرة الآخرين -“هُم”- الذين يملون عليها ما ينبغي أن تفعله. تمكّنت من الخروج إلى الضوء، واللحاق بزوجها إيليا، وكان قد سبقها إلى العالم البرّاني الأرحب، محقّقين مشروعهما الأصيل.
وإذا كانت الأقدار قد أسقطت بطرس في حفرة ليستكشف عالم المدينة المطمورة، فهذه المتاهة-الحصار بمنزلة تجربة فضائيّة وجوديّة تعيد تشكيل هويّته”حين ينظر الواحد إلى الموت ينظر إليه في عينيه. الواحد بعد تجربة كهذه لا يبقى هو ذاته. أشياء أبسط بكثير تبدّلنا. كيف لا نتبدّل بعد تجربة صعبة مثل هذه؟” (بيريتوس).
في السياق نفسه، نستلهم ما يفصح عنه أحد الرواة المتكلمين في رواية “الاعترافات” بأنّ القدر يصنع شخصيّة الإنسان، مجادلًا بذلك هيرقليطس القائل إنّ شخصيّة الإنسان قدره، وموضّحًا أنّ ثمة علاقة جدليّة بين القدر والشخصيّة من حيث التأثير والخلق.
هذه العلاقة التبادليّة بين القدر والشخصيّة تعود بنا إلى مفهوم “الدازين” في دائرة الأونطيك-أونطولوجي، بين «وجود –في- ذاته” بما يحمل من إمكانات، و”وجود- لذاته” بما يحقّق من ممكنات.
من الخيارات الأصيلة ما تبيّن في مسعى أخوة يوسف السبعة من أبناء إبراهيم خاطر جابر، والمتبقّين على قيد الحياة. فقد غادروا الجبل اللبناني، متّجهين إلى جبل العرب وبلاد الشام، ليتّقوا بدايةً، شرّ الأميرين الشهابيّين بشير وخليل. في هروبهم خيار، وموقف تكشّف في رفضهم تقسيمَهم ليتقاتلوا في صفّين، بعضهم في مواجهة بعضهم الآخر، كلّ يناصر أحد الطرفين: المصريّ أو العثمانيّ. اختاروا أن يبقوا موحّدين في هروبهم وفي قتالهم الأخير على حدّ سواء. يستجيب القدر لإرادتهم بأن قتلوا معًا. هكذا كان الموت تأسيسًا لوجودهم على نحو مغاير للمُعطى والمفروض من الآخرين. «أجسامهم تتحوّل جسمًا واحدًا يتذكر الأجسام الأخرى الغائبة، وبينما يتذكرها يحتويها… الأخوة السبعة ركبوا معًا للمرّة الأولى… أحسّوا أنّهم توحّدوا في كائن واحد… كانت هذه حربهم لا ضدّ أحد، وإنما من أجل أن يحاربوا معًا أخيرًا”. صوّرهم الراوي على شكل جسم خرافيّ (متعملِق) هزمه الموت؛ وهذا الاقتباس خير تعبير عن حريّة الموقف لتحقيق وجود واعٍ. هكذا تحقّق، بموتهم، مشروعهم الأصيل من أجل ذات جماعيّة موحّدة، فتخلصوا من التشظّي ومن صيغ الـ”هُم” المفرّقة كافةً.
إزاء هذه المشاريع المعبّرة عن الخيارات الحرّة للذوات، تنكشف مشاريع تهجينيّة قسريّة للهويّة. لعلّ الأكثر تمثيلًا لها شخصيّتا الأمير أوفيد بمسخه ضفدعًا، وحنّا يعقوب المسيحي بوسمه باسم سليمان عزّالدين الدرزي. ذلك من غير إغفال الهجنة والتغريب اللذين لحقا بيوسف جابر.
“الغرابة المحيّرة”، بتعبير كييركيغارد، في قضيّة التحوّل العبثيّ للأمير إلى ضفدع تكمن في أنّه لم يختر هذا القدر اختيارًا قصديًّا؛ إنما، ضفدعًا، احتفظ بذاكرته الإنسانيّة. غير أنّ التحوّل جاء نتيجة لعنة نزلت عليه، لكراهيته البشر واحتقارهم، لما يتّصفون به من طبيعة مخادعة وخائنة. تقضي التعويذة بأنه لا يتمكّن من استعادة صورته البشريّة إلا حين يسترجع هويّته الإنسانيّة «بأن يعود إنسانًا، وبأن يحبّه إنسان». هذا المصير البائس الذي وصل إليه يؤكّد، من جهة أخرى اختيار الشخصية اللاواعي لقدرها، نموذج يعود بنا إلى مبدأ هيرقليطس آنف الذكر، في أنّ شخصيّة الإنسان قدره. أوفيد نفسه الذي خاض تجربة الانتقال من موقع منفعل، فاقد الهويّة، إلى موقع فاعل، ظلّ متأرجحًا في منطقة الـ«مابين»، مراوحًا ذهابًا وإيابًا في مستوى رغبته بين أن يعود إنسانًا ويسترجع مكانته في قصره ووسط حاشيته ورعيته، وبين أن يبقى ضفدعًا بعيدًا عن الناس وخداعهم، مكتفيًا بمكانه في الغابة، وبموقع العاجز، مستَلَب الإرادة، والمتأمّل والمراقب لقصر آخر، لأميرة أخرى غير خطيبته ماريّا. فتلك الأميرة وعدته بأن تحبّه ولم تفِ بوعدها، لتتكرّر الخيانة بحقّه. «ماذا يوجد هناك خلف الغابة في مدن الناس؟ ربّما كانت تلك العجوز [المشعوذة التي أسقطت عليه اللعنة] تمنحني حياةً جديدة بطريقتها الخاصّة. الرّب هكذا طرقه غامضة لا يستوعبها دماغ إنسان”.
الأمر المماثل حدث مع حنّا، بائع البيض البيروتي؛ فقد أُلبس هويّة شخص آخر، وأُرغم على حمل اسمه «سليمان» وارتداء زيّه: القلنسوة الدرزيّة البيضاء والسروال الجبلي، ونودِي بلقبه «الشيخ»، إلى أن التبست لديه ولدى الآخرين هويّته، فتارةً هو «الشيخ سليمان”، وتارةً أخرى هو “الشيخ حنّا». كما اضطرّته ظروف التخفّي إلى قبول مناداته باسم «الدرويش سليمان” في رحلة عودته إلى بيته وعائلته. سخّر الإمكانات المتاحة لتحقيق مشروعه العَودَوي، والتخلّص من الظرف الذي وُضع فيه، فيتجلّى مشروعه الأصيل في استعادة هويّته واسمه وديانته وفضائه حيث مكانه الأوّل، بيته وزوجته في بيروت.
محاولات الاستلاب من الآخرين أصابت أيضًا سمعان يارد، لتبقي وجوده وجودًا متشيّئًا، يعيش في حالة التّنائي، واللافعل؛ فلا يؤسّس لحياة مجدية. و«التّنائي» صيغة رئيسة في رواية “تقرير ميليس”، مسّت غالبيّة الشخصيات الثانويّة والجماعيّة، حيث عاشت في حصار وترقّب، ولا شيء سوى الانتظار. لا هجر البلد محبوب، ولا البقاء فيه آمن وسعيد.
شعور المثقّف بالاغتراب على الرغم من إنجازاته المعرفيّة والعمليّة، إن دلّ على أمر فهو يدلّ على حالة «الدازين» المتراوح بين حركتين: حركة تدعوه إلى التقدّم للإمساك بوجوده الحقيقي، وحركة توقفه وتدفعه في الاتجاه المعاكس. هذه الحالة من التذبذب تشعره بحريّة جوفاء يمتلكها ولا تسعفه في التقدّم أكثر لجعل الوجود العام يتماهى مع وجوده؛ فتتطوّر حينئذٍ رؤية الذات الجماعيّة كما تطوّرت ذاته الفرديّة. هذا ما حدث مع الأكاديمي رالف رزق الله الذي اتّسع فضاؤه باتساع رؤيته، ولم يتمكّن من تسريب وعيه إلى محيطه. ظلّ الفضاء الذي يتحرّك فيه ضيّقًا، كما بقي هو نفسه وجودًا فرديًّا خارج العالم. الأمر الذي أدّى به إلى التوقف عن السعي، هاربًا من حرّيّة لا يراها مُجدية.
مثال آخر عن المثقّف المغترب يتمثّل في شخصية يوسف جابر الذي تبدّل اسمه إلى يوسف الإنجليزي، ثم إلى جوزف ماندر، وتحوّل من الدرزيّة إلى المسيحيّة، ومن ابن قرية إلى ابن مدينة، مرتحلًا بين مدن عديدة ذهابًا وإيابًا بدلالة اللامكان وافتقاد العائلة. ويمعن هربًا من الأمكنة قاصدًا “العالم”، من غير تحديد صريح لمكانه. يدلّ اختفاؤه على أنّه لم يجد سوى ذاته ينتمي إليها خارج الأمكنة جميعها. غير أنّ الأمكنة ومَن سكنها، تسكنه وتطارده بذكرياتها رغم ابتعاده، يريد أن «يحلم بحياة جديدة بلا ماضٍ وبلا ذاكرة”. انكسار حلمه بامتلاك سرّ اللون يعود إلى أنّه لم ينطلق من إمكانات ممنوحة له بالفطرة؛ فما أُعطي هو موهبة الرسم وحسب، في إشارة إلى هجنة في مستوى الحلم نفسه، حين يوصف بأنّه «كان يطارد حلمًا لا يعرف من الذي زرعه في رأسه، حلم امتلاك سرّ اللون… لكنّ الحلم تبدّد كالسراب مخلّفًا تلك الخيبة والإحساس بالخديعة.. خسر وطنًا دون أن يربح حلمًا”.
عاش يوسف في بَينيّة سرابيّة: لحظة التصديق في دهشة الحلم وانخطافه، حيث لا يقوى على المقاومة، ولحظة السقوط حيث اللاتصديق وانهيار كلّ مقاومة. فيمثّل ذلك الفرد المتنائي عن ذاكرته؛ والذاكرة مكوّن رئيس لكينونته. وما عمّق من اغترابه الروافد الثقافيّة التي أدّت دورًا تهجينيًّا جليًّا في مستوى اللغة والعقيدة. لدى عودته من لندن وبيروت إلى بلدته الجبليّة كفربرك، وقد اكتسب عناصر جديدة أعادت تشكيل هويّته، ألفى بلدته مكانًا لا يزال ضيّقًا لم يتبدّل، ولم يتمكن هو من تبديله أو التناغم معه، فخرج عليه.
هذه الشخصيات العالقة في دائرة الاختلاف، دائرة النفي المستمرّ للماضي، أي للوجود في ذاته، تتّفق مع حال الراوي المتكلّم، بوصفه روائيًّا داخل عالم الحكاية، ومن خلفه المؤلف الضمني، في روايتين “الفراشة الزّرقاء” و”رالف رزق الله في المرآة”. فالتسامي الأدبي فضاء حُلميّ، والأثر الفنّي ما هو إلا فضاء برزخي يتجلى فيه الواقع المرغوب فيه، وغير المتحقّق في الواقع المرجعي للنصوص.
إنّ الموت، والحروب اللبنانية المتكررة أيقظت في الروائي روح البحث عن البداية. فوجدها في تاريخ لبنان السياسي والديني والثقافي، علّه يعثر على منفذ للخلاص والتغيير. العنف أدمى ذاكرته، وصبغ تاريخ شخصياته؛ غير أنّ إيمانه بأنّ “الذاكرة التي تروي لا تموت”، وبأنّ “كل تعاسة مهما قست يمكننا أن نتحمّلها إن نحن رويناها كقصّة”، دفعه في اتجاه اختيار طريق السرد.
تغدو علاقة الروائي، والمثقف عامة، بالمجتمع علاقة انفصال، الاندماج فيه غير مقدور عليه، فيعيش محاصرًا في وضع بَيني: بين مساعيه الانفتاحيّة والواقع الرديء المنهِك، وبين التمرّد نشدانًا للتغيير والرضوخ، وبين الفاعلية والغياب. لم ينسحب التغيير في هويّته الفردية إلى تحوّل في مستوى الجماعة، بتجاوزها الحاضر نحو نظام قيم أكثر إنسانيّة. حالت دون ذلك عوامل تتمثّل في قهر الجماعة للفرد، وقهر السلطة الحاكمة للأفراد والجماعات، وقهر الموروثات العقديّة الانغلاقيّة للحكام والجماعات والأفراد على السّواء، وقهر المستعمرين لهؤلاء جميعًا.
يؤكّد الروائي بذلك وظيفتين للسرد: وجوديّة في تدوين التجربة التاريخية، وبانصهار أفقها مع أفق التوقّع، واستشفائيّة. ليتبدّى السرد تساؤلًا عن الكينونة في محاولته فهم الوجود، واستردادًا لحياة مستَلَبة، وفضاءً لتمكين الموجود الإنساني من تحمّل لامعقوليّة الواقع وعنفه، وخروجًا آمنًا لذاكرته من دهاليز الماضي ومآسيه. نتيجة لذلك، تتأسّس هويّة سرديّة للذات الكاتبة والقارئة معًا، تُبتنى من فقدين: فقد الذاكرة لوجودات “كانت”، وفقد الحلم لوجودات مرتجاة “تكون”.