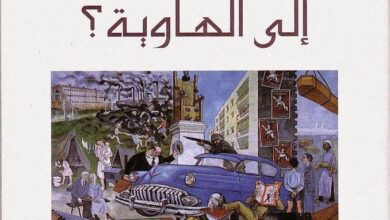تفكيك مفهوم القومية

يفصح العنوان هنا مصادفةً عمّا يريد النص فعله: تفكيك مفهوم القومية بالعموم، ومفهوم القومية العربية على وجه الخصوص. العنوان هنا هو إعلان وفاة “باراديغم” القومية، كأحد الأركان الأساسية للسياسة العربية التي أقامت على أساسها مشروعها الذي لم يتحقق يومًا، في بناء “الدولة العربية الحديثة”.
أما أسباب الوفاة فهي هرم هذا المفهوم الذي أدى إلى تعطل وظائفه الحيوية، بخاصة وظيفة الإطراح، ومن ثم أدى إلى تراكم السموم في جسده، فتوقف قلبه عن الخفقان.
لا بدّ إذن -من دون الحاجة إلى أو الرغبة في شيطنة هذا المفهوم الذي كان له ما يبرّره في فترة سابقة- من كشف القناع عن الدور المعطِّل لهذا المفهوم الذي تقادم عهده، بعد أن ترك أثرًا سلبيًا على نشوء الاستبداد العربي والدولة الفاشية العربية، لا بد إذن من تفكيك هذا المفهوم وكشف زيفه الأيديولجي وسحبه من يد السّلطات السياسية العربية، التي تجيد لعبة قلب المصطلحات، بحيث تطرح الشعارات البراقة لتمارس نقيضها فعليًا، كما فعلت مع “مفهوم” القومية الذي طرحته كغاية لم تسع يومًا من أجلها، بينما حولته إلى أداة سلكتها دويلات قطرية (بضم القاف) لمنع تحقيق الدولة القومية التي تهدد مصالحها منفردة.
والسبب الثاني الملح في تفكيك هذا المصطلح الآن، وهنا هو استعار أواره من جديد وعودة شبحه بكل رعبه ليخيّم على الاقتتال في الساحة التي استعرت فيها الهويات القوميّة القاتلة: أكراد في مقابل عرب، على سبيل المثال.
لا شك في أن مفهوم القوميّة قد لعب دورًا أساسيًّا في بلدان الغرب الحديث، في تأسيس الدولة/ الأمة محدّدًا بذلك حدود ومقومات تكوّن القوميات التي ظهرت مع الحداثة الأوروبية.
ولكن يجب الاعتراف أيضًا بأن فكرة القومية كانت من أخطر المفاهيم الحديثة وأكثرها قابلية للانحراف، لما تتضمنه وتنطوي عليه من عصبية وعرقية هوياتيّة، تقود إلى حروب خارجية وإلى اضطهاد وإقصاء للأقليات التي لا تنطبق عليها مقومات القومية التي يتم تقديسها في بلدٍ ما. تفترض القوميّة “هويّة” ما، يتحدد من خلالها شعب معين في مقابل غيره من الشعوب والأمم الأخرى، والتأكيد على عظمة الهويّة القومية المزعومة لذلك الشعب وأفضليتها على غيرها من القوميات الأخرى التي تمثِّل خطرًا مزمنًا مباشرًا أو غير مباشر.
هكذا انتهى مفهوم القومية بكل تضميناته المباشرة وغير المباشرة، إلى التعصب للهويّة القومية إلى درجة العنصرية racism، كما شرح ذلك بدقة المؤرخ الماركسي البريطاني إريك هوبسباوم، الذي درس طبيعة الترابط بين القومية والعنصريّة، وافترض أن العلاقة بينهما عضوية واضحة[1].
وهذا ما عرفته بلدان الغرب الأوروبي في النصف الأول من القرن العشرين. فلأسباب قوميّة، قبل أن تكون أي شيء آخر، استعر الصراع الفرنسي/ الألماني في الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال لا الحصر. ونحن نعرف جيدًا أن فكرة القومية كانت المنطلق الأساسي لظهور الفاشيات الأوروبية، وبخاصة النازية الهتلرية في ألمانيا، التي غذّت النزعة القوميّة معتبرةً أن قوميتها هي الأرقى والأقوى والأجدر بالحياة “ألمانيا فوق الجميع”.. إلخ. ويُظهر لنا التاريخ بوضوح أن الفاشيات -على اختلافها- هي أكثر من تغنى بفكرة القوميّة وألّهها، وحين وصلت إلى العرب، كانت بكامل حلتها الأيدولوجية الفاشية.
وبالإضافة إلى مشكلة العنصرية في العداء لقوميات الأمم الأخرى التي غالبًا ما انتهت بحروب في محاولة القضاء على الهوية القومية للأخر، ظهرت مشكلة التمييز بين شعوب البلد الواحد الذين تم إقحامهم جميعًا في هوية قوميّة لا تنطبق على الجميع تاريخيًا، ولا وفق الحق الفردي في الاختيار والانتماء.
في كل مرّة، وُجدت فيها هويّة قومية منتصرة، كانت هناك ممارسات عنصرية وتمييز بين أبناء البلد الواحد، ويشهد التاريخ إلى الآن أن هذه الصراعات قد مارست قمعًا وإقصاءً وتهميشًا للأقليات القومية، كما حصل للأكراد، مثلًا، في سورية والعراق، وللقبائل في الجزائر، أو كما حصل مع اليهود العرب سابقًا، في مصر والعراق وسورية والجزائر، وربما إلى اليوم في المغرب وتونس (اليهودية كديانة قامت على أسس قومية “شعب إسرائيل”).
ولو عدنا لتقصي انحرافات وكوارث التلاعب بمفهوم القومية على الساحة العربيّة؛ لوجدنا أن أكثر الأنظمة الفاشيّة عربيًا قامت على أساس مفهوم القومية العربية، كما حصل في ليبيا القذافي، وفي حزب البعث العربي بنسختيه العراقية الصدّامية والسوريّة الأسديّة، حيث قامت هذه الأنظمة بالأصل على مفهوم متصدّع منذ التكوين، فتأسست عليه نظريًّا ومارست عنصريتها من خلاله.
إن ما أقصده هنا بالخلل البنيوي، للنسخة العربية لمفهوم القومية، هو المثالية القومية والطوباوية الحالمة أو الماضوية الميتافيزيقية الماهوية الثابتة التي ظلّت -بسبب مثاليتها- مغتربة بشكلٍ ما عن الواقع، وغير قادرة على إيجاد معادلاتها السياسيّة فيه. فالأمة مثلًا لدى زكي الأرسوزي، أحد أهم منظريّ القومية العربية، هي ماهية سابقة على الوجود العربي، وهي الإطار المكوِّن له والمقدَّم عليه زمانيًا وأنطولوجيًا.
هكذا تختلط المفاهيم المؤسسة لدى الأرسوزي بمثاليات جوهرية متعاليّة متأثرة بدراسته لجمهورية أفلاطون[2]. وعلى ذلك الموالتتناسل المفاهيم المثالية الميتافيزيقيّة في تبني مشروع الدولة القوميّة لحزب البعث، كاللغة والروح القوميّة. ففي حين يرى ميشيل عفلق أن القوميّة هي تجسيد للروح العربيّة، يبلور قسطنطين زريق هذه المسألة في كتابه الوعي القومي (1938)، حيث يرى أن القومية في جوهرها ليست سوى حركة روحيّة ترمي إلى بعث قوى الأمة الداخلية.[3] وفق منظري فكر البعث، إذًا هناك جواهر روحية ثابتة تقوم على أساسها القومية العربية قديمة قدم العالم خالقة له ومتقدمة عليه، أو كما يرى ميشيل عفلق القومية العربية بوصفها جوهرًا معطى ميتافيزيقيًا يؤثِر في الأحداث دون أن يتأثر بها.
وقد كان هناك المزيد من “الآثار الجانبية” السلبيّة والمباشرة التطبيقيّة لمفهوم القومية العربية، ولشرح ذلك سنأخذ مثالًا الدولتين اللتين “اعتمدتا” حزب البعث، بوصفه الحزب الوحيد القائد للدولة والمجتمع: العراق وسورية. حيث تم اضطهاد القوميات غير العربية، ورفض الاعتراف بأدنى حقوقها، حتى حق المواطنة. ولحق ذلك بالأقليات الإثنية في سورية، مثل الأكراد والتركمان والشركس والسريان.
ولعل أبرز حالات الاضطهاد قد لحقت بالكرد، ففي دولة البعث العراقيّة، مثلًا، وصلت حدود العنصرية والتمييز الممارسين ضدهم إلى حد المجازر، كما حصل في حلبجة في العراق، عندما قام نظام البعث الصَّدّاميّ (نسبة إلى صدّام حسين) بالهجوم الكيمياوي على المدينة عام 1988. وفي سورية مُنِع الأكراد في فترة حكم الأسدين من حقوقهم في ممارسة أعيادهم (إلى أن قامت الثورة السورية، حيث حاول نظام الأسد شراء ودّ الأكراد) أو الاعتراف رسميّا بلغتهم، وبمواطنيّتهم، أما قبل ذلك، فقد كان يعاقبهم بالقتل عند أي احتجاج، كما حصل عام 2004 في أحداث القامشلي[4].
كان هذا الاضطهاد للأقليات الإثنية أحد أبرز الشروخ في مفهوم القومية العربية، بنسختها البعثيّة المتصلِّبة على الهوية العربية، التي أغلقت المجتمع، فمنعت إمكانية التعدّد القومي فاتحة النار على الأقوام اللاعرب الموجودين على الأرض التي أقصى فيها مفهوم القومية البعثيّة الإثنيات الأخرى، من دائرة الاعتراف والحقوق. كان لا بد لهذا الإقصاء أن يولّد الحقد والرفض لسيطرة هيمنة القوميّة العربية والسّلطات الممثلة لها، كما تجلى ذلك في العراق ما بعد صدام حسين، وفي أثناء الثورة السوريّة ضد نظام بشار.
من مفارقات مفهوم القوميّة (كغيره من المصطلحات، حين تدخل الدائرة السحرية للسياسة الفاسدة)، قابليته أن يكون معطلًا ذاتيًا لهدفه المعلن. فمن بعد طرحه شعارًا؛ عملت السلطات العربية على تكريس نقيضه واقعًا، وما أعنيه هنا وقوف مفهوم القوميّة -بصيغته المعطّلة والمعطِّلة- كحاجز وسد منيع أمام تحقيق هدفه المعلن أي وحدة البلدان العربية المنشودة، أو تحقيق مشروع الأمة العربية الواحدة أو حتى القيام بتحالفات إقليمية عربية.
هـذا على صعيد الشعار والسطح، أما على صعيد الواقع وفي العمق، فقد عملت هذه السلطات على تكريس الدولة القُطرية التوريثيّة، كضامن لمصالحها في السلطة والثروة، بتأجيل كل المشاريع في النهضة والتقدم والتنوير إلى حين تحقيق الدولة القومية. فدخلنا في الحلقة المفرغة، فللخروج من إطار الدولة القطرية إلى الدولة القومية، لا بد من العمل على خطوات التفاهم والعمل المشترك، وتطوير بنى الدول العربية ومؤسساتها القانونية واستراتيجياتها الاقتصادية، وهذا أضعف الإيمان، لتحقيق دولة قومية تجمع عدة دويلات قطرية، بينما تعطل السلطات العربية الحاكمة أي مشروع قومي (لأنه سيقضي بالفعل على استئثارها العائلي بالسلطة والثروة) بحجة الحاجة إلى التوحّد القوميّ أولًا.
كان حزب البعث بمقدماته النظرية يفترض رفض الدولة القطرية كهدف، وضرورة الانتقال منها نحو دولة قوميّة عربية تجمع شتات الدول القطرية في أمةٍ عربيةٍ واحدة. ولكن المفهوم شيء وتطبيقه شيء آخر. فإضافة إلى العيوب البنيوية التي ولدت مع مفهوم القومية في هذا الحزب، نجد أن أفكاره قد تم مسخها وإعادة تفصيلها لتتناسب مع العسكر الذين وصلوا باسمه إلى السّلطة بانقلابات عسكرية.
في العراق وسورية، أعيد تفصيل الحزب على مقاس البوط العسكري، وراحت مغانم السّلطة تضيق مع الزمن من دائرة الموالين للجنرال المنتصر إلى “جماعته” الدينية التي خرج منها وينتمي إليها، وصولًا إلى أفراد عائلته الذين تنازعوا فيما بينهم السّلطة أيضًا. إعادة تفصيل الحزب على مقاس العسكر تجلت بوضوح في مصير منظريّ الحزب التراجيدي، في كل من سورية والعراق[5]، فما تخيلوه كفكرة قد اصطدم بمصالح ضباط انقلابيين لا يريدون من الحزب سوى واجهة أيدولوجية لمصالحهم.
هكذا ما لبثت أن تحولت السلطة، في سوريا حافظ الأسد وفي عراق صدَّام حسين، إلى مزرعتين يحكمهما مجموعة من العسكريين الدكتاتوريين بأجهزتهم الأمنية، الذين فرضوا على المجتمعين السوري والعراقي -باسم القومية البعثية- توجهًا عسكريًّا إكراهيًا لا يقبل بأي شريك[6]، ولا يمكن أن يتنازل عن امتيازاته لمصلحة تكوين قوميّ مطروح كشعار منتهية صلاحيته، لكنه مناسب تمامًا، لهذا السبب، لتعطيل المجتمع المدني وخنقه.
لكل هذا، يبدو لي أن هناك حاجة ماسّة إلى تفكيك مفهوم القومية، وبخاصة بعد ارتفاع اللهجة الانفصالية المطالبة لبعض القوميات غير العربية، وبخاصة الأكراد الذين عانوا الأمرّين من التمييز والاضطهاد والتهميش من قبل أنظمة تحمل شعار القومية، سواء أكانت عربية أو تركيّة أو إيرانيّة، بحيث جعلت من مفهوم القومية سيفًا مسلطًا على من لا ينتمي إليها ويقع تحت حكمها.
نتيجة المظلومية التاريخية التي عاناها الأكراد، يمكن لنا تفهم مطالبهم بالانفصال وتأسيس دولتهم الخاصة، ولكن لا بد من التنبيه هنا إلى أنهم على وشك أن يعيدوا مأساة تجربة القومية العربية، بشكل أكثر تطرفًا وتعصّبًا. فبالنهاية لن تكون دولة الكورد القومية سوى نسخة جديدة من الدولة القائمة على الهوية والمتعصبة لها، بل الساعية للثأر التاريخي من القومية التي اضطهدتها، وهي القومية العربية، مما يؤذن بحروب قومية قادمة عربية/ كرديّة.
فمفهوم القوميّة الذي يسعى الكورد لتأسيس دولتهم عليه، ودخول التاريخ ككيان سياسيّ عبر بناء دولتهم على أساس قوميّ “صافٍ”، هو بوابة الجحيم الذي سارت عليه الفاشيات السياسيّة الحديثة وما بعد الحديثة. تصوروا أمة كرديّة فقط، بلون واحد هو اللون الكرديّ؟ بصراحة: الأمر يبعث على الأسى، ويؤكد أن حروب الهويات ستستمر إلى آلاف السنين القادمة في منطقة الشرق الأوسط. أن تقوم دولة على لون واحد هو أمرٌ يبعث على الإحباط حقًّا، ويذكِّر -شئنا أم أبينا- بكيان “إسرائيل” الذي قام على أساس قوميّ غير إثني بالضرورة هو وحدة الدين ﻟ “شعب إسرائيل”. هذا قوميّة دينة وذاك قومية إثنية، أي دولتان كل واحدة منهما بلون واحد، متمركزتان على هويتهما، ومصرتان على لونهما الوحيد الذي يقصي ما عداه.
أتفهّم ردات فعل كثير من الأكراد التي، نتيجة الاضطهاد التاريخي المتواصل الذي يقف في وجه إنشاء دولتهم، صارت متصلبة متجذِّرة على “الهوية” أكثر، كلما دار نقاش حول مشروع إقامة الدولة الكردية لأكراد العالم. لكن هذا التعصّب لا يؤسس لدولة حديثة، ولا لمجتمع تعددي تمامًا، كما لا يتجاوز خطأ القومية العربية التي لا تعترف بغيرها، وإنما يؤدي ذلك إلى نشوء كيان سياسيّ متمترس على هويته ومُقصٍ لغيره، وينذر باستمرار حروب الهويات التي تسير على قدم وساق اليوم، في سورية والعراق ومنطقة الشرق الأوسط: سنّة/ شيعة، عرب/ أكراد، مسلمون/ يهود، أقليات/ أكثريات.. إلخ.
ما البديل عن كل ذلك إذن؟ لا شك في أن البديل ليس إعادة ترميم مفهوم القومية العربية، إنما هو دفنه. ولكن هل يعقل أن تقوم دولة حديثة دون أساس قوميّ أو مرجعية قومية؟ الجواب: نعم. وهذي هي الحال واقعيًا في أوروبا، مثلًا، التي أدركت أن قومياتها متفرقة ومتفردة، وأنها لن تمكنها من مواجهة التحديات السياسيّة الخارجيّة، ولكن قبل أن تكون هناك انفجارات محتملة لمجتمعاتها الحالية مختلطة الثقافات والمرجعيات القومية والدينية والثقافية، كان لا بدّ لها من إعادة تعريف دور الدولة والمجتمع، فعملت على الخروج من زنزانة القومية، إلى المجتمع التعددي plural society أو المجتمع متعدد الثقافات Multicultural society، عبر الاعتراف باختلاف الآخر، وتوسيع مفهوم المواطنة وإعادة تعريفه، والدخول في تحالفات إقليمية واقتصادية تسمح لها بالبقاء.
هكذا عملت مجتمعات الحداثة الغربية (التي يفرّ إليها العرب والمسلمين المضطَهدين في كل أنحاء الأرض) على التلوّن والتعدد والاعتراف بالاختلاف؛ لإدراكها أن أي مجتمع يحترم حقوق الإنسان هو مجتمع تعدّدي، إذا ما أردنا أن نحقق حلم كانط الشهير، بكرةٍ أرضية سطحها ملكية مشتركة لكل الناس.
في أوروبا، مع الضبط المعياري العقلاني لمفاهيم السياسة والقانون وتجديدها، لم تعد المفاهيم مجرّد يوتوبيات خيالية، وإنما هي أفكار، وقد تجسدت سياسيًا وأنشأت الدول والمجتمعات الحديثة. وهذا ما يجب أن تكون عليه الحال عربيًا، لنستطيع بناء لغة سياسية يمكن من خلالها إعادة بناء السياسة، بشكلٍ مدنيّ وحضاريّ تحّرريّ. مفهوم القومية إذن هو من اللغة الخشبية المتقادمة التي صار لا بد من حرقها، للتفكير في بدائل حيّة قابلة للحياة الكريمة وتتسع للجميع. والبديل المتاح لنا الآن هو المجتمع التعدديّ، وإلا؛ فالصراعات والاضطهاد والقمع وحروب الهويّات.
إما أن نحيا معًا مختلفين، وإما أن نموت بسيوف القومية والهويات المتعصبة والمتمركزة على ذاتها وحقيقتها.
[1] انظر في ذلك كتابه:
E. J., Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, Cambridge University Press, 1990, p. 2.
[2] في معرض نقده لفكر الأرسوزي، يقول ناصيف نصّار: “في الواقع، ليس من السهل حصر تفكير الأرسوزي السياسيّ وتحديد بنيته بصورة ثابتة جليّة؛ إذ يختلط فيه أساس التجربة الرحمانية المثالية بصورة ثابتة جلية بالنزعة الأفلاطونيّة في تصور السياسة والدولة، وبالفكر السياسيّ الذي نشرته الليبرالية الغربيّة، وبالمفاهيم السياسية العربية القديمة…” انظر: ناصيف نصار، طريق الاستقلال الفلسفيّ، دار الطليعة، بيروت، ط2، 1979، ص 173.
[3] قسطنطين زريق، الوعي القومي العربي، بيروت، 1938، ص 12 ـ 13، نقلًا عن محمد جمال باروت، “قراءة نقدية في الفكر القومي العربي التقليدي ـ إنسان النظرية القومية العربية التقليدية”، النهج، شتاء 1997، ص، 103.
[4] http://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm
[5] مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن عفلق والبيطار والحوراني كانوا مقربين من العسكر ويعملون معهم يدًا بيد، ولكن بقي هناك مسافة بين ما نظّروا له وما أراده العسكر الانقلابيون.
[6] قبل أن تقوم أجهزته الأمنية باغتياله عام 1980، كان حافظ الأسد قد حاول جذب صلاح الدين البيطار إلى جانبه، ليدعم الواجهة الأيديولوجية للبعث السوري في مقابل البعث العراقي الذي انتمى إليه ميشيل عفلق، ولكن الساعات الخمس التي أمضاها الأسد في محاولة إغراء البيطار لم تنجح في تقريب فكر هذا الأخير من بسطار الأسد العسكريّ. انظر حول ذلك:
Pierre Guingamp, Hafez El Assad et le parti Baath en Syrie. Comprendre le Moyen-Orient, Editions L’Harmattan, 1996. p. 252.