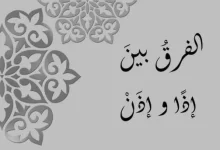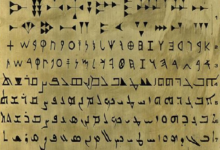ولا تسخر لغة من لغة

يسود، في المخيال الشَّعبي العربي، مَبدأ أفضليّة الضاد على سائر لغات العالَم. وقد يتضخّم هذا الإحساس بالفوقية إلى درجة ازدراء الألسن الأجنبية، ولا سيما ألسن الشعوب الفقيرة أو البعيدة أو المجهولة.
وقد تشيع في محاورات الناس أمثالٌ شعبية تُضرب كنايةً عن غموض اللغات وصُعوبتها، وتُلقى على سبيل السخرية والتهكم بألسنة “الآخر”. ومن ذلك القول: “فلان يتكلم باللغة الصينية” أو “يَرطن بالرقريقية”، وهي تحويلٌ عن “إغريقية”، فضلاً عن السؤال الإنكاري: “هل أتكلم البربريَّة؟”.
وحتى في كتب التراث، ومُؤلفات الجاحظ أبرزها، لا نُعدم فَقراتٍ يُسخر فيها من رطانة الأعاجم وقبح نطقهم وبشاعة أصواتهم.
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ كلمة “أعجمي”، التي كانت تُطلق على غير الناطقين بالعربية، من فُرس وتُرك وأكراد وهنود، على سبيل الزراية، مُشتقة من “العُجمة”، وهي عدم القدرة على الإعراب.
“وكلُّ مَن لَم يُفصح بشيء فقد أعَجَمه. واستعجم عليه الكلام: استبهم، والأعجم: الأخرس، والعجماء والمستعجم: كل بهيمة”، (…) سُمِّيت عجماء لأنها لا تتكلم”، بحسب التحليل المطول الذي خصصه ابن منظور في “لسانه” لهذه المادة. فهل من سُخرية أقذع من تشبيه لغات غير العرب بتصويتات الحيوان؟
وتشمل مَواضيع التهكم، على وجه الخصوص، المكونات الصوتيّة للغة الغير. فتُعدّ غريبة متنافرةً، ومجرّد النطق ببعض الحروف، على وجه التتابع، يُغرق السامع في الضحك بسبب تنافُرها وتكررها. كما قد يضحك طول الكلمات وغرابة أجزائها رغم عدم فهم معانيها.
وقد ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في ترسيخ التهكم من بعض اللهجات المحكية، مثل الفيديو الذي شاع مؤخرًا تحت عنوان “أغرب لغةٍ في العالم”، حيث ظهرَ مذيعان يتكلمان بسرعةٍ، تتعاقب على ألسنتهما حروف متشابهة وكلماتٌ متقاربة.
وهو ما حدا بالملحق الثقافي بدولة كازاخستان في القاهرة إلى إصدار توضيح يذكّر بعراقة اللغة الكازاخية ويؤكد أنَّ الفيديو مجرد تمرين صوتي قام به المذيعان من أجل امتلاك الكفاءة الشفوية والقدرة على الاسترسال في الحديث بكلماتٍ متشابهة المخارج.
لكم يجدر أن ننتبه هنا إلى أن المسألة لا تخص العربية وحدها، ولنذكر سخرية فَرنسيي القرون الوسطى التي انصبت على العربية وأصواتها الثخينة، حتى أنهم صاغوا لفظًا شديد السلبية وهو Charabia بمعنى الكلام الضوضائي الذي لا معنى له. والمفردة، بحسب بعض الافتراضات الإتيمولوجية، اقتراض لكلمة “عَربية”، عبر الإسبانية.
في كل هذه الظواهر، لا يتهكم الساخر من اللغة في حد ذاتها، فهذا محالٌ. وإنما من طريقة أداء بعض الأشخاص لعملية التلفظ. وهذا التمييز هو عينه الذي أجراه، منذ قرنٍ، أبو اللسانيات فرديناند دي سوسير حين فَصَل بين اللسان والكلام، أيْ بين النظام الشامل للغةٍ ما، والأداء الفردي لأصواتها وكلماتها من قبل المتكلمين.
وعليه، يمكن لأيّ أداء، إذا أنجز بشكل آلي أن يثير الضحكَ ويبعث على السخرية، حتى ضِمن الناطقين باللغة نفسها. إذ من بين تعليلات الإضحاك، التي قدمها الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون، مشابهة الإنسان الآلة، فنحن نضحك ممن “تَحكمت به الحركة الآلية التي اعتاد تِكرارها فأصبح أقربَ إلى الآلة منه إلى الإنسان”.
وأما من الناحية الألسنية المحضة، فلا فضلَ للغة على أخرى. فكل لغة هي عبارة عن نظامٍ تَواصلي مؤلف من أصواتٍ تصير، بعد نظمها كلماتٍ تَربطها علاقات نحوية، للتعبير عن الأغراض.
وتتساوى كل اللغات في هذه القواسم المشتركة التي يسميها الألسنيون الكبار، مثل بلومفيلد وتشومسكي، “كليات اللغة”، وهي التي تَفانوا في استخراجها. وعليه تصبح السخرية من اللغات جهلاً بالطبيعة التحكمية بين الدالّ والمدلول، أي بَين الأصوات والصور الذهنية.
وأما من الناحية الثقافية، فقد بَيّن ابن خلدون، منذ قرون، أن العلاقات بين اللغات ليست سوى انعكاس للعلاقات بين الدول، أي بين الغالب والمغلوب. فهي علاقات نفوذ سياسي بين المسيطرين والمسيطر عليهم. ومن المعتاد أن يَسخر الغالب من المغلوب، وكذلك من البعيد والمجهول والمختلف…