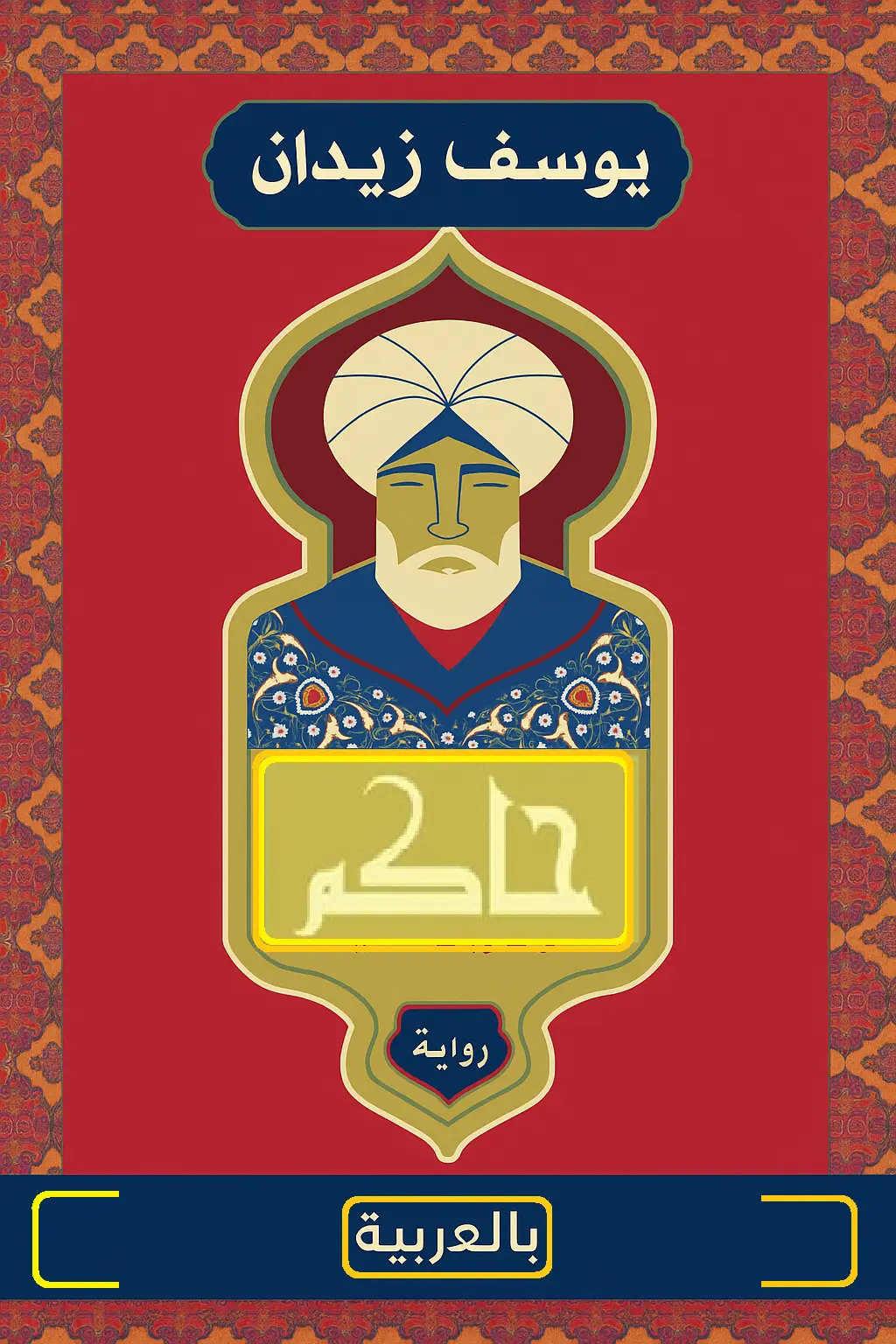
تمثل هذه المادة إضاءة علمية أولية لدراسة أكاديمية رصينة أعدّها الدكتور سعيد الحنصالي، تتناول بعمقٍ موضوع التداخل بين المعرفة والتخييل، والعلاقة الجدلية بين التاريخ والتاريخ المغاير في السرد الأدبي الحديث.
يمكن تعريف الرواية ذات الخلفية التاريخية؛ بأنها عمل خيالي تدور أحداثه في بيئة تاريخية أصيلة، لكنها تقوم على عنصر تخييلي مبتكر، سواء من خلال شخصيات مفبركة تخييليا، أو أحداث متخيلة، أو أماكن مبتدَعة تُعيد بناء التاريخ من زاوية فنية جديدة.
تعود البذور الأولى لهذه الرؤية إلى العصور القديمة، كما في الأوديسة والإلياذة، حيث امتزج الواقع التاريخي بالأسطورة. ومع مرور القرون، عمّق كتّاب كبار مثل والتر سكوت في الطلسم وإيفانهو، وألكسندر دوما في الفرسان الثلاثة، وجون رونالد تولكين في السيلماريلين وسيد الخواتم، هذا التفاعل بين التاريخ والخيال، مما جعل من الرواية التاريخية الخيالية فضاء لتأمل الماضي وفهم الحاضر في آنٍ واحد.
الرواية التاريخية، بهذا المعنى، ليست مجرد إعادة تمثيل للماضي، بل هي قراءة جديدة له، تُستثمر لفهم أسئلة الحاضر الوجودية والسياسية والاجتماعية. فالتخييل التاريخي ليس استحضارا بريئا للأحداث، بل وسيلة لتفكيك علاقة الإنسان بالزمن والسلطة والذاكرة.
ولهذا السبب، يلجأ العديد من الروائيين، قدامى وحداثيين، إلى استلهام التاريخ من أجل فهم الحاضر وتفكيك ألغازه الوجودية والنفسية والفكرية.
كل رواية تستلهم التاريخ، إذن، تُعيد صياغة الحدث في ضوء منظورين متقابلين: التاريخ كما وصل إلينا، والتاريخ كما يعيد السرد تأويله. ومن بين هذا التوتر بين الحدث وتأويله يولد ما يسمى بـ«التاريخ المغاير»، أي التاريخ كما يمكن أن يكون لا كما كان.
ومن أبرز الأمثلة على هذه اللعبة السردية المعقدة رواية يوسف زيدان «حاكم: جنون ابن الهيثم»، التي تُعيد تركيب العلاقة بين العلم والسياسة والدين من خلال إعادة قراءة فترة حكم الحاكم بأمر الله الفاطمي. لا يتعامل زيدان مع الحدث التاريخي كماضٍ مغلق، بل يحوّله إلى مختبر لفهم الحاضر، رابطا بين تجربة ابن الهيثم العلمية ومأزق الحاكم السياسية، ومُدخلا عنصر ثقافة المخطوطات كرافعة للحكاية السردية.
بهذا المعنى، يندرج عمل زيدان ضمن تقليد طويل من الروايات التي توظف التاريخ لإعادة مساءلته، كما فعل سالم حميش في مجنون الحكم (1990)، وحسين السيد في الحاكم بأمر الله (2018)، وأمين معلوف في ليون الإفريقي وسمرقند، وواسيني الأعرج في كتاب الأمير: مسالك أبواب الحديد، وأميرة غنيم في نازلة دار الأكابر، وحسن علوان في موت صغير.
كل هذه الأعمال تؤكد أن؛ التاريخ في الرواية ليس مادة توثيقية، بل مكون جمالي ومعرفي يُستثمر لإعادة بناء الوعي بالزمن الإنساني.
إن ما يميز معالجة الدكتور سعيد الحنصالي لهذا الموضوع هو منهجه التحليلي العميق في تفكيك العلاقة بين _المعرفة والتخييل_، وقراءته للتاريخ كفضاء مفتوح على إمكانات متعددة لا تحدها الوقائع الثابتة. فهو لا يرى في «الرواية التاريخية» مجرد سرد ماضٍ، بل مشروعا تأويليا معرفيا يسائل علاقة الأدب بالتاريخ، والعقل بالخيال، والذاكرة بالهوية.
للاطلاع على الدراسة الكاملة من المصدر: