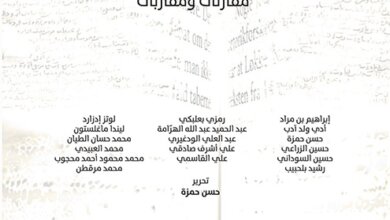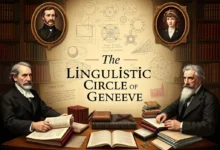اللغة والمجتمع

الحديث حول (اللغة والمجتمع) حديث طويل يتناول نظريات وأبحاثاً كبيرة، بل هو حقل معرفي يعود إلى النقد الماركسي الذي تعود بدايته عند لينن في أعماله النقدية، وما مر به من تحول تداخلت فيه الدراسات اللغوية بالمجتمع بالأدب والنقد، لا يمكن تناوله بكتاب بل مقالة واحدة، بيد أني سأنطلق من القضية التي قالها المتخصصون فيه عن صلة اللغة بالطبقات أو الفئات الاجتماعية.
فمما قالوه في هذا الصدد أن اللغة كائن اجتماعي يتأثر بالمجتمع المحيط به، وعليه فإنه ينقسم مثل انقسام المجتمع إلى فئات أو طبقات، فتجد الصناع لهم لغتهم، وتجد الحرفيين لهم لغتهم، والموظفين لهم لغتهم وكذلك المعلمون (اللغة تعني المستوى اللغوي الذي يشمل المفردات الخاصة، وما قد تشتمل عليه من معانٍ ودلالات مغايرة لما يفهمه من هو خارج دائرة المستعملين الضيقة)، كما أن الطبقات الاجتماعية أيضًا لها لغاتها، فالفقراء لهم لغتهم، والأغنياء لهم لغتهم التي يختلفون فيها.
ويعيد المتخصصون في هذا الحقل التباين اللغوي إلى أن الأغنياء يتعاطون في حياتهم اليومية شؤونًا وموضوعات مغايرة لشؤون الفقراء وموضوعاتهم ما يجعل لغتهم تتأثر بهذه الشؤون.
ولأن غالب النماذج التي يذكرها المتخصصون تعود إلى الألفاظ ودلالتها التي تميز كل طبقة أو فئة عن الأخرى، فإن النقاد وعلى رأسهم باختين في دراسته النقدية قد عد هذا التمييز بين اللغات مما ينبغي أن تتمايز به الشخصية الروائية، فلا ينبغي مثلاً للعامل أن يتحدث في النص الروائي كما يتحدث العالم، كما لا ينبغي للمزارع البسيط أن يتحدث مثل ما يتحدث صاحب التجارة العريضة، وإذا ما حدث ذلك فسيعد عيبًا يؤخذ على الكاتب الذي لم يتمكن من جعل اللغة تعكس الشخصية الروائية جيدًا.
ولست بصدد الحديث عن الأسباب المؤدية إلى هذا الاختلاف سوى ما ذكره العلماء السابقون من تأثير الظروف الاجتماعية إلا أن الذي أريد أن أقف عنده هو ما ذكره باختين من أن هذه المستويات اللغوية قد تتداخل في الرواية، بمعنى أن مستوى لغويًا قد ينتقل إلى مستوى اجتماعي لا يتصل به عادة، فيتحدث مثلاً العامل بلغة العالم أو العكس، أو قد يتحدث الفلاح البسيط بلهجة السيد صاحب التجارة العريضة.
وقد جعل هذا من أدوات الرواية الهزلية، وذلك أن الكاتب – من وجهة نظر باختين- حين ينطق إحدى شخصياته كلامًا بلغة مستوى مغاير فإن هذا يأتي على سبيل السخرية أو المحاكاة الهازلة، وهذا يجعلها في الإضحاك والتندر أكثر من الجد والحقيقة.
وبعيدًا عن التفسير السياسي لهذا الدمج بين المستويات اللغوية في النص الروائي (خاصة حين يكون الموقف لا يحتمل ذلك) فإن الذي أتحدث عنه هنا ليس الجمع في النص الروائي كما في فعل باختين، وإنما في الحياة الواقعية، فإذا عرفنا أن هذا المستوى اللغوي ليس مستوى منفردًا وإنما هو جزء من منظومة اجتماعية عمادها الطبقة التي ينتمي إليها.
وهو ما يعني أن هذه اللغة ترتبط بالعادات الاجتماعية لمتحدثيها، ومستواهم الثقافي والعلمي، الأمر الذي ينعكس على ما يملؤون به أوقاتهم بعد ذلك. ما يعني بدوره أن المستوى اللغوي نتاج جماع مكونات مختلفة كالفهم، والتفسير، والمعنى الذي يتأثر بالظروف سابقة الذكر ويتكون من خلالها.
فإذا انتقلت لغة طبقة إلى طبقة أخرى في الحياة الواقعية، فإن هذا الانتقال لا يعني انتقال الجملة وحدها، أو العبارة أو حتى المفردة، لأن الانتقال بهذه الصورة لا يعني شيئًا، وإنما لا بد من انتقال كل الظروف والمكونات المحيطة بها حتى تؤدي دلالتها، وحين يتم ذلك، فسيتم في الوقت نفسه مزج أكثر من طبقة؛ الطبقة الأصلية التي نقلت عنها اللغة.
والطبقة الأخرى التي نقلت إليها، ولأنه نقل لا يختص باللغة نفسها فإن هذا يعني أن هذا النقل سيؤدي إلى المزج بين الطبقتين من حيث -ما يمكن أن أسميه – عقل كل طبقة، ولأنه ليس على سبيل الإضحاك -كما في النص الروائي- (أو في الواقع، وسبق أن تحدثت في بلاغة النكتة عن أنها تقوم على الجمع بين سياقين مختلفين أو ما يسمى بالمفارقة) فإن هذا سيؤدي بدوره إلى فوضى بالوعي، وذلك أن الفهم والتفسير يقوم بدوره على أدوات معرفية وخبرات اجتماعية ولغوية.
وستقوم الطبقة العليا باستخدام أدوات الطبقة الدنيا وخبراتها الاجتماعية في فهم اللغة وتوظيفها، بناء على أنها تستقبل المستوى اللغوي نفسه كاملاً وتتلقاه كما هو بتركيبته ودلالته، هذه التركيبة والدلالة المعتمدة على جهاز معرفي (ابتستمولوجي) كامل.
ولنأخذ مفاهيم جوليا كريستيفا في إيضاح هذه الفكرة، فالنص عندها «جهاز عبر لغوي»، والنص هنا هو الجملة المفيدة التي تنتمي إلى مستوى لغوي معين، فهي هنا «جهاز عبر لغوي» بمعنى أنها تصل إلى الوعي عن طريق اللغة، و«جهاز» أي مجموعة مكونات مترابطة فيما بينها ذات نظام معين يتحكم في سيرورتها، وعندما تتلقى الطبقة هذا (الجهاز) فإنها تخضع لنظامه المعين حتى تتحقق سيرورته بين أفرادها، وهذا ما يحدث «فوضى الوعي» الذي يحدثه استعارة مستوى لغوي في مستوى لغوي آخر بناء على اختلاف الطبقة الاجتماعية المنتجة لهذا الجهاز (الجملة).
هذه الفوضى في الوعي ستنعكس بعد ذلك على جوانب أخرى مما سميته من قبل بـ«عقل الطبقة»، فتؤثر على خاصية الاستقبال والتقويم، والإدراك، والحكم على الأشياء بعد ذلك، وهي قضية ذات أهمية من الناحية المعرفية والنفسية على أقل تقدير.
كما سبق ذكرت أن اللغويين يرون صلة وطيدة بين اللغة والطبقة الاجتماعية، وقلت: إن نقل كلام طبقة إلى طبقة أخرى يؤدي إلى ما سميته بـ«فوضى الوعي»، ويؤكد هذا المفهوم ما يسمى في النقد بالمدرسة الكلاسيكية، وهي المدرسة الأدبية ذات الصفات المحددة، ويهمني هنا مفهومها كما يدل عليه اسمها، فالكلاسية -كما يقول مؤرخو النقد- مأخوذة من كلمة (Class) وهي التي تعني (طبقة).
وتعني فصلاً دراسيًا، ويربط الدارسون بين المعنيين، في أن الأدب الذي يناسب طبقة معينة من المجتمع هو الذي يكون موضوعًا في الفصل الدراسي، وهذا ما سيؤدي إلى أن المتعلمين سيشكلون طبقة واحدة، ولأن الطبقة التي جعلت معيارًا في تحديد موضوعات الفصل الدراسي هي الطبقة الأرستقراطية في تلك الحقبة، فإن المستوى العلمي هو ما ينتج تلك الطبقة بمفاهيمها، وذوقها.
الأمر الذي يعني أن الأفراد المنحدرين من الطبقات المختلفة يندمجون في الطبقة الأرستقراطية لتكون مقوماتهم الشخصية موافقة لذوقها.
وهذا ما يمنع ما سميناه بـ«فوضى الوعي» بناء على قيام التعليم بتحديد المعايير الطبقية الصالحة لأن تكون مقياسًا للوعي، والعقل فلا ينداح أحدها على الآخر، وإن كان يدل على أن إحدى الطبقات هي المسيطرة بعقلها ووعيها على الطبقات الأخرى حتى ولو كان الذين يتولون العملية التعليمية في الفصل من الطبقات الأخرى، فهم يستعملون أدب الطبقة الأرستقراطية في التدريس وفي التواصل وفي إثبات الذات.
بيد أن استبداد الطبقة الأرستقراطية لم يلبث أن أدى إلى رفض من قبل الطبقة الأخرى التي تمارس التدريس والكتابة، وهي الطبقة الوسطى أو ما يسمونها بـ«البرجوازية»، ما جعلها ترفض هذه المعايير المحددة في الذوق والثقافة والتعليم والكتابة، وتؤسس معاييرها الخاصة.
هذه الثورة على معايير المدرسة الكلاسيكية أحدثت ما يمكن أن يسمى بفوضى الوعي من وجهة نظرها، وتسمى في النقد بـ(المدرسة الرومانسية).
فالرومانسية في الحقيقة تمثل الثورة والتمرد على جميع قواعد المدرسة الكلاسيكية، ورفضًا لها ومحاولة إيجاد قواعد ومعايير للذوق تتفق مع معاييرها هي.
ولو قرأنا نصًا أدبيًا من نصوص المدرسة الرومانسية بمقياس النقد الكلاسيكي، فسنجده نصاً هزيلاً لاختلافه الشديد عما تعودنا عليه من قبل، ومن خلال هذه النصوص والقواعد الأدبية التي سارت عليها بإرساء مفاهيم فنية جديدة، استطاعت إزاحة الوعي الطبقي الكلاسيكي وفرض نوع من الوعي الجديد تسمى بالرومانسية.
ولو رجعنا إلى مفهوم الرومانسية لوجدناها في الأساس تعود إلى اللهجات المحلية المتفرعة من اللاتينية والتي أصبحت لغات مستقلة، وصاحب نشأتها نشأة ما يسمى بالشعور القومي، بمعنى ارتبطت نشأتها بالشعور القومي لدى أفراد البلدان المتحدثة بها، وأصبح الحديث بها يعني تعزيز هذا الاتجاه القومي، وتأكيدًا له.
وهنا ندرك أن هذا الوعي الجديد إنما منح الاعتبار بتضافر جهود اجتماعية وأدبية ونقدية كبيرة، أخرجت هذا الاختلاف في الأدب وطرائق التعبير من أن يكون خاص بطبقة اجتماعية معينة يؤدي إلى «فوضى الوعي» لدى أخرى، إلى الأدب الرسمي الذي يلقى قبولاً من الأدب بوصفه مؤسسة ذات مواصفات جمالية وفنية تتوارثها الأجيال، وتلقى قبولاً في المدارس.
هذه المرحلة التي يحظى بها الكلام بالمقبولية من الطبقات المختلفة تمر بعدد كبير من الجهود، والأعمال، وهذا بدوره يؤكد ما قلناه سلفًا عن أن انتقال كلام من طبقة إلى أخرى يؤدي إلى نوع من فوضى الوعي لأنه يحتاج إلى هذه المراحل، وهذه الجهود، مما لا يتوافر لكل كلام.
وينطبق هذا القول على الحداثة في بداية ظهورها، وما قابلته من رد فعل عنيف، أو نعوت بوصفها تدعو إلى الفوضى، وتحطيم القديم، والهزء بالقيم الفنية المعروفة سابقًا، وذلك بسبب عدم فهم القطاع العريض من المتلقين للقواعد النظرية التي تقوم عليها.
وهو فهم ليس بالضرورة موجوداً لدى المنتمين إليها في بداية نشأتها، ولكنه الشعور الواحد الذي التقى عليه هذا الفئام من الناس، ووحد بينهم وجعلهم ينتمون إلى حركة إبداعية واحدة، وقد لا يكونون متفقين في طبيعة المنتج الذي ينتجونه، والموقف الذي يقفونه من هذا المنتج، بيد أن رغبتهم في الجديد، وسأمهم مما تعارفوا عليه من أدوات التعبير، وشعورهم بعدم قدرتها على الإفصاح عما في نفوسهم، أو عكس رؤيتهم جعلهم يلتقون على البحث عن أدوات تعبيرية جديدة تعكس ما يجدونه من رؤى ومشاعر.
هذه الحركة المتتابعة التي أنتجت أعمالاً فنية متراكمة نشأ عنها حركة نقدية بينت الأسس الفنية التي قامت عليها تلك النصوص، والجماليات التي تنطوي عليها، واجترحت مفاهيم تؤطر تلك الجماليات والأسس، ما جعلها مدرسة أدبية ذات قيمة في الفكر والأدب بعد أن كانت نوعاً من الفوضى في وعي المتلقي.
أ.د. إبراهيم بن محمد الشتوي: أستاذ الأدب والنقد.
مجلة فكر الثقافية