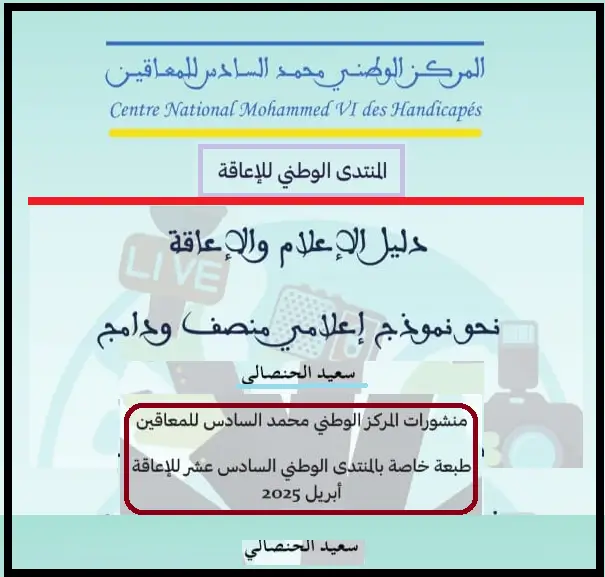
صدر عن منشورات المركز الوطني محمد السادس للمعاقين: دليل الإعاقة والإعلام: من أجل نموذج إعلامي منصف ودامج (أبريل 2025). يتضمن هذا الكتاب تصورا ديناميا ودامجا حول العلاقة الضرورية بين الإعلام والإعاقة، وطيف ينبغي أن تكون هذه العلاقة، علاقة ترافع وإعلاء شأن ودفاع عن الحقوق الطبيعية للاختلاف.
ويرتكز الدليل على آخر ما أنتجته الوثائق والتقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بالموضوع، مثل اليونسكو والأمم المتحدة، كما يرتكز على آخر الأبحاث المعرفية واللسانية والعصبية المعنية بالاضطرابات في مجملها.
فيما يلي قراءة وتقديم للخلفيات والتصورات الموجهة نحو إنجاز هذا الكتاب الذي جاء في صورة دليل علمي وتربوي وإرشادي.
- 1 الحديقة الخلفية لدليل الإعاقة والإعلام:
رغم الحرج الذي وجدته والصعوبة التي واجهتني في إعداد هذه المداخلة، بسبب أن مهمتي انتهت بإنجاز هذا الدليل، إلا أن المناسبة شرط كما يقال. لذلك ما سأعرضه في هذه الجلسة هو بشكل من الأشكال الحديقة الخلفية التي وجهت إنجاز هذا الكتيب بالصيغة التي يعرض فيها على أنظاركم.
أشتغل على موضوع اللغة في الإعاقة، وبالخصوص، المصطلح في مختلف أبعاده اللسانية والمعرفية والذريعية والتواصلية منذ أكثر من عقد من الزمان. ويعود ذلك إلى ما يفرضه التخصص أولا وإلى رغبتي في إبراز الأسباب وراء الخلفيات اللغوية والمعجمية والمفهومية التي توجه الخيارات اللغوية المتنوعة والمتعارضة في تصورنا للإعاقة في كثير من الأحيان.
لا أقصد فقط الخيارات المتصلة بالمخيال الشعبي في تسمية الإعاقة ومشتقاتها؛ أتحدث بالأخص عن الإعاقة في المخيال العالم كذلك، أي معجم الإعاقة في مخيال العلماء والدارسين والأطباء والإعلاميين والسياسيين، وكيف أن هذه الخيارات كثيرا ما تفتقد لوعي كامل بأبعادها وبما يمكن أن تحدثه في الاستعمال العام والمتخصص حول الإعاقة والاضطرابات.
تناسلت على أساس ذلك أسئلة كثيرة:
فيما تختلف تسمية عن تسمية، وفيما يختلف مصطلح عن مصطلح؟
ما أهمية اللغة ولماذا يكون الوعي بمستوياتها وأبعادها ومضمراتها وخلفياتها ضروريا عند الحديث عن الإعاقة ومجالاتها؟
ما معنى الوعي الحقوقي في الخيارات المفهومية والاصطلاحية الخاصة بالإعاقة؟
لماذا هناك نقاش مستفيض على المستوى الدولي (الأكاديمي من جهة أو على مستوى المنظمات والدولية من جهة اخرى) حول ما ينبغي حظره وما يستحب اعتماده وما يحسن تجنبه..الخ؟
لماذا للغة كل هذه السلطة حتى يلتف حولها جمهور الأكاديميين والعلماء والإعلاميين وحاملي راية الترافع؟
ليس هدف ولا مهمة هذه الورقة أن تجيب على هذه الأسئلة، لأن لذلك سياق آخر. هي فقط أسئلة موجهة نحو فهم السياق الذي جاء فيه اختيار أن ينظم المنتدى حول محور مركزي في تأمل قضايا الاختلاف، وهو: حضور الإعاقة في المشهد الإعلامي؛ وهو السياق الذي دفع إلى إنجاز دليل عربي في الموضوع يفترض فيه أن يخلق نقاشا ويثير أسئلة ويقدم اقتراحات.
تاريخيا تطورت لغة الإعاقة مع تطور التصورات الخاصة بها، أما مفهوميا فقد تغير الجهاز المصطلحي في كثير من المحطات التاريخية ليواكب تطور الإطار الحقوقي من جهة أولى، وليستثمر نتائج الأبحاث اللسانية حول الإعاقة من جهة ثانية، وليؤطر تطور البناء المعجمي والمفرداتي التي يتنفس فيه الإبداع الإنساني اليومي في إبداع عبارات وخلق مسكوكات وابتكار أبنية استعارية تصف الاختلاف في شتى أبعاده.
لكل هذه الأسباب، وعلى أساس هذه المقدمات، عنونت هذه المداخلة ب: اللغة والإعلام والإعاقة: من سلطة التسمية إلى صناعة المعنى العادل، أو: كيف يمكن للكلمات أن تصوغ واقعا أكثر إنصافا؟
- 2 حين تصبح الكلمات بوابة للدمج أو جدارا للإقصاء:
في عصر الإعلام الرقمي والسيولة المعلوماتية، تصبح اللغة أكثر من مجرد وسيلة للتواصل؛ هي أولا وسيلة لإنتاج المعنى أو بالأحرى سلطة المعنى، وهي ثانيا قوة قادرة على تشكيل الواقع، وتوجيه التصورات، وإماطة اللثام عن الحقائق أو تكريس الصور النمطية.
إنها مرآة تكشف عن المواقف الثقافية والتمثلات الذهنية والانحيازات المضمرة في الخطاب الاجتماعي والسياسي والإعلامي. وعندما يتعلق الأمر بالإعاقة، تتعاظم أهمية الكلمات، حيث يمكنها أن تكون الجسر الذي يربط بين المجتمعات، أو العقبة التي تعمّق الهوة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وباقي أفراد المجتمع.
وكما يقول الفيلسوف لودفيغ فيتغنشتاين: “حدود لغتي تعني حدود عالمي”، فإن اختيار الكلمات المناسبة عند الحديث عن الإعاقة ليس مجرد مسألة شكلية، بل مسألة جوهرية تحدد مدى شمولية المجتمع وإنصافه، ومدى وعيه بخاصية التنوع المحددة للكائن البشري وغير البشري.
ليست الإعاقة مقولة مجردة. إنها، بغض النظر عن كل التعريفات التي تتناسل وتتغير بتغير الشروط التاريخية المنتجة لها، مفهوم متصل اتصالا وثيقا بالأشخاص المعنيين بها، وهو اتصال يضعهم بالأساس في مركز الاحتياجات وفي مركز البناء اللغوي الذي يعبر عنهم.
- 3 الإعلام والإعاقة : مسؤولية الصياغة وسلطة التسمية:
يضطلع الإعلام بدور محوري في بناء الفهم العام حول الإعاقة، إما بإرساء ثقافة دامجة تحترم التنوع البشري، أو بإعادة إنتاج خطابات إقصائية تستند إلى مفاهيم قديمة ومتجاوزة. تبرز هنا مسؤولية الصياغة اللغوية: هل نقول “ذوو الإعاقة” أم “المعاقون أم المعوقون أم ذوو الاحتياجات الخاصة أم ذوو الهمم أم مجرد أصحاب اختلاف وظيفي ذهني أو عضوي أو عصبي”؟ هل نصف شخصا بأنه “يتحدّى إعاقته” أم نركز على نجاحه بعيدا عن هذا القالب البطولي المرهق؟ أقول هذا لأن المعنى الذي نسنده للكلمة ليس عبثا ولا ترفا.
المعاني تصنعها السياقات بوجه عام لأن الإبداع البشري في اللغة لا حد له ولا نهاية، ما بالك في موضوع يكون فيه للكلمة ما يكون للسيف إذا قطع. ليست هذه الفروقات لغوية فحسب، إنها فضلا عن ذلك تحمل شحنات دلالية وثقافية تحدد كيفية نظر المجتمع لهؤلاء الأفراد، بل وكيف ينظر هؤلاء الأفراد إلى أنفسهم.
إن الاختيارات اللغوية ليست ولا يمكن أن تكون محايدة؛ فهي تنبع من خلفيات ثقافية وعلمية وحقوقية وتشكل الهويات وتنتج المعايير وتفرض أشكالا من الفهم والتقييم.. واللغة التي يتبناها الإعلام تحدد إلى حد بعيد طبيعة العلاقة بين المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة، إما بوصفهم أفرادا فاعلين ومشاركين، أو ككيانات تحتاج إلى الشفقة أو المساعدة المستمرة.
يقول ستيوارت هول – وهو أحد مؤسسي الدراسات الثقافية: ” ليست اللغة انعكاسا بسيطا للواقع، بل هي التي تخلق ذلك الواقع”. ربما يكون هذه القول مدخلا للتأكيد كيف يمكن أن يكون التناول الإعلامي للإعاقة أداة تحرر أو أداة قمع.
من هنا يتأس براديغم أو أنموذج جديد في صورنة اللغة والمصطلحات الخاصة بالإعاقة ضمن منظور لساني وعلمي وحقوقي يرتكز على منطق أساسه مفاهيم وكلمات أكثر دقة وإنصافا. يتأسس هذا البراديغم، إذن، على المنظورات الآتية:
- المنظور اللساني الذي يعني بالأساس أن اللغة إطار معرفي إدراكي يشكل رؤيتنا للعالم. وعند الحديث عن الإعاقة، فإن استخدام مصطلحات تراعي البعد الإنساني الكوني مثل “الأشخاص ذوي الإعاقة” كما شكلتها البنية اللغوية المراعية لمنظور الإعاقة في الترسانة المفهومية للأمم المتحدة، يسهم في تقديم الإعاقة كجزء من الهوية المتعددة للشخص، وليس كتعريف حصري له. اللغوي جورج لايكوف – وهو فيلسوف لغة مشهود له بتقديم منظورات غير تقليدية للعلاقة بين اللغة والفكر والممارسة- يؤكد أن “الطريقة التي نتحدث بها تحدد الطريقة التي نفكر بها”، وهذا يسلط الضوء على الدور العميق للكلمات في تشكيل الفهم المجتمعي للإعاقة.
- المنظور العلمي الذي تأسس وما زال يتأسس على تشكيل وإعادة تشكيل التصورات حول الإعاقة بناء على المسار الذي عرفه تطور المفهوم من النموذج الطبي البحت، الذي يرى فيها قصورا أو خللا، إلى النموذج الاجتماعي الذي يركز على الحواجز التي يفرضها المجتمع. وبالتالي، فإن استخدام لغة تعكس هذا التحول أمر مهم وحاسم في خلق وعي جديد يدرك أن التحدي ليس في الشخص، بل في البيئة غير المهيأة. الباحثة البريطانية كارول توماس، في دراساتها حول “الإعاقة بوصفها سيرورة اجتماعية”، تشرح كيف أن القيود التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة غالبا ما تكون نتيجة للهياكل الاجتماعية بدلا من أي ضعف ذاتي. تقول في ذلك: “ لا ينبغي أن تُفهم الإعاقة على أنها مجرد إعاقة فردية بل يجب أن تُفهم على أنها بنية اجتماعية تشكلها الحواجز المجتمعية”.
- المنظور الحقوقي الذي عرف مسارا طويلا من المخاض قبل أن يتوج باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة والتي تؤكد على ضرورة استخدام لغة دامجة تحترم الكرامة الإنسانية، وهو ما يفرض على الفاعلين السياسيين والتربويين والإعلاميين والمعنيين المباشرين بالإعاقة التزاما أخلاقيا بتبني مصطلحات تعزز الشمول ولا تعيد إنتاج الإقصاء. تقول ستيلا يونغ، وهي ناشطة مشهورة بدفاعها عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن “أكبر عقبة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ليست إعاقتهم، بل الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم”. أضيف إلى ذلك، “والطريقة التي يشكل بها هذا المجتمع معجمه الواصف للإعاقة وللمعنيين بها”.
تدعوني هذه المعطيات الأولية إلى طرح سؤال أعتقده مركزيا: كيف يمكن أن يكون الإعلام محركا للتغيير؟ وكيف يمكنه أن يكون جزءا من الحل؟ وكيف نعيد صياغة الخطاب؟
في كتاب مشترك بعنوان السرديات البديلة: الإعاقة وتبعيات الخطاب Narrative Prosthesis: Disability and the Dependencies of Discourse، صدر سنة 2001، قام باحثان أمريكيان هما ديفيد ميتشل David T. Mitchell وشارون سنايدر Sharon L. Snyder بتناول إشكالية الإعلام وصناعة الصور النمطية عن الإعاقة.
وقد أكدا في هذا الكتاب على أن الإعلام يضطلع بدور حاسم في تشكيل التمثلات الاجتماعية حول الإعاقة حيث غالبا ما يتبنى الإعلام بشكل عام وفي كل المجتمعات سرديتين متكررتين: الأولى تمجد الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أبطالا تحدوا مصيرهم وحققوا ما هو غير متوقع، والثانية تصورهم كضحايا يحتاجون إلى الدعم والإحسان والمساعدة.
في هذا الكتاب تم طرح مفهوم السرديات البديلة التي تجعل من الإعاقة عنصرا يجب تجاوزه ليحقق البطل الانتصار. إن اعتماد هذه السرديات يقزم من التجربة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويفرغها من تعقيداتها وتنوعها البشري. ويصبح الإعلام الذي يتبنى هذا النموذج أداة لإعادة إنتاج الإقصاء بدلا من أن يكون وسيلة للتحول المجتمعي.
النموذج الذي يتجلى فيه هذا الأمر بوضوح هو عندما تعيق اللغة عملية الدمج برمتها، حيث إن التحدي لا يكون فقط في الصورة التي يقدمها الإعلام بل في اللغة ذاتها، ذلك أن اللغة يمكنها أن تخلق ما يمكن تسميته بالإعاقة اللغوية أي البنية الخطابية التي تقصي أو تحقر أو تشيء الآخر المختلف.
في هذا السياق تُظهر العديد من الدراسات النفسية واللسانية النفسية أن المفاهيم التي تستخدم لوصف الإعاقة تؤثر على إدراك الأشخاص لذواتهم، وكذلك على طريقة تفاعل الآخرين معهم. اللغة ليست محايدة كما ذكرنا أعلاه. إنها تعيد تشكيل الوعي والسلوك.
أعيد طرح السؤال بصيغة مباشرة أكثر: كيف يكون الإعلام دامجا ومنصفا؟ إنه السؤال الفرعي لدليل الإعلام والإعاقة. وحوله تدور كل الإشكالات. لنستخلص الدروس من التجارب الدولية. تعد التجربة الاسكندنافية نموذجا ملهما في هذا السياق، حيث تم تبني خطاب إعلامي جديد يقوم على مفاهيم أساسية من قبيل التنوع البشري والدمج المجتمعي بدلا من المقاربات الطبية التي تختزل الإنسان في مفهوم ضيق للقصور.
وقد تم تأكيد ذلك عمليا بالعديد من الإجراءات منها استخدام مجموعة من التقنيات مثل الترجمة النصية التلقائية والترجمة إلى لغة الإشارة أو الترجمة الصوتية، ومنها تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من تمثيلهم بشكل عادل في البرامج الإعلامية، ومنها محاولات لترجمة المفاهيم المعقدة بطريقة يسهل فهمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية أو التعلمية أو النمائية.
ومنها كذلك تطوير وتطبيق تقنيات جديدة لدعم الإعلام الدامج، مثل تقنيات تحويل النص إلى كلام أو تطبيقات القراءة المساعدة، التي تجعل المحتوى الإعلامي أكثر وصولا للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية.
بذلك يكون الإعلام جزءا من الحل حين يتبنى الإجراءات الآتية:
- الابتعاد عن الصيغ الدرامية: بتجاوز ثنائية الضحية/ البطل، واعتماد مقاربات تظهر الإنسان في تعقيد تجربته وفاعليته في المجتمع. ذلك أن تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أبطالا خارقين أو كضحايا محتاجين للرأفة يساهم في تكريس ثنائية غير منصفة.
الناشط والرياضي الأمريكي في مجال حقوق الإعاقة كريس نيكيتش Chris Nikic، الذي أصبح أول شخص من ذوي الثلاثي الصبغي 21 يكمل عام 2020 سباق “ترياثلون” أو سباق الرجل الحديدي Ironman triathlon، وهو لم يتم بعد عامه الواحد والعشرين قال ذات مرة: “أنا لا أحتاج إلى إعجابكم، بل إلى فرص متساوية”.
- استخدام لغة محايدة ودقيقة ومنصفة: على سبيل المثال، بدلا من قول “شخص مقعد” يمكن القول “شخص يستخدم كرسيا متحركا”، – وهو إجراء لغوي بسيط يحافظ على وصف محايد وغير اختزالي. الأمثلة لا حصر لها ويمكن لمتصفحي الدليل أن يجدوا جردا شبه استقصائي لما ينبغي وما لا ينبغي قوله.
تجدر الإشارة إلى أن الدليل الذي يوجد بين أيديكم الآن اعتمد آخر الإصدارات الدولية في الموضوع، أهمها الدليل التوجيهي من أجل دمج الإعاقة في التواصل، والذي أصدرته الأمم المتحدة باللغة الإنجليزية سنة 2022 ولم يصدر بعد بلغات أخرى، ومنها الدليل الإرشادي الذي أصدرته اليونسكو سنة 2024 بعنوان المساواة في تناول قضايا الإعاقة في الإعلام: التمثيل إمكانية الوصول، والتدبير – دليل عملي، وقد صدر هو الآخر بالإنجليزية وحدها. لم يقف الدليل عند هذا الحد بل اقترح في جزئه السابع مسردا ثلاثي اللغة مع تعريف كاف لأهم المصطلحات العلمية والحقوقية الشائعة والمتداولة.
- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الإعلام وفي صناعة المادة الإعلامية: ليس فقط بوصفهم موضوعات للتقارير أو الحوارات، بل كفاعلين وصحفيين ومقدمي برامج ومنتجين لها، وهو أمر من شأنه أن يسهم في إعادة تشكيل الخطاب من الداخل. قال أحدهم: الدمج لا يعني أن نُرى فقط، بل أن يكون لنا صوتٌ مسموع في صناعة القصص ذاتها”.
ليز فوسلين Liz Fosslien وهي مؤلفة ورسامة وخبيرة في التصميم تقول إن التنوع يعني أن يكون لك مكان على الطاولة، والشمول أو الدمج يعني أن يكون لك صوت، والانتماء يعني أن يُستمع إلى هذا الصوت.” إن تشييد بيئة دامجة بشكل عام يقوم على تصور مفاده أن تمكين الأفراد من مشاركة قصصهم وتجاربهم لا يسهم فقط في تعزيز الشعور بالانتماء.
بل يمنحهم دورا نشطا في رسم معالم السردية الجماعية، لا سيما في أماكن العمل أو الصناعة الثقافية. إنه أحد الأدوار المركزية التي على الإعلام أن يضطلع بها في منح الأشخاص ذوي الإعاقة -بغض النظر عن حجم إعاقتهم وطبيعتها – صوتا يُستمع له بدلا من الاكتفاء بالحديث نيابة عنهم.
- 4 نحو لغة تصنع واقعا أكثر عدالة داخل خطاب إعلامي دامج:
كيف نشيد، إذن، تصورا لغويا ومفهوميا يرى في الإعاقة إشكالية عرضانية تعبر كل فضاءات الفكر والممارسة؟
إن العلاقة بين الإعاقة والإعلام…. تتقاطع مع كل مجالات الحياة وليست شأنا قطاعيا معزولا. إنها إشكالية عرضانية تعبر كل فضاءات الفكر والممارسة. وبذلك فهي أبعد ما يكون عن تشخيص بيولوجي أحيائي محض لأنها بالأساس تعبير عن تنوع عصبي ومعرفي وبشري. وطرائق تعاملنا مع الإعاقة في الخطاب الإعلامي تظهر كيف ننظر إلى الاختلاف ذاته وكيف ندبر التنوع داخل الفضاء العام.
وقد أشار الصحفي والمفكر الأمريكي ستيف سيليبرمان Steve Silberman في كتابه: القبائل العصبية: إرث التوحد ومستقبل التنوع العصبي “NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity، إلى أن الفهم التقليدي للإعاقة العصبية –التوحد على سبيل المثال لا الحصر – قد أدى إلى تهميش ملايين الأشخاص الذين لا يتوافق نمط إدراكهم مع المعايير السائدة. ويدعو سيلبيرمان إلى الاعتراف بما يسميه “التنوع العصبي” (Neurodiversity) بوصفه جزءا من ثراء الإنسانية، وليس خللا ينبغي إصلاحه.
الإعلام، إذن، ليس مجرد مرآة تعكس الواقع، بل هو أداة تُصمّم كيفية رؤيتنا للعالم. وبالتالي، فإن تبنّي لغة عادلة عند الحديث عن الإعاقة ليس مجرّد تجميل بلاغي، بل هو فعل سياسي ومعرفي يُعيد توزيع الإمكانات داخل الفضاء العمومي.
قال عالم اللسانيات رومان جاكوبسون: “Languages differ essentially in what they must convey and not in what they can convey.” إن اللغة تُرغمنا على قول أشياء معينة لا على مجرد قدرتنا على التعبير عنها—وهذا يعني أن تغيير اللغة قد يكون الخطوة الأولى نحو تغيير الواقع.
ومن هنا، فإن بناء خطاب إعلامي جديد حول الإعاقة، يقوم على العدل والاحترام والتنوع، هو مهمة جماعية لا تقتصر على الإعلاميين فقط، بل تشمل اللغويين، والمربين، والمشرّعين، وكل من يسهم في صناعة المعنى داخل المجتمع.
في الشق المقابل الكلمات ليست مجرد أدوات محايدة، بل هي قوى تعيد تشكيل تصوراتنا للواقع. وفي سياق الإعلام والإعاقة، فإن الاستخدام الواعي للمصطلحات والصياغات يمكن أن يكون مفتاحا لصنع مجتمع أكثر شمولا وإنصافا. من هنا، يصبح لزاما على الإعلاميين والباحثين وجميع الفاعلين في المجال اللغوي والحقوقي والسياسي وعلماء النفس والاجتماع أن يكونوا أكثر وعيا بمسؤولية الكلمة.
لأنها في نهاية المطاف، إما أن تفتح الأبواب أو تغلقها. ترى روزماري جارلاند طومسون Rosemarie Garland-Thomson وهي جامعية وباحثة في دراسات الإعاقة أن “الطريقة التي نتحدث بها عن الإعاقة تشكل الطريقة التي نعترف بها أو ننكر إنسانية الأفراد”.
دليل الإعاقة والإعلام: من أجل نموذج إعلامي منصف ودامج
منشورات المركز الوطني محمد السادس للمعاقين