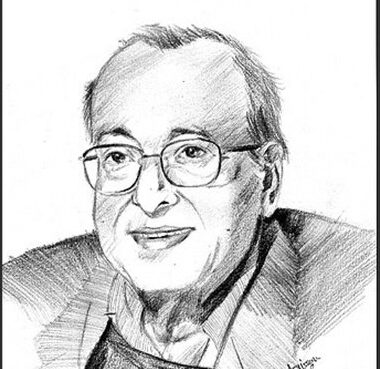
وُلد عبد الوهاب محمد المسيري في أكتوبر عام 1938، ويُعدّ أحد أبرز المفكرين وعلماء الاجتماع في مصر والعالم العربي خلال القرن العشرين. عُرف المسيري بموسوعيته وعمق رؤيته النقدية، وهو صاحب العمل الموسوعي الفريد “موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية“، التي اعتُبرت من أبرز ما نُشر في القرن العشرين في هذا المجال.
تميّز المسيري في موسوعته بتقديم مقاربة علمية وموضوعية لليهودية والصهيونية، حيث قدّم “نظرة جديدة” شاملة للظاهرة اليهودية ضمن سياقها الحضاري والاجتماعي، بعيدًا عن التعميمات الأيديولوجية. تناول أيضًا في كتاباته إشكاليات الحداثة الغربية وتحولاتها القيمية.
إلا أن هذا الطرح لم يخلُ من النقد، إذ اعتبره البعض “متساهلًا” أو حتى “متعاطفًا” مع اليهود في بعض مواقفه، ووُصفت الموسوعة من قِبل بعض منتقديه بأنها “تدافع فعليًا عن اليهود”. ومع ذلك، ظل مشروع المسيري قائمًا على مساءلة الحداثة الغربية نفسها، لا الانحياز لمنظوماتها.
من بين أهم ما ميّز المسيري، قدرته على الربط بين قضايا الحداثة، والهوية، والإنسان، والاقتصاد، والأخلاق، والدين، في رؤية فلسفية شاملة. وفي هذا السياق كتب:
“قد يكون من الأكثر رشداً وعقلانية ألا نطالب بـ”تحرير المرأة” وألا نحاول أن نقذف بها هي الأخرى في عالم السوق والحركية الاستهلاكية، وأن نطالب بدلاً من ذلك بتقييد الرجل أو وضع قليل من الحدود عليه وعلى حركيته بحيث نبطئ من حركته فينسلخ قليلاً عن عالم السوق والاستهلاك، وبذلك يتناسب إيقاعه مع إيقاع المرأة والأسرة وحدود إنسانيتنا المشتركة. انطلاقاً من هذه الرؤية لا بد أن يُعاد تعليم الرجل بحيث يكتسب بعض خبرات الأبوة والعيش داخل الأسرة والجماعة.”
وفي مساجلة الحداثة المادية والنزعة الوضعية، يرفض المسيري الفكرة العشوائية في نشأة الكون:
“خلق العالم بالصدفة هو مجرد افتراض وتخمين وليس حقيقة علمية. ومن الاعتراضات المعروفة على هذا الرأي أن يكون كائن كالإنسان من تلك الذرات مصادفة أكثر بعداً من احتمال قرد يخبط على آلة كاتبة فيخرج لنا قصيدة رائعة.”
وينتقد المسيري التعريف السطحي للعلمانية، فيقول:
“لكن أنا أعرّف العلمانية بأنها ليست فصل الدين عن الدولة، وإنما فصل مجمل حياة الإنسان عن جميع القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، بحيث يتحول العالم إلى مادة استعمالية يوظفها القويّ لحسابه.”
ويؤكد على قيمة التجاوز الأخلاقي والمعرفي:
“التجاوز بالمعنى العام هو (تخطي شيء ما وصولاً إلى ما هو أسمى منه).”
في تحليله للتحولات الاجتماعية، يرى المسيري أن طابع الفرح نفسه تغير جذريًا:
“الفرح أصبح هو اللحظة غير الإنسانية التي يتم فيها استعراض الثروة والتباهي بها وتزداد فيها حدة الصراع الطبقي، بعد أن كان اللحظة الإنسانية التي يتم فيها إسقاط الحدود الاجتماعية مؤقتًا، ويتم تقليل حدة الصراع الطبقي ليعبر الجميع عن إنسانيتهم المشتركة.”
ويُبدي اهتمامًا بالعلاقة بين الثقة بالنفس والنموذج التفسيري:
“الثقة بالنفس ضرورية كي يمكن للمرء أن يعمم ويصوغ نماذج تفسيرية.”
وعن المثقف الحق، ينقل رؤيته التربوية والمعرفية:
“وقد أخبرني مرة أن النسيان (وليس التذكر) هو الذي يصنع المثقف، وكان يعني أن المثقف الحقيقي لا يتذكر التفاصيل دون إطار ودون رؤية كلية، وأن الرؤية الكلية بالضرورة تعني استبعاد (نسيان) بعض التفاصيل.”
كما يحذّر من تفريغ الهوية من بعدها الفلسفي العميق:
“لا بد أن يدرك الناس أن الهوية ليست مجرد فولكلور ولكنها الرؤية الفلسفية للإنسان. فالناس تستيقظ كل يوم لأداء عملها لتحقيق هدف ما، ولكن من دون وجود هدف تصبح عملية الاستيقاظ عملية بيولوجية خالية من المعنى. بينما أعتقد أنه في ظل وجود مشروع حضاري يصبح الاستيقاظ فعلاً إنسانيًا يسهم في بناء الوطن.”
✦ عبد الوهاب المسيري: رؤى نقدية وفكر إصلاحي
تميّز المسيري بنقده العميق للحالة الثقافية العربية المعاصرة، حيث كتب في أحد تعليقاته الساخرة:
“كان صاحب المكتبة رجلًا مثقفًا يساعدنا على اختيار الكتب، على عكس بائعي الكتب هذه الأيام الذين يتسمون بالجهل المُطبق، فاهتمامهم بالكتاب ينتهي عند سعره ولونه.”
وفي موضع آخر، عبّر عن رفضه للمعلوماتية السطحية التي تفتقد للمعنى:
“الرغبة المعلوماتية حينما تنهش إنسانًا فإنها تجعله يقرأ كل شيء حتى يعرف كل شيء، وينتهي الأمر بالمسكين أنه لا يعرف أي شيء.”
وقد ربط المسيري الهوية بالإبداع، فقال:
“بطبيعة الحال، فالإنسان الذي لا هوية له لا يمكنه أن يُبدع، فالإنسان لا يُبدع إلا إذا نظر للعالم بمنظاره هو، وليس بمنظار الآخرين. لو نظر بمنظار الآخرين، أي لو فقد هويته، فإنه سيُكرر ما يقولونه ويصبح تابعًا لهم، كل همه أن يُقلدهم أو أن يلحق بهم ويُبدع داخل إطارهم، بحيث يصير إبداعه في تشكيلهم الحضاري.”
ويُميز المسيري بين المعرفة المتوفرة وبين “الحقيقة” المتجردة:
“أحب أن أشير إلى أنه عندما يبدأ المرء في قراءة كتاب ما دون أن تكون عنده إشكالية فكرية فإنه قد لا يؤثر فيه، فوجود مثل هذه الإشكالية تجعل الإنسان يستوعب محتويات الكتاب… ولذا أُميز بين الحقائق والحقيقة، فالحقائق موجودة على الإنترنت وفي الصحف والموسوعات، أما الحقيقة فيُجردها الإنسان بعقله… وهذا لا يعني السقوط في الذاتية، لأنه عندما أصل إلى تعميم ما أراه هو الحقيقة، فإنني أطرح هذا التعميم لا على أنه حقيقة مطلقة ونهائية، وإنما باعتباره حقيقة قمت بتجريدها ولا بد من اختبار مقدرتها التفسيرية على محك الواقع.”
وفي دفاعه عن اللغة العربية الفصحى، يكتب:
“إن حلم الفصحى ليس (حلم العودة)، وإنما حلم الانطلاق نحو غدٍ يمسك فيه العرب بزمام أمرهم… أما التحيز إلى العامية، فهذا هو طريق الهزيمة والسوق الشرق أوسطية.”
وفي نقده للعامية بوصفها ذاكرة ثقافية بديلة، يقول:
“لو أصبحت العامية وحدها هي مستودع ذاكرتنا التاريخية لفقدنا امرؤ القيس والبحتري وابن خلدون وابن سينا، أي أننا سنفقد كل شيء، وتصبح كلاسيكياتنا هي أغاني شكوكو وأقوال إسماعيل ياسين.”
ويُلاحظ أن الإنسان المتوازن لا يكون دائمًا الأكثر إنتاجية وفق معايير السوق:
“الإنسان السعيد المتزن تقل إنتاجيته بعض الشيء، إذ تصبح أهدافه في الحياة إنسانية.”
كما ينتقد الإنسان الاستهلاكي الحديث:
“الإنسان الاستهلاكي الحديث يفضل ما هو سهل وبسيط على ما هو جميل ومركب.”
ويُصرح بإيمانه بـ”النسبية الإسلامية”:
“أنا أؤمن بما أسميه “النسبية الإسلامية”، وهو أن يؤمن الإنسان بأن هناك مطلقًا واحدًا هو كلام الله، وما عدا ذلك فهو اجتهادات إنسانية.”
وفي نقده للجمود الفكري:
“الإذعان والقبول بالأمر الواقع هما جوهر الجمود والرجعية.”
ويشبّه السعادة والزواج بالأعمال الفنية التي تحتاج إلى جهد:
“السعادة لا تهبط من السماء، وإنما هي مثل العمل الفني، لا بد أن يكدّ المرء ويتعب في صياغته وصنعه، والزواج، مثل العمل الفني، أيضًا، ومثل أي شيء إنساني مركب، يحتوي على إمكانات سلبية وإيجابية ولا يمكن فصل الواحد عن الآخر.”
ويحذر من تأخير تكوين المثقف العربي:
“إن تأخير تكوين المثقف في العالم العربي أمر يؤثر في التنمية، فهذا يعني أن الكثيرين يتساقطون أثناء العملية التربوية، وإن من يخرج سليمًا منها فإن سنين العطاء عنده تكون محدودة للغاية.”
ويُوجز أهمية المشروع الحضاري بقوله:
“إن من لا يملك مشروعًا حضاريًا يتقدم بخطى حثيثة إلى مزبلة التاريخ.”
كما ينتقد الطابع العنصري للمجتمع الإسرائيلي:
“المجتمع الإسرائيلي هو ليس مجتمعًا عنصريًا فحسب، ولكن قوانينه أيضًا عنصرية.”
ويستشهد بمقولة ذات دلالة أخلاقية:
“ويل للمرء الذي يربح كل شيء ويخسر نفسه.”
ويربط التقدم الغربي باستغلال العالم الثالث:
“التقدم الغربي هو ثمرة نهب العالم الثالث، وأن الحداثة الغربية لا يمكن فصلها عن عملية النهب هذه.”
ويؤكد على الطبيعة المقارنة للمعرفة:
“المعرفة الإنسانية معرفة مقارنة، فنحن لا نعرف الشيء في حد ذاته، بل نعرفه في علاقته بشيء يشبهه وآخر يختلف عليه.”
وفي لحظة تأمل إنساني عميق، يقول:
“الإنسان الذي لا يحلم لا يغير ويعيش في حالة اكتئاب، خاصة أن كل ما في حياتنا الآن يدعو للاكتئاب.”
ويميز الإنسان عن غيره من الكائنات:
“الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على أن يرتفع على ذاته أو يهوى دونها، على عكس الملائكة والحيوانات، فالملائكة لا تملك إلا أن تكون ملائكة، والحيوانات هي الأخرى لا تملك إلا أن تكون حيوانات، أما الإنسان فقادر أن يرتفع إلى النجوم أو أن يغوص في الوحل.”
وفي تأملاته الوجودية، يكتب:
“وقد تعلمت من هذه التجارب أن النجاح والفشل في الحياة العامة حسب المعايير السائدة ليس بالضرورة حكمًا مصيبًا أو نهائيًا، وأن الإنسان قد يفشل بالمعايير السائدة، ولكنه قد ينجح بمعايير أكثر أصالة وإبداعًا.”
كما يُبرز التباين بين الدولة والنخبة:
“عندما يدرك الناس أن الدولة تُدار لحساب نخبة وليس لحساب أمة؛ يصبح الفرد غير قادر على التضحية من أجل الوطن، وينصرف للبحث عن مصلحته الخاصة.”
ولا يتردد في السخرية من الأكاديميين التقليديين:
“الأكاديمي: شخص عديم الخيال، يُلحق ببحثه قائمة طويلة بالمراجع، ويشرح أطروحته بطريقة مملة.”
ويختم بتشخيص عميق لمشكلة المرأة بوصفها قضية إنسانية:
“مشكلة المرأة مشكلة إنسانية لها سماتها الخاصة.”