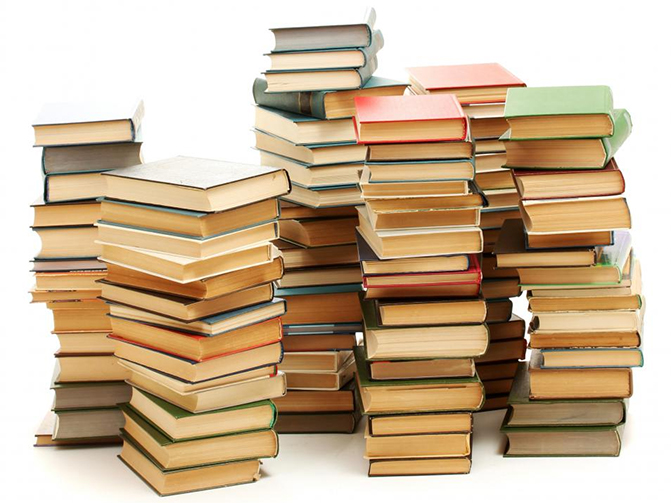
الحَشْوُ؛ عيبٌ مِن عُيوبِ الكتابة العلمية، إلى جانبِ عُيوبٍ أخرى كثيرةٍ تَطَرَّقْنَا لبعضِها في المقالات السابقة ضمن هذه السلسلة، وسنتطرق للبقية في مُقبل المقالات بحول الله تعالى، ونعني بالحشو في الكتابة العلمية؛ التكرارُ الذي لا فائدة منه.
ويَحدثُ غالبا بتكرارِ معنىً أو فكرةٍ واردةٍ سَلَفاً؛ بأسلوبٍ مختلفٍ، أو الاستفاضة في شرحِها، دون أن يكون لهذا التكرار وهذا الشرح إضافة معرفية أو علمية. والحشو مِمَّا لا فائدة منه، وقد يكون الحشو بالاستطراد في جزئية خارجَ الموضوع؛ دون أن يُضيف أيَّ إغناءٍ أو معلومةٍ جديدة.
إذا ما ألقينا نظرةً على نوعية البحوث والرسائل والأطروحات الـمُنجزة في الجامعات العربية، خاصة تلك التي تتَّبِع النظام التعليمي الفرنكفوني (المغرب – الجزائر – تونس – لبنان– جزر القمر- مصر – جيبوتي-)؛ فإننا سنجدُها عبارةً عن مُجلدات ضخمة، أصغرُها قد يُقارب الألف صفحة أو يزيد.
وهذا راجع إلى طبيعة المدرسة (الفرنكوفونية) التي تقوم أساسا على التحليل المستفيض في المباحث النظرية؛ وتَعَقُّبِ التفاصيل والجزئيات البسيطة والثانوية، ومَنْحِ المقدمة أو التقديم للبحث حصة الأسد من الوقت والجهد والأوراق، نتيجة الخَوْضِ في العموميات والتاريخ والنظريات على حساب الموضوع الرئيسي، فيصبح البحث سمينا جدا، ولكن قيمتَه العلمية تكون محدودةً ومحصورةً وضئيلة للغاية.
في حين؛ نجد أن المدرسة “الأنجلوساكسونية” هي على عكس المدرسة الفرنسية تماما، فهي تُقدس التخصص وتَنْفُرُ من الإطناب والخوض في التفاصيل والعموميات، فبحوث ودراسات المدرسة الأنجلوساكسونية؛ تضع الأصبع على الجرح مباشرة دون مقدمات، فنجد أن البحوثَ محدودةُ الحجم من حيث عدد الأوراق.
أيْ أنها تكاد لا تصل المئة ورقة إلا فيما ندر، ولكن قيمتَها العلمية عاليةٌ جدا، بل وتُعتبَر الدراسات والأبحاث التي تنتمي للمدرسة الأنجلوساكسونية الأعلى قيمة والأرفع جودة في العالَم، بل والأكثر تأثيرا واستشهادا بها في معاملاتِ التأثير العالمية أيضا.
لأنها ببساطة؛ لا ترتكز على النظريِّ بل على التطبيق، فالنظري بالنسبة للمدرسة الإنجليزية متوفر للجميع؛ ويمكن الإحالة عليه من مراجعه الخاصة، بدل نسخِهِ من جديد، إلا إذا كانت هناك معطيات أو معلومات جديدة أو إضافات لم يَسبِق لها أحد، في هذه الحالة؛ تكون سَبْقا علميا أو معرفيا؛ وتُصبح ضرورية وإلزامية إدراجها.
الحشو يُضعف كثيراً قيمة البحث أو المقال العلمي، ويُسبِّب تدنِّيا كبيراً في جودتِـه.
يتحرّج كثيرٌ من الأساتذة فضلا عن الطلبة الباحثين؛ مِن تقديم أوراقهم البحثية على صفحات معدودة؛ مما يدفعهم إلى التسويد والحشو والتوسُّع في الأفكار وملئ الفراغات ليَصير بحثُهم سمينا ومقبولا وأنيقا مِن حيث المظهر عند طباعتِه.
كما أن بعض الجامعات وبعض الأساتذة الذين يُشرفون على الرسائلِ والأطاريح؛ يُلزمونَ طلبتَهم بعددٍ مُحدَّدٍ من الأوراق والصفحات يجب أن يبلُغَها البحث ليتم الموافقَة على إحالتِه للمناقشة.
لدرجةِ أنَّ في بعض الجامعات لا يُسمح بمناقشة البحوث والأطاريح التي تقل عدد صفحاتِها عن النسبة المُحددة في بنود المناقشة، وهذه البنود لا تستند لأي معيار أو مقايس علمي أو منهجي.
وغالبا ما تفوق هذه النسبة المئة ورقة في رسالة الماجستير، وتقارب ألفاً في أطروحة الدكتوراه، وليس لِهذا الخُرافة سندٌ لا علميٌّ ولا منهجيّ ولا حتى منطقي، فعدد الأوراق يُحددها الموضوع نفسُه المراد البحث فيه، وعدد الأوراق المطلوبة؛ هي عدد الأوراق التي تم تحريرُ البحث عليها دون حشوٍ أو زيادة، ومن دون نقصانٍ أو إهمال أو تكاسل.
فإن كانت عَشْرُ ورقاتٍ هي مَتَمُّ البحث فهي كذلك، وإن كانت مئة فهي كذلك. أما أن يَفرض الأستاذ على الطالب شيئا كهذا، فهذا ليس من المنهجية أو العِلْمِ في شيء. بل هو هَوَىً مُتبّعٌ من طرف الأستاذ أو إدارة الجامعة، وهو مِمَّا يَشُدُّ (عن) ويُخالفُ أصول الكتابة العلمية.
ثقافة الحشو السائدة في المؤسَّسات التعليمية العربية؛ هي التي أدتْ إلى تقديم الكَمّ على حِساب الكَيْف.
ولأن جامعاتَنا العربية التي مازالت تعتمد السياسات والمنهاج العتيقة والقديمة، تولي أهمية كبيرة واستثنائية للكَمِّ على حساب الكَيْفِ، فهي تَفْرِضُ على الطلبة ممارسة الحشو والتَّمَرُّنِ عليه، بَلْ وإتقانِه،
وهذا ما يعكس سبب تردي وتدني جودة البحوث العلمية والجامعية في وطنِنا العربي. إذ يَحْضُرُ الكَمُّ ويُهمن بشكلٍ مُفرط على الكيف، ويغيبُ النوع، وتنعدِمُ الجودة والجدَّة في هذه البحوث.
ولعل هذا الحشو (ونقصد به منهجيا) تكرار المعروفِ والمشهور والمعلوم، وإقحام الشروحات غير الضرورية والإطناب والاسترسال في الكلام الذي لا طائل منه، دون الإتيان بأي جديد، والحشو نوعٌ من النَّقل أو النَّسخ، يُكلف كاتبَه جُهدا، ويُكلف قارئَه مجهودا أكبر.
ولعل ظاهرة الحشو هذه، هي مَن أنتجتْ ما يُعرف الآن بالقراءة المائلة[i]، وهي حاجةٌ تمَّ اختراعُها للتعامل مع مثل هذه الكتابات والأبحاث والمقالات التي تّعِجُّ بالحشو والإطناب والتفاصيل الهامشية التي لا فائدة ولا نفع ولا طائل من ورائِها.
الحَشْوُ عَيْبٌ في الكتابة العلمية؛ وهو المسؤول عن ضُعف المعنى.
لقد انتشرتْ ثقافة الحشو في المجتمع العلمي العربي بشكل عام، وترسَّخت بشكل خاص في أوساط الصحفيين والإعلاميين والطلبة الجامعيين، ففي مجال الصحافة المكتوبة؛ نجد أن الجرائد والمجلات العربية تقوم أساسا على الحشو، لسبب واحد هو ضرورة ملئ صفحات الجريدة العشرين (20)، وملئ صفحات المجلة المئة (100).
لذلك نتفاجأ كل يوم بأن عدد الأخبار المنشورة يوميا تُساوي بالضبط عدد صفحات الجريدة، وهذا أمر مُثير للضحك ومثيرٌ للشفقة أيضا.
- نماذج وأمثلة للحشو
بعض العبارات الإنشائية المكروهة في المقالات العلمية، والـمُفْضِيَّة إلى الوقوع في الحشو:
- “وقبل أن نخوض في معالجة قضية هذا المحور لابد أن نُعرّج على مسألة مهمة وهي..”.
- “بداية لابد أن نؤكد على أمر مهم يتمثل في …”.
- “سنعرّج سريعا على مسألة في غاية الأهمية؛ يتعلق الأمر بـ…”.
- “وسنفتح هنا قوسا لنتحدث قليلا عن ….”.
هذه التعابير . وغيرُها كثيرٌ؛ تَرِدُ كثيرا في البحوث الجامعية (الرسائل والأطاريح)، وهي حيلة من الحيل التي يُسمّن بها الطالب بحثه أو الكاتب مقالَه ليكون مقبولا من حيث الكم والسُّمْك لدى الإدارة ولدى الأستاذ المشرف.
هذه التعابير والجُمل البسيطة؛ قد تُكلف أحيانا عشراتِ الصفحات من التَّيْه في مجاهِلَ لا علاقة لها بموضوع البحث. وهذا النوع من البحوث تُشبه رُزمة حاطِبِ الليل، إذ تجد في البحث الواحد عشرات المواضيع التي تختلف عن قضية البحث، وأحيانا تتعارض في الأبواب والفصول والمحاور.
فالطلبة بدورِهم قد تأقلموا مع هذا الوضع وتعلّموا وابتكروا طُرُقا وأساليبَ مختلفة للإرضاء الإدارة على حساب أخلاقيات وأصول البحث العلمي.
- “كما هو معلوم” : هذه العبارة تَرِدُ كثيرا في البحوث والمقالات العلمية والمقالات الصحفية، وهي تعبيرٌ خاطئ، إذ لا داعي لذِكر الأمور المعلومة، لأن ذكرَها يُعدُّ حشوا، كما أن الأمور التي تكون معلومة عند الكاتب قد تكون مجهولة عند القارئ. وبالتالي؛ فاللغة العلمية لا تُبْنى على هكذا عبارات، والصحيح أن نذكر الأمور المهمة التي تخدم المقال أو البحث، وأن نتفادى ذكر الأمور التي تُعتبر تكراراً وحشوا وإطنابا.
- أسفرتْ عملية زراعة الخلايا الجذعية لمريض من طرف أطباء بريطانيين إلى مفاجآت غير متوقعة: هذا التعبير بلاغيٌّ وليس علميا، إذ يجب ذِكر النتائج بلغة تقريرية علمية دون توظيف اللغة البلاغية أو الأدبية. كما أن هذا التعبير غيرُ سليمٍ من الناحية الدلالية، فكل المفاجآت غير متوقعة، وليست هناك مفاجآت متوقعة وأخرى غير متوقعة، وإذا كانت متوقعة فإنها ليست مفاجأة أصلا.
الحشو؛ عاملٌ أساسيٌّ في تدني المردودية العلمية للبحوث العربية.
- بعض التعابير المكروهة في الكتابة بشكل عام
- … سيُعالِج المريضَ بالدواء.
- شبَّ حريق ضخمٌ في الغابة بسبب النيران.
- سافر بواسطة وسيلة نقل.
- … وهي من الثِّمار اللذيذة التي تتمتع بطعم حلو المذاق.
- أكدتْ مصادر عِلمية / هذه العبارة غيرُ صالحة، إذ وجودُ مصادرَ علميةٍ يفتَرضُ أن هناك مصادرَ غيرَ عِلمية. والصواب أن نَذْكُرَ اسم وصفة هذا المصدر العلمي تصريحا بالإحالة عليه أو في الهامش مِن دون تحفظ.
- في البحوث العلمية لا يجب إيراد عبارة مِن قبيل (وتشير التقديرات)، بل يجب اعتماد إحصاءات وأرقام صحيحة مِن مصادرِها المؤكدة، لأن التقديرات يمكن أن يكونَ الفرق بينَها وبين الأرقام الحقيقية فرقا كبيرا جدا، وبالتالي؛ تكون الدراسة المبنية على التقديرات دراسةً غيرَ علميةٍ بالمطلق.
- يجب تجنُّبُ استعمال صيغ المبالغة قدر الإمكان؛ وعدم الإكثار منها، لأن هذه الألفاظ إنشائية وتُخاطب المشاعر، أما المقالات العلمية فيجب أن تَستعمل ألفاظا تحترم المنطق وتخاطب العقل؛ ومثالُها:
عالمٌ عظيم / الـمُفكر والباحث العملاق / الطبيب البارز / العلامة والفهامة والبحاثة (تاء المبالغة) نستعيض عنها بــ (عالِم عوضاً عن علامة / باحث عِوضاً عن بَحَّاثة… إلخ.
- بعض الحلول المُقترَحَة لـتَجَنُّب الحَشْو
- الإكثار من قراءة المقالات والنصوص والبحوث الرصينة، خاصة تلك التي تنتمي إلى المدرسة الأنجلوساكسونية.
- التَّمَرُّنُ (بالكتابة) على الاقتصار على المفيد والضروري دون إطناب ولا زُيادة.
- الكتابة وفق مَنهجية مِن الـمَنهجيات الـمُعتمَدة في الكتابة العلمية.
- توظيف الإحالات والهوامش للمعلومات والمعارف التي يَعتقد الكاتب أنها ضرورية دون إيرادِها في المقال أو البحث.
- ضرورة إلغاء فكرة الكَّم التي تستحوذ على غالبية الكتاب، وعدم إيلائِها أيَّة أهمية، والتركيز على الكَيْف وعلى النوعية.
- عدم شرح وتبسيط الأفكار الواضحة، والاقتصار على الأمور الـمُبهَمة التي تحتاج إلى شرح وبشكل مقتضب جدا.
- الاقتصار على المختصر المفيـــد، وتجنُّبُ توظيف واستعمال العبارات الإنشائية والمحسنات البديعية في الكتابة العلمية.
- تجنب الخوض في العموميات والانضباط مع الموضوع.
- توظيف العرائض لعَرْض الأفكار الأساسية بدَل صياغتِها على شكل فقرة.
- قاعــــدة
لا تترك فراغا (مسافة) بين حرف الواو والكلمة الملحوقة به، لأن الحروف عند إلحاقها بالكلمات تصير جزءاً منها. ومثاله:
والله بـالله تـالله، ولا يصح أن تكتب وـ الله / بـ ـ الله / تـ ـ الله.
[i] للتوسع أكثر في تقنية القراءة المائلة يُرجى الاطلاع على المقال الخامس من السلسلة: مشكل الجُمل الطويلة وطُرُق تجنبها.
- رابط المقال: https://bilarabiya.net/2169/