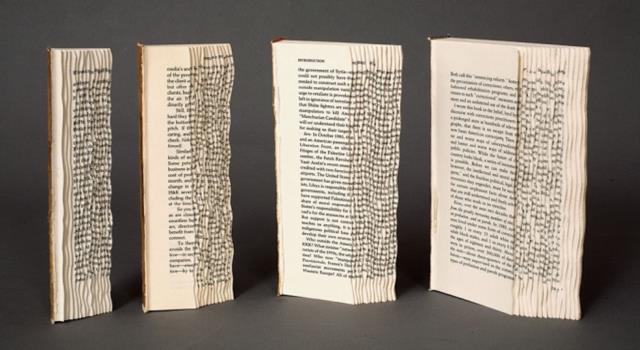
كثيرا ما نَسمع لفظة “بِنْيَة” في البرامج واللقاءات والمحاضرات والندوات باختلاف مجالاتِها المعرفية وتخصصاتِها العلمية والمعرفية، كما يتكررُ استعمال هذه اللفظة في المقالات والأوراق العلمية، وفي المؤلفات والكُتب بشكل عام.
إلا أن كثيرا من الباحثين يستعملون هذا المصطلح دون أن تكون لهم خَلفية معرفية عن أصلِه اللغوي أو عن دلالاتِه المُعجمية والاصطلاحية؛ وبالتالي يتم التراشق بهذا المصطلح المُهَيْمِن (تقريبا) في حَقْل المصطلحية، بشكل عبثِيٍّ، واقحامِه في سياقاتٍ بعيدة كل البعد عن مجال تخصّصِه وعن مواطِن اشتغالِه.
- فماذا نقصد بمصطلح البنية؟
- ما هو مجالُه العلمي والمعرفي الذي ينتمي إليه؟
- ماهي خصائص هذا المصطلح؟
- وما هي أليات اشتغالِه؟
- البنية لغةً واصطلاحا
- البنية في اللغة:
البنية، مِن الفعل الثلاثي بَنَى، أيْ شَيَّدَ، وجاء في لسان العرب لابن منظور، (تـ711هـ) “البِنْيَةُ والبُنْيَة؛ ما بَنَيْتَه وهو البِنَى والبُنَى … البِنيَة الهيأة التي بُنِيَّتْ عليها،… وفلان صحيحُ البُنيَة، أيْ الفِطرة، وأبنَيتَ الرجلَ، أعطيتَه بِنىً وما يَبْتَني به الأرض”[1].
أما في المعاجم الفرنسية[2]؛ فقد تعددتْ دلالات ومرادفات لفظة بِنْيَة، فقد وردتْ باسم النظام (ordre)، التركيب (constitution)، والهيكلة (organisation)، والشكل (forme).
وحسب “جورج مونان” فإن كلمة بنية لا تُغادر معناها الصريح المتمثل في البناء والتشييد، يقول جورج مونان[3] “إن كلمة بنية ليس لها رواسب وأعماق ميتافيزيقية، فهي تدل أساسا على البناء بمعناه العادي“[4].
ففي النحو العربي مثلا، نجد ما يُسمى بـ: ثنائية المعنى والـمَبْنَى، والمبنى هنا؛ نقصد به الطريقة التي تُبنى بها وحدات اللغة العربية، وبالتالي فالزيادة في المبنى زيادةٌ في المعنى كذلك، فكلُّ تحوُّلٍ في البنية يَنتجُ عنه تحولٌ في الدلالة.
البنية إذاً؛ موضوع منظَّمٌ له صورتُه الخاصة ووحدته الذاتية، فالكلمةُ بِنيةٌ في أصلِها، وتتوقف على ما عَداها، وتتحدَّدُ من خلال علاقتِها بغيرها من الكلمات.
- البنية في الاصطلاح:
أطلق اللغويون العرب القدامى لفظة بنية على الهيكل أو الأركان أو الأساسات الثابتة للشيء، ومنه الحديث الشريف (بُني الإسلام على خمس …،/ (الأركان الخمسة للإسلام)). وقد وَظفَ النحاة العرب مُصطلح (البناء) واشتقوا منه مصطلح (المبني[5])، للدلالة على الحروف وبعضِ الأسماء، والتمييز بينَه وبين (المُعرب[6]).
المؤكد؛ أن لفظة “بنية” بهذه الصيغة لم تكن غريبة عن البيئة العربية، وربما كانت شائعة ومتداولة، عكس ما ذهب إليه بعض النقاد الذين ينفون ورود لفظة بنية في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف وفي النصوص العربية القديمة من شعرٍ ونثر.
ففي القرآن الكريم، وردتْ ألفاظ مُشتقة من لفظة بنية، تارة بصيغة الفعل (بَنى)، وتارة بصيغة الاسم (بناء / بُنيان / مَبنى). وأما في النصوص التراثية القديمة، فقد وردتْ لفظة بنية في قصةٍ أوردها ابن المعتز في كتابه (طبقات الشعراء) حول أبي العتاهية؛ عندما جَلَدَهُ الخليفة المهدي بسبب شِعرٍ قالَه في جاريةٍ من جوارِ الخليفة، قال: “….فأحضَرَهُ وضرَبَهُ بالسِّيَاط … وكان ضعيفَ البِنية (البُنية) فغُشيَ عليه…“[7].
وقد قُصد بالنية هنا تكوينَه وبِنْيَتَه الجسمانية، كما وُجد مفهوم البنية في التراث النقدي العربي القديم، ولكن بمعنىً ماديّ، ونستدل بما أورده قُدامى بن جعفر في قوله: “إن بنية الشعر إنما هي في التَّسْجِيع والتَّقْفِيَّة“[8].
لقد شاعت لفظة بنية في مجال الهندسة المعمارية، وهي من المفردات أو المصطلحات الرّحالة المَرِنَة، فقد استُدعيتْ إلى حقول عِلمية ومعرفية وتِقنية مختلفة، خصوصا في الفلسفة الكانطية التي وظفتْ مُصطلح البنية لدراسة مفهوم الفِكر (بنية الفكر).
تــابــع قــراءة المقــال . . .
- البنيوية
لا يمكننا أن الحديث عن “البنية”، دون أن نُعَرِّج على البنيوية، المدرسة التي أنجبتْ هذا المفهوم المشاغب والـمُشاكل والزئبقي، فالبنيوية تَعْتَبِرُ البنية نظاما ذاتيا يتسم بالشمولية والتحول، تحكمه مجموعة من القوانين الداخلية.
يُعرف لنا “لالاند“[9] البنية قائلا: “إنها كل مكون من ظواهر متماسكة، يقوم كل جزء منها على ما سواها“.
أما “إميل بنفنيست[10]” فيُعرف “البنية” باعتبارها: “نظاما تتحدد كل أجزائه بمقتضى رابطة، تجعل من اللغة وحدات منتظمة من العلامات (المنطوقة) التي تتفاعل فيما بينها. والتي يَدُل بعضُها على بعض“.
في المُحصلة؛ تعني لفظة “بنية” مجموع العناصر المترابطة والمتماسكة والمُتَّسقة، المكونة لشكل بنائي ما، والمنظم في علاقة عناصرِهِ بعضِها ببعض، والتي لا تُدرَك إلاَّ جملةً، (فاللبنة لا تدل على البنيان إلا في علاقتها مع باقي اللبنات المشكِّلة له)، ولا يُشترط أن يكون النظام ظاهريا ماديا، وبالتالي؛ فالبنية تشترط الشكل وتشترط حتمية وإمكانية علاقة الأجزاء أو جزئيات البنية بعضِها ببعض.
- البنية في علم اللغة
- تَنَازَعَ مفهومَ البنيةِ تعريفات عديدة ومتنوعة، اتسمت في معظمها بالغموض والانزياح، بسبب الكم الهائل من المفاهيم والعبارات التي تُنتقى بغرض صياغة تعريفات تنوعتْ ألفاظُها واتخذَ معناها اتجاها واحد.
- ظهر مفهوم البنية مع عالِم الأنثروبولوجيا “كلود ليفي شتراوس”، خلال دراسته للمجتمعات الهندية في البرازيل، خصوصا عند محاولته تطبيق بنيوية “سوسير” في دراسته للمجتمعات البدائية، موظفا الأساطير في دراسته، والتي توَصَّلَ مِن خلالِها إلى أن “البنية” عبارةٌ عن “نموذج يقوم الباحث بتكوينه كفرضية للعمل، انطلاقا من الواقع نفسه“[11].
- جاء بعدَهُ “رومان ياكبسون” الذي أحرز قصب السبق في ابتكار مصطلح البنيوية بمفهومه الحديث، وخلفَهُما بعد ذلك “جون بياجيه” الذي اعتبر البنيوية “نسقا من التحولات، له قوانينُه الخاصة به… وهذه البنية تقوم على ثلاث خصائص وهي: الكلية، التحولات، والتنظيم الذاتي“[12].
نَخْلُصُ إلى أن البنية؛ هي مجموعة مُركبة من عناصر مُترابطة ومُنسجمة ومُتداخلة فيما بينها، بحيث لا تكون للعنصر أيةُ قيمة خارج البنية (النصية) التي تُشَكِّلُها العناصر مجتمعة.
كثيرا ما يَنْسُبُ بعض النقاد والباحثين اللسانيين مصطلح البنية لـ”سوسير[13]“، والحقيقة أن سوسير لم يستعمل قط كلمة “بنية” في كتابه “محاضرات في عِلم اللغة العام”، بل كان يستعمل كلمة “نسق”.
وبالتالي؛ فكثير من المفاهيم التي وردت حول مفهوم البنية، يحتمل أنها تدل على “النسق” لا على “البنية“، وكثير من الباحثين لا يفرقون بين البنية والنسق، ويستعملون كِلا المصطلحين كمترادفين يدل أحدُهما على الآخر، أو يُحِلُّون بعضهُما مكان الآخر.
إلى جانب لفظة “نسق” استعمل “سوسير” لفظة “نظام، أيضا؛ “ويقول إميل بنفنست “لقد تم تأكيد مبدأ البنية كموضوع للبحث قبل سنة 1930، على يد مجموعة صغيرة من اللسانيين الذين تطوعوا للوقوف ضد التصور التاريخي الصرف للسان، وضدَّ لسانياتٍ كانت تُفكك اللسان إلى عناصر معزولة، وتنشغل بتتبع التغيرات الطارئة عليه….
ويَجمُل بنا أن نشير إلى أن سوسير لم يستعمل أبدا وبأي معنى من المعاني كلمة بنية، إذ المفهوم الجوهري في نظره هو مفهوم النسق“[14].
تــابع قراءة المقــال . . .
- خصائص البنية:
وضع الفرنسي “جان بياجيه[15] للبنية ثلاث خصائص لا بد أن تتسم بها وهي:
- الكُلية: تتكون البنية من عناصر داخلية خاضعة لقوانين النسق.
- التَّحول: وهو سلسلة من التغيرات الباطنة تحدث داخل النسق، على اعتبار أن البنية لا يمكن أن تظل في حالة ثبات أو استقرار أو جمود دائم. إنها دائمة التحول، ومن هذا المنطلق اعتبرتْ البنيوية أن كلَّ نص يحتوي ضمنيا على نشاط داخلي، هذا النشاط يتم من خلال تفاعل العناصر ذاتيا؛ ومع بعضها البعض. ومن هذا المنطلق أيضا اعتبر البنيويون النص الأدبي نصا تحوليا تتناسل أفكارُه وعناصر بشكل دائم ومستمر. (أقرب الى الفكرة التي تقوم عليها التفكيكية).
- التنظيم الذاتي: تُنظم البنية نفسها لتحفظ لها وحدتِها، وتساهم في طول بقائها، إنها عملية مستمرة تمكن البنية من الاستقلالية الذاتية، وتنظيم البنيات حولها، وتنظيم نفسها بنفسها وفي نفس الوقت تنتظم مع باقي البنى وتتفاعل معها دون أن تفقد خصوصيتها، ودن أن تنزاح خارج حدودها المجالية.
“البنية نَسَقٌ من العلاقات له نظامُه الخاص”[16]
يمكن أن نـُجمِل خصائص البنية في هذا المثال التوضيحي:
نَعتبرُ أساتذة الجامعة بنية، هذه البنية تسمح بتنوع الأفراد داخل فضاء الجامعة مِن ذكورٍ وإناث، مقيمين أو وافدين، مُتزوجين أو عُزّابا …، كل هذه الفوارق لا تأخذها البنية بعين الاعتبار، إن ما تُعنى به البنية، هي السمة التي تربط بين هؤلاء الأشخاص؛ وهي وظيفة “الأُستاذية”، والإطار الذي يجمعهم هو “مؤسسة الجامعة”.
وبالتالي، فهذه البنية الكبيرة تحتوي في داخلها على بنيات صغيرة ومتوسطة عديدة جدا، فالأساتذة يتوزعون بحسب تخصص كل واحد (عربية – فرنسية – فلسفة – رياضيات – …)، وكل أستاذ له قسمُه الخاص ومنهجه الخاص وبرنامجه الزمني الخاص به، وأسلوب تدريسه الخاص.
لكن كل هذه البنى تتلاقى في المحددات العامة، (سلطة الإدارة – القانون الداخلي- العقد الوظيفي – القسم – الطلبة …) كما أن فضاء الجامعة يشمل إلى جانب الأساتذة والطلبة، موظفي الإدارة والحُرَّاس وعُمَّال النظافة …،
ولكن تظل كل بنية مستقلة بذاتها ومحافظة على خصوصيتها، إذا مهما تدخلتْ وتداخلتْ البنى الأخرى، يستحيل أن يصير أستاذ الجغرافية أستاذا للفلسفة، أو الحارس أستاذا للفيزياء أو عامل النظافة مديرا أو عميدا…،
فالبنية تنظم نفسها ذاتيا وآليا، بواسطة القوانين التي تحكم البنية الكبرى ككل. كما يستحيل دخول عنصر خارجي للبنية، إذا كان من بنية خارجية مختلفة، (رجل الأمن لا يمكن أن يحل مكان الأستاذ) مثلا. وكل هذه البُنى تمثل نسقا كليا هو “الجامعة“.
هناك خصائص أخرى للبنية كالاعتباطية والازدواجية، والتمايز، والانتاجية …
[1] ابن منطور، لسان العرب، جذر بنى، جزء 15، ص93-94.
[2] La rousse / Le robert.
[3] لساني فرنسي معاصر, وهو مؤلف عدد من الكتب, من بينها: (مفاتيح للسانيات 1968) و(مدخل إلى السيميولوجيا 1870) و(التواصل الشعري 1969) و(المشاكل النظرية للترجمة) (غاليمار 1963) و(تاريخ اللسانيات منذ الأصول إلى القرن العشرين 1974).
[4] جورج مونان، مدخل الى الألسنة، ترجمة الطيب البكوش، منشورات سعيدان 1994، ص 80.
[5] المبني: هو الذي لا تتغير حركة آخره مع تغير موقعه من الإعراب.
[6] المُعرب: هو الذي تتغير حركة آخره مع تغير موقعه من الإعراب.
[7] عبد الله بن محمد بن المعتز العباسي، طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستّار أحد فراج، الطبعة الثالثة، دار المعارف – القاهرة، ص 230.
[8] قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى 1963م، ص 90.
[9] أندريه لالاند، فيلسوف فرنسي، حاصل على شهادة دكتوراه في الأدب، اشتغل أستاذا مساعدا في قسم الفلسفة بالسربون، ألفَ المعجم الفلسفي المشهور بمعجم لالاند.
[10] لساني فرنسي (1902 ـ 1976).
[11] محمد عزّام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طبعة 2003، ص 14.
[12] محمد عزّام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طبعة 2003، ص 20.
[13] عالم لغويات سويسري يعتبر الأب الروحي والمؤسس لمدرسة البنيوية في اللسانيات في القرن العشرين.
[14] إميل بنفنست، البنية في اللسانيات، تعريب: حنون مبارك، مجلة دراسات أدبية ولسانية، المغرب 2/ 1986، ص 131.
[15] عالم نفس وفيلسوف سويسري، طور نظرية التطور المعرفي عند الأطفال فيما يعرف الآن بعلم المعرفة الوراثية، أنشأ بياجيه في عام 1965م مركز نظرية المعرفة الوراثية في جنيف، وترأسه حتى وفاته في عام 1980. يعتبر بياجيه رائد المدرسة البنائية في علم النفس.
[16] محمد عزّام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طبعة 2003، ص 14.
- مراجع الدراسة:
- ابن منطور، لسان العرب، جذر بنى، جزء 15.
- إميل بنفنست، البنية في اللسانيات، تعريب: حنون مبارك، مجلة دراسات أدبية ولسانية، المغرب 2/ 1986.
- [1] جورج مونان، مدخل الى الألسنة، ترجمة الطيب البكوش، منشورات سعيدان 1994.
- قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى 1963م.
- عبد الله بن محمد بن المعتز العباسي، طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستّار أحد فراج، الطبعة الثالثة، دار المعارف – القاهرة.
- محمد عزّام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طبعة 2003.
- La rousse / Le robert.