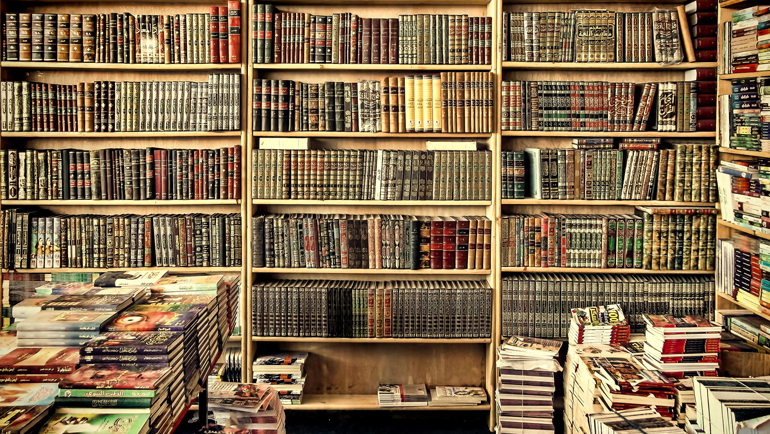
لا تزال المصطلحات المستعملة في حقل السرديات؛ محط خلاف وتباين بين مستعمليها (النُّقاد) عموما، والمشتغلين بها على وجه الخصوص (السرديون). ترتب عنه فوضى في الترجمة والتعريب والتوليد والنحت، وإشكالا في الحمولة المفهومية لهذه المصطلحات السردية. وما زاد الأمر تعقيدا؛ عدمُ وجود تواطؤ واتفاق مشرقيٍّ مغربي حول هذه المصطلحات، والمقصودِ منها في الاستعمال.
يظهر هذا الاختلاف بجلاء في الأطاريح والرسائل الجامعية في مجال السيميائيات ولسانيات النص وتحليل الخطاب، حيث تطفو فوضى التعددية المصطلحية والاشتراك المفهومي في توظيفات خاطئة وتنويعات لا مُنسجمة، مرة بمرادفاتِها ومرات بأضدادِها، ومردُّ ذلك إلى كثرة المُشتغلين بهذه المصطلحات في قطيعة وانعزال تام فيما بينهم.
وكذلك؛ إلى عدم وجود نموذج مرجعي عربي موحد ترعاهُ مؤسسة أو هيئة متخصصة، يُغني الباحث عن التوهان والضياع بين عشرات المراجع المتناقضة، أو الاصطدام مع إيديولوجيا ونرجسية وذاتية بعض الأساتذة المُشرفين الطامحين بجموح إلى إلغاء الطرح الآخر والانتصار عليه.
تستمر هذه الحالة من التخبط والفردانية، ويستمرُ معها مُراكمة الخلل وتكريسه أكثر فأكثر، مع كل أطروحة أو رسالة جامعية تُطبع وتلقى في المكتبات لتكتسي مع الوقت صفة “مرجع”، دون أن تكون هي الأولى قد أُسِّسَت على مرجع حقيقي أو بُنيت على مرجعية.
إن الحاجة لإحلال روح الجماعة ونبذ الفردانية والنرجسية في كل المباحث والتخصصات المتداخلة العلمية أو التي لها القابلية لأن تستقل علوما بذاتِها، يُحتم على المشتغلين بالنقد والمشتغلين بالسرد تحديدا؛ أن ينمازوا أو يتكاملوا،
فإذا كان سعيد يقطين يرى أن السرديات من اختصاص السردي وليس الناقد، فوجب حسْمُ هذا الطرح؛ إما بتولي السردي كل المهام من الترجمة إلى التحليل، أو خلق تراتبياتٍ في التخصص يُكمل بعضُها بعضا، وهذا لن يتأتّ طبعا؛ إلا في إطار عمل مؤسساتي جامع، أو على الأقل عمل جماعي ترعاهُ مؤسسة.
إن المِبْضَعَ الذي يُجري به الطبيب عملياته الجراحية لم يُصنع بمعزل عن الطبيب، وإنما تم تطويرُه وتحسينُه باستمرار وفق ملاحظات وتوجيهات مُستعمليه من الأطباء والجراحين، وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر بين المُتصدِّين للترجمة المتخصصة، والمشتغلين بهذه المفاهيم التي يتم ترجمتُها، لا أن يُترجِم المُترجم ويكون على المُشتغل بالتحليل إيجاد وظيفة ومفهوما مناسبا لكل مصطلح لقيط؛ خرج من رحمة الترجمة الهاوية.
فلم تعد البلاغة مُلهمة ولا مُسعفة في إمداد الناقد والدارس بما يحتاجه من مصطلحات ومفاهيم للتحليل، في المقابل أغنت باقي العلوم (الإنسانية والتجريبية) معاً؛ سوق الدارسين والمحللين والنقاد بهذه المصطلحات إلى حد التخمة والشّبع، ونخص بالذكر هنا؛ الإسهامات الكبيرة لمباحث الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الطبيعية،،، فتم تجاوز خلل النقص.
لكن في المقابل تم خلق مشكل الاختلاف والاختلاط والتداخل، ولأن هذه المصطلحات كانت في وقت من الأوقات ولا زالت موضة للتباهي وإعلان التمكن والتفوق، فبدل مصطلح لكل مفهوم تم اعتماد عشرة، وفي وقت وجيز اختلط الأمر على الطالب والباحث والناقد والسارد،
وزاد من الأمر سوءا؛ تشبث كل ذي رأي برأيه، وبدل تصويب هذا المشكل وإيقاف نزيف هذه المصطلحات، وتفكيك هذه الشبكة الضخمة والمعقدة من المفاهيم والمصطلحات الآتية من علوم ومعارف شتى؛ وإعادة موْضعتِها تخصُّصا، تركيبا، مفهوما واستعمالا.
خُلق جدال هامشيٌّ جديد بعيد عن القضية المركزية؛ وهو التأليف في إثبات وجهة النظر، وتفرغ كل ناقد لتبرير اختياراتِه من المصطلحات وتخطيئ الاختيارات الأخرى.
وللأسف؛ لم ينتج عن هذا الحوار المعرفي مدارس ولا مذاهب، وإنما خلقَ تكتلات وجُزرا متباعدة ومنطوية على خياراتِها صحيحةً كانت أو خاطئة. وظل السؤال المهم والجوهري من كل هذا السجال غائبا أو مغيبا، وهو؛ ما الحاجة من هذه المصطلحات ؟
معاجم متخصصة حول المصطلحية:
- قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، رشيد بن مالك، دار الحكمة، طبعة 2000.
- معجم اللِّسانيِّات، إشراف جورج مونان، ترجمة جمال الحضري، المكتبة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 2012.
- جيرالد برنس، المصطلح السردي (معجم المصطلحات)، ترجمة عابد خزندار، مراجعة وتقديم محمد بريري، المجلس الأعلى للثقافة الطبعة الأولى 2003.
قائمة مختارة من الرسائل والدراسات المحكمة المتاحة على غوغل سكولار حول المصطلحية السردية، اللسانية والسيميائية:
- بن مالك. إشكالية ترجمة المصطلح اللساني و السيميائي من الفرنسية إلى العربية معجم” المجيب” لأحمد العايد أنموذجا (Doctoral dissertation).
- عبد الجليل لغرام. (2018). تحليل الخطاب من اللسانيات إلى السيميائيات. مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 11(01).
- سعدي. (2022). المصطلح السردي في معجم السرديات لمحمد القاضي-مقاربة مصطلحية (Doctoral dissertation, Université de Bouira).
- قرفة, & زينة. (2015). المعجم المختص دراسة في المادة و المنهج المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات (Doctoral dissertation).
- سعد السعود. واقع ترجمة المعاجم اللسانية في الدرس اللساني العربي دراسة في معجم المصطلحات المفاتيح في اللسانيات لماري نوال غاري بريور (Doctoral dissertation, Université Médéa-Yahia Farès).
- مرسي فاطمة. (2014). ترجمة معجم تحليل الخطاب لباتريك شارودو دومينيك مانغينو–دراسة في المصطلحات و التعريفات (Doctoral dissertation, جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف, قسم الأدب العربي.
- عبد الجليل لغرام. (2018). تحليل الخطاب من اللسانيات إلى السيميائيات. مجلة الواحات للبحوث والدراسات.11(01).
- عبد الجليل مرتاض. (2012). مقاربات مبدئية في اللسانيات. الممارسات اللغوية, (11), 81-98.
- عبد الرحيم الرحموني، مقال” من قضايا ترجمة المصطلح الأدبي” ضمن الجزء الثاني من كتاب قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية، من إعداد عزالدين البوشيخي ومحمد الوادي. سلسلة الندوات 12، 2000.
- لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار الطبعة الأولى، بيروت- لبنان 2002.
- داود ياسمين. (2016). إشكالية تعدد ترجمات المصطلح اللساني من الفرنسية إلى العربية (Doctoral dissertation) جامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر 2.
- تومان غازي الخفاجي خالد كاظم حميدي. (2016). السيميائية ومشكلات المفهوم والموضوع والترجمة. حوليات المخبر(06).
- علي حسن الدلفي. (2012). مَنَاهِجُ البحْثِ الُّلغَويّ الحَدِيثِ وَأثَرُهَا في تَطَوّرِ الحَرَكَةِ المُعْجَمِيَّة دِرَاسَة تَطْبِيقِيّة. لارك, 1(9), 115-161.
- داود, بوغمبوز, & الأزهر (مدير البحث). (2016). إشكالية تعدد ترجمات المصطلح اللساني من الفرنسية إلى العربية [مصدر نصي غير مخطوط]: دراسة تحليلية تقويمية لترجمتيْ كتاب Georges Mounin الموسوم بـ” Linguistique et traduction” (Doctoral dissertation, Algiers 2 University Abou El kacem Saad Allah جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله.
- تونسي, & عادل. (2017). إشكالية المصطلح النقدي عند عبد السلام المسدي من خلال كتابه الأسلوبية والأسلوب (Doctoral dissertation).