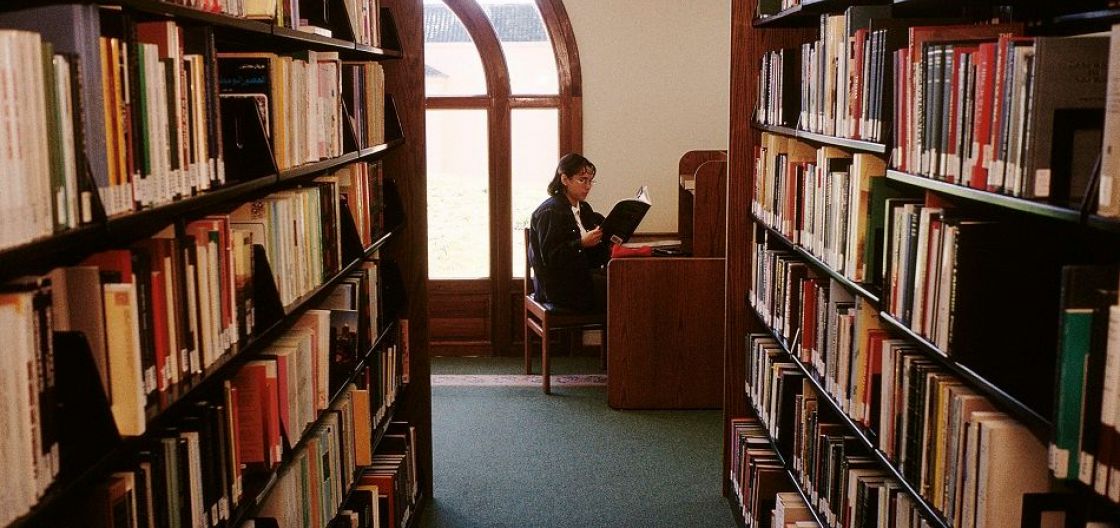
يَضطرّ الصحفيّون والمُحرِّرون في الصحف والمجلاّت؛ والباحثون في الدوريات العلمية؛ والتلاميذ والطلبة في الواجبات المنزلية والعروض والامتحانات؛ إلى إنجازِ مقالاتٍ وبحوثٍ خاصة بِطَلَبٍ مِن إدارة التحرير أو اللجنة العِلمية أو الأستاذِ أو المُشرف، فيَتِمُّ مُباشرةُ الإنجاز وِفْقَ النَّمط أو المنهجية أو الطريقة التي اعتادَ الصحفيّ أو الباحثُ الكتابَة بها.
إلاَّ أن المقالات والأبحاث التي تُكتَبُ تحت الطَّلب؛ تَخْضَعُ لِمنهجيّة مُحدَّدَة؛ دقيقةٍ وصارمة، يجب على الكاتب التَّقَيُّدَ بها؛ حتى يَتَمكَّنَ مِن إنجاز مقالٍ جامِعٍ مانِعٍ يُجَسِّدُ موضوعَه بدقَّة كبيرة، ويَستوفي كلَّ عناصرِه الأساسية وَوَحداتِه العضوية.
تَتَطَلَّبُ كتابةُ مقالٍ أو بحثٍ تَحْتَ الطَّلَبِ؛ تِقنياتٍ منهجية مضبوطة؛ وأدواتٍ إجرائية خاصة نُجمِلُها في الآتي:
- حَصْرُ الموضوعِ وتَحدِيدُ حُدودِه.
مُعظم الموادّ المطلوبِ إنجازُها (تحت الطلب) تكون عناوينُها فضفاضة جدا؛ وغيرَ مُؤطَّرَة؛ وغيرَ مُحدَّدة، ويستدعي هذا من الكاتب أو المكلَّف بإنجاز العمَل؛ تكثيفَ وحصرَ موضوع المقال أو البحث إلى حدودِه القصوى.
- مثال:
يُوحي مُدير التحرير إلى صحفيٍّ عِلمي؛ إنجازَ مقالٍ مُفصَّل عن التلوث، هذا الموضوع عامٌّ وفضفاض ومتشعِّب، مما يستوجب من هذا الصحفي العِلْمِيّ؛ حَصْرَ موضوعِه وتحديدَ حُدُودِه ليتسنى له الاشتغالَ عليه. فموضوع التلوث بمفهومِه العام والفضفاض؛ يَشْمَلُ العناصر التالية:
بعدَ حَصْرِ الموضوع في جُزئِهِ المطلوب، يجب تحديد النِّطاق، وذلك استكمالا للعناصر المطلوبِ الاشتغال عليها؛ فبعد أن حدَّدنا نوعَ التلوث المستهدَف في البحث، بقي معرفة ميدانِ أو فضاءِ أو حقلِ الدراسة.
إنَّ حَصْر النِّطاق والتَّقيد به؛ من أهم عوامِل نجاح المقال؛ ومن سِمات الصّحفي العِلمي الناجح والمتمكّن أيضا.
يُوفِّر حَصْرُ حقلِ الدّراسة الكثيرَ مِن الجُهد والوقت والتركيز؛ وينعكسُ إيجاباً على المَردودية العِلمية لِلعَمَل.
جرد لِبعض حقول الدراسة المرتبطة بموضوع (المثال) التلوث:
بعد الفضاء أو النطاق المكاني؛ يمكن إدراج الفضاء الزمانيّ إذا اقتضى الأمر ذلك. خصوصا في بعض المواضيع العِلمية أو الإحصائية أو الاستقصائية.
- صياغةُ عنوانٍ للمقال أو البحث المُرادُ إنجازه.
تتم صياغة عنوانٍ مُتوافقٍ مع ما تم انتقاؤه في عَمَلِيَّة حَصر الموضوع وتحديد نِطاقِه (نشير إلى أننا نقصد بالنِّطاق هنا؛ الـحَيِّزَ الذي يتحرّك فيه الموضوع، والذي لا يُسمَح للباحث بتجاوزِه).
والحرص على تضمين العنوان الوحدات الكبرى للموضوع. فكلما كانت عملية حصر الموضوع مضبوطة؛ كُلَّما كانت جودة المقال عالية، والعكس صحيح.
يمكن أن نُعطي نموذجا تقريبا من المثال الذي نشتغل عليه (التلوث)؛ ونصوغَ هذا العنوان للتوضيح:
ــ التلوث الإشعاعي في مدينة فوكوياما سنة 2011م ــ
نلاحظ أن هذا العنوان؛ يتضمن الوحدات الأساسية المطلوبة لِبناء مقالٍ دقيقٍ محدّدِ الأهداف ومتخصصٍ، وِفق منهجية الحَصْر والتّحديد.
يلتزمُ الباحث بتوظيفِ وحداتِ العنوان كمُحدِّداتٍ للبحث، ويتقيد بها ولا يتعداها.
- تفكيك العنوان إلى وحداتِه الدلاليـــة:
بخلاف عناوينِ الكتابات الأدبية؛ فإن عناوينَ المقالات والبحوث العِلمية؛ يجب أن تكون صريحة؛ موَّجَّهةً ومباشِرةً، وتعكِسُ الموضوع وتُحيلُ عليه.
- حضورُ عُنصرِ الجِدَّة في الموضوع:
ليس كلُّ المواضيع التي تُقترَح تكونُ صالحةً للإنجاز، لسببٍ بسيطٍ؛ كونُها مستهلَكَة وتم الاشتغال عليها والكتابة حولَها مرارا وتكرارا، وإذا كنتَ تُفكِّر في تكرار نفس العَمَليّة؛ وإعادة تدوير المقالات والبحوث السابقة لاستخراج بحثٍ أو مقالٍ مختلِف من حيث الصياغة، ومشابه في المضمون، فأنتَ ناسخٌ أو ناقلٌ أو وسيطٌ؛ ولستَ باحثا أكاديميا ولا صحفيا عِلميا.
الباحث أو الصحفي العلمي الحقيقيّ؛ هو ذاك الذي يملك حِسًّا عِلميا يستطيع به تـَحْيِينَ المواضيع القديمِة وتدعيمِها وتغذيتِه بالجديد والآنيِّ والراهن، لتصيرَ مادة علمية أخرى، تُعطي قيمة مضافة لما تم إنجازُه من قبْل، وليسَ مجرَّدَ صورةٍ طِبْقَ الأصل للمستَهلَك.
- تقديرُ الوقت اللاّزم لإنجاز العمل:
مِن الممارساتِ الخاطئة والشائعة عند الكُتَّاب؛ مُباشَرَةُ الكتابة منذ لحظة استلام عنوان الموضوع، وهذا خطأ منهجي، إذ لا بد للكاتب أن يأخذَ وقتَهُ الكافي في البحث والتنقيب والتحرِّي في الموضوع، والتعرُّفَ على مُعظم ما تم انجازُه في ذلك الباب، ليُكوِّنَ فكرةً عمَّا يُمْكن أن يقوم به، أو عمَّا يستطيع أن يُضيفه في المبحث الذي هو بصددِه.
من سِماتِ الكاتب الجيد؛ والصحفيِّ العِلمي الناجح:
- القدرةُ على تقدير حَجْم الجهد الذي يَتَطَلَّبُه إنجاز العمل.
- المطالبة بالوقت الكافي لإتمام العمل.
- عدَمُ التورُّطِ في قبول إنجازِ بحوثٍ مُستعجَلةٍ؛ يتطلَّبُ إنجازُها الفعليُّ أيَّاماً أو أسابيعا.
- أنتَ لا تَكتُبُ فقط لرئيسِك أو مديرِك في العمل أو أستاذِك. إنكَ تَكتُب لجمهورٍ عريضٍ من القُرَّاء؛ لذلك وجب أنْ تأخذَ هذا الأمرَ في الاعتبار. وأن تُقدم منتوجا جيدا ومفيدا ينتَفِعُ به الناس؛ وتكسِبَ به سمعةً عِلميّةً، وتصنَعَ به اسمكَ في لائحة الكُتَّابِ الكبار الـمُتفرِّدين والمتميزين.
- لا تعتبر المقالات التي تطلبُها منكَ الجهة التي تعمَل عندها عبءً ثقيلا يجبُ التخلص منه بأي ثمن. هذا الاعتقاد سيؤثر على مردودِك سَلْباً؛ وقد يُعرِّضُك للمساءَلة أو الطَّرد، كن مسؤولا وجوِّد عمَلَك.
- اذا استطعتَ استغفالَ مُديرِك أو أستاذِك أو الجهة التي كلَّفَتْكَ بإنجازِ المقال، فإنك لا تستطيع استغفال القارئ. افترض دائما أنك تَكتب لقارئٍ أفضلَ وأعلمَ وأقْدَرَ مِنكَ على كَشْفِ أخطائِك وهفواتِك وحِيَّلِك. عِندَها؛ ستجدُ نفسَكَ تكتُبُ بطريقة أحسن.
- إذا طلب منك رئيسكَ أو أستاذُكَ، أو جهةً عِلمية أو أكاديمية ما؛ إنجازَ بحثٍ أو مقالٍ في موضوع معين، يتعين عليك بدايةً؛ تحديدَ حدودِه، وصياغة عنوانٍ له.
- اعتماد الخطاطة:
الخطاطة من أبرز تجليات البحوث الناجحة، وأحد أهم تقنيات البحث الحديثة، إذ تُغني الكاتب والقارئ على حدٍّ سواء عن جهدِ قراءَة صفحاتٍ كثيرةٍ، وتَعَقُّب الفقرات والجمل لتحصيل الأفكار والمعطيات والنتائج. فالخطاطة الجيدة يمكن أن تُلخص للقارئ فصلاً كاملا في بِضعة رسوم تشجيرية أو أشكال توضيحية.
التَّمَرنُ على استعمال وتوظيف الخطاطات؛ يساعد على تبسيط الأفكار وتقريب المعلومات وتيسير الفهم.
- تفعيل عملية التواصل بين الكاتب والجهة التي طلبتْ المقال/البحث.
يأتي الإخفاق الأكبر والفَشل الذريع في المقالات والبحوث التي تُنجز تحت الطلب؛ من غياب التواصل بين الجهة التي طلبتْ المادة البحثية؛ والجهة التي تَكَفَّلَتْ بالإنجاز.
إذ يؤدي انقطاع التواصل بين الجهتيْن؛ إلى عدم مواكبة ظروف سير العمل، وتأخذ العمل اتجاها ومَنْحىً واحداً؛ هو رؤية الكاتب وتصوُّرُه للموضوع. في غيابٍ تامٍ لرؤية وتصور الجهة التي طلبتْ العمل.
في هذه الحالة غالبا ما تحدث مشاكلُ عدة عند الانتهاء من العمل وتقديمِه للجهة المعنية. كأن يتم المطالبة بإعادة البحث، أو تعديل جزء منه. فعدم التواصل هذا؛ يؤدي إلى ضياع الجهد والوقت؛ وتدني جودة العمل وربما إلى رفضه العمل جُملةً.
- حضورُ لمسة الكاتب فيما يُنجِز من مقالات وبحوث:
لابد أن يحاورَ ويُسائل الكاتبُ المعطياتِ والمعلومات التي ضمَّنَها في بحثه أو مقالِه، وأن يبدي ملاحظات واستنتاجات، ويعرض النتائج التي توصل إليها حتى لا يظهر الكاتب بصورة الناقل أو الجامع للمعلومات فقط.
لابد أن تسود روح الكاتب المقال، ويبصم عليه بأسلوبه ويُغذيه بطرحِه وملاحظاتِه، وينفتِح به على أسئلة وإشكاليات جديدة يُمكن أن تكون نواة لمقال أو بحث جديد وماتِع.
- للتوسع أكثر في موضوع صياغة العنوان وفق الشروط والضوابط المنهجية، نُحيلُكم على هذا المقال:
صِياغةُ العُنوان وِِفْقَ الشّروطِ والضّوابطِ المَنهجيّة