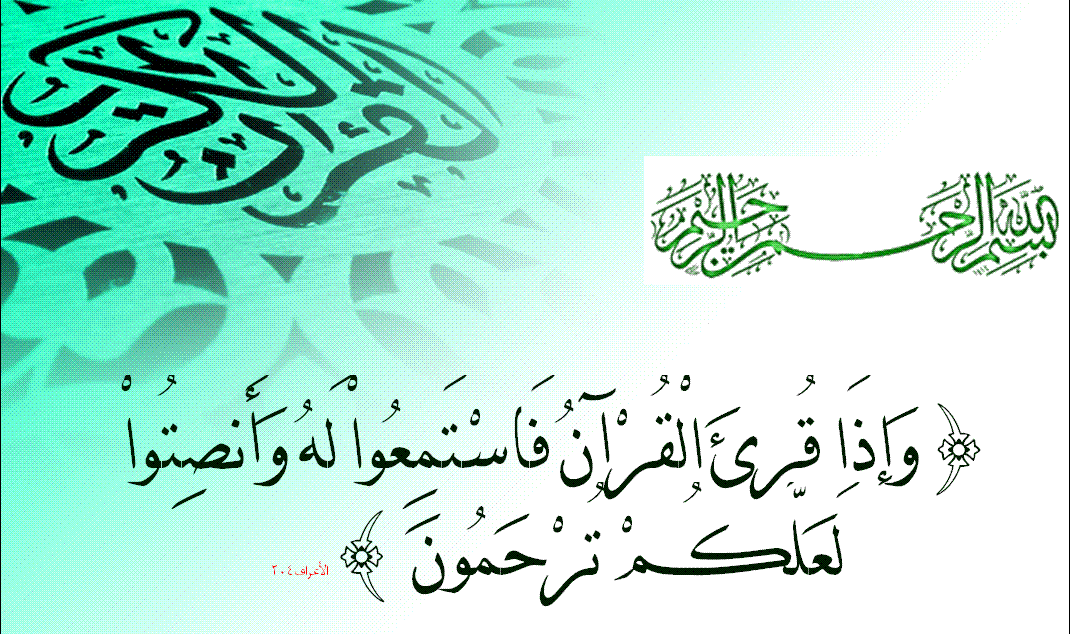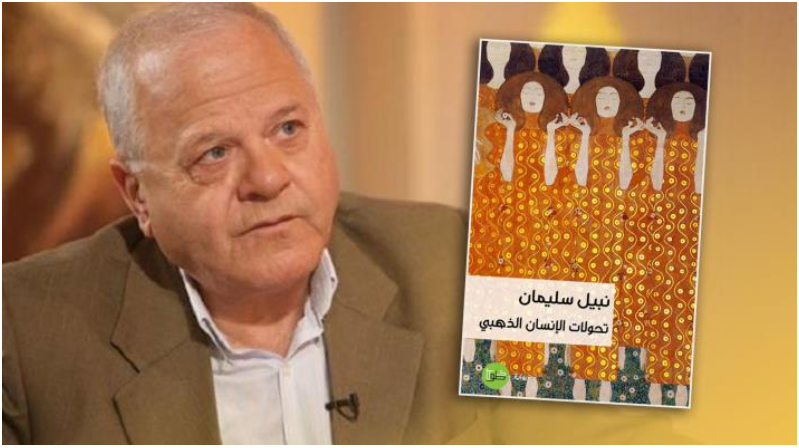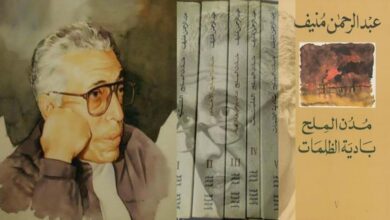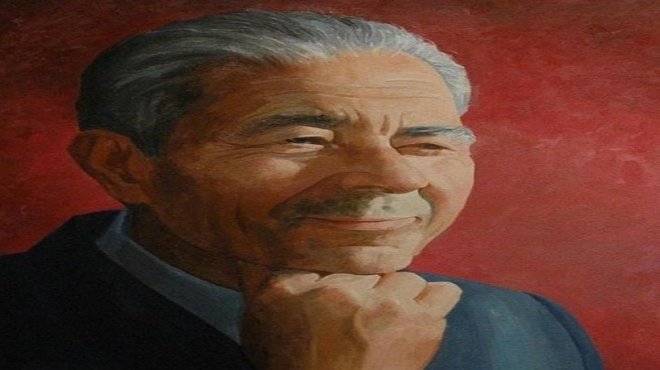المعنى ميزة الإنسان وحده، فهو على خلاف غيره من الكائنات الأخرى، لا يستمد وجوده من حاضن طبيعي أخرس، بل يودعه في ما أضافته الثقافة إلى ممكنات الغرائز والبرمجة الطبيعية داخله.
لذلك يمتاز بكونه كائنا رمزيا وضع حياته كلها في اللغة وفي كل الأنساق الدالة التي تستوطن الذاكرة التجريدية في انفصال كلي عن النسخ التي تأتي من الطبيعة وتضمحل داخلها. وبذلك كان موطن الإنسان في” الوجود” لا “داخله” (هايدغر)، بما يعني التخلص من “ظاهر مادي” والاحتماء بما يشكل الأبعاد الرمزية فيه.
فهو منفتح على العالم، ولكنه لا يمكن أن يوجد إلا من خلال قدرته على استيعاب ممكنات هذا العالم ضمن محددات دلالية هي شرط أنسنته وشرط انفصاله عما يوجد خارجه؛ وبهذا الشرط وحده أصبح الإنسان واقعة في التاريخ، لا حدثا عرضيا في الطبيعة.
وهو ما يعني ألا ” وجود لعالم إنساني” إلا إذا كان قادرا على التدليل (كريماص)، فلكي يستقيم وجود الكون في الذاكرة عليه أن يقتات من “المعنى“، فداخل هذا المعنى فقط يستطيع الإنسان تنظيم جنسه ونسله وأقاربه وحياته وموته، ومن خلاله يحكم ويصنف ويرفض ويقبل أيضا.
إنه من خلال ذلك كله يخرج من ذاته، لكي ينصهر داخل فضاء موضوعي هو السبيل إلى تعميم الذاكرات الفردية، ومن خلال هذه الموضوعية يستطيع أيضا الإمساك بالزمن “مُشْبَعا” بانفعالات شتى ويسقطه على أمام فيه الأمل والترجي، وعلى خلف فيه الحنين أو الندم، ويحتفي بلحظات الحاضر في حياته. وبذلك عُدت الدلالة، ضمن محددات الشرط الإنساني، “حركة جدلية تفك التناقض بين الإنسان الطبيعي والإنسان الثقافي” (بارث).
والحاصل من هذا أن بؤرة ” الدلالة” في عوالم الإنسان موجودة في العُرف والاستعمال والتواضع، لا في مضمون العلامة ذاتها، فهاته ليست سوى ممر لا يمكن أن يصبح سالكا إلا باستحضار سقف ثقافي/رمزي هو أصل الدلالات فيها والضامن لتداولها وإشاعتها بين الناس. وهي صيغة أخرى للقول إن معنى العلامة ليس في جوهرها المفترض، بل مستمد من النسق الذي يحتضنها.
فنحن نبني السياقات ونحتمي بالمقامات لكي نُصَرِّف ما تراكم عندنا من مواقف وانفعالات وأفكار لا سبيل لها إلى الوجود خارج اللغة بممكناتها في الصوت والنحو والدلالة. وتلك خاصية من خاصيات المعاني، إنها منتشرة في كل “الوقائع”، فهي في اللغة والصورة والطقوس الاجتماعية وهي في اللباس وطريقة استقبال الضيف أيضا.
وتلك خاصية من خاصيات الإنسان أيضا، كل ما يلمسه يتحول إلى علامات، ذلك أن “وجود الإنسانية رهين بوجود تجارة للعلامات ” ( إيكو)، أي تعميم للمعاني.
فهل المعنى، حسب هذا التصور، موجود في قلوبنا أم محايث للأشياء، أم هو، على العكس من ذلك، مودع في “عرف” اجتماعي هو ذاته ما يشكل جوهر وجودنا على الأرض باعتبارنا كائنات ” تُتاجر” في الرموز وتتداول أفكارها وانفعالاتها من خلالها؟ نحن في جميع هذه الحالات منتجات لغة لا شيء يمكن أن يستقيم خارج حدودها بما فيها كينونتنا.
فلا وجود في واقع الأمر للمعنى إلا من خلال سلسلة من العلاقات فيها التقابل والتناقض والتشابه أو التطابق، كما بشر بذلك سوسير وأتباعه، وفصل القول فيه السميائيون بعده، والهرموسيون قبلهم.
إن الدلالة، على هذا الأساس، هي المصفاة التي يتسرب من خلالها الإدراك الحسي إلى الذهن لكي يستوطن المفاهيم المجردة. لذلك كان المعنى بداهة في حياة الإنسان لا توازيها سوى بداهة الرمزية التي تتحكم في طريقة تصريف سلوكه خارج الواجهة البرانية فيه.
وهو ما يعني أن دراسة المعنى اللساني لا تتم على مستوى العلاقات التعيينية القائمة بين الكلمة والشيء، كما يعتقد في ذلك العامة من الناس، بل تتحقق على مستوى العلاقات التي تجمع بين الكلمات باعتبارها حدودا داخل نسق مغلق هو ما يشكل اللسان، أرقى الأشكال الرمزية وأكثرها قدرة على التعبير عن كينونة الإنسان.
وبذلك لن يكون اللسان مدونة، ولن يكون ظلا لأشياء تسميها كلماته، إنه نسق من العلامات وظيفته الأساس هي إعادة بناء العالم ضمن حدود المجرد في الوجود.
لذلك لم يكتف الإنسان بتسمية الأشياء والفصل بينها ضمن ما يستجيب لرغبة في بقاء لا امتداد له خارج محددات العيش الحافي، بل بحث فيها عما يشكل المتعة داخله. وتلك كانت بوابته نحو خلق الاستعارات والمجازات، وتصور عالم الأشياء من خلال حالات الترادف والتضاد وكل أشكال الترابطات الممكنة بين التسميات وحالات التفييء التي تمكننا من خلق “حقول” دلالية تترابط داخلها كلمات تجمع بينها قرابة دلالية تفصل بين الحاض والـمُحتَضن.
وبذلك يكون الإنسان قد بلور استعمالات جديدة لوحدات كانت موجهة في الأصل لالتقاط “الحاجات” النفعية وحدها. وقد تكون حالات الترادف من أهم القضايا التي وقف عندها الباحثون في علم الدلالات. ذلك أن هذه الصيغة التعبيرية هي شكل من أشكال تجلي التعدد المعنوي الذي يتجاوز الإحالة المرجعية ليصوغ ما يمكن أن يُنوع من حضور الإنسان في الوجود ويُغنيه.
وتلك بعض القضايا التي حاول هذا الكتاب الإجابة عنها. ذلك أن علم الدلالة هو في الأصل حالة من حالات تأمل النشاط الإنساني من خلال “شاشة” مفهومية تمكننا من معرفة أنفسنا ومعرفة طريقتنا في تنويع أشكال وجودنا في الكون.
إن اللغة فيه تتأمل ذاتها من خلال حدود “مصنوعة” ومفصولة عن النشاط التعييني داخلها، فلا مرجع للمصطلحات سوى الإطار المعرفي، أو جهة النظر التي تتحكم في التحليل وتوجهه. إنها كلمات نتحدث من خلالها عن مثيلاتها، خارج العرف التعييني، إنه جهاز موجه إلى إنتاج معرفة تخص وجود اللغة في التداول العلمي والاشتغال، وطرق تداولها في شأن العالم الذي تقوم بتسميته.
ويُعد علم الدلالة ثانيا، فيما هو أبعد من رصد الدلالات في الكلمات والجمل أو الملفوظات والوقائع التي ينتجها الجسد من خلال سجله الإيمائي، محاولة لفهم موطن الإنسان في الوجود من خلال طريقته في إنتاج معانيه والتنويع فيها.
يتعلق الأمر بماهية الإنسان ذاته، أو بكينونته كما تُبنى في الأشكال الرمزية، وكما يلتقطها الحس ويعيد صياغتها وفق محددات قد لا يكون لها أي رابط مع المرجع الذي قد يحتضنها لاحقا.
يقدم هذا الكتاب جردا شاملا لكل القضايا التي يثيرها علم الدلالة : مدارسه وتياراته وجهات النظر وحالات تشكل المعنى ودور الثقافة وحالات النفس في ذلك، بل دور البرجمة البيولوجية، الدماغية، في صياغة لغة تتميز بكونها تحمل فكرا هو في الأصل سجلات دلالية دائمة التنوع والتجدد.